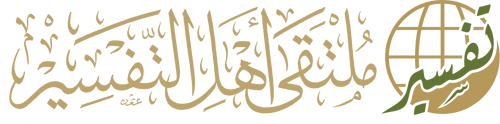يوسف العليوي
New member
- إنضم
- 05/07/2004
- المشاركات
- 103
- مستوى التفاعل
- 2
- النقاط
- 18
[align=justify]الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد،
فقد كنت في عام 1426هـ أدرس طلابي مقرر البلاغة في الدورة التأهيلية للانتساب بالجامعة، ووافقت الدراسة ليالي رمضان، فكانت مناسبة أن نتناول فيها آيات الصيام بالتحليل البلاغي حسب ما ندرسه، وجمعت في ذلك وريقات مما وقفت عليه في كتب التفسير، وما فتح الله به، ثم أردت أن أنقحها لتكون مقالة في الملتقى المبارك لأهل التفسير وعلوم القرآن، ثم علمت من أخي الفاضل د.عبدالعزيز العمار أنه كتب في بلاغة آيات الصيام وعرضها في الملتقى في عام مضى، فبحثت عنها فرأيته قد أجاد وأفاد، فلم أرد أن أكرر كل ما قال، ورأيت أن أذكر ما لم يذكره، ثم رأيت أن أذكر في هذه المقالة بعض الأساليب البلاغية التي أسهمت في غرض ركزت عليه آيات الصيام، وهو غرض التيسير على العباد والتهوين من مشقة التكليف عليهم، والتلطف بهم للترقي بهم من الأخف إلى الأشد، ترغيبًا للقيام بهذه العبادة العظيمة، وذلك من رحمة الله بنا وهو اللطيف الخبير، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
وأقول:
شرع الله عز وجل (الصيام) وفيه مشقة على العباد، حيث يجتنبون -عن تكليف لهم- ما تشتهيه نفوسهم من المآكل والمشارب والمناكح، مع ما يجدونه من مشقة الجوع والعطش، والتكليف بأي عبادة ومنها الصوم فيه مشقة على النفوس، لكن إذا كان التكليف بترك ما جبلت النفس على محبته والرغبة فيه، فإن المشقة عليها تكون أعظم، ولذا جاءت آيات الصيام بأساليب بلاغية تراعي تهوين الصيام على العباد وتيسير تلقيه، لعلهم يستجيبون ويرغبون في أدائه.
ومن هذه الأساليب ما يأتي:
1- النداء في أول الآيات (يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ).
وقد جاء هذا المكتوب –الصيام- متصلاً بمكتوبين على المؤمنين: القصاص، فالوصية؛ أما القصاص فنودي المؤمنون عند إعلامهم به، وأما الوصية فلم يكرر النداء، ثم كرر النداء لكتب الصيام، قال الله عز وجل: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) }.
ونداء المؤمنين بوصف (الإيمان) المحبب إليهم فيه مراعاة لطبيعة النفس البشرية التي يشق عليها التكليف، فتحتاج إلى ما يسهل عليها قبوله والاستجابة له، وإلى ما يستجيشها ويحثها ويدفعها للقيام به، فكان هذا النداء بهذا الوصف تسهيلاً وترغيبًا، وحثًا، وتذكيرًا بأن الإيمان بالله عز وجل يقتضي الاستجابة لأمره مهما كان شاقًا على النفس.
والنداء في مثل هذا المقام فيه تودد وتلطف، ولما كان الصيام مما يشق على النفوس كرر النداء، إظهارًا للتلطف بالعباد، وإظهارًا لمزيد الاعتناء بما سيلقى إليهم من تكليف، لعلهم يرغبون في القيام بما سيفرض عليهم مما قد يشق على نفوسهم.
وذكر بعض المفسرين أنه لم يحتج إلى نداء في المكتوب الثاني (الوصية) لانسلاكه مع الأول في نظام واحد، وهو: حضور الموت بقصاص أو غيره، وتباين هذا التكليف الثالث منها. وقد يكون لبعد العهد بالنداء الأول أثر فحسن التكرار، والله أعلم.
2- عبرت الآيات عن الوجوب والفرضية والإلزام بالكتابة (كتب)، فالكتابة كناية عن الوجوب، بدلالة التعدية بـ(على)، ولا يمنع القول بالكناية إرادة حقيقة الكتابة في اللوح المحفوظ.
وفي الكناية بالكتابة دلالة على ثبوت الحكم واستقراره ودوامه ((لأن ما كتب جدير بثبوته وبقائه)) كما قال في البحر المحيط، وقال ابن عطية في تفسير الآية (178) من سورة البقرة: ((الكَتْب مستعمل في الأمور المخلدات الدائمة كثيرًا))، وقال ابن عاشور في تفسير الآية نفسها: ((أصل الكتابة نقش الحروف في حَجَر أَوْ رَقِّ أو ثوب ولما كان ذلك النقش يراد به التوثق بما نقش به دوام تذكره أطلق "كُتِب" على معنى حَقَّ وثبت)).
وقد صيغ الفعل (كتب) ماضيًا، ولم يقيد المكتوب بزمن مستقبل، للدلالة على أن الصيام تكليف قائم قد تحقق وقوعه، فيبادر إلى فعله.
ومع هذه الدلالة فإن اختيار التعبير بـ(الكتابة) يتلاءم مع معنى التيسير والتسهيل والتهوين، لأن (الكتابة) أخف وأسهل على النفوس من التعبير بـ(الإلزام أو الوجوب أو الفرض)، خصوصًا أن المكتوب (الصيام) فيه مشقة عليها، بترك أعظم ما جبلت النفس على اشتهائه ومحبته والرغبة فيه.
3- بني الفعل الماضي (كُتِب) في هذه الآية وفي الآيتين اللتين سبقتا في (القصاص والوصية) لما لم يسم فاعله (المجهول، المفعول)، ومعلوم أن الذي كتب الصيام على العباد هو الله عز وجل، ولعل هذا الفعل جاء على هذه الصيغة لما في التكليف من مشقة وصعوبة على العبد، فلم يسند الفعل إلى الله عز وجل ظاهرًا في اللفظ، قال أبو حيان بعد أن ذكر هذا الوجه: ((وحين يكون المكتوب للمكلف فيه راحة واستبشار يبنى الفعل للفاعل، كما قال تعالى: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ} {كَتَبَ ٱللَّهُ لأّغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِىۤ} {أُوْلَـٰئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلإِيمَـٰنَ}. أما بناء الفعل للفاعل في قوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} فناسب لاستعصاء اليهود وكثرة مخالفاتهم لأنبيائهم، بخلاف هذه الأمة المحمدية، ففرق بين الخطابين لافتراق المخاطبين)).
4- قدم الجار والمجرور (عليكم) بما فيه من معنى الوجوب والإلزام على المفعول به الصريح (الصيام)؛ لأن المنادى حينما يعلم أنه هو المكلف فإن نفسه بعد ذلك تكون أكثر تنبهًا وارتقابًا لما ستكلف به، وهذا أسهل عليها مما لو جاءها من التكليف ما لا ترتقبه.
5- التعريف بالألف واللام في (الصيام) للعهد الذهني، أي: كتب عليكم جنس الصيام المعروف. والنفس أسهل عليها التكليف بما تعرفه، ولو لم تقم به من قبل، بخلاف ما لا تعرفه فإنه يشق عليها التكليف به، ولو كان أسهل مما تعرفه.
وقد كان العرب يعرفون الصوم، فقد جاء في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية»، وفي بعض الروايات قالت: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه»، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: «ما هذا؟»، فقالوا: هذا يوم نجَّى الله فيه موسى، فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق بموسى منكم فصام، وأمر بصومه» وسؤاله صلى الله عليه وسلم إنما هو عن مقصد اليهود من الصوم، لا عن أصل الصوم، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شاء صام يوم عاشوراء، ومن شاء لم يصمه». قال ابن عاشور: ((المأمور به صوم معروف جنسه، زيدت في كيفيته المعتبرة شرعًا قيود تحديد أحواله وأوقاته، بقوله تعالى: {فَالآَنَ بَاشِرُوهُنَّ} إلى قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]، وقوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ} [البقرة: 185] الآية، {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: 185) وبهذا يتبين أن في قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ} إجمالاً وقع تفصيله في الآيات بعده)).
6- التشبيه في قوله {كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ}.
ووجه الشبه قيل: في أصل الوجوب، وقيل في الكيفية، وقيل فيهما.
و(الذين من قبلنا) قيل: أهل الكتاب، وقيل: النصارى، وقيل: الأنبياء والأمم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام، والقول الأول مروي عن ابن عباس.
وأيا كان القول فإن للتشبيه بمن سبق أغراضًا عديدة ذكرها المفسرون، ومما ذكروه مما يتعلق بمقصدنا أن في التشبيه بالسابقين تهويناً على المكلفين بهذه العبادة أن يستثقلوا هذا الصوم؛ فإن في الاقتداء بالغير أسوة في المصاعب ((والشيء الشاق إذا عم سهل تحمله)) كما قال الرازي، وقال أبو السعود: ((فيه تأكيدٌ للحكم وترغيبٌ فيه وتطيـيبٌ لأنفس المخاطبـين به، فإن الشاقَّ إذا عمّ سهُل عملُه))، وقد قالت الخنساء:
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي
ومن أغراض التشبيه ما ذكره ابن كثير قال: ((ذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [المائدة: 48])).
7- التعليل في قوله تعالى: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} بيان لحكمة الصيام وما لأجله شرع، فهو في قوة المفعول لأجله لـ(كُتب).
والشيء الذي تظهر حكمته يكون أداؤه أخف على النفوس -ولو كان شاقًا- من الذي لم تظهر له حكمة، كيف والحكمة التي من أجلها شرع الصيام أمر يرغبه أهل الإيمان ويسعون في تحقيقه، وقد أمروا به من قبل، وذكر لهم ما يحببهم إليه ويرغبهم فيه، وقد سبق آيات الصيام في سورة البقرة الأمر بالتقوى في قوله تعالى: {فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} وقوله: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} وقوله: {وَلَوْ أَنَّهُمْ آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}. وسبق آيات الصيام في النزول الترغيب في التقوى في قول الله عز وجل في سورة الأنعام: {وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ} وقوله في سورة الأعراف: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} وقوله في سورة يونس: {إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ} وكذلك قوله: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآَخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} وغيرها من الآيات التي ترغب المؤمن في تحقيق التقوى.
وفي هذا الموضع فائدة ذكرها أبو حيان في البحر المحيط عند قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}: ((إذا كان التكليف شاقاً ناسب أن يعقب بترجي التقوى، وإذا كان تيسيراً ورخصة ناسب أن يعقب بترجي الشكر، فلذلك ختمت هذه الآية بقوله: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} لأن قبله ترخيص للمريض والمسافر بالفطر، وقوله: {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ} وجاء عقيب قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ} {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، وقبله {وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ} ثم قال: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}؛ لأن الصيام والقصاص من أشق التكاليف، وكذا يجيء أسلوب القرآن فيما هو شاق وفيما فيه ترخيص أو ترقية، فينبغي أن يلحظ ذلك حيث جاء، فإنه من محاسن علم البيان)).
8- التعليل جاء بـ(لعل)، وهي تستعمل للتعليل، وتستعمل أيضًا للترجي، والترجي فيه توقع وترقب لحصول الشيء، والتعليل له أدوات أخرى غير (لعل)، ولعل التعليل بها دون غيرها من أدوات التعليل لما تحمله من معنى الترجي، حيث يشعر العباد بقرب حصول العلة (التقوى)، وفي ذلك ترغيب لهم بالصيام وتيسير له.
9- التعبير عن الأيام بجمع القلة (أيام) على وزن (أفعال) وهو من أوزان القلة، ووصفها بـ(معدودات) وهو يشعر بالقلة، مما يهون الصيام على النفس، قال ابن عاشور: ((والمراد بالأيام من قوله: {أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ} شهر رمضان عند جمهور المفسرين، وإنما عبر عن رمضان بـ(أيام) وهي جمع قلة، ووصف بـ(معدودات) وهي جمع قلة أيضاً؛ تهوينًا لأمره على المكلفين، والمعدودات كناية عن القلة؛ لأن الشيء القليل يعد عدًّا؛ ولذلك يقولون: الكثير لا يعد، ولأجل هذا اختير في وصف الجمع مجيئه في التأنيث على طريقة الجمع بألف وتاء وإن كان مجيئه على طريقة الجمع المكسر الذي فيه هاء تأنيث أكثر)).
هذه بعض الأساليب البلاغية التي جاءت لتسهم في تيسير عبادة الصيام على العباد وترغيبهم فيها ليستقبلوا أمر الله لهم بها عن رغبة واستجابة تامة، وفي الآيات أساليب أخرى بلاغية وتشريعية، ولعل فيما ذكر تحفيزًا على تتبع ما بقي.
وقد صرح الله عز وجل في آيات الصيام بتيسير هذه العبادة وجميع التكاليف بقوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ} وجاء التعبير بأسلوب المقابلة، حيث أُثبت أولاً إرادة اليسر، ونُفي بعدها إرادة العسر، مع أنه يمكن التعبير بغير أسلوب المقابلة كأسلوب القصر الذي هو في قوة جملتي إثبات ونفي، بحيث يقال: لا يريد الله بكم إلا اليسر، وفي هذا التعبير إثبات لإرادة اليسر ونفي لإرادة غيره وهو العسر، لكنه نفي مفهوم وليس بمنطوق، ولعل كون التكليف بما يظن أن فيه مشقة على العباد يوهم إرادة العسر جاء التعبير بأسلوب المقابلة لينفي صراحة أي توهم بإرادة العسر، وليكون إرادة اليسر مقصود ابتداءً ليكون تعليلاً للرخصة في إفطار المريض والمسافر، قال ابن عاشور: ((قوله: {وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ} نفي لضد اليسر، وقد كان يقوم مقام هاتين الجملتين جملةُ قصر نحو أن يقول: ما يريد بكم إلا اليسر، لكنه عُدل عن جملة القصر إلى جملتي إثبات ونفي؛ لأن المقصود ابتداءً هو جملة الإثبات؛ لتكون تعليلاً للرخصة، وجاءت بعدها جملة النفي تأكيدًا لها، ويجوز أن يكون قوله: {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ} تعليلاً لجميع ما تقدم من قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ} إلى هنا، فيكون إيماء إلى أن مشروعية الصيام وإن كانت تلوح في صورة المشقة والعسر فإن في طيها من المصالح ما يدل على أن الله أراد بها اليسر)).
أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه وحسن فهمه وتدبره، وأن يسددنا في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.[/align]
فقد كنت في عام 1426هـ أدرس طلابي مقرر البلاغة في الدورة التأهيلية للانتساب بالجامعة، ووافقت الدراسة ليالي رمضان، فكانت مناسبة أن نتناول فيها آيات الصيام بالتحليل البلاغي حسب ما ندرسه، وجمعت في ذلك وريقات مما وقفت عليه في كتب التفسير، وما فتح الله به، ثم أردت أن أنقحها لتكون مقالة في الملتقى المبارك لأهل التفسير وعلوم القرآن، ثم علمت من أخي الفاضل د.عبدالعزيز العمار أنه كتب في بلاغة آيات الصيام وعرضها في الملتقى في عام مضى، فبحثت عنها فرأيته قد أجاد وأفاد، فلم أرد أن أكرر كل ما قال، ورأيت أن أذكر ما لم يذكره، ثم رأيت أن أذكر في هذه المقالة بعض الأساليب البلاغية التي أسهمت في غرض ركزت عليه آيات الصيام، وهو غرض التيسير على العباد والتهوين من مشقة التكليف عليهم، والتلطف بهم للترقي بهم من الأخف إلى الأشد، ترغيبًا للقيام بهذه العبادة العظيمة، وذلك من رحمة الله بنا وهو اللطيف الخبير، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
وأقول:
شرع الله عز وجل (الصيام) وفيه مشقة على العباد، حيث يجتنبون -عن تكليف لهم- ما تشتهيه نفوسهم من المآكل والمشارب والمناكح، مع ما يجدونه من مشقة الجوع والعطش، والتكليف بأي عبادة ومنها الصوم فيه مشقة على النفوس، لكن إذا كان التكليف بترك ما جبلت النفس على محبته والرغبة فيه، فإن المشقة عليها تكون أعظم، ولذا جاءت آيات الصيام بأساليب بلاغية تراعي تهوين الصيام على العباد وتيسير تلقيه، لعلهم يستجيبون ويرغبون في أدائه.
ومن هذه الأساليب ما يأتي:
1- النداء في أول الآيات (يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ).
وقد جاء هذا المكتوب –الصيام- متصلاً بمكتوبين على المؤمنين: القصاص، فالوصية؛ أما القصاص فنودي المؤمنون عند إعلامهم به، وأما الوصية فلم يكرر النداء، ثم كرر النداء لكتب الصيام، قال الله عز وجل: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) }.
ونداء المؤمنين بوصف (الإيمان) المحبب إليهم فيه مراعاة لطبيعة النفس البشرية التي يشق عليها التكليف، فتحتاج إلى ما يسهل عليها قبوله والاستجابة له، وإلى ما يستجيشها ويحثها ويدفعها للقيام به، فكان هذا النداء بهذا الوصف تسهيلاً وترغيبًا، وحثًا، وتذكيرًا بأن الإيمان بالله عز وجل يقتضي الاستجابة لأمره مهما كان شاقًا على النفس.
والنداء في مثل هذا المقام فيه تودد وتلطف، ولما كان الصيام مما يشق على النفوس كرر النداء، إظهارًا للتلطف بالعباد، وإظهارًا لمزيد الاعتناء بما سيلقى إليهم من تكليف، لعلهم يرغبون في القيام بما سيفرض عليهم مما قد يشق على نفوسهم.
وذكر بعض المفسرين أنه لم يحتج إلى نداء في المكتوب الثاني (الوصية) لانسلاكه مع الأول في نظام واحد، وهو: حضور الموت بقصاص أو غيره، وتباين هذا التكليف الثالث منها. وقد يكون لبعد العهد بالنداء الأول أثر فحسن التكرار، والله أعلم.
2- عبرت الآيات عن الوجوب والفرضية والإلزام بالكتابة (كتب)، فالكتابة كناية عن الوجوب، بدلالة التعدية بـ(على)، ولا يمنع القول بالكناية إرادة حقيقة الكتابة في اللوح المحفوظ.
وفي الكناية بالكتابة دلالة على ثبوت الحكم واستقراره ودوامه ((لأن ما كتب جدير بثبوته وبقائه)) كما قال في البحر المحيط، وقال ابن عطية في تفسير الآية (178) من سورة البقرة: ((الكَتْب مستعمل في الأمور المخلدات الدائمة كثيرًا))، وقال ابن عاشور في تفسير الآية نفسها: ((أصل الكتابة نقش الحروف في حَجَر أَوْ رَقِّ أو ثوب ولما كان ذلك النقش يراد به التوثق بما نقش به دوام تذكره أطلق "كُتِب" على معنى حَقَّ وثبت)).
وقد صيغ الفعل (كتب) ماضيًا، ولم يقيد المكتوب بزمن مستقبل، للدلالة على أن الصيام تكليف قائم قد تحقق وقوعه، فيبادر إلى فعله.
ومع هذه الدلالة فإن اختيار التعبير بـ(الكتابة) يتلاءم مع معنى التيسير والتسهيل والتهوين، لأن (الكتابة) أخف وأسهل على النفوس من التعبير بـ(الإلزام أو الوجوب أو الفرض)، خصوصًا أن المكتوب (الصيام) فيه مشقة عليها، بترك أعظم ما جبلت النفس على اشتهائه ومحبته والرغبة فيه.
3- بني الفعل الماضي (كُتِب) في هذه الآية وفي الآيتين اللتين سبقتا في (القصاص والوصية) لما لم يسم فاعله (المجهول، المفعول)، ومعلوم أن الذي كتب الصيام على العباد هو الله عز وجل، ولعل هذا الفعل جاء على هذه الصيغة لما في التكليف من مشقة وصعوبة على العبد، فلم يسند الفعل إلى الله عز وجل ظاهرًا في اللفظ، قال أبو حيان بعد أن ذكر هذا الوجه: ((وحين يكون المكتوب للمكلف فيه راحة واستبشار يبنى الفعل للفاعل، كما قال تعالى: {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ} {كَتَبَ ٱللَّهُ لأّغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِىۤ} {أُوْلَـٰئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلإِيمَـٰنَ}. أما بناء الفعل للفاعل في قوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} فناسب لاستعصاء اليهود وكثرة مخالفاتهم لأنبيائهم، بخلاف هذه الأمة المحمدية، ففرق بين الخطابين لافتراق المخاطبين)).
4- قدم الجار والمجرور (عليكم) بما فيه من معنى الوجوب والإلزام على المفعول به الصريح (الصيام)؛ لأن المنادى حينما يعلم أنه هو المكلف فإن نفسه بعد ذلك تكون أكثر تنبهًا وارتقابًا لما ستكلف به، وهذا أسهل عليها مما لو جاءها من التكليف ما لا ترتقبه.
5- التعريف بالألف واللام في (الصيام) للعهد الذهني، أي: كتب عليكم جنس الصيام المعروف. والنفس أسهل عليها التكليف بما تعرفه، ولو لم تقم به من قبل، بخلاف ما لا تعرفه فإنه يشق عليها التكليف به، ولو كان أسهل مما تعرفه.
وقد كان العرب يعرفون الصوم، فقد جاء في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية»، وفي بعض الروايات قالت: «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه»، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: «ما هذا؟»، فقالوا: هذا يوم نجَّى الله فيه موسى، فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نحن أحق بموسى منكم فصام، وأمر بصومه» وسؤاله صلى الله عليه وسلم إنما هو عن مقصد اليهود من الصوم، لا عن أصل الصوم، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شاء صام يوم عاشوراء، ومن شاء لم يصمه». قال ابن عاشور: ((المأمور به صوم معروف جنسه، زيدت في كيفيته المعتبرة شرعًا قيود تحديد أحواله وأوقاته، بقوله تعالى: {فَالآَنَ بَاشِرُوهُنَّ} إلى قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]، وقوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ} [البقرة: 185] الآية، {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: 185) وبهذا يتبين أن في قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ} إجمالاً وقع تفصيله في الآيات بعده)).
6- التشبيه في قوله {كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ}.
ووجه الشبه قيل: في أصل الوجوب، وقيل في الكيفية، وقيل فيهما.
و(الذين من قبلنا) قيل: أهل الكتاب، وقيل: النصارى، وقيل: الأنبياء والأمم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام، والقول الأول مروي عن ابن عباس.
وأيا كان القول فإن للتشبيه بمن سبق أغراضًا عديدة ذكرها المفسرون، ومما ذكروه مما يتعلق بمقصدنا أن في التشبيه بالسابقين تهويناً على المكلفين بهذه العبادة أن يستثقلوا هذا الصوم؛ فإن في الاقتداء بالغير أسوة في المصاعب ((والشيء الشاق إذا عم سهل تحمله)) كما قال الرازي، وقال أبو السعود: ((فيه تأكيدٌ للحكم وترغيبٌ فيه وتطيـيبٌ لأنفس المخاطبـين به، فإن الشاقَّ إذا عمّ سهُل عملُه))، وقد قالت الخنساء:
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي
ومن أغراض التشبيه ما ذكره ابن كثير قال: ((ذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم، فلهم فيه أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [المائدة: 48])).
7- التعليل في قوله تعالى: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} بيان لحكمة الصيام وما لأجله شرع، فهو في قوة المفعول لأجله لـ(كُتب).
والشيء الذي تظهر حكمته يكون أداؤه أخف على النفوس -ولو كان شاقًا- من الذي لم تظهر له حكمة، كيف والحكمة التي من أجلها شرع الصيام أمر يرغبه أهل الإيمان ويسعون في تحقيقه، وقد أمروا به من قبل، وذكر لهم ما يحببهم إليه ويرغبهم فيه، وقد سبق آيات الصيام في سورة البقرة الأمر بالتقوى في قوله تعالى: {فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} وقوله: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} وقوله: {وَلَوْ أَنَّهُمْ آَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}. وسبق آيات الصيام في النزول الترغيب في التقوى في قول الله عز وجل في سورة الأنعام: {وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ} وقوله في سورة الأعراف: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} وقوله في سورة يونس: {إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ} وكذلك قوله: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآَخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} وغيرها من الآيات التي ترغب المؤمن في تحقيق التقوى.
وفي هذا الموضع فائدة ذكرها أبو حيان في البحر المحيط عند قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}: ((إذا كان التكليف شاقاً ناسب أن يعقب بترجي التقوى، وإذا كان تيسيراً ورخصة ناسب أن يعقب بترجي الشكر، فلذلك ختمت هذه الآية بقوله: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} لأن قبله ترخيص للمريض والمسافر بالفطر، وقوله: {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ} وجاء عقيب قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ} {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، وقبله {وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ} ثم قال: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}؛ لأن الصيام والقصاص من أشق التكاليف، وكذا يجيء أسلوب القرآن فيما هو شاق وفيما فيه ترخيص أو ترقية، فينبغي أن يلحظ ذلك حيث جاء، فإنه من محاسن علم البيان)).
8- التعليل جاء بـ(لعل)، وهي تستعمل للتعليل، وتستعمل أيضًا للترجي، والترجي فيه توقع وترقب لحصول الشيء، والتعليل له أدوات أخرى غير (لعل)، ولعل التعليل بها دون غيرها من أدوات التعليل لما تحمله من معنى الترجي، حيث يشعر العباد بقرب حصول العلة (التقوى)، وفي ذلك ترغيب لهم بالصيام وتيسير له.
9- التعبير عن الأيام بجمع القلة (أيام) على وزن (أفعال) وهو من أوزان القلة، ووصفها بـ(معدودات) وهو يشعر بالقلة، مما يهون الصيام على النفس، قال ابن عاشور: ((والمراد بالأيام من قوله: {أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ} شهر رمضان عند جمهور المفسرين، وإنما عبر عن رمضان بـ(أيام) وهي جمع قلة، ووصف بـ(معدودات) وهي جمع قلة أيضاً؛ تهوينًا لأمره على المكلفين، والمعدودات كناية عن القلة؛ لأن الشيء القليل يعد عدًّا؛ ولذلك يقولون: الكثير لا يعد، ولأجل هذا اختير في وصف الجمع مجيئه في التأنيث على طريقة الجمع بألف وتاء وإن كان مجيئه على طريقة الجمع المكسر الذي فيه هاء تأنيث أكثر)).
هذه بعض الأساليب البلاغية التي جاءت لتسهم في تيسير عبادة الصيام على العباد وترغيبهم فيها ليستقبلوا أمر الله لهم بها عن رغبة واستجابة تامة، وفي الآيات أساليب أخرى بلاغية وتشريعية، ولعل فيما ذكر تحفيزًا على تتبع ما بقي.
وقد صرح الله عز وجل في آيات الصيام بتيسير هذه العبادة وجميع التكاليف بقوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ} وجاء التعبير بأسلوب المقابلة، حيث أُثبت أولاً إرادة اليسر، ونُفي بعدها إرادة العسر، مع أنه يمكن التعبير بغير أسلوب المقابلة كأسلوب القصر الذي هو في قوة جملتي إثبات ونفي، بحيث يقال: لا يريد الله بكم إلا اليسر، وفي هذا التعبير إثبات لإرادة اليسر ونفي لإرادة غيره وهو العسر، لكنه نفي مفهوم وليس بمنطوق، ولعل كون التكليف بما يظن أن فيه مشقة على العباد يوهم إرادة العسر جاء التعبير بأسلوب المقابلة لينفي صراحة أي توهم بإرادة العسر، وليكون إرادة اليسر مقصود ابتداءً ليكون تعليلاً للرخصة في إفطار المريض والمسافر، قال ابن عاشور: ((قوله: {وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ} نفي لضد اليسر، وقد كان يقوم مقام هاتين الجملتين جملةُ قصر نحو أن يقول: ما يريد بكم إلا اليسر، لكنه عُدل عن جملة القصر إلى جملتي إثبات ونفي؛ لأن المقصود ابتداءً هو جملة الإثبات؛ لتكون تعليلاً للرخصة، وجاءت بعدها جملة النفي تأكيدًا لها، ويجوز أن يكون قوله: {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ} تعليلاً لجميع ما تقدم من قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ} إلى هنا، فيكون إيماء إلى أن مشروعية الصيام وإن كانت تلوح في صورة المشقة والعسر فإن في طيها من المصالح ما يدل على أن الله أراد بها اليسر)).
أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يعلمنا تأويل كتابه وحسن فهمه وتدبره، وأن يسددنا في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.[/align]