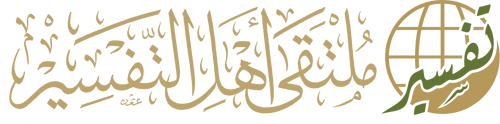محمد العبادي
مشارك فعال
- إنضم
- 30/09/2003
- المشاركات
- 2,157
- مستوى التفاعل
- 2
- النقاط
- 38
- الإقامة
- الخُبر
- الموقع الالكتروني
- www.tafsir.net

الحديث في ترجمة القرآن الكريم ذو شجون، ومع كثرة ما قيل فيه ووضوح حجج قائليه، يتكرر النقاش كلما جاءت مناسبته، وكثير منه خلاف لفظي لا يعود إلى حقيقة، ومنه ما يعود إلى تصوّر متخيّل في ذهن المتكلم لا يلبث أن يتبدد حين يصحّ تصور الأمر على ما هو عليه.
في هذا الموضوع نقف مع كلام شريف ذكره ابن الأثير في الفصل العاشر من مقدمة كتابه الشهير (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)، يتبيّن به حقيقة حال من أراد حلّ الشعر ونثره، وذلك في سياق حديثه عن الطريق إلى تعلّم الكتابة، وأن من أَعْوَن الأشياء عليها هو حلّ الأبيات الشعرية.
يقول رحمه الله:
"حل الأبيات الشعرية ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: منها، وهو أدناها مرتبة، أن يأخذ الناثر بيتًا من الشعر فينثره بلفظه من غير زيادة؛ وهذا عيب فاحش، ومثاله كمن أخذ عقدا قد أتقن نظمه وأحسن تأليفه فأوهاه وبدّده، وكان يقوم عذره في ذلك أن لو نقله عن كونه عقدا إلى صورة أخرى مثله أو أحسن منه وأيضا فإنه إذا نثر الشعر بلفظه كان صاحبه مشهور السرقة، فيقال: هذا شعر فلان بعينه، لكون ألفاظه باقية لم يتغير منها شيء، وقد سلك هذا المسلك بعض العراقيين فجاء مستهجنا لا مستحسنا...فلم يزد هذا الناثر على أن أزال رونق الوزن وطلاوة النظم لا غير.
ومن هذا القسم ضرب محمود لا عيب فيه، وهو أن يكون البيت من الشعر قد تضمن شيئا لا يمكن تغيير لفظه، فحينئذ يعذر ناثره إذا أتى بذلك اللفظ ...وكذلك الأمثال السائرة؛ فإنه لا بد من ذكرها على ما جاءت في الشعر.
وأما القسم الثاني: وهو وسط بين الأول والثالث في المرتبة، وهو أن ينثر المعنى المنظوم ببعض ألفاظه، ويعزم عن البعض بألفاظ أخر، وهناك تظهر الصنعة في المماثلة والمشابهة ومؤاخاة الألفاظ الباقية بالألفاظ المرتجلة؛ فإنه إذا أخذ لفظا لشاعر مجيد قد نقحه وصححه فقرنه بما لا يلائمه كان كمن جمع بين لؤلؤة وحصاة، ولا خفاء بما في ذلك من الانتصاب للقدح، والاستهداف للطعن.
والطريق المسلوك إلى هذا القسم أن تأخذ بعض بيت من الأبيات الشعرية هو أحسن ما فيه ثم تماثله...فإذا أردت أن تنثر هذا المعنى فلا بد من استعمال لفظه بعينه؛ لأنه في الغاية القصوى من الفصاحة والبلاغة، فعليك حينئذ أن تؤاخذه بمثله، وهذا عسر جدا وهو عندي أصعب منالا من ناثر الشعر بغير لفظه؛ لأنه مسلك مضيق؛ لما فيه من التعرض لمماثلة ما هو في غاية الحسن والجودة، وأما نثر الشعر بغير لفظه؛ فذلك يتصرف فيه ناثره على حسب ما يراه، ولا يكون مقيدا فيه بمثال يضطر إلى مؤاخاته...
وأما القسم الثالث: وهو أعلى من القسمين الأولين، فهو أن يؤخذ المعنى فيصاغ بألفاظ غير ألفاظه، وثمّ يتبين حذق الصائغ في صياغته، ويعلم مقدار تصرفه في صناعته؛ فإن استطاع الزيادة على المعنى فتلك الدرجة العالية، وإلا أحسن التصرف، وأتقن التأليف؛ ليكون أولى بذلك المعنى من صاحبه الأول.
واعلم أن من أبيات الشعر ما يتسع المجال لناثره، فيورده بضروب من العبارات، وذلك عندي شبيه بالمسائل السيالة في الحساب التي يجاب عنها بعدة من الأجوبة، ومن الأبيات ما يضيق فيه المجال حتى يكاد الماهر في هذه الصناعة ألّا يخرج عن ذلك اللفظ، وإنما يكون هذا لعدم النظير...
وسببه أن المعنى ينحصر في مقصد من المقاصد حتى لا يكاد يأتي إلا قدا...فإذا فك نظم هذا البيت وأريد صوغه بغير لفظه لا يمكن ذلك... وهو وأمثاله مما يجب على الناثر أن يحسن الصنعة في فكّ نظامه؛ لأنه يتصدى لنثره بألفاظه؛ فإن كان عنده قوّة تصرف وبسطة عبارة فإنه يأتي به حسنا رائقا" ا.ه. باختصار وتصرف 1/ 93-99
ولنا -أيها لأحبة- مع الكلام السابق وقفات:"حل الأبيات الشعرية ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: منها، وهو أدناها مرتبة، أن يأخذ الناثر بيتًا من الشعر فينثره بلفظه من غير زيادة؛ وهذا عيب فاحش، ومثاله كمن أخذ عقدا قد أتقن نظمه وأحسن تأليفه فأوهاه وبدّده، وكان يقوم عذره في ذلك أن لو نقله عن كونه عقدا إلى صورة أخرى مثله أو أحسن منه وأيضا فإنه إذا نثر الشعر بلفظه كان صاحبه مشهور السرقة، فيقال: هذا شعر فلان بعينه، لكون ألفاظه باقية لم يتغير منها شيء، وقد سلك هذا المسلك بعض العراقيين فجاء مستهجنا لا مستحسنا...فلم يزد هذا الناثر على أن أزال رونق الوزن وطلاوة النظم لا غير.
ومن هذا القسم ضرب محمود لا عيب فيه، وهو أن يكون البيت من الشعر قد تضمن شيئا لا يمكن تغيير لفظه، فحينئذ يعذر ناثره إذا أتى بذلك اللفظ ...وكذلك الأمثال السائرة؛ فإنه لا بد من ذكرها على ما جاءت في الشعر.
وأما القسم الثاني: وهو وسط بين الأول والثالث في المرتبة، وهو أن ينثر المعنى المنظوم ببعض ألفاظه، ويعزم عن البعض بألفاظ أخر، وهناك تظهر الصنعة في المماثلة والمشابهة ومؤاخاة الألفاظ الباقية بالألفاظ المرتجلة؛ فإنه إذا أخذ لفظا لشاعر مجيد قد نقحه وصححه فقرنه بما لا يلائمه كان كمن جمع بين لؤلؤة وحصاة، ولا خفاء بما في ذلك من الانتصاب للقدح، والاستهداف للطعن.
والطريق المسلوك إلى هذا القسم أن تأخذ بعض بيت من الأبيات الشعرية هو أحسن ما فيه ثم تماثله...فإذا أردت أن تنثر هذا المعنى فلا بد من استعمال لفظه بعينه؛ لأنه في الغاية القصوى من الفصاحة والبلاغة، فعليك حينئذ أن تؤاخذه بمثله، وهذا عسر جدا وهو عندي أصعب منالا من ناثر الشعر بغير لفظه؛ لأنه مسلك مضيق؛ لما فيه من التعرض لمماثلة ما هو في غاية الحسن والجودة، وأما نثر الشعر بغير لفظه؛ فذلك يتصرف فيه ناثره على حسب ما يراه، ولا يكون مقيدا فيه بمثال يضطر إلى مؤاخاته...
وأما القسم الثالث: وهو أعلى من القسمين الأولين، فهو أن يؤخذ المعنى فيصاغ بألفاظ غير ألفاظه، وثمّ يتبين حذق الصائغ في صياغته، ويعلم مقدار تصرفه في صناعته؛ فإن استطاع الزيادة على المعنى فتلك الدرجة العالية، وإلا أحسن التصرف، وأتقن التأليف؛ ليكون أولى بذلك المعنى من صاحبه الأول.
واعلم أن من أبيات الشعر ما يتسع المجال لناثره، فيورده بضروب من العبارات، وذلك عندي شبيه بالمسائل السيالة في الحساب التي يجاب عنها بعدة من الأجوبة، ومن الأبيات ما يضيق فيه المجال حتى يكاد الماهر في هذه الصناعة ألّا يخرج عن ذلك اللفظ، وإنما يكون هذا لعدم النظير...
وسببه أن المعنى ينحصر في مقصد من المقاصد حتى لا يكاد يأتي إلا قدا...فإذا فك نظم هذا البيت وأريد صوغه بغير لفظه لا يمكن ذلك... وهو وأمثاله مما يجب على الناثر أن يحسن الصنعة في فكّ نظامه؛ لأنه يتصدى لنثره بألفاظه؛ فإن كان عنده قوّة تصرف وبسطة عبارة فإنه يأتي به حسنا رائقا" ا.ه. باختصار وتصرف 1/ 93-99
- حلّ الشعر ونثره فنٌّ له أصوله وأهله، ولا يجيده إلا من ضرب في الفصاحة والبلاغة بسهم وافر.
- إذا كان حلّ الشعر بهذه المرتبة العالية وهو لا يعدو أن يكون نقلا لنوع من الكلام إلى نوع آخر داخل لغة واحدة، فكيف بنقله إلى لغة أخرى؟
وإذا كان ذلك كذلك فكيف بترجمة القرآن الكريم الذي هو أعلى الكلام وأفصحه وأبلغه، وإرادة نقل معانيه إلى لغة أخرى؟
- لا يصح نقل كلامٍ وحلُّه إلا بفهم معانيه، وتبيّن مفاصله ومبانيه ومحاسنه.
- من الكلام ما لا يمكن تغيير لفظه، إذا لا يقوم غيره مقامه.
- من الكلام ما لا يتوصل إلى أداء معناه إلا بالكلام الطويل وقوة التصرف وبسط العبارة.
وفوائد الكلام المنقول كثيرة، والمقصد من نقله هنا هو التأمل في حقيقة نقل الكلام وحلّه، وفهم طبيعة المعاناة في ذلك، والتي يتبيّن منها حقيقة عمل المترجم للقرآن للكريم، وتصحيح التصوّر الذي يدفع بالبعض إلى الظن بسهولة هذا الأمر، أو التقحم فيه دون آلة، أو القول بما يسمى بـ "الترجمة الحرفّية" والتي يتبين بما سبق أنها ليست سوى ظنٍّ لا يقوم أمام التطبيق العملي.