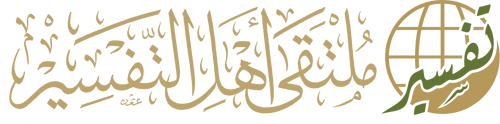بودفلة فتحي
New member
- إنضم
- 10/08/2010
- المشاركات
- 295
- مستوى التفاعل
- 1
- النقاط
- 18
أحاديث الآحاد
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]مصطلح الحديث الدرس الثاني: مسجد الفتح واد أوشايح الجزائر العاصمة
يوم الأحد 8 محرم 1438هـ الموافق لـ: 09 أكتوبر 2016م بعد صلاة المغرب
أبو إسماعيل فتحي بودفلة[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
الآحاد في الاستعمال اللغوي
في اللغة من مادة (و ح د) يقال لكل شيء انفرد وَحَدٌ[1]، والواحد أوّل العدد ومثله الأحد وإن كان لا يستعملان في المعنى ذاته تقول رأيتُ أحد الرجلين ولا تقول واحد الرجلين، تقول أحد وأحدان وآحاد وواحد وأوحد ووحدان[2]، وأصل هذه المادة الدلالة على الانفراد[3].
ولعل العلاقة بين دلالات واستعمالات هذه المادة وبين مفهومها اللغوي أنّ أحاديث الآحاد أحد أقسامه ما انفرد به واحدُ، أو ربّما اختاروا هذا اللفظ لدلالة آحاد النّاس على بعضهم، والبعض لا يرتقي لدرجة التواتر.
الآحاد في الاصطلاح:
· التسمية والاصطلاح: يطلق عليه اصطلاح خبر الآحاد وخبر الواحد، والاصطلاح الأوّل هو الصحيح؛ لأنّه يقع على جميع أفراده وأقسامه بخلاف الثاني فإنّه إنّما يقع مطابقة على أحد أنواع الآحاد فقط وهو الغريب. ومن أخذ به فإنّما اعتمده من باب خروج اللفظ مخرج الغالب، أي تسمية الشيء باسم غالب أحواله وأشهر أوصافه وعلى مثل هذا يحمل قوله تعالى: ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ النساء: ٢٣
· التعريف: هو الحديث الذي لم يرتق إلى درجة التواتر. أو هو الذي لم تتوفر فيه شروط التواتر[4]. وعرّفه ابن حجر بكونه من له طرق محصورة سواء بالواحد أو بالاثنين أو بما فوق الاثنين[5]، وينبغي أن نضيف ها هنا [إلى ما دون التواتر]
حكم خبر الآحاد:
· من حيث القبول والردّ: خبر الآحاد ليس كالمتواتر الذي يفيد العلم بذاته ويقبل دون البحث في أحوال رجال سنده، بل لا بدّ في الآحاد من الوقوف على أحوال رواته من حيث ضبطهم وعدالتهم والنظر في السند من حيث اتّصاله وفي المتن من حيث خلوّه من الشذوذ والعلل حتى يحكم للحديث بالصحة والقبول.
· من حيث إفادته للعلم وإيجابه للعمل: ذهب جماعة من أهل العلم ونسبه بعضهم للجمهور[6] أنّ خبر الآحاد إذا صحّ أفاد العلم وأوجب العمل، ومذهب الجمهور كما ذكر الإمام النووي[7] وابن حجر[8] أنّها تفيد الظنّ لاحتمال الخطأ وتوجب العمل لأنّه سبحانه وتعالى تعبّدنا بالظنّ. وإن حفت بقرائن كقبول الأمة، ورواية الصحيحين... فإنّها تفيد العلم والعمل. وذهب بعضهم إلى قصر العمل بها في الشريعة دون العقيدة، أو فيما لا يخالف عمل أهل المدينة، أو فيما لا يخالف الأصول العقلية، أو في غير الحدود والديات، أو في غير ما تعمّ به البلوى...[9]
· من حيث حكم منكره: من أنكر أحاديث الآحاد الصحيحة يختلف حكمه باعتبار سبب ومورد هذا الانكار فقد يكون من أهل الاجتهاد الذين ينكرون الاحتجاج بالآحاد في بعض المسائل العلمية، وقد يكون من الذين ينكرون الاحتجاج بالسنة، وقد يكون ممّن يريد التفلت من بعض الشرائع والأحكام... ولهذا يتردد حكم منكر أخبار الآحاد بين التكفير والخطأ والله أعلم.
أقسامه:
أوّلا: الغريب
الغريب في اللغة: مادته اللغوية (غ ر ب)، ذهب ابن فارس إلى أنّ استعمالاته غير مُنقَاسَة فلا تجتمع في أصلٍ واحدٍ، ولكنّها متجانسة[10]، من استعمالات هذه المادة ودلالاتها اللغوية البعيد، والغامض، والتنحي، والذهاب، والتمادي، والحدّة، والنفي....[11]
في الاصطلاح:
· تسمياته: يطلق عليه أيضا اطلاح "الفرد" والجمع "أفراد".[12]
· تعريفه: هو ما رواه في طبقة من طبقاته أو أكثر راوٍ واحدٌ.
حكمه: من حيث صحته، يتردد بين القَبول والردّ، لذا ينظر في سنده ومتنه فإن توفّرت فيه شروط القبول فهو صحيح أو حسن، وإن لم تتوفر فيه فهو ضعيف.
أمّا تحذيرات السلف ونهيهم عن الاشتغال بغريب الحديث ، فمحمول على الاصطلاح القديم الذي كان يطلق عند بعضهم على الضعيف المردود[13]، أو لأنّ الغريب يغلب عليه الضعف والردّ ومن هذا القبيل قول الإمام أحمد بن حنبل "لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنّها مناكير وعامتها عن الضعفاء"[14].
أقسامه: باعتبار موضع الغرابة في الحديث : قال الحافظ ابن كثير: "أما الغرابة فقد تكون في المتن؛ بأن يتفرّد بروايته راوٍ واحدٌ، أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحدٌ زيادةً لم يقلها غيرُهُ... وقد تكون الغرابةُ في الإسنادِ، كما إذا كان أصلُ الحديثِ محفوظاً من وجهٍ آخرَ أو وجوهٍ، ولكنّه بهذا الإسنادِ غريبٌ."[15]
لكن غرابة المتن لا تكون إلاّ مصحوبة بغرابة في السند[16].
باعتبار نسبة الغرابة إلى جهة معيّنة أو مطلقة: (الفرد المطلق والنسبي)
الفردُ المطلقُ: هو ما تقدّم تعريفه من انفراد راوٍ واحد في طبقة أو أكثر من طبقات السند برواية هذا الحديث ومثاله:
حديث: "إنما الأعمال بالنّيات" تفرد به عمر بن الخطّاب رضي الله عنه في أصل السند كما تفرّد به عنه علقمة بن وقاص وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد ثمّ تواتر بعده.
حديث: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع الولاء وهبته" تفرّد به عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه.
الفردُ النّسبيُّ: ويسمى بالفرد المقيّد، وهو الغريب والفرد بالنسبة لوصف معيّن، أي بإضافته لرجل أو بلدٍ أو متن.
مثال 1: أن لا يرويه عن فلان إلاّ فلان، حديث "قصة الكدية الشديدة التي عرضت لهم يوم الخندق" أخرجه البخاري من حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
مثال 2: أن ينفرد راوٍ بجزء من المتن، كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم فرضَ زكاة الفطر من رمضان على كلّ حُرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى، من المسلمين." ذكر الترمذي أنّ مالكا انفرد بع عن نافع.[17]
مثال 3: أن ينفرد به أهل مدينة، حديث عائشة رضي الله عنها "والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم على سهل بن بيضاء وأخيه في المسجد." قال الحاكم: تفرد به أهل المدينة.[18]
مثال 4: انفراد أهل مصر عن أهل مصر آخر، حديث "إنّه كان ينهي عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال" فقد انفرد به أهل البصرة عن أهل الكوفة.
التفريق في الاصطلاح بين الغريب والفرد:
قال ابن حجر: الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلاّ أنّ أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلّته، فالفرد ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي."[19]
كتب ألفت في الغرائب والأفراد: "الأفراد" للدارقطني في مائة جزء، ذكر الشيخ الألباني أنّه يوجد منه في ظاهرية دمشق جزءان، جمع كتاب الدارقطني الحافظ محمد بن طاهر في (أطراف)[20].
ومن مظان الغرائب والأطراف: مسند البرزار - غرائب مالك للدراقطني - السنن التي تفرّد بها أهل كلّ بلد لأبي داود - ما وصفه الترمذي بقوله: غريب من هذا الوجه أو لا يروى إلاّ من هذا الوجه.[21]
ثانيا: الحديث العزيز
العزيز في اللغة[22]: من المضاعف عزّ، مادته (ع ز ز)، عزَّ يَعِزُّ، عِزّاً، والْعُزَّى: تَأْنِيثُ الْأَعَزِّ، وَالْجَمْعُ عُزَزٌ. وَيُقَالُ الْعُزَّانُ: جَمْعُ عَزِيزٍ، وَالذُّلَانُ: جَمْعُ ذَلِيلٍ. قال ابن فارس: "العين والزاي أصل صحيحٌ واحدٌ، يدلّ على شِدّة وقوّة وما ضاَهَاهُما، من غلبةٍ وقهرٍ." ولهذه المادة في اللغة استعمالات عدّة منها الندرة يقال: عزّ الشيء حتى يكاد لا يوجد ومن هذا قولهم: "أَعَزُّ مِنْ بَيْضِ الْأَنُوقِ"، و"أَعَزُّ مِنَ الْأَبْلَقِ الْعَقُوقِ"، و"أَعَزُّ مِنَ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ" و"أَعَزُّ مِنْ مُخَّةِ الْبَعُوضِ". والتَّقَوِي ومنه قوله تعالى {فعزّزنا بثالث} [يس14] والغلبة، وعِظم الشيء، والناقة ضيقة الإحْلِيل، والموت، والأرض المستوية التي لا تنبت، وأوّل الشيء وطرفه، زالسّنة الشديدة، والمطر الشّديد... ويطلق مجازا على البخيل الموسر وعلى المريض إذا اشتدّ مرضه وعلى لحم الناقة إذا صلب واشتدّ... ولعلّ أشبه هذه الدلالات بالاستعمال الاصطلاحي التَّقَوي والندرة.
العزيز في الاصطلاح
اختلافهم في تعريف الحديث العزيز:
اختلفت عبارات وصيغ علماء الحديث في تعريف العزيز، فابن حجر وحده وردت عنه عبارات عدّة وألفاظ شتّى كقوله في نخبة الفكر : "وهُو أَنْ لا يَروِيَه أقلُّ مِن اثنين عن اثنين"[23] ومثله قوله: "ما رواه اثنان عن اثنين وهكذا..." وعرّفه في موضع آخر بقوله: "ما لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين وهكذا وقد يزيد في بعض طبقاته."[24]
وفي بعض هذه العبارات إيهام اشتراط الراويين في جميع طبقات الحديث، وهذا الذي دفع جماعة من المحدثين كابن حبان[25] وغيره إلى القول باستحالة وجود الحديث العزيز.
وممّا يدل على أنّ ابن حجر رحمه الله لا يرى اشتراط الراويين في جميع طبقات السند قوله متعقّبا مذهب ابن حبّان ورأيه: " قلت: إن أراد أَنَّ رِوايَةَ اثْنَيْنِ فَقَطْ عَنِ اثْنَيْنِ فَقَطْ لا يُوجد أَصْلاً فَيُمْكِنُ أَنْ يُسَلَّمَ، وأَمَّا صُورَةُ العَزيزِ الَّتي حَرَّرْناها فمَوْجودَةٌ بأنْ لا يرويَهُ أقلُّ مِن اثْنَيْنِ عَنْ أقلَّ مِنَ اثْنَيْنِ."
وللخروج من هذا اللبس في التعريف نقول: "الحديث العزيز هو الذي يرويه في طبقة من طبقاته أو أكثر راويان اثنان"
ويشترط في الحديث العزيز حتى يصدق عليه هذا الاصطلاح أن لا يرويه في طبقة من طبقاته أقلّ من اثنين؛ وإلاّ أُدرِج في خانة الحديث الغريب، وهذا هو معنى قول ابن حجر رحمه الله: " أن لا يرويه أقلّ من اثنين عن أقلّ من اثنين."
ولا يضر الحديث العزيز أن يرويه في باقي طبقاته أكثر من اثنين، إن اقتصرت طبقة من طبقاته على راويين اثنين؛ لأنّ العبرة في تسمية الحديث باعتبار عدد رواته بالطبقة الأقلّ رواة من طبقات السند ولا يعتد بالطبقة الأكثر رواة.
هل رواية الثلاثة تندرج في الحديث العزيز؟
قال ابن الصلاح: روينا عن الحافظ أبي عبد الله بن منده أنه قال: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا"[26].
ظاهر الكلام الذي نقله ابن الصلاح أنّ الحديث العزيز هو الذي يرويه في طبقة من طبقاته أو أكثر راويان أو ثلاثة وما فوق ذلك يسمى مشهورا وما دون ذلك هو الفرد والغريب.
وعبارة البيقونية تفيد ذلك أيضا :
عزيز مروي اثنين أو ثلاثة ... مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
ونسب الدكتور نور الدين عتر هذا الرأي للإمام النووي كذلك[27].
ويبدو والله أعلم أنّه اصطلاح خاص بهؤلاء الأعلام، ككثير من مفاهيم واصطلاحات علوم الحديث ولكن ما أثبتناه أوّلاً والاصطلاح الذي استقرّ عليه علم مصطلح الحديث والله أعلم.
سبب التسمية:
قال ابن حجر مبيّنا سبب تسميته بالعزيز: "وسُمِّيَ بذلك إِمَّا لقلةِ وجودِهِ، وإِمَّا لكونِهِ عَزَّ، أَيْ قَوِيَ بمَجيئِهِ مِن طريقٍ أُخْرى."[28]
أمثلة للحديث العزيز:
مثاله ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة والشيخان من حديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين" , فقد رواه من الصحابة أنس وأبو هريرة ورواه عن أنس اثنان: قتادة، وعبد العزيز بن صهيب ورواه عن قتادة اثنان: شعبة، وسعيد، ورواه عن عبد العزيز اثنان: إسماعيل بن علية، وعبد الوارث ورواه عن كل منهما جماعة.[29]
حكم العزيز:
من حيث القبول والردّ ينظر في سنده ومتنه إن توفّرت فيه شروط القبول فهو صحيح أو حسن وإن لم تتوفر فيه فهو ضعيف.
اصطلاحات خاصة للعزيز:
· اشتراط بعضهم العزّة لصحة الحديث: قال ابن حجر: "ولَيْسَ شَرْطاً للصَّحيحِ، خِلافاً لمَنْ زَعَمَهُ، وهو أَبو عَليٍّ الجُبَّائِي مِن المُعْتزلةِ، وإِليهِ يومئُ كلامُ الحاكِمِ أَبي عبد اللهِ في علومِ الحديثِ، حيثُ قال: الصَّحيحُ أنْ يَرْوِيَهُ الصحابيُّ الزائلُ عنهُ اسمُ الجَهالة؛ بأَنْ يكونَ لهُ راويان، ثم يتداوله أَهلُ الحَديثِ إِلى وَقْتِنِا، كالشَّهادَةِ عَلى الشَّهادَةِ."[30]
· وزعم ابن العربي المالكي في شرحه على البخاري أنّ العزّة من شروط البخاري في صحيحه[31] وهذا مردود بما في صحيح البخاري من الأحاديث الغريبة والمفردة وعلى رأسها حديث عمر رضي الله عنه "إنّما الأعمال بالنياّت".
· رأي خاص بالدكتور اللاحم[32] يلغي قسم العزيز: يقول د. إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن اللاحم في شرحه لاختصار علوم الحديث "حسب ما وقفت عليه منذ درست المصطلح منذ سنوات طويلة، وأنا أبحث عن نص.. عن إمام يطلق العزة فيريد بها عدد الطرق، سواء اثنان أو ثلاثة، ما وقفت -إلى الآن- على مثال للعزيز، وإنما يطلق الأئمة العزة، ويريدون بها الندرة، فيقولون فلان عزيز الحديث، أو حديثه يعز، ونحو هذه الكلمات، هذه موجودة بكثرة، ولا يريدون بها أنها قسيم للغريب والمشهور...إذن نخلص من هذا الكلام بأمر، وهو بساطة التعريف، بساطة الاستخدام، الحديث إما غريب وإما خرج عن حد الغرابة إلى الشهرة، وتستريح، من يعني.. حتى أن تعريف الحديث مثال الحديث العزيز، مثل ابن حجر -رحمه الله- بمثال واحد، واعترض عليه باعتراضات، وفهمه صعب عسر جدا فهمه، موجود في النزهة، ويتداول هذا المثال إلى وقتنا الحاضر، يتداول هذا المثال إلى وقتنا الحاضر، مثال واحد...فالمقصود أن استخدام كلمة عزيز إذا يعني نحيتها يبقى عندك الشهرة والعزة." اهـ
ثالثا: الحديث المشهور
المشهور في اللغة:
اسم فاعل أو اسم مفعول من مادة (ش هـ د)، تقول شَهِدَ يَشْهَدُ شُهُودا وشَهادةً، قال ابن فارس: "الشِّينُ وَالْهَاءُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى وُضُوحٍ فِي الْأَمْرِ وَإِضَاءَةٍ."[33]
من استعمالاتها ودلالتها اللغوية: الخبر القاطع، المعاينة، الحضور، الانتشار، الذيوع، الظهور، العلامة، الإضاءة[34]...إلخ
تعريف الاصطلاحي:
"ما لَهُ طرقٌ محصورةٌ بأكثرَ مِن اثْنَيْنِ ولم يبلغ حدّ التواتر."[SUP][SUP][35][/SUP][/SUP]
"ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، ما لم يبلغ حد التواتر."[SUP][SUP][36][/SUP][/SUP]
هو الذي يرويه في طبقة من طبقاته أو أكثر ثلاثة رواة أو أكثر من ثلاثة ما لم يبلغوا حدّ التواتر أو يقلّوا عن ثلاثة.
حكمه:
من حيث القبول والردّ أو من حيث إفادته للعلم والعمل، ينظر في حال سنده ومتنه إن توفرت فيهما شروط الصحّة فهو مقبول يعمل به في الاعتقاد والأحكام على حدٍّ سواء كسائر أقسام أحاديث الآحاد، وإن لم تتوفر فيهما شروط الصحة فهو مردود لا يحتجّ به إلاّ في حدود سيأتي بيانها في محلّها.
الفرق بين المشهور والمستفيض: اختلف المحدثون في التفريق بين المشهور والمستفيض إلى ثلاثة أقوال:
1. هما بمفهوم واحد.
2. المُسْتَفيضَ يكونُ في ابتدائه وانْتِهائِهِ سَواء، والمَشْهورَ أعمُّ مِنْ ذلكَ.
3. عكس ذلك، المستفيض أعمّ من المشهور.
وللقاضي الماوردي اصطلاح ، فالمستفيض عنده أقوى من المتواتر، قال ابن كثير في الباعث الحثيث : "وهذا اصطلاح منه"[37].
وظاهر ما رجحه واختاره إليه الشيخ الألباني رحمه الله أنّ المستفيض ما زاد نقلته عن الثلاثة إلى ما دون المتواتر، والمشهور ما رواه أكثر من اثنين، والمتواتر فوق المستفيض[38]. فالحديث عنده يبدأ غريبا ويرتقي للعزيز فالمشهور ثمّ المستفيض لينتهي إلى التواتر.
أمثلة للمشهور:
من الأحاديث التي يمثلون بها للمشهور حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبق عالماً) وفي رواية: (لم يَبق عالم). الحديث رواه البخاري
"اتقوا الله ولو بشقّ ثمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة" رواه البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم.
"انصر أخاك ظالما أو مظلوما" رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه.
"تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
المشهور عند الحنفية:
المتواتر عند الحنفية هو قسيم للمتواتر والآحاد؛ إذ القسمة عندهم ثلاثية:متواتر، مشهور، وآحاد. وهو ما كان آحاداً في أصل روايته أي في الطبقة الأولى لكن اشتهر وانتشر وتواتر في الطبقة الثانية وما بعدها
ويمثلون للحديث المشهور بحديث عمر بن الخطاب " إنما الأعمال بالنيات ".
وحكمه عندهم أنّه يفيد علم الطمأنينة في حين أن المتواتر يفيد علم اليقين، أي أنه قريب من حكم المتواتر لكنه أقل رتبة من المتواتر ، وهو عندهم يصلح لكلّ ما يصلح الحديث المتواتر من نسخ القرآن والزيادة عليه[39] .
وقال الجصاص وأبو بكر الرازي من الحنفية: "أن المشهور أحد قسمي المتواتر".[40] فالقسمة على هذا ثنائية متواتر وهو قسمان : متواتر ومشهور، وآحاد وهو بدوره قسمان: غريب وعزيز. المشهور المعروف عند الحنفية ما ذكرناه أوّلا من كون القسمة عندهم ثلاثية والله أعلم.
المشهور في غير الاصطلاح:
هو المشهور بمعناه اللغوي، وهو بالنظر إلى سنده وطرق روايته قد لا يكون له سند أصلا وقد يكون له سند واحد أو أكثر متواترا أو آحادا...
فمن أمثلة الأحاديث المشهورة ولكنّها موضوعة أو ضعيفة "اطلب العلم ولو في الصين" قال ابن حبان باطل لا أصل له. "اجتماع الخضر وإلياس كل عام في الموسم" قال الحافظ لا يثبت منه شيء. "رضا النّاس غاية لا تدرك" لا يصح مرفوعا ومثله "زرْ غِبّاً تزدد حبّاً" و"الحسود لا يسود" و"صاحب الحاجة أعمى" و"كلْ الصيد في جوف الفرا" وحديث"السلام قبل الكلام" منكر، و"سيد القوم خادمهم" فيه ضعف وانقطاع، و"حسنات الأبرار سيئات المقربين" لا أصل له، "مثله "اختلاف أمتي رحمة"[41].
ويختلف هذا النوع باختلاف من وقعت الشهرة عندهم، ومن أمثلته:
المشهور عند الفقهاء:
حديث المسيء صلاته، وإنّما اشتهر عندهم لكونه أصلا في فقه الوضوء والصلاة، ومثله حديث مالك بن الحويرث في الصلاة "صلوا كما رأيتموني أصلي" وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين في الحجّ "خذوا مناسككم عنّي"، وحديث إنّما الأعمال بالنّيات – عند غير الحنفية- فهم يذكرونه في أوّل جميع مسائل ومباحث العبادات.
المشهور عند الأصوليين:
"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" فهو أصل في باب عوارض الأهلية، وكثيرا ما يذكرونه في باب الحكم التكليفي وباب المحكوه عليه، وشروط التكليف...إلخ.
المشهور عند علماء اللغة:
حديث "ليس من امبِرّ امصِيامُ في امسَفَر" رواه أحمد والطبراني في الكبير بهذا اللفظ عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه. إنّما اهتم به اللغويون لأنّه جاء على لغة الأشعريين ولأنّه يثبت ظاهرة صوتية هي إبدال اللام ميما.
المشهور عند النحاة:
"نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه". إنّما اهتموا به لأنّه من شواهدهم على أبواب عدّة من ابواب النحو كأدوات الشرط، والجزم، ومخصوص نعم، وأساليب التخلص من التقاء الساكنين...إلخ.
المشهور عند القضاة:
"أبغض الحلال إلى الله الطلاق" وهو حديث ضعيف، لكنّ القضاة كثيرا ما يستعملوه محاولين الصلح بين الأزواج المتخاصمين قبل اللجوء إلى إيقاع الطلاق.
المشهور عند الدعاة:
"بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ" وإنّما اشتهر عندهم من حيث كون عملهم واجتهادهم في الإصلاح إنّما يبدأ من ملاحظة غربة الإسلام وابتعاد المجتمعات عن تمثل حقيقته.
المشهور عند المحدثين بغير دلالته الاصطلاحية:
لا يستبعد أن يستعمل المحدّث اصطلاح المشهور بدلالته اللغوية، يريد به الحديث المعروف المتداول بين المحدثين، ومثاله حديث أنس أنس: "قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان".
المشهور عند العوام:
"حبّ الوطن من الإيمان" أو "العجلة من الشيطان" أو "النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان" وأكثر هذه النّصوص ليست أحاديث اصلاً.
وفي هذا الصنف الأخير يقول الإمام أحمد: أربعة أحاديث تدور في على رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الأسواق ليس لها أصل: "من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنّة" و"من آذى ذميّاً فأنا خصمه يومَ القيامة" و"نحركم يوم صومكم" و"للسائل حقّ وإن جاء على فرس".[42]
كتب ألّفت في الأحاديث المشهورة[43]:
التذكرة في الأحاديث المشهورة لبدر الدين الزركشي (ت794هـ)
اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة لابن حجر
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي (ت902هـ)
كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة النّاس للعجلوني الجراحي (1162هـ)
النوافح العطرة في الأحادي المشتهرة للقاضي محمد بن أحمد الصنعاني (1223هـ ).
قائمة المصادر والمراجع:
1. جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (321هـ). تحقيق رمزي منير بعلبكي. دار العلم للملايين – بيروت الطبعة الأولى، 1987م
2. معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (395هـ). تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار الفكر 1399هـ - 1979م.
3. مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر عبد القادر الحنفي الرازي (666هـ) تحقيق يوسف الشيخ محمد. المكتبة العصرية بيروت والدار النموذجية صيدا (د ت).
4. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو العباس (770هـ) المكتبة العلمية بيروت.
5. أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (538هـ). تحقيق: محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة الأولى 1419 هـ - 1998م
6. معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر (1424هـ) بمساعدة فريق عمل عالم الكتب 1429هـ 2008م.
7. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (852هـ) تحقيق وتعليق نور الدين عتر. مطبعة الصباح، دمشق الطبعة الثالثة، 1421 هـ - 2000 م.
8. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، مصطفى سعيد الخن. مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 1402هـ 1982م
9. العقيدة في الله، سليمان الأشقر. دار النفائس عمان الطبعة الثانية عشر 1419هـ 1999م .
10. خبر الواحد حجيته، أحمد محمود عبد الوهاب. المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية 1413هـ.
11. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (مطبوع ملحقا بكتاب سبل السلام)، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (852هـ) تحقيق عصام الصبابطي - عماد السيد. دار الحديث – القاهرة. الطبعة الخامسة، 1418 هـ - 1997 م.
12. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ). تحقيق عبد الله بن ضيف الله الرحيلي. مطبعة سفير بالرياض الطبعة الأولى، 1422هـ.
13. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة (المتوفى: 1403هـ). دار الفكر العربي.
14. الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجاني (365هـ) تحقيق عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوض. الكتب العلمية - بيروت-لبنان. الطبعة الأولى، 1418هـ1997م.
15. معرفة أنواع علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (643هـ) تحقيق عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين الفحل. دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1423 هـ / 2002 م.
- معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد، محمد ضياء الرحمن الأعظمي. أضواء السلف الرياض الطبعة الأولى 1420هـ 1999م .
18. مختصر علوم الحديث أو مقدمة ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 643هـ). تحقيق نور الدين عتر. دار الفكر- سوريا، دار الفكر المعاصر – بيروت 1406هـ - 1986م.
- قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت 489هـ) تحقيق محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة الأولى، 1418هـ/1999م.
[1] جمهرة اللغة 3\1301.
[2] جمهرة اللغة 1\507.
[3] مقاييس اللغة 6\90.
[4] نزهة النظر على نخبة الفكر 51.
[5] نخبة الفكر ص 721. (طبع ملحقا بكتاب سبل السلام، انظر بيانات الكتاب في فهرست المصادر والمراجع)
[6] معجم مصطلحات الحديث ص15.
[7] انظر: شرح النووي على مسلم، المطبعة المصرية بالأزهر، ط1، 1347هـ/1929م، 1/20- 130، 131
[8] شرح النخبة لابن حجر، تحقيق د. نور الدين عتر، دار البصائر، ط1، 2011، ص51. 52
[9] انظر: أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، مصطفى سعيد الخن. مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 1402هـ 1982م ص410- 426... العقيدة في الله، سليمان الأشقر. دار النفائس عمان الطبعة الثانية عشر 1419هـ 1999م . خبر الواحد حجيته، أحمد محمود عبد الوهاب. المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية 1413هـ.
[10] مقاييس اللغة 4\420.
[11] العين 4\409...، تهذيب اللغة 8\116...، أساس البلاغة 1\696، مختار الصحاح 225، المصباح المنير 2\444، معجم اللغة العربية المعاصرة 2\1601...
[12] معجم مصطلحات الحديث ص289.
[13] وهو أحد استعمالات الإمام الترمذي.
[14] الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي الجرجاني. 1\111.
[15] الباعث الحثيث 2\460.
[16] انظر: معرفة أنواع الحديث ص374-375
[17] الباعث الحثيث 1\191
[18] انظر أمثلة لتفرّد أهل مكة والكوفة وغيرها من الأمصار في: تعليقات عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين الفحل على معرفة أنواع علوم الحديث ص185.
[19] انظر معجم مصطلحات الحديث ص48-49 وأحال على شرح النخبة ص29.
[20] الباعث الحثيث 1\189
[21] معجم مصطلحات الحديث 49.
[22] مقاييس اللغة 4\38...42.
[23] نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (نسخة الرحيلي) ص50.
[24] الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ص 201.
[25] نزهة النظر ص 53.
[26] مقدمة ابن الصلاح النوع الحادي والثلاثون (نسخة نور الدين عتر ص270) وانظر الباعث الحثيث 2\460.
[27] منهج النقد في علوم الحديث ص416.
[28] نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ص51 (نسخة الرحيلي).
[29] معجم مصطلحات الحديث ص285.
[30] نزهة النظر (الرحيلي) ص51.
[31] المصدر نفسه.
[32] د. إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن اللاحم، من مواليد عام 1376هـ في مدينة بريدة، تخرّج من كلية الشريعة بالرياض، عام 1396هـ، ناقش رسالة الماجستير في تحقيق كتاب "الكشف الحثيث في من رمي بوضع الحديث" لبرهان الدين الحلبي عام 1401هـ، وناقش رسالة الدكتوراه في كتاب "التحقيق في أحاديث التعليق" لابن الجوزي عام 1409هـ، وهو عضو في هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود فرع القصيم، نفع الله به وسدد خطاه.
[33] مقاييس اللغة 3\222.
[34] الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 2\494، مقاييس اللغة 3\222.
[35] نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (الرحيلي) ص49.
[36] الشرح المسموع لنخبة الفكر لـ: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير، الدرس الثالث.
[37] الباعث الحثيث 2\455.
[38] المرجع نفسه.
[39] انظر: قواطع الأدلة في الأصول ج: 1 ص: 397
[40] الشرح المسموع لنخبة الفكر لـ: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير
الدرس الثالث.
[41] معجم مصطلحات الحديث ص415-416.
[42] ذكره ابن الجوزي في الموضوعات 2\236 ولا يصح هذا الكلام عن الإمام أحمد قاله العراقي في التقييد والإيضاح 263. انظر معجم مصطلحات الحديث ص416. وحديث الأخير روي بألفاظ متقاربة في سنن أبي داود في كتاب الزكاة باب حق السائل 2\428 وأحمد عن الحسين بن علي مرفوعا 1\201 ومالك مرسلا عن زيد بن أسلم 2\996 ...قال العراقي في التقييد والإيضاح: "حديث أبي داود وأحمد إسناده جيد ورجاله ثقات" انظر: معجم مصطلحات الحديث هامش الصفحة 416-417
[43] الباعث الحثيث 2\456. معجم مصطلحات الحديث 417-418.
أخوكم فتحي بودفلة