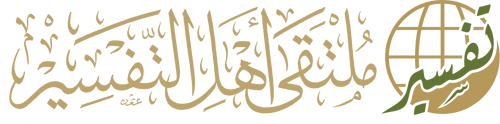مساعدأحمدالصبحي
New member
الحمد لله .. وبعد
مهما بلغ طالب العلم والعالم من التمكن في العلم إلا أنه يحتاج لشيء مختصر ميسّر أثناء تلاوته وتدبره للقرآن، شيء عاجل لا يقطع عليه ورده اليومي ويشغله عن إتمامه
ومن هنا كان كتاب : "التفسير الواضح الميسّر" للشيخ محمد علي الصابوني أنفع ما رأيت لجميع الطبقات بلا استثناء ، ينتفع به المبتديء ، ويفزع إليه المنتهي، ولا يملّه من بينهما
وقد أثنى عليه المشرف العام على هذا الملتقى فقال:
وفي الرابط التالي تقريض وثناء من مستشار الملتقى: أبي مجاهد العبيدي
http://vb.tafsir.net/71231-post11.html
=======================================
والمقصود من هذا الموضوع أن أذكر ما وقفت عليه من هذا التفسير من محاسن وشروح نادرة لمعاني الآيات وفِّق إليها ، شروح ينشرح لها صدر المتدبر لكتاب الله، ويفرح بها الأديب ، ويبتهج لها أهل التفسير
وهذه أولى المحاسن
قال الله تعالى في سورة الفرقان: {قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (15) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا (16)}
والمراد تفسيره لقوله تعالى {كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا}
قال: "كان ذلك الجزاء وعدا على الله واجب التحقيق"
فهو لم يقف عند لفظ الآية كما فعل غيره من المفسيرين فقالوا أن معناه: كان ذلك وعداً يسئله إياه عباده المتقون
فاحتاجوا بعد ذلك أن يستدركوا فيقولوا مثلا: ووعد الله متحقق فهو -سبحانه - لا يخلف الميعاد
ولكن الشيخ الصابوني تجاوز لفظ الآية إلى المعنى النهائي منه ، ولتقريب الأمر أقول إن الإنسان إذا أوجب على نفسه لشخص آخر أمرا أو تعهّد له بشيء وألزم به نفسه ، فإن لهذا الشخص أن يسأله الوفاءَ به، أما إذا لم يلزم الإنسان نفسه بشيء فإنه لا يصح أن يُسئلَه ، لأن الأمر أصلا تبرع منه لا يلزمه الوفاء به،
فوصف الله وعده الذي أوجبه على نفسه لعباده المتقين بأنه: "مسئول" وهي صيفة المفعول من الفعل : سأل
فكأن وصف الله تعالى وعده بأنه مسئول كناية المقصود بها تأكيد وتحقيق كونه واجبا لازما الوفاء به
وهذا يشبه تأكيد حياة امريء بأنه : يُرزق ، كما يقال: هو "حيّ يُرزق" وليس المقصود بهذا التعبير إثبات أنه يُرزق أو لا يُرزق بل المقصود تأكيد حياته بأنه يُرزق لأن الميت لا يُرزق
فكذلك هنا فالإخبار بأنه : "وعد مسئول" ليس المقصود إثبات أنه سوف يُسأل بل الفائدة من هذا التعبير هو تأكيد كونه لازما واجبا على الله أوجبه سبحانه على نفسه
والله تعالى أعلم
مهما بلغ طالب العلم والعالم من التمكن في العلم إلا أنه يحتاج لشيء مختصر ميسّر أثناء تلاوته وتدبره للقرآن، شيء عاجل لا يقطع عليه ورده اليومي ويشغله عن إتمامه
ومن هنا كان كتاب : "التفسير الواضح الميسّر" للشيخ محمد علي الصابوني أنفع ما رأيت لجميع الطبقات بلا استثناء ، ينتفع به المبتديء ، ويفزع إليه المنتهي، ولا يملّه من بينهما
وقد أثنى عليه المشرف العام على هذا الملتقى فقال:
....، وأنصح بقراءة هذا التفسير والاستفادة منه فقد أجاد فيه مؤلفه وتجنب ما في كتابه الآخر (صفوة التفاسير) من ملحوظات .
وفي الرابط التالي تقريض وثناء من مستشار الملتقى: أبي مجاهد العبيدي
http://vb.tafsir.net/71231-post11.html
=======================================
والمقصود من هذا الموضوع أن أذكر ما وقفت عليه من هذا التفسير من محاسن وشروح نادرة لمعاني الآيات وفِّق إليها ، شروح ينشرح لها صدر المتدبر لكتاب الله، ويفرح بها الأديب ، ويبتهج لها أهل التفسير
وهذه أولى المحاسن
قال الله تعالى في سورة الفرقان: {قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (15) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا (16)}
والمراد تفسيره لقوله تعالى {كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا}
قال: "كان ذلك الجزاء وعدا على الله واجب التحقيق"
فهو لم يقف عند لفظ الآية كما فعل غيره من المفسيرين فقالوا أن معناه: كان ذلك وعداً يسئله إياه عباده المتقون
فاحتاجوا بعد ذلك أن يستدركوا فيقولوا مثلا: ووعد الله متحقق فهو -سبحانه - لا يخلف الميعاد
ولكن الشيخ الصابوني تجاوز لفظ الآية إلى المعنى النهائي منه ، ولتقريب الأمر أقول إن الإنسان إذا أوجب على نفسه لشخص آخر أمرا أو تعهّد له بشيء وألزم به نفسه ، فإن لهذا الشخص أن يسأله الوفاءَ به، أما إذا لم يلزم الإنسان نفسه بشيء فإنه لا يصح أن يُسئلَه ، لأن الأمر أصلا تبرع منه لا يلزمه الوفاء به،
فوصف الله وعده الذي أوجبه على نفسه لعباده المتقين بأنه: "مسئول" وهي صيفة المفعول من الفعل : سأل
فكأن وصف الله تعالى وعده بأنه مسئول كناية المقصود بها تأكيد وتحقيق كونه واجبا لازما الوفاء به
وهذا يشبه تأكيد حياة امريء بأنه : يُرزق ، كما يقال: هو "حيّ يُرزق" وليس المقصود بهذا التعبير إثبات أنه يُرزق أو لا يُرزق بل المقصود تأكيد حياته بأنه يُرزق لأن الميت لا يُرزق
فكذلك هنا فالإخبار بأنه : "وعد مسئول" ليس المقصود إثبات أنه سوف يُسأل بل الفائدة من هذا التعبير هو تأكيد كونه لازما واجبا على الله أوجبه سبحانه على نفسه
والله تعالى أعلم