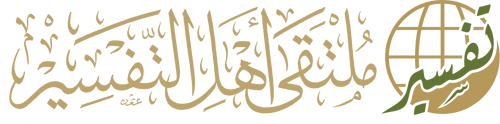طارق منينة
New member
- إنضم
- 19/07/2010
- المشاركات
- 6,331
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 36
حاولت قدر الإمكان أن اتتبع الردود من مجلة المنار على جورجي زيدان فتوفر لي التالي)أزيد من 100 صفحة)
نقد تاريخ التمدن الإسلامي
الشيخ شبلي النعمانى
( 1 )
تمهيد للمنار
تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي أفندي زيدان صاحب الهلال مشهور ، وقد
سبق لنا تقريظه في المنار ونقد بعض مباحثه ، وذكرنا أننا كنا نود لو نجد سعة من
الوقت لمطالعته كله ونقده نقدًا تفصيليًّا . ولما عرضه مؤلفه على نظارة المعارف
المصرية وطلب منها أن تقرره للتدريس في مدارسها عهدت النظارة إلى بعض
أساتذتها بمطالعته وإبداء رأيهم فيه ، فلما طالعوه بينوا للنظارة أن فيه غلطًا كثيرًا
وأنه غير جدير بأن يعتمد عليه في التدريس ولا المطالعة ، فلأجل هذا لم تقرره
النظارة . وكنت انتقدت الأساتذة الذين طالعوا الكتاب وانتقدوه أنهم لما يكتبوا ما
رأوه فيه من الغلط وبينوه للناس وللمصنف أيضًا لعله يرجع إلى الصواب إذا ظهر
له ، فإنه يدعو الكتاب دائمًا على نقد كتبه .
نعم إن بعض من قرأه قد انتقده بمقالات نشرت في جريدة المؤيد وأجاب
المصنف عن بعض ما انتقد عليه واعترف ببعض ، وقد ذكرت هذا في المنار .
ويرى بعض الناقدين لهذا التاريخ قولاً وكتابة أن مؤلفه يتعمد التحامل على العرب
وعلى الإسلام نفسه ، وكنت إذا سمعت ذلك منهم أعارضهم وأرجح أنه غير متعمد ،
وأن السبب في أكثر ما أخطأ به هو عدم فهم بعض المسائل كتفسيره لمسألة القول
بخلق ألفاظ القرآن بأن القرآن غير منزل من عند الله وكخطئه فيما ذكره عن ثروة
المسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مما انتقدناه عليه في المنار ،
وإما جعل بعض الوقائع الجزئية قواعد كلية عامة ، وهذا معهود في جميع مؤلفاته ،
ولكن ظهر لنا مما كتبه بعد ذلك ومن بعض حديثه معنا ومع غيرنا من أصحابه أنه
يكاد يكون من الشعوبية الذين يتحاملون على العرب ويفضلون العجم عليهم وكان
هذا سبب ترجمة هذا الكتاب بالتركية .
وقد انبرى في هذه الأيام الشيخ شبلي النعماني العلامة المصلح الشهير مؤسس
جمعية ندوة العلماء في الهند ومحرر مجلتها إلى الرد على هذا التاريخ ، وكتب إلينا
أنه يريد أن يرسل إلينا ما يكتبه ويطبعه من هذا الرد بالتدريج لننشره في المنار ،
كلما طبع منه شيئًا في ( لكنؤ ) أرسله إلى أن يتم ، ولما كان الانتقاد من مثل هذا
العالم المؤرخ هو ضالتنا وضالة صديقنا وصديقه المؤلف ، بادرنا إلى نشره
معتذرين عما في أوله من شدة الحكم ، وودنا لو لم يصرح به وإن أثبته ، ولولا أنه
طبعه لحذفناه منه . قال :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه
أجمعين إن الدهر دار العجائب . ومن إحدى عجائبه أن رجلاً من رجال العصر [1]
يؤلف في تاريخ تمدن الإسلام كتابًا يرتكب فيه تحريف الكلم وتمويه الباطل ، وقلب
الحكاية ، والخيانة في النقل ، وتعمد الكذب ما يفوق الحد ، ويتجاوز النهاية ، وينشر
هذا الكتاب في مصر وهي غرة البلاد ، وقبة الإسلام ، ومغرس العلوم ، ثم يزداد
انتشارًا في العرب والعجم ، ومع هذا كله لا يتفطن أحد لدسائسه [2] { إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ
عُجَابٌ } ( ص : 5 ) .
لم يكن المرء ليجترئ على مثل هذه الفظيعة في مبتدأ الأمر ولكن تدرج إلى
ذلك شيئًا فشيئًا ، فإنه أصدر الجزء الثاني من الكتاب وذكر فيه مثالب العرب دسيسة
يتطلع بها على إحساس الأمة وعواطفها ، ولما لم يتنبه لذلك أحد ، ولم ينبض لأحد
عرق ، ووجد الجو صافيًا ، أرخى العنان ، وتمادى في الغي ، وأسرف في النكاية ،
في العرب عمومًا وخلفاء بني أمية خصوصًا .
وكان يمنعني عن النهوض إلى كشف دسائسه اشتغالي بأمر ندوة العلماء ,
ولكن لما عم البلاء ، واتسع الخرق ، وتفاقم الشر ، لم أطق الصبر ، فاختلست من
أوقاتي أيامًا وتصديت للكشف عن عوار هذا التأليف والإبانة عما فيه من أنواع
الإفك والزور وأصناف التحريف والتدليس .
معذرة إلى المؤلف
إني أيها الفاضل المؤلف غير جاحد لمننك فإنك قد نوهت باسمي في تأليفك
هذا وجعلتني موضع الثقة منك ، واستشهدت بأقوالي ونصوصي ، ووصفتني بكوني
من أشهر علماء الهند ، مع أنى أقلهم بضاعة ، وأقصرهم باعًا ، وأخملهم ذكرًا ،
ولكن مع كل ذلك هل كنت أرضى أن تمدحني وتهجو العرب غرضًا لسهامك ودريّة
لرمحك ، ترميهم بكل معيبة وشين ، وتعزو إليهم كل دنية وشر ، حتى تقطعهم إربًا
إربًا ، وتمزقهم كل ممزق ، وهل كنت أرضى بأن تجعل بني أمية لكونهم عربًا
بحتًا من أشر خلق الله وأسوئهم ، يفتكون بالناس ، ويسومونهم سوء العذاب ،
ويهلكون الحرث والنسل ، ويقتلون الذرية وينهبون الأموال ، وينتهكون الحرمات ،
ويهدمون الكعبة ويستخفون بالقرآن .
وهل كنت أرضى بأن تنسب حريق خزانة الإسكندرية إلى عمر بن الخطاب ،
الذي قامت [1] بعدله الأرض والسماء ، وهل كنت أرضى بأن تمدح بني العباس
فتعد من مفاخرهم أنهم نزلوا العرب منزلة الكلب ، حتى ضرب بذلك المثل ، وأن
المنصور بنى القبة الخضراء إرغامًا للكعبة ، وقطع الميرة عن الحرمين استهانة
بهما ، وأن المأمون كان ينكر نزول القرآن ، وأن المعتصم بالله أنشأ كعبة في
( سامرَّا ) وجعل حولها مطافًا واتخذ منى و عرفات .
وهب أني عدمت الغيرة على الملة والدين ، وافتخرت كصنيع بعض الأجانب
بأني فلسفي بحت عادم لكل عاطفة ووجدان ، فلا أرضى ولا أغضب ولا أسر ولا
أغاظ ولا أفرح ولا أتألم ، وهب أني حملت نفسي على احتمال الضيم ، وقبول
المكروه ، والصم عن البذاء ، ومجازاة السيئة بالحسنة ، ومكافأة الخبيث بالطيب ،
فهل كنت أرضى بأن تشوه وجه التاريخ ، وتدمغ الحق ، وتروج الكذب ، وتفسد
الرواية ، وتقلب الحقيقة ، وتنفق التهم ، وتعود الناس بالخرافة ، بئس ما زعمت
أيها الفاضل ، فإن في الناس بقايا وإن الحق لا يعدم أنصارًا .
إن الغاية التي توخاها المؤلف ليس إلا تحقير الأمة العربية وإبداء مساويها
ولكن لما كان يخاف ثورة الفتنة غير مجرى القول ، ولبس الباطل بالحق . بيان
ذلك أنه جعل لعصر الإسلام ثلاثة أدوار : دور الخلفاء الراشدين ، ودور بني أمية ،
ودور بني العباس ، فمدح الدور الأول وكذلك الثالث ( ظاهرًا لا باطنًا كما سيجيء )
ولما غر الناس بمدحه الخلفاء الراشدين ، وهم سادتنا وقدوتنا في الدين ، وبمدحه
لبني العباس وهم أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم ، وبهم فخارنا في بث التمدن
وأبهة الملك ، ورأى أن بني أمية ليست لهم وجهة دينية فلا ناصر لهم ، ولا مدافع
عنهم ، تفرغ لهم ، وحمل عليهم حملة شنعاء ، فما ترك سيئة إلا وعزاها إليهم ، وما
خلى حسنة إلا وابتزها منهم ، ثم لو كان هذا لأجل أنهم من آل مروان أو لكونهم من
سلالة أمية لكنا في غنى عن الذب عنهم ، والحماية لهم ، ولكن كل ذنبهم أنهم
العرب على صرافتهم ما شابتهم العجمة مطلقًا كما قال : ( وتمتاز- أي دولة بني
أمية - عن الدولة العباسية بأنها عربية بحتة ) - الجزء الثاني من تمدن الإسلام -
( وجملة القول أن الدولة الأموية دولة عربية أساسها طلب السلطة والتغلب ) -
الجزء الرابع صفحة 103 - .
عصبية العرب على العجم
أطال المؤلف وأطنب في إثبات هذه الدعوى فذكر طرفًا منه في الجزء الثاني
مدسوسًا - انظر صفحة 18 - ثم جعل له عنوانًا خاصًا في الجزء الرابع ( 58 )
وهذه نصوصه :
فإن العرب كانوا يعاملونهم معاملة العبيد ، وإذا صلوا خلفهم في المسجد
حسبوا ذلك تواضعًا لله .
وكانوا يحرمون الموالي من الكنى ولا يدعونهم إلا بالأسماء والألقاب ولا
يمشون في الصف معهم .
وكانوا يقولون لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة حمار أو كلب أو مولى .
فكان العربي يعد نفسه سيدًا على غير العربي ويرى أنه خلق للسيادة وذاك
للخدمة .
فتوهم العرب في أنفسهم الفضل على سائر الأمم حتى في أبدانهم وأمزجتهم
فكانوا يعتقدون أنه لا تحمل في سن الستين إلا قرشية ، وأن الفالج لا يصيب
أبدانهم .
ومنعوا غير العرب من المناصب الدينية المهمة كالقضاء فقالوا لا يصلح
للقضاء إلا عربي وحرموا منصب الخلافة على ابن الأمة ولو كان أبوه قرشيًّا .
ولا يزوجون الأعجمي عربية ولو كان أميرًا وكانت هي من أحقر القبائل
وكان الأمويون في أيام معاوية يعدون الموالي أتباعًا وأرقاء وتكاثروا فأدرك
معاوية الخطر من تكاثرهم على دولة العرب فهمَّ أن يأمر بقتلهم كلهم أو بعضهم .
اعلم أن للمؤلف في إنفاق باطله أطوارًا شتى :
فمنها تعمُّد الكذب كما سترى ، ومنها تعميمه لواقعة جزئية ، ومنها الخيانة في
النقل وتحريف الكلم عن مواضعه .
ومنها الاستشهاد بمصادر غير موثوقة مثل كتب المحاضرات والفكاهات .
وهاك أمثلة من كل نوع منها قال : ( إذا صلوا خلفهم في المسجد حسبوا ذلك
تواضعًا لله وكانوا يحرمون الموالي من الكنى إلخ , وكانوا يقولون لا يقطع الصلاة
إلا ثلاثة إلخ ) .
غير خافٍ على من له إلمام بتاريخ الفرس والعرب أن الفرس كانت قبل
الإسلام تحتقر العرب وتزدريهم ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه
إلى كسرى العجم اشمأز وقال عبدي يكتب إليَّ ! ! وكتب يزدجرد إلى سعد بن أبي
وقاص فاتح القادسية أن العرب مع شرب ألبان الإبل وأكل الضب بلغ بهم الحال
إلى أن أفنوا دولة العجم فأفٍّ لك أيها الدهر الدائر , وكانت ملوك الحيرة تحت إمرة
ملوك العجم .
ثم لما شرف الله العرب بالإسلام انتصفت العرب من العجم واستنكفوا من
سيادتهم عليهم ، وجاءت الشريعة الإسلامية ماحية لكل فخر ونخوة فقال رسول الله
في خطبته الأخيرة في حجة الوداع ، أن لا فضل للعربي على العجمي ولا للعجمي
على العربي كلكم أبناء آدم ) .
وحينئذ ارتفع التمايز وتساوى الناس ولكن مع ذلك بقيت في بعض الناس من
كلا الطرفين حزازات كامنة في صدورهم كانت سببًا لحدوث حزبين متقابلين يسمى
أحدهما الشعوبة وهي التي تحتقر العرب وترميه بكل معيبة حتى إن أبا عبيدة
صنف كتبًا عديدة يطعن فيها على أنساب كل قبيلة من قبائل العرب ، والثاني
المتعصبون للعرب . وقد عقد العلامة ابن عبد ربه في كتابه العِقْد الفريد بابًا في
حجج كِلا الطرفين وأقوالهما . ومعظم ما نقله المؤلف في إثبات عصبية العرب هي
أقوال ذكرها صاحب العقد في هذا الباب ، كما لوَّح به المؤلف في هامش الكتاب .
وإذا تصفحت الكتب يظهر لك أن الأقوال التي نسبها إلى العرب عمومًا إنما
هي أقوال شرذمة خاصة موسومة بأصحاب العصبية ، وصاحب العقد حيثما ذكر
هذه الأقوال صدرها بقوله ( قال أصحاب العصبية من العرب ) وأنت تعلم أن هذه
العصبة ليست كافة العرب ولا أكثرها ، بل ولا عشر معشارها ، فإنك سترى أن
هؤلاء أناس شرذمة مغمورون في الناس . ثم إن المؤلف ما اقتنع بذلك بل ربما
نسب قول رجل معين معلوم الاسم إلى العرب عامة .
فقال ناقلاً عن كتاب العقد : ( وكانوا يكرهون أن يصلُّوا خلف الموالي وإذا
صلوا خلفهم قالوا : إنا نفعل ذلك تواضعًا لله ) قال صاحب العقد : نسب هذا القول
إلى نافع بن جبير فأخذه المؤلف وجعله قولاً عامًّا للعرب ، وهذه الصنيعة أعني
تعميم الواقعة الجزئية هي أكبر الحيل التي يرتكبها المؤلف لترويج باطله بل هي
قطب رحى تأليفه .
قال المؤلف : ( فأدرك معاوية الخطر من تكاثرهم على دولة العرب فهمَّ أن
يأمر بقتلهم كلهم أو بعضهم ) - الجزء الرابع صفحة 59 - إن نص معاوية الذي
نقله المؤلف بعد هذه العبارة هو هذا ( كأني أنظر إلى وثبة منهم على العرب
والسلطان فرأيت أن أقتل شطرًا وأدع شطرًا ) فأنت ترى أن الرواية على تقدير
صحتها ليس فيها إلا أن معاوية رأى أن يقتل شطرًا منهم . ولكن المؤلف زاد على
العبارة وقال : إن معاوية همَّ أن يأمر بقتلهم كلهم .
قال المؤلف : فكانوا يعتقدون أن الفالج لا يصيب أبدانهم ، - الجزء الرابع
صفحة 6 - استشهد في هذه الدعوى بطبقات الأطباء كما لوح في هامش الكتاب .
وايم الله لو كنت تقف على عبارة الطبقات لوقعت في أشد حيرة من اجتراء المؤلف
على قلب الحكاية ، وتغيير الرواية ، ذكر صاحب الطبقات تحت ترجمة عيسى
الطبيب ( الراجح أنه نصراني ) أن المهدي ضربه فالج فحضر المتطببون ومنهم
عيسى صاحب الترجمة فقال ( المهدي بن المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله
بن عباس يضربه فالج ، لا والله لا يضرب أحدًا من هؤلاء ولا نسلهم فالج أبدًا إلا
أن يبذروا بذورهم في الروميات والصقلبيات وما أشبههن ) .
قد نقل صاحب الطبقات بعد الحكاية المذكورة عن يوسف الطبيب أن إبراهيم
بن المهدي لما اعتل بعلة شبيهة بالفالج دعا يوسف وقال له : ما العلة عندك في
عروض هذه العلة لي ؟ ( قال يوسف ) : فعلمت أنه كان حفظ عن أمه قول عيسى
أبي قريش في المهدي وولده أنه لا يعرض لعقبه الفالج إلا أن يبذروا بذورهم في
الروميات وأنه قد أمل أن يكون الذي به فالجًا لا عارض الموت . فقلت : لا أعرف
لإنكارك هذه العلة معنى إذ كانت أمك التي قامت عنك دنباوندية و ( دنباوند ) أشد
بردًا من كل أرض الروم ، فكأنه تفرج إلى قولي وصدقني وأظهر السرور .
فأنت ترى أن الظن ببراءتهم من الفالج إنما كان مبناه حَرّ أرض العرب وليس
له أدنى مساس بشرف النسل . ولو كان كما يتبادر إلى الذهن من عد أسماء آباء
المهدي فهو يختص بعائلة النبي عليه السلام لا يفهم منه العموم مطلقًا ، ولذلك لما
ذكر لإبراهيم ( وهو ابن الخليفة المهدي ) أن أمه من ( دنباوند ) وهو أشد بردًا من
كل أرض الروم ، ذهب عنه استغرابه عروض الفالج له .
فانظر كيف كان مجرى الحكاية فغيرها المؤلف وارتكب لذلك خيانات تترى ،
ثم إن هذا قول عيسى الطبيب ولا يدرى أنه عربي أم لا وغالب الظن أنه نصراني
وهب أنه عربي فهو رجل من حاشية الدولة يريد التزلف إلى الخليفة والتملق له
فهل يكون قوله قول العرب كافة ؟ .
قال المؤلف : ومنعوا غير العرب من المناصب الدينية المهمة كالقضاء فقالوا :
لا يصلح للقضاء إلا عربي - الجزء الرابع صفحة 60 - وأسند هذه الرواية إلى
ابن خلكان .
حقيقة هذا القول أن الحجاج لما أسر سعيد بن جبير التابعي المشهور وكان من
الموالي قال له ممتنًّا عليه : أما جعلتك إمامًا للصلاة في الكوفة ولم يكن في الكوفة إلا
العرب ، قال ابن جبير : نعم ، ثم قال له الحجاج : أليس أني لما أردت أن أوليك
قضاء الكوفة ضجَّ العرب وقالوا : لا يصلح للقضاء إلا عربي ؟ وقد ذكر الرواية
ابن خلكان بطولها ولا يخفى عليك أن كوفة لم يكن إذ ذاك فيها إلا العرب وظاهر أن
القضاء لا يصلح له إلا من كان عارفًا بعوائد الأمة مطلعًا على خصائصهم وكيفية
تعاملهم فيما بينهم ، وسعيد بن جبير لم يكن من العرب ، ولو كان استنكاف أهل
كوفة من قضائه لأجل كونه من الموالي لاستنكفوا من إمامته للصلاة فإن الإمامة
أعظم شرفًا وأرفع محلاً من القضاء . وهذا أبو حنيفة كان من الموالي وأرادوا أن
يولوه القضاء في عصر بني أمية فامتنع ولم يرض بذلك وقد ذكر الواقعة ابن خِلِّكان
مفصلاً .
قال المؤلف ( وحرموا منصب الخلافة على ابن الأَمَة ولو كان قرشيًّا ) نعم
ولكن لم يكن هذا للاستهانة به .
قال الأصمعي : كانت بنو أمية لا تبايع لبني أمهات الأولاد فكان الناس يرون
أن ذلك للاستهانة بهم ولم يكن لذلك ولكن لما كانوا يرون أن زوال ملكهم على يد أم
ولد [1] .
أما ما استدل به المؤلف من قول هشام بن عبد الملك لزيد بن علي : إنك ابن أمة
ولذلك لا تصلح للخلافة ، فقد رده عليه زيد وقال : إن إسماعيل كان ولد الجارية
وكان سيد البشر محمد من سلالته , ومن المعلوم أن زيدًا وهو ابن الإمام زين
العابدين أرفع شأنًا وأعظم محلاًّ وأطيب أرومة وأصدق قولاً من هشام . ثم لو كان
هذا الأمر حقًّا ما كانوا يولُّون الخلافة يزيد بن الوليد الأموي ومروان الحمار وهما
ابنا أمة .
ولما فرغنا من إبداء شطر من خيانات المؤلف ليكون كالعنوان على دأبه في
تأليفاته حان لنا أن نحقق أصل المسألة أي أن العجم والموالي هل كانوا أذلاء
ساقطين مرذولين يعاملون معاملة العبيد في عصر بني أمية كما يدعيه المؤلف أو
كانوا بمحل من الشرف والعزة يعترف لهم العرب بالفضل والسؤدد ، ويوفَّى لهم
أوفى قسط وأكمل حق .
اعلم أن البلاد التي كانت عواصم الأقاليم وقواعدها في عصر بني أمية هي
مكة و المدينة و البصرة و الكوفة و اليمن ومصر و الشام و الجزيرة و خراسان
وكان لكل هذا الأصقاع إمام يقودهم ويسود عليهم وهذه أسماؤهم .
مكة المشرفة عطاء بن أبي رباح هو أستاذ الإمام أبي حنيفة
اليمن ... ... طاوس
الشام ... ... مكحول
مصر ... ... يزيد بن أبي حبيب
الجزيرة ... ميمون بن مهران
خراسان ... ضحاك بن مزاحم
البصرة ... الإمام الحسن البصري
الكوفة ... إبراهيم النخعي
وكل هؤلاء غير إبراهيم النخعي كانوا من الموالي وبعضهم أبناء الإماء ومع
كونهم أعجامًا وكونهم أولاد الإماء كانوا سادة الناس وقادتهم تذعن لهم العرب
وتحترمهم خلفاء بني أمية وولاة الأمر .
فأما ( عطاء بن أبي رباح ) فمع كونه ابن سندية كان شيخ الحرم وإليه
المرجع في الفتوى وعليه المعول في المسائل ، قال ابن خلكان في ترجمته : قال
إبراهيم بن عمرو : ابن كيسان أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج صائحًا
يصيح ( لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح ) وهل يمكن أن ينادى بمثل ذلك من
غير رضى الخلفاء [1] .
وأما ( طاوس ) فلما قضى نحبه بمكة ازدحم الناس في جنازته حتى تعذرت
الصلاة عليه وكان إبراهيم بن هشام إذ ذاك واليًا على مكة فاستعان بالشُّرَطة ومشى
في جنازته عبد الله ابن الإمام حسن عليه السلام واضعًا نعشه على عاتقه وصلى
عليه الخليفة هشام بن عبد الملك الأموي ، ذكر كل هذا العلامة ابن خلكان في
ترجمة طاوس فهل يكون منزلة أعظم من ذلك ؟
وأما ( مكحول الشامي ) فأحد الأئمة المتبوعين وقال الزهري : العلماء أربعة
فلان وفلان ومكحول .
وأما ( يزيد بن أبي حبيب ) فهو الذي أرسله عمر بن عبد العزيز ليفقه الناس
في مصر ويفتيهم في المسائل وهو المعلم الأول لهم كما صرح بذلك السيوطي في
حسن المحاضرة .
وأما ( ميمون بن مهران ) فمع فضيلته وسيادته كان أميرًا على الخراج في
الجزيرة كما صرح به ابن قتيبة في المعارف .
أما ( حسن البصري ) فحدث عن البحر ولا حرج ، يذعن له الملوك والسادة
والقواد وعليه المعول وإليه المنتهى [1] .
ذكر السخاوي في شرح ألفية الحديث للعراقي ( طبع لكهنو صفحة 498
و 499 أن هشامًا قال للزهري : من يسود أهل مكة ؟ . قال : عطاء ، قال : بم
سادهم ؟ قال : بالديانة والرواية ، قال هشام : نعم من كان ذا ديانة حقت الرياسة له
ثم سأل عن يمن قال طاؤس ، وكذلك سأل عن مصر والجزيرة وخراسان
والبصرة والكوفة فأخذ الزهري يعد أسماء سادات هذه البلاد وكلما سمى رجلاً كان
هشام يسأل هل هو عربي أم مولى ؟ وكان يقول الزهري : مولى ، إلى أن أتى
على النخعي وقال : إنه عربي . فقال هشام ( الآن فرَّجت عني والله ليسودن
الموالي العرب ويخطب لهم على المنابر والعرب تحتهم ) .
إن التابعين لهم أعلى محل في تاريخ الإسلام - ورأسهم سعيد بن جبير وهو
أسود وقد ولاه حجاج بن يوسف إمامة الصلاة في الكوفة كما ذكره ابن خلكان في
ترجمته والكوفة إذ ذاك جمجمة العرب وقبة الإسلام ، وهل يصح بعد ذلك دعوى
المؤلف أن العرب كانت تستنكف من الصلاة خلف الموالي .
وهذا سليمان الأعمش أستاذ الثوري كان عبدًا عجميًّا وكان بمنزلة من العز
والشرف أنه لما كتب إليه الخليفة هشام بن عبد الملك أن يكتب له مناقب عثمان
ومساوئ علي أخذ كتاب هشام وألقمه عنزًا كان عنده وقال للرسول قل لهشام هذا
جواب كتابك .
... ... ... ... ... ... ... ( ابن خلكان ترجمة الأعمش )
وهذا حماد الراوية الذي دوَّن المعلقات وله المكانة الكبرى في الأدب والشعر
كان عبدًا أسود وكانت ملوك بني أمية تقدمه وتؤثره وتستزيره كما ذكره ابن
خلكان .
وهذا سالم بن عبد الله بن عمر كان ابن أمة ولما دخل الخليفة هشام بن عبد
الملك المدينة أرسل إليه يدعوه فاعتذر فدخل عليه هشام ووصله بعشرة آلاف ثم لما
حج ورجع كان سالم إذ ذاك مريضًا فذهب لعيادته ولما توفي صلى عليه وقال : لا
أدري بأي الأمرين أنا أسر : بحجتي أم بصلاتي على سالم ؟ ولو أخذنا في تعداد
أمثال هذه الوقائع لطال الكلام ومل الناظرون .
ويظهر مما مر عليه أن الموالي كانوا في أيام بني أمية بأعلى محل من
الشرف والمكانة وكانت العرب تذعن لهم وتقدمهم وتقتدي بهم وترفع شأنهم ، فهل
يصح قول المؤلف بعد ذلك : إن الموالي وأبناء الإماء كانوا في عصر بني أمية
مرذولين ساقطين يزدرى بهم ولا يقام لهم وزن وكان العرب وبنو أمية يعاملونهم
معاملة العبيد ؟
( لها بقية )
((يتبع بمقال تالٍ))
__________
(1) هو جرجي زيدان صاحب مجلة الهلال اهـ من خط المؤلف في هامش الأصل .
(2) المنار : قد علم من التمهيد أن كثيرين قد فطنوا لما في الكتاب من الخطأ وبعضهم انتقدوه .
(3) لعل الأصل شهدت بدل قامت .
(4) انظر الجزء الثاني من العقد الفريد طبع مصر صفحة 330 .
(5) المنار : الأمر أكبر من ذلك ، كان عطاء يشدد في وعظ عبد الملك والوليد فيقبلان منه راجع في صفحة 422 و 423 من مجلد المنار التاسع وعظه لعبد الملك وهو جالس معه على كرسيه وترفعه عن الأخذ منه وقول عبد الملك عند خروجه : (هذا وأبيك الشرف) ومخاطبته للوليد باسمه وتشديده في وعظه حتى أغمي عليه .
(6) راجع في 423 وما بعدها من مجلد المنار التاسع إغلاظ الحسن على الحجاج ، وفي صفحة 498 منه نصيحته لوالي بني أمية على العراق .
نقد تاريخ التمدن الإسلامي
بقلم الشيخ شبلي النعماني
( 2 )
مثالب بني أمية
المقصد الذي جعله المؤلف نصب عينه ومرمى غايته هو أن الأمة العربية إذا بقيت على صرافتها فهي جامعة لجميع أشتات الشر ، أي الجور والقسوة والهمجية وسفك الدماء والفتك بالناس . ولكن لما كان لا يقدر على إظهار هذا المقصد تصريحًا
احتال في ذلك فغمض المذهب وجعل الكلام طيب الظاهر وذلك بأن قسم
عصر الإسلام إلى ثلاثة أدوار - فمدح سياسة الخلفاء الراشدين ، وقال بعد مدحها :
( على أن سياسة الراشدين على الإجمال ليست مما يلائم طبيعة العمران أو
تقتضيه سياسة الملك وإنما هي خلافة دينية توفقت إلى رجال يندر اجتماعهم في
عصر .
فأهل العلم بالعمران لا يرون هذه السياسة تصلح لتدبير الممالك في غير ذلك
العصر العجيب وأن انقلاب تلك الخلافة الدينية إلى الملك السياسي لم يكن منه بد .
( الجزء الرابع صفحة 29 و30 )
فأثبت بذلك أن سياسة الخلفاء الراشدين ليست فيها أسوة للناس ، وأنها من
مستثنيات الطبيعة ، أما دور العباسيين فمدحه ولكن لا لأجل أنه دولة عربية بل
لكونها فارسية مادة وقوامًا مؤتلفًا ونظامًا وصرح بذلك فقال :
( دعونا هذا العصر فارسيًّا مع أنه داخل في عصر الدولة العباسية ؛ لأن تلك
على كونها عريبة من حيث خلفاؤها ولغتها وديانتها فهي فارسية من حيث سياستها
وإدارتها ؛ لأن الفرس نصروها وأيدوها ثم هم نظموا حكومتها وأداروا شئونها
ومنهم وزراؤها وأمراؤها وكتابها وحُجَّابها ) .
( الجزء الرابع صفحة 106 )
ثم أشار في غير موضع إلى أن الدولة العربية الساذجة إنما هي دولة بني أمية
فقال :
( وجملة القول أن الدولة الأموية دولة عربية ) ( الجزء الرابع صفحة
103 ) وظل العرب في أيام بني أمية على بداوتهم وجفاوتهم وكان خلفاؤها يرسلون
أولادهم إلى البادية لإتقان اللغة واكتساب أساليب البدو وآدابهم ( الجزء الرابع
صفحة 61 ) .
ولما أثبت أن خلافة الراشدين لم تكن تلائم النظام الطبيعي وأن دولة بني
العباس دولة فارسية وأن الباقية على صرافتها هي الدولة الأموية أخذ يعدد مثالب
بني أمية تحت عنوانات مستقلة منها الاستخفاف بالدين وأهله ، ومنها الاستهانة
بالقرآن والحرمين ، ومنها الفتك والبطش ، ومنها قتل الأطفال ، ومنها خزانة
الرءوس . وأتى في مطاوي هذه العنوانات من الإفك والاختلاق والتحريف والتبديل
بما تجاوز الحد وخرج عن طور القياس . والآن أذكر نبذًا منها وأكشف عن جلية
حالها .
***
الاستهانة بالقرآن والحرمين
قال المؤلف تحت هذا العنوان :
( أما عبد الملك فكان يرى الشدة ويجاهر بطلب التغلب بالقوة والعنف ولو
خالف الدين ؛ لأنه صرح باستهانة الدين منذ ولي الخلافة .. . ذكروا أنه لما جاءوه
بخبر الخلافة كان قاعدًا والمصحف في حجره فأطبقه وقال : هذا آخر العهد بك -
أو- هذا فراق بيني وبينك . فلا غَرو بعد ذلك إذا أباح لعامله الحجاج أن يضرب
الكعبة بالمنجنيق وأن يقتل ابن الزبير ويحتز رأسه بيده داخل مسجد الكعبة . وظلوا
يقتلون الناس فيها ثلاثًا وهدموا الكعبة وهي بيت الله عندهم وأوقدوا النيران بين
أحجارها وأستارها ) ( الجزء الرابع صفحة 78 و79 ) .
الحكاية على الإجمال أن ابن الزبير ادعى الخلافة فملك الحرمين و العراق
وكاد يغلب على الشام وكان أمره كل يوم في ازدياد وبإزائه بنو أمية في الشام فلما
تولى عبد الملك الخلافة أرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره ولاذ ابن الزبير
بمكة فنصب الحجاج المنجنيق على الزيادة التي كان زادها ابن الزبير ( كما يجيء
تفصيله ) .
يعرف كل من له أدنى إلمام بالتاريخ أن الحجاج ما أراد إلا قتال ابن الزبير
ولكونه لائذًا بالكعبة اضطر إلى نصب المنجنيق على الكعبة ، ولكن مع ذلك تحرز
عن رمي الكعبة فحوَّل وجهها إلى زيادة ابن الزبير . فانظر كيف غير المؤلف
مجرى الحكاية فصدر الباب بالاستهانة بالقرآن والحرمين . ثم ذكر أن عبد الملك
قال للقرآن :
هذا فراق بيني وبينك . وأنه أباح للحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدم
الكعبة وإيقاد النيران بين أستارها ، فالناظر في عبارته يتوهم بل يستيقن أن
عبد الملك تفرغ من بدء الأمر للاستهانة بالدين والقرآن والحرمين وجعل الاستهانة
نصب عينه ومرمى غايته ، وقتل ابن الزبير كان إما لأنه دافع عن مكة أو لكونه
أيضًا جنس الاستهانة بالحرم .
أما تفصيل الواقعة وتعيين بادئ الظلم فهو أن ابن الزبير لما استولى على
الحرمين أخرج بني أمية من المدينة فخرج مروان وابنه عبد الملك وهو عليل مجدر
فاستولى على الشام ، وصدرت من ابن الزبير أفعال نقموا عليه لأجلها فمنها أنه
تحامل على بني هاشم وأظهر لهم العداوة والبغضاء [1] حتى إنه ترك الصلاة على
النبي في الخطبة ولما سألوه عن هذا قال : إن للنبي أهل سوء يرفعون رءوسهم إذا
سمعوا به [2]ومنها أنه هدم الكعبة ومع أن هدمها لم يكن إلا لرمتها وإصلاحها ولكن
لم يكن هذا مألوفًا للناس ، ولذلك تحرز النبي عليه السلام عن إدخال الحطيم في
الكعبة فاتخذ الحجاج هذه الأمور وسيلة لإغراء الناس على ابن الزبير . ولعل ابن
الزبير كان مضطرًّا إلى هذه الأعمال ولكن من شريطة العدل أن نوفي كل واحد
قسطه من الحق ، فإذا اعتذرنا لابن الزبير فعبد الملك أحق منه اعتذارًا ، فإن ابن
الزبير هو البادئ والبادئ أظلم . ويظهر من هذا أن عبد الملك ما أراد الحط من
شأن الكعبة ومس شرفها ولكن اضطر إلى قتال ابن الزبير فوقع ما وقع عرضًا غير
مقصود بالذات ولذلك لما نصب الحجاج المناجيق على الكعبة حولها عن الكعبة
وجعل الغرض الزيادة التي كان زادها ابن الزبير ، صرح بذلك العلامة البشاري في
أحسن التقاسيم . ثم إن من مسائل الفقه أن البغاة إذا تحصنوا بالكعبة لا يمنع هذا
عن قتالهم ولذلك أمر النبي في وقعة الفتح بقتل أحدهم وهو متعلق بأستار الكعبة
وابن الزبير كان عند أهل الشام من البغاة والمارقين عن الدين .
ولو كان أراد الحجاج الاستهانة بالحرم فما كان مراده من رمته وإصلاحه بعد
قتل ابن الزبير ، ومعلوم أن تعمير الحَجاج هو كعبة الإسلام وقبلة المسلمين كافةً .
أما قول عبد الملك للقرآن هذا فراق بيني وبينك ، فحقيقته أن عبد الملك كان
قبل الخلافة ناسكًا منقطعًا إلى العبادة لا يشتغل بشيء من الدنيا ، قال نافع : ما
رأيت في المدينة أشد نُسكًا وعبادة من عبد الملك ، ولما سألوا ابن عمر إلى من
ترجع في الفتوى بعدك ؟ قال ( ولد لمروان ) وكان يقول ابن الزناد الفقهاء في
المدينة سبع أحدهم عبد الملك . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
وقال الإمام الشعبي : ما جالست أحدًا إلا وجدت عليه الفضل إلا عبد الملك
بن مروان . ذكر كل هذه الأقوال العلامة السيوطي في تاريخه للخلفاء . فلما جاءته
الخلافة وهو يقرأ القرآن تصور خطارة الأمر ، وأن مثل هذا العبء لا يمكن تحمله
إلا المنقطع إليه فقال تحسرًا : هذا آخر العهد بك . أي الآن لا يمكن الانقطاع إلى
العبادة وقراءة القرآن كما كان دأبي أولاً ، وليس هذا على سبيل الاستهانة بالدين
مطلقًا فإنا نرى اشتغال عبد الملك بالفرائض والسنن فيما بعد فهو يصوم ويصلي
ويحج قال اليعقوبي في تاريخه : وأقام الحج للناس في ولايته سنة 72 الحجاج بن
يوسف وسنة 73 وسنة 74 الحجاج أيضًا وسنة 75 عبد الملك بن مروان وسنة 76
أبان بن عثمان بن عفان ، وسنة 77 أبان أيضًا وسنة 78 وسنة 79 وسنة 80 أبان
أيضًا وسنة 81 سليمان بن عبد الملك ( وسرد باقي السنوات فتركناها ) وعبد الملك
هو الذي كسا الكعبة الديباج ، فهل هذا صنيع من يريد الاستهانة بالحرم ؟
قال المؤلف :
( ويحتز رأسه بيده داخل مسجد الكعبة ) ( الجزء الرابع صفحة 79 ) استند
المؤلف في هذه الرواية بالعِقد الفريد لابن عبد ربه والاستناد بمثل هذه الكتب في
مثل هذه الوقائع هو من إحدى حيل المؤلف المعتادة بها فأنت تعلم أن حادثة قتل ابن
الزبير مذكورة في الطبري وابن الأثير وغيرها من المصادر التاريخية المتداولة
الموثوق بها وعليها المعوَّل وإليها المرجع لكن لما لم تكن كيفية الحادثة في هذه
الكتب وفق هوى المؤلف أعرض عن هذه كلها وتشبث بكتاب هو في عداد
المحاضرات وإنما يرجع إلى أمثاله إذا لم يكن في الباب مستند غيره ومتى لم
يخالف الأصول .
والمذكور في الطبري وغيره أن عبد الله بن الزبير أصيب في الحجون وقتل
هناك قتله رجل من المراد ، وما احتز رأسه داخل الكعبة .
قال المؤلف : ( وهدموا الكعبة ) .
قدمنا أن الكعبة لم تكن غرضًا للحجاج وإنما كان نصب المناجيق على الزيادة
التي زادها ابن الزبير ، ولما كانت متصلة بالكعبة نالت الأحجار من الكعبة ولكن
كان أول ما فعله الحجاج بعد ما استتب القتال أمره بكنس المسجد الحرام من
الحجارة والدم كما نص عليه ابن الأثير فهل كنس المسجد الحرام من الحجارة والدم
وهدم الكعبة شيء واحد ؟
أما ما نقل المؤلف عن كفر الوليد وأنه أمر بالمصحف فعلقوه وأخذ القوس
والنبل وجعل يرميه حتى مزقه وأنشد :
أتوعد كل جبار عنيد ... فها أنا ذاك جبار عنيد
إذا لاقيت ربك يوم حشر ... فقل لله مزقني الوليد
ونقل هذه الرواية عن الأغاني فهي من خرافات الأغاني ، ومعلوم أن صاحب
الأغاني شيعي ديانته شنآن بني أمية والحط منهم . وأما الأبيات فأثر التوليد ظاهر
عليها ، ومن له أدنى مسكة بالأدب يشهد أن نسجها غير نسج الأوائل ، فأما جهابذة
المحدثين المرجوع إليهم في نقد الروايات والذين قولهم فصل في هذا الباب
فيجحدون أمثال هذه الروايات المختلقة . قال العلامة الذهبي : هو رأس الحديث
ومرجع الرواية - : ( لم يصح عن الوليد كفر ولا زندقة بل اشتهر بالخمر والتلوط
فخرجوا عليه لذلك ) ( تاريخ الخلفاء للسيوطي ترجمة الوليد ) .
ثم إن هناك أمرًا آخر وهو أن الناقم على الوليد وقاتله هو خليفة أموي ،
فكيف ينسب استهانة الدين إلى خلفاء بني أمية عامتهم . ثم إن هذا الذي عزا إليه
صاحب الأغاني الاستهانة بالقرآن قد ذكر له صاحب العقد ما ينبئ عن تعظيمه
للقرآن وتفخيمه شأنه وحث الناس على حفظه وتعهده قال صاحب العقد [1] : إنه
شكا رجل من بني مخزوم دينًا لزمه فقال ( الوليد ) : أقضيه عنك إن كنت لذلك
مستحقًّا قال : يا أمير المؤمنين كيف لا أكون مستحقًّا في منزلتي وقرابتي ؟ قال
قرأت القرآن ؟ قال : لا ، قال فادن مني فدنا منه فنزع العمامة عن رأسه بقضيب
في يده فقرعه قرعة وقال لرجل من جلسائه ضم إليك هذا العِلْج ولا تفارقه حتى
يقرأ القرآن . فقام إليه آخر فقال يا أمير المؤمنين اقض دَيني ، فقال له أتقرأ القرآن ؟
قال نعم فاستقرأه عشرًا من الأنفال وعشرًا من براءة فقرأ ، فقال : نعم نقضي دينك
وأنت أهل لذلك . فأنت ترى أن الوليد يعد من لا يقرأ القرآن عِلْجًا والمؤلف يعد
الوليد علجًا .
فأما ما ذكره المؤلف من أقوال الحجاج وخالد القسري وأنهما كانا يُفضلان
الخلافة على النبوة فمع أن أكثر هذه الأقوال مأخوذ من العقد الفريد وهو من كتب
المحاضرات لسنا نحتاج إلى الذب عن الحجاج وخالد فإنهما من أشرار الأمة حقًّا ،
ولكن كم لنا من أمثال هؤلاء الملاحدة في الدولة العباسية كالعجاردة وابن الرواندي
الذي عمل كتابًا رد فيه على القرآن وسماه بالدامغ ، فإذا كان العباسيون مسئولين
عن أوزار هؤلاء عند المؤلف فكذلك بنو أمية . وإن كان عبد الملك والوليد
يرتضيان بسوء أعمال الحجاج فمعلوم أن غيرهما من بني أمية كانوا ناقمين عليه
كافة حتى أن هشامًا قال ( هل الحجاج استقر في جهنم أو يهوي إلى الآن ) ولما
وصل إلى هشام أن خالدًا القسري استخف بامرأة مؤمنة عزله من الإمارة وسجنه
كما ذكره ابن خلكان .
والحاصل أن المؤلف لو خص رجلاً أو رجلين من بني أمية بالمطاعن لاعترفنا
به ، ولكن من سوء مكيدة المؤلف أنه يجعل الفرد جماعة والفذ توءمًا
والنادر عامًا والشاذ مطردًا .
جور بني أمية
سمعنا بمظالم بختنصر ، وأحطنا علمًا بشنائع جنكيز خان ، واطلعنا على ما
جنته أيدي التتر ، فوالله - لو صدق المؤلف - هم ما كانوا أشد قسوة ولا أفظع
أعمالاً ولا أسفك دماء ولا أجمع لأنواع الفتك من بني أمية .
قال المؤلف ( حتى في أيام معاوية فإنه أرسل بسر بن أرطاة وأرسل معه
جيشًا ويقال : إنه ( أي معاوية ) أوصاهم أن يسيروا في الأرض ويقتلوا كل من
وجدوه من شيعة علي ولا يكفوا أيديهم عن النساء والصبيان ( الجزء الرابع صفحة
82 ) .
قبل أن أكشف عن جلية الأمر لا بد من تقديم مقدمة ، وهي أن المؤلف مدح
بني العباس وجعل أعمالهم مناطًا للعدل ودلالة على الرفق فقال :
( ولا غرابة فيما تقدم من عمران البلاد في ظل الدولة العباسية فإن العدالة توطد
دعائم الأمن ، وإذا أمن الناس على أرواحهم وحقوقهم تفرغوا للعمل فتعمر
البلاد ويرفه أهلها ويكثر خراجها ( الجزء الثاني صفحة 81 ) .
وعلى هذا إذا وجدنا بني أمية معادلين لنبي العباس في جميع أعمالهم سواء
بسواء كان اختصاصهم بالذم دون بني العباس جورًا فاحشًا وميلاً عظيمًا . ثم إن
هناك أمرًا آخر وهو أن المؤرخين بأسرهم كانوا في عصر بني العباس ومن المعلوم
أنه لم يكن يستطيع أحد أن يذكر محاسن بني أمية في دولة العباسيين ، فإذا صدر
من أحد شيء من ذلك فلتة كان يقاسي قائلها أنواعًا من الهتك والإيذاء ووخامة
العاقبة ، وكم لنا من أمثال هذه في أسفار التاريخ . ومع أننا نفخر بأن مؤلفي الإسلام
كانوا أصدق الناس رواية وأجرأهم على إظهار الحق ما كان يمنعهم عن بيان
الحقيقة سلطة ملك ولا مهابة جائر ، ولكن مع ذلك فرق بين تعمد الكذب والسكوت
عن الحق ، ولذلك نعتقد أنهم ما قالوا شيئًا افتراء على بني أمية ولكن إن قلنا :
إنهم كثيرًا ما سكتوا عن محاسنهم فذلك شيء لا يدفع وليس فيه غض منهم .
أما بنو العباس فكانوا في عصرهم ولاة البلاد ، وملاك رقاب الناس ، رضاهم
الحياة ، وسخطهم الموت ، فالوقيعة فيهم والأخذ عليهم ما كان يمكن إلا بعد
مخاطرة النفس والاقتحام في الهلاك ونصب النفس للموت .
رجعنا إلى قول المؤلف : إن معاوية أمر بقتل النساء والصبيان اعلم أن هذه
الواقعة أي إرسال ( بسر بن أرطاة ) إلى شيعة علي من أشهر الوقائع المذكورة في
سائر كتب التواريخ ، وليس في أحد منها قتل النساء والصبيان بل فيها ما يخالف
هذه الرواية قال المؤرخ اليعقوبي : ( ووجه معاوية بسر بن أرطاة وقيل : ابن أبي
أرطأة العامري من بني عامر بن لؤي في ثلاثة آلاف رجل فقال له : سر حتى تمر
بالمدينة فاطرد أهلهم وأَخِفْ من مررت بها وانهب مال من أصبت له مالاً ممن لم
يكن دخل في طاعتنا وأوهمْ أهل المدينة أنك تريد أنفسهم وأنه لا براءة لهم عندك...
حتى تدخل مكة ولا تعرض فيهما لأحد وأرهب الناس فيما بين مكة والمدينة ثم
امض حتى تأتي صنعاء فإن لنا بها شيعة وقد جاءني كتابهم . فخرج بسر فجعل لا
يمر بحي من أحياء العرب إلا فعل ما أمره معاوية ( اليعقوبي طبع أوربا صفحة
231 من الجزء الثاني ) .
فترى في هذه العبارة أنه لم يكن هناك إلا تخويف وتهديد وإيهام . ولما رأى
المؤلف أن المصادر التاريخية الموثوق بها لا يوجد فيها ما يوافق هواه جنح إلى
الأغاني ونقل أمر معاوية بقتل النساء والصبيان ثم اعتذر عن معاوية بأن المظنون
خلاف ذلك لحلمه ودهائه ، والظن أن معاوية أطلق يد بسر ولم يعين له حدودًا وكان
بسر سفاكًا للدماء فلم يستثن طفلاً ولا شيخًا .
قد قلنا : إن الأغاني من كتب المحاضرات ، فإذا كان الأمر هينًا والحديث
فكاهة أو تسللاً من كد العمل إلى استراحة فلا بأس به وبأمثاله أما إذا كان الأمر ذا
بال وكانت الواقعة معترك الاختلاف ومتعفر الأهواء رافعًا لشأن أو هادمًا لأساس
فأمثال هذه الكتب لا يؤذن لها ولا يلتفت إليها مطلقًا .
ثم إن الرجل ( أي صاحب الأغاني ) شيعي إذا جاءه شيء مما يشين معاوية
ويدنسه وجد في نفسه ارتياحًا إلى قبوله ، ولو كان من أوهن الأحاديث وأكذبها .
نعم إن بسر بن أرطاة قتل طفلين ولكن القتل لم يتجاوز الاثنين [1] فأين هذا
من قول المؤلف :
وكان بسر سفاكًا للدماء فلم يستثن طفلاً ولا شيخًا .
قال المؤلف ( فإذا كان هذا حال العمال في أيام معاوية مع حلمه وطول أناته
فكيف في أيام عبد الملك مع شدته وفتكه فهل يستغرب ما يقال عن فتك الحجاج
وكثرة من قتلهم صبرًا ، ولو كانوا 120000 ( الجزء الرابع صفحة 83 ) .
نعم قتل الحجاج مئة ألف أو مائتين ولكن أين هذا من صنيعة أبي مسلم
الخراساني القائم بدعوة بني العباس المؤسس لدولتهم فإنه قتل صبرًا بدون حرب ما
يبلغ ستمائة ألف ، وقد اعترف به المؤلف في هذا التأليف نفسه ( الجزء الثاني
صفحة 112 ) والمؤلف ينتحل لذلك عذرًا ويحسبه من طبيعة السياسة . فالحجاج
أحق بالعذر وأجدر بالعفو ، فإن الحجاج عربي قح طبعه الجفاء والقسوة . أما أبو
مسلم فعجمي تربى في حجر التمدن ، وغذي بلُبان الظرف ودَماثة الأخلاق (! !).
أما قوله إن عبد الملك كان أشد وطأة منه ( أي من الحجاج ) فلم يأت عليه
بشاهد غير غدره بعمر بن سعيد ، وأين هذا من غدر المنصور العباسي بأبي مسلم
الذي هو رب الدولة العباسية ، ولولاه لما قامت للعباسيين قائمة ، ولا كان لهم ذكر،
وكذلك غدر المنصور بابن هبيرة .
وغاية ما يقضي منه العجب أن المؤلف بعدما ذكر فتك بني أمية بقوله :( وقد
نفعتهم هذه السياسة ( أي سياسة الفتك ) في تأييد سلطانهم ( قال ) : صارت سُنَّة
من مَلَك بعدهم من بني العباس وغيرهم وأنت تعلم أن المؤلف يبرئ ساحة العباسية
من الجور والظلم فضلاً عن الفتك ، فهل هذا تناقض في القول أو أراد بهم نفعًا
فضرهم من حيث لا يعلم ؟ لا والله لا هذا ولا ذاك ، بل هي من مكايد المؤلف التي
لا يهتدي إليها إلا فطن خبير لطوية الرجل وكامن ضغنه .
((يتبع بمقال تالٍ))
__________
(1) اليعقوبي طبع أوروبا صفحة 311 من الجزء الثاني .
(2) الجزء الثاني من اليعقوبي صفحة 311 .
(3) الجزء الثاني صفحة 258 .
(4) المنار : في هذا النفي بل فيما أورده الناقد في هذه المسألة نظر فقد نقل الحافظ في الإصابة عن ابن يونس أن معاوية وجه بسرًا إلى اليمن و الحجاز سنة أربعين (وأمره أن ينظر من كان في طاعة علي فيوقع بهم ففعل) فهذا كلام المحدثين لا الشيعة وأهل المحاضرة ، وقد أشار في الإصابة إلى أنه لا ينبغي التشاغل بأخبار بسر الشهيرة في الفتن أي لما قيل من أن له صحبة وهل يعقل أن يكون إيقاعه بالمطيعين لعلي قاصرًا على قتله طفلي ابن عباس رضي الله عنهما ؟ ؟ .
التقاريظ
( انتقاد تاريخ التمدن الإسلامي وآداب اللغة العربية )
تشر العالم الفاضل شمس العلماء الشيخ شبلي النعماني رئيس جمعية ندوة
العلماء هذا الانتقاد بكتاب خاص ، ونشر جميعه في مجلة المنار ، وقد طبعه على
حدة ، ثم كتب الأستاذ العالم المحقق الشيخ أحمد عمر الإسكندري انتقادًا على الجزء
الثاني من كتاب تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي أفندي زيدان ، ورأينا في مجلة
المشرق انتقادًا آخر لهذا الجزء أيضًا للأستاذ الأب لويس شيخو اليسوعي ، فرأينا
تذييل انتقاد الشيخ النعماني بهذين الانتقادين ، وسيصدر الكتاب في أثناء شهر شوال
المقبل إن شاء الله تعالى ، وإليك ما كتبه صاحب ومنشئ المنار مقدمة لانتقاد الشيخ
شبلي النعماني ، وهو :
بسم الله الرحمن الرحيم
{ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ } ( الأنبياء : 112 ) .
أمّا بعدُ ، فإن علماء الإفرنج قد سبقونا إلى وضع تاريخ سلفنا في القالب
العلمي الحديث . ثم حذا حذوهم رصيفنا الفاضل جرجي أفندي زيدان بكتابه الذي
سماه ( تاريخ التمدن الإسلامي ) فشكر له عمله هذا المسلمون عربهم وعجمهم
بإقبالهم عليه , وترجمتهم إيّاه إلى عِدّة لغات وثنائهم عليه . ولكن الرجل أقدم على
هذا الأمر ولم يعدّ له كل عدته ، ولا أخذ له جميعَ أُهْبَتِهِ ، لما رأى مجال القول
واسعًا ، وميدان الكتابة واسعًا ، وكلاهما خالٍ من فِرْسَانِ الكلام ، حملته أسلات
الأقلام ، وظن أنه يكفيه من الاستعداد لذلك اقتباس أسلوب الإفرنج فيه ,
ومراجعة كتبهم العربية الجامعة لمادته ، ككتب الدين والأدب ، والتاريخ والنسب ،
وإنْ كان لم يأخذ هذه العلوم عن أهلها ، ولا عَرَفَ فَرْعَها ولا أصلَها ، ولعله لم يقرأ
شيئًا من كتبها قراءة دراسة وبحث ، إلا بعض كتب التاريخ المعروفة ؛ لأنه لَمَّا يكُنْ
مسلمًا , ولم يَتَرَبَّ في مدرسة تُقرأُ فيها العلومُ الإسلامية , لم يكن له باعث على
تحصيل هذه العلوم ، وإنما رأى نفسه محتاجًا إلى مراجعة كتبها ، عندما قام في
نفسه الباعث للتأليف فيها ، وَمَنْ كان هذا شأنه لا يتسنّى له فَهْم ما يراجعه مِن
المسائل حقَّ الفهم .
وقد قال الفقهاء : إن نقل المخالف في المذهب لا يعتدّ به ؛ لأن الفِقْهَ - وإنْ كان
فنًّا واحدًا - تختلف اصطلاحات المذاهب وأصولها فيه ، وطرق الترجيح
والتصحيح لمسائله ، فمن يراجع عند الحاجة كتابًا في غير مذهبه الذي تَلَقَّاهُ
بالمدارسة لا يوثق بفهمه لما يراجعه فيه , وكثيرًا ما يغتر بغير الصحيح المعتمد عند
أهله منه ، وإذا كان الأمر كذلك في نقل فقيه مذهب لبعض المسائل مِن مذهب آخرَ ,
فأجدر بالمخالف في أصل الذي ينظر إليه في غير مِرْآتِهِ ، والذي لم يتدارس شيئًا من
علومه ، أنْ لا يُعْتَدَّ بِفَهْمِهِ ، ولا يوثقَ بنقله ، مَهْمَا كان متحريًا للحق ، صدوقًا في
النقل ، ينقل ما ينقله بالحرف ، فإذا كان ينقل بالمعنى كما هو دأب صاحب تاريخ
التمدن في الغالب , فإن خطأَه يكون أكثرَ .
كنت كلما نُشِرَ جزء من أجزاء هذا التاريخ أنظر في بعض صفحاته , فأرى
فيها خطأً وغَلطًا في النقل والرأي , ويظهر أن سببَه ما شَرَحْتُهُ آنِفًا ، أو جعل
الواقعة الجزئية قضيةً كُلِّيَّةً وقاعِدَةً عامَّةً ، وقد نبّهْتُ على ذلك في ( المنار ) غيرَ
مَرّةٍ , واقترحت على أهل الفراغ من أهل التاريخ أن يطالعوا الكتاب كله ، وينتقدوه
انتقادًا عادلاً ، ويبينوا أغلاطه وخطأه في المسائل الإسلامية ، وهضمه للأمة العربية ،
لعل المصنف يصحح ويصلح ما يظهر له من الصواب ، ويبيِّن عذره في غيره
فيتحرر الكتاب ؛ لأنه كثيرًا ما يطالب الكتاب بالانتقاد , واعتذرت عن نفسي إذ لم
تقم بهذا العمل بكثرة الشواغل التي يضيق بها وقتي .
ولما عرض المصنف تاريخه هذا على نظارة المعارف العمومية لتقرره في
مدارسها عهدتُ إلى بعض أصدقائي من أساتذة مدارسها العالية بالنظر فيه , وبيان
رأيهم فيه لها ، فطالعوه وَبَيَّنُوا للنظارة أنه لا يصلح للتدريس لكثرة أغلاطه المعنوية
واللفظية ، وتمنيت يومئذ لو كانوا أحصوا ما ظَهَرَ لَهُمْ مِن ذلك الغَلَطِ , وَنَشَرُوهُ ,
وَاقْتَرَحْتُ ذَلِكَ على بعضِهِمْ فَمَا أَفَادَ الاقْتِرَاحُ ، وإذًا لتيسر تنقيح الكتاب .
وقد انتقد بعض الناظرين الكتاب في المؤيد ، وَرَمَوْا مُؤَلِّفَهُ بِسُوءِ النِّيَّةِ ، وتعمُّدِ
التحريف ، وفسادِ الاستنباط ، وَرَأَوْا أنْ سببَ ذَلِكَ هو التعصُّب الديني والنظر إلى
تاريخ الإسلام وآدابه بعين السخط . وكنت مخالفًا لهم في هذا الرأي ، وجاهرت
بِالرَّدِّ عَلَيْهِمْ فيه ، على علمي بأنه لا يعقل أن ينظر أحد إلى دين لا يدين اللهَ به
بعين الرضا التي يراه بها أهله ؛ لأنني لا أرمي أحدًا بسوء النية ، إلا بِبَيِّنََةٍ وَحُجَّةٍ
قوية .
ثم جاءني في فاتحة هذا العام وَرَقَاتٌ مطبوعةٌ مِن مصنف جديد في الانتقاد
على هذا التاريخ لعالم شهير من علماء الهند ، يعده جرجي أفندي زيدان صديقًا له ،
وهو شمس العلماء الشيخ شبلي النعماني رئيس جمعية ندوة العلماء ، وجاءني معه
كتاب من مؤلفه يرغب إليّ فيه أن أنشر هذا الانتقاد في المنار لِيَعُمَّ نَفْعُهُ . وهذا
الكتاب هو الذي دعاني فيه أول مرة إلى مؤتمر ندوة العلماء ، ورياسة احتفاله
السنوي في هذا العام ، ولما رجحت إجابة الدعوة صار لنشر هذا الانتقاد في المنار
ثلاث دَوَاعٍ : فائدة الانتقاد في نفسه ، وإجابة اقتراح كاتبه لعلمه وفضله ، والحاجة
إلى مادة للمنار في مدة سفري غير ما أكتبه من التفسير وغيره ، إذ لا يتيسر لي أن
أكتب في السفر كل ما يحتاج إليه من المواد .
أذنت بنشر الانتقاد في المنار وسافرت بعد الشروع فيه ، ولم أكن أعلم بكل ما
جاء فيه من الإنحاء الشديد من المنتقد على مؤلف تاريخ التمدن الإسلامي , ورميه
بالتحريف والكذب في النقل ، واتِّهَامه بسوء النية والقصد ، ولم أكن أتصور منه كل
هذه الشدة في التُّهْمَة ، وإبرازها في أقبح صورة ، لعلمي بما بينهما من المودة
الأدبية ، والصحبة القَلَمِيَّة ، ولو علمت بذلك لاستأذنت المنتقد في حذف تلك الألقاب ،
والتلطف في هاتيك العبارات ، ولما لقيته في الهند , وكنت قد قرأت بعض ما
نشر من الانتقاد راجعته القول في سبب هذه الشدة , فعلمت أن سببها الانفعال والتألم
من مؤلف تاريخ التمدن الإسلامي لاعتقاده أنه تعمد التحريف والكذب لأجل تحقير
العرب .. . وسبب هذا الاعتقاد أن ذلك الخطأ الكبير ، والغلط العظيم إما أن يكون
عن جهل ، أو عن سوء قصد ، والمنتقد يستبعد جِدًّا أنْ يكونَ عن جهل ، فترجَّح أو
تعين عنده أنه عن سوء قصد ، هذا ما علمناه منه ، وقد أطلعني على كتاب جاءه من
جرجي أفندي زيدان يقول فيه : إنه رأى الانتقاد على كتاب تاريخ التمدن الإسلامي
منشورًا في المنار معزوًّا إلى صديقه الشيخ شبلي النعماني , فلم يصدق أنه له
ولم يشأ أن يتنازل عن صحبة عشرين سنةً قبل التثبت بسؤاله عنه ، وطلب منه أن
ينكر عزوه إليه ، ولكن الأستاذ لم يجبه بشيء ، ليعلم أن السكوت إقرار ، وأن
الكذب والتزوير لا يَدْنُوانِ مِن مجلة المنار ، وقد عُلم من هذا أن رصيفنا الفاضل
صاحب الهلال الأغر قد أساء الظن بنا ولا شبهة ، بمقدار ما أَحْسَنَّا الظَّنَّ فيه على
كثرة الشُّبه .
وإنني مع هذا أُشْهِدُ اللهَ والناسَ أنني أجد في نفسي أَلَمًا مِن هذا الانتقادِ في
المنار ، مِن حَيْثُُ نَبْذُ الرصيفِ فيه بتلك الألقاب ، ثُمَّ من نشره كذلك في كتاب على
حدته ، بإذن المؤلف وإجازته ، ولكن الدواعي توفرت , والبواعث قد قضت بهذا
النشر .
هذا وإننا نرجو أن يكون لظهور هذا الانتقاد في هذه الأيام فائدة وراء فائدة
تمحيص التاريخ وحمل صاحب تاريخ التمدن الإسلامي على التروي والتدقيق فيما
يكتبه بعد في تاريخ الإسلام ، تلك الفائدة المرجوة هي أن يترجم هذا الانتقاد باللغة
التركية كما ترجم التاريخ المنتقد فيكبح من جِماح دعاة العصبية التركية الذين
استعانوا بنشر ترجمته بلغتهم على تحقير العرب وانتقاص مدنيتهم ، وغمط
حضارتهم ، وتفضيل الأعاجم عليهم ، فكادوا يولدون بذم العرب عصبيةً عربيةً ،
بإزاء ما رفعوا قواعده من العصبية التركية ، ولو كانوا يقسمون الجنسية الإسلامية
إلى عِدَّةِ جنسيات ، من غير مفاضلة ومغامز تثير العصبيات ، وتفرق بين الإخوة
والأخوات لَهَانَ الأمرُ ، وقلّ الضُّرُّ ، وَلَكِنَّهُمْ سَفَكُوا بِهَا دِمَاءَ الألوف الكثيرة ،
وَأَضَاعوا بذلك القناطير المقنطرة من أموال الدولة ، ولا يعلم أحد إلا الله إلى أين
تنتهي عاقبتها ، إذا لم يوفق رجال الدولة إلى تلافي أَمْرها .
ثم المَرْجُوُّ مِنَ الْمُطَّلِعِ على هذا الانتقادِ أنْ يجعل حظه منه تحرير المسائل
التاريحية دون الالتفات إلى مقاصد الكاتبين ، ونِيّات المصيبين والمخطئين ،
{ فَبِشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ
هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ } ( الزمر : 17-18 ) .
... ... ... ... ... ... ... ... ... محمد رشيد رضا
***
الكاتب : أحمد عمر الإسكندري
شوال - 1330هـ
أكتوبر - 1912م
غرة رجب - 1320هـ
3 أكتوبر - 1902م
3 أكتوبر - 1902م
الكاتب : محمد رشيد رضا
__________
قصص ( روايات ) مجلة الهلال
جاءنا من بعض فضلاء القراء ما يأتي بحروفه :
( رأيت في مجلة المنار الصادرة في غرة جمادى الأولى سنة 1320 تقريظًا
للرواية الأخيرة من روايات حضرة محرر مجلة الهلال التي عنوانها ( الحجاج بن
يوسف ) وقد ألمعتم فيه إلى ما انتقد به على المؤلف حينما ظهرت رواية ( عذراء
قريش ) وقد ظهر لبعض القراء أن حضرتكم لا تنقمون على هذه الروايات لما
قدمتموه من الأعذار عما يشوبها من الأكاذيب التي هي من لوازم وضعها مع أن
منها نسبة العشق إلى مثل محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما مع شهرته في التاريخ
بضد ذلك ، وتشبه عذراء قريش بالرجال ووقوفها في مجمع الصحابة ترشدهم إلى
حقائق الدين وتوبخهم على ما حصل منهم في بدء الفتنة المشهورة ، ولا يخفى
حضرتكم أن مثل مقدمته التي نقلتموها لا يبرئ الكاتب مما يأتي به مخالفًا لحقائق
التاريخ كما هو مبدأ الإسلام في كراهة الكذب على أية حال ، وإني متيقن أنكم لو
كنتم اطلعتم على هذه الرواية لما قلتم كلمة واحدة في تقريظها وما كنا نهتم لو جاء
هذا المدح في غير مجلة المنار التي هي المجلة الدينية الموثوق بها فيما تبديه من
الآراء في أحكام الدين ، فمعظم القراء يطلبون من حضرتكم الإفصاح عما ترون فيها
لأن المسألة عظيمة ؛ إذ أساسها تاريخ الإسلام والصحابة الذين هم الأسوة الحسنة في
أعمالهم وهم نقلة الحديث وهم الثقات فيما يروون ، وأنا واثق أن كلمة منكم ليست
ككلمة من غيركم ، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق إلى الحق والسلام ) .
( المنار ) قد صرحنا في تقريظ القصة الأخيرة بأننا لم نقرأ القصص التي
ينشئها صاحب الهلال في التاريخ الإسلامي فنحكم لها أو عليها ، وإنما ذكرنا أننا
قرأنا في المؤيد نقدًا عليها وعلمنا أن بعض الفضلاء ناقمين من مؤلفها ؛ لأنه وصف
بعض رجال السلف الكرام بالعشق الذي لا يليق بمقامه ، وقلنا في القصة الأخيرة
إننا رأيناها خالية من هذا العيب ، وهذا دليل على إنصاف المؤلف وعمله بما يقتضيه
نقد الناقد برجوعه عن نسبة العشق إلى الصحابة وأئمة السلف رضي الله عنهم .
والحاصل أن ما تنتقد به هذه القصص أمران أحدهما عدم حفظ كرامة السلف
بأن ينسب إليهم ما لا يليق بهم ، وقد كان المؤلف وقع في هذا تقليدًا للإفرنج الذين لا
يتحامون مثله ، ويظهر أنه رجع عنه إرضاءً لقراء ما يكتب من المسلمين ، وثانيهما
اشتباه الحق بالباطل في سرد وقائع التاريخ ممزوجًا بأخبار الغرام الكاذبة ونحن
نرى أن المقدمة التي نقلناها عنه تبرئه من هذا النقد إلا أن تكون غير صادقة ، فإذا
كان يقول إن كل ماعدا الحكاية الغرامية من القصة هو من التاريخ المنقول فلا
سبيل إلى تخطيئه إلا ببيان أن بعض ما في تلك القصص وراء الحكاية الغرامية التي
تتخللها غير صحيح أو أن هناك اشتباهًا بين الحكاية والتاريخ ، فعلى المنتقد
الشواهدُ والبيناتُ إذا ادعى هذا ، وعلينا أن ننشره ونبين رأينا فيه والله يوفقنا جميعًا
لما يحبه ويُرضِيه . (5/397)
__________
قصص ( روايات ) مجلة الهلال
جاءنا من بعض فضلاء القراء ما يأتي بحروفه :
( رأيت في مجلة المنار الصادرة في غرة جمادى الأولى سنة 1320 تقريظًا
للرواية الأخيرة من روايات حضرة محرر مجلة الهلال التي عنوانها ( الحجاج بن
يوسف ) وقد ألمعتم فيه إلى ما انتقد به على المؤلف حينما ظهرت رواية ( عذراء
قريش ) وقد ظهر لبعض القراء أن حضرتكم لا تنقمون على هذه الروايات لما
قدمتموه من الأعذار عما يشوبها من الأكاذيب التي هي من لوازم وضعها مع أن
منها نسبة العشق إلى مثل محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما مع شهرته في التاريخ
بضد ذلك ، وتشبه عذراء قريش بالرجال ووقوفها في مجمع الصحابة ترشدهم إلى
حقائق الدين وتوبخهم على ما حصل منهم في بدء الفتنة المشهورة ، ولا يخفى
حضرتكم أن مثل مقدمته التي نقلتموها لا يبرئ الكاتب مما يأتي به مخالفًا لحقائق
التاريخ كما هو مبدأ الإسلام في كراهة الكذب على أية حال ، وإني متيقن أنكم لو
كنتم اطلعتم على هذه الرواية لما قلتم كلمة واحدة في تقريظها وما كنا نهتم لو جاء
هذا المدح في غير مجلة المنار التي هي المجلة الدينية الموثوق بها فيما تبديه من
الآراء في أحكام الدين ، فمعظم القراء يطلبون من حضرتكم الإفصاح عما ترون فيها
لأن المسألة عظيمة ؛ إذ أساسها تاريخ الإسلام والصحابة الذين هم الأسوة الحسنة في
أعمالهم وهم نقلة الحديث وهم الثقات فيما يروون ، وأنا واثق أن كلمة منكم ليست
ككلمة من غيركم ، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق إلى الحق والسلام ) .
( المنار ) قد صرحنا في تقريظ القصة الأخيرة بأننا لم نقرأ القصص التي
ينشئها صاحب الهلال في التاريخ الإسلامي فنحكم لها أو عليها ، وإنما ذكرنا أننا
قرأنا في المؤيد نقدًا عليها وعلمنا أن بعض الفضلاء ناقمين من مؤلفها ؛ لأنه وصف
بعض رجال السلف الكرام بالعشق الذي لا يليق بمقامه ، وقلنا في القصة الأخيرة
إننا رأيناها خالية من هذا العيب ، وهذا دليل على إنصاف المؤلف وعمله بما يقتضيه
نقد الناقد برجوعه عن نسبة العشق إلى الصحابة وأئمة السلف رضي الله عنهم .
والحاصل أن ما تنتقد به هذه القصص أمران أحدهما عدم حفظ كرامة السلف
بأن ينسب إليهم ما لا يليق بهم ، وقد كان المؤلف وقع في هذا تقليدًا للإفرنج الذين لا
يتحامون مثله ، ويظهر أنه رجع عنه إرضاءً لقراء ما يكتب من المسلمين ، وثانيهما
اشتباه الحق بالباطل في سرد وقائع التاريخ ممزوجًا بأخبار الغرام الكاذبة ونحن
نرى أن المقدمة التي نقلناها عنه تبرئه من هذا النقد إلا أن تكون غير صادقة ، فإذا
كان يقول إن كل ماعدا الحكاية الغرامية من القصة هو من التاريخ المنقول فلا
سبيل إلى تخطيئه إلا ببيان أن بعض ما في تلك القصص وراء الحكاية الغرامية التي
تتخللها غير صحيح أو أن هناك اشتباهًا بين الحكاية والتاريخ ، فعلى المنتقد
الشواهدُ والبيناتُ إذا ادعى هذا ، وعلينا أن ننشره ونبين رأينا فيه والله يوفقنا جميعًا
لما يحبه ويُرضِيه . (5/397)
( فتح الأندلس )
قصة تاريخية غرامية هي الحلقة السابعة من سلسلة ( روايات تاريخ الإسلام )
تتضمن تاريخ أسبانيا قبيل الفتح ، ووصف أحوالها الإدارية والسياسية والدينية
وعلاقة بعضها ببعض ، وبسط عادات القوط والرومان هناك ، والفرق بين طبقات
الناس ، وقدوم طارق بن زياد لفتحها ، والسبب الذي دعاه إلى ذلك - إلى مقتل
رودريك ملك القوط في واقعة وادي ليتة سنة 93هـ ( هذا ما لخص به الرواية
مؤلفها جُرجي أفندي زيدان ، وهي كما قال ، رغب إلينا المؤلف في قراءة القصة
قبل تقريظها حبًّا في النقد الذي لا يحبه إلا الواثق بحسن عمله ، الراغب في تكميله
فقرأناها بلذة عظيمة ، وشهدنا له بحسن تصنيف القصص ، فإن القارئ لا ينتهي من
فصل من فصولها إلا بشوق يلح به ، ويحفزه إلى قراءة ما بعده حتى ينتهي بالفصل
الأخير .
وننتقد عليه أن المقصود من القصة بيان تاريخ الإسلام كسوابقها ، وليس فيها
منه إلا ذكر الفتح بغاية الإيجاز . وانتقد غيرنا من نبهاء المسلمين على هذه القصص
أنها تصوِّر للقارئ أن انتصار المسلمين في الفتوحات لم يكن إلا بسبب ما كان ألمَّ
بالأمم التي فتحوا بلادها كالرومانيين والفرس والمصريين والبربر والقوط من فساد
الأخلاق واختلاف المذاهب الدينية ، وتفرق الكلمة . ويرى هؤلاء المنتقدون أن هذا
غمْط لحقوق المسلمين وعدم اعتراف بشجاعتهم وعناية الله تعالى بهم حمل المؤلف
عليهما التعصب الديني . ونحن ننكر عليهم هذا الرأي كتابة كما أنكرناه قولاً ، فإن ما
ذكره من فساد دين الأمم وأخلاقها وتفريق كلمتها هو السبب الأول في قهر أولئك
الشراذم من المسلمين لتلك الأمم القوية العظيمة السلطان بل لولا ذلك الفساد العام لما
أرسل الله تعالى ذلك المصلح العام كافة للناس بشيرًا ونذيرًا ( صلى الله عليه وسلم )
وأيده بعنايته فجمع له كلمة الأمة العربية التي لا يعرف لها التاريخ اجتماعًا ، فأدبها
وأدب بها - على بداوتها - أمم العلوم والمدنية ، على أن المؤلف نوه بشجاعة
العرب وفضلهم وعدلهم ، ولم ينقصهم منه شيئًا .
أما عبارة القصة فقد كنت أتوقع أن تكون خيرًا مما سبقها فإذا هي كغيرها في
السلاسة ، ولكن فيها كلمات وعبارات عامية لم أَرَ مثلها في كتابة قبلها للرصيف
فجزمت بأنه متعمد ليسهل فهم كتابته على العوام ، وعندي أن سلاسة عبارته كافية
في الوصول إلى هذا المرام ، وصحة العبارة لا تحول بين المعنى والأفهام(6/389)
قصة تاريخية غرامية هي الحلقة السابعة من سلسلة ( روايات تاريخ الإسلام )
تتضمن تاريخ أسبانيا قبيل الفتح ، ووصف أحوالها الإدارية والسياسية والدينية
وعلاقة بعضها ببعض ، وبسط عادات القوط والرومان هناك ، والفرق بين طبقات
الناس ، وقدوم طارق بن زياد لفتحها ، والسبب الذي دعاه إلى ذلك - إلى مقتل
رودريك ملك القوط في واقعة وادي ليتة سنة 93هـ ( هذا ما لخص به الرواية
مؤلفها جُرجي أفندي زيدان ، وهي كما قال ، رغب إلينا المؤلف في قراءة القصة
قبل تقريظها حبًّا في النقد الذي لا يحبه إلا الواثق بحسن عمله ، الراغب في تكميله
فقرأناها بلذة عظيمة ، وشهدنا له بحسن تصنيف القصص ، فإن القارئ لا ينتهي من
فصل من فصولها إلا بشوق يلح به ، ويحفزه إلى قراءة ما بعده حتى ينتهي بالفصل
الأخير .
وننتقد عليه أن المقصود من القصة بيان تاريخ الإسلام كسوابقها ، وليس فيها
منه إلا ذكر الفتح بغاية الإيجاز . وانتقد غيرنا من نبهاء المسلمين على هذه القصص
أنها تصوِّر للقارئ أن انتصار المسلمين في الفتوحات لم يكن إلا بسبب ما كان ألمَّ
بالأمم التي فتحوا بلادها كالرومانيين والفرس والمصريين والبربر والقوط من فساد
الأخلاق واختلاف المذاهب الدينية ، وتفرق الكلمة . ويرى هؤلاء المنتقدون أن هذا
غمْط لحقوق المسلمين وعدم اعتراف بشجاعتهم وعناية الله تعالى بهم حمل المؤلف
عليهما التعصب الديني . ونحن ننكر عليهم هذا الرأي كتابة كما أنكرناه قولاً ، فإن ما
ذكره من فساد دين الأمم وأخلاقها وتفريق كلمتها هو السبب الأول في قهر أولئك
الشراذم من المسلمين لتلك الأمم القوية العظيمة السلطان بل لولا ذلك الفساد العام لما
أرسل الله تعالى ذلك المصلح العام كافة للناس بشيرًا ونذيرًا ( صلى الله عليه وسلم )
وأيده بعنايته فجمع له كلمة الأمة العربية التي لا يعرف لها التاريخ اجتماعًا ، فأدبها
وأدب بها - على بداوتها - أمم العلوم والمدنية ، على أن المؤلف نوه بشجاعة
العرب وفضلهم وعدلهم ، ولم ينقصهم منه شيئًا .
أما عبارة القصة فقد كنت أتوقع أن تكون خيرًا مما سبقها فإذا هي كغيرها في
السلاسة ، ولكن فيها كلمات وعبارات عامية لم أَرَ مثلها في كتابة قبلها للرصيف
فجزمت بأنه متعمد ليسهل فهم كتابته على العوام ، وعندي أن سلاسة عبارته كافية
في الوصول إلى هذا المرام ، وصحة العبارة لا تحول بين المعنى والأفهام(6/389)
. غرة رجب - 1322هـ
11 سبتمبر - 1904م
11 سبتمبر - 1904م
الكاتب : محمد رشيد رضا
__________
آثار علمية وأدبية
( تاريخ التمدن الإسلامي )
صدر الجزء الثالث من هذا الكتاب لمؤلفه جرجي أفندى زيدان صاحب مجلة
الهلال وهو يبحث ( فى العلم والأدب ، وما كان منهما عند العرب قبل الإسلام من
التغيير في القرائح والعقول , وما نقل عن اللغات الأجنبية من العلوم , وما كان من
تأثير التمدن الإسلامي في كل ذلك ) فما كان قبل الإسلام هو النجوم والأنواء
والميثولوجيا والكهانة ، ويعني بالميثولوجيا : الخرافات المتعلقة بتأليه النجوم
والأنواء ، والميثولوجيا الخرافات وأما العلم الحقيقي الذي كان عندهم فهو التاريخ ,
والأنساب فرع منه والأدب , ومنه الشعر والخطابة , وما هو ممزوج من الحقيقة
والوهم وهو الطب ، وقد ذكر المؤلف هذه كلها سردًا على وجه التقسيم ، وكانوا
يعرفون علومًا أخرى لم يتكلم عنها كعلم الريافة ( استنباط المياه من الأرض )
والقيافة والعيافة والزجر وغير ذلك ، ولم يكن شيء من هذه العلوم مدونًا في
الصحف والكتب ، بل كان مما يعملون به ويتناقلونه باللسان لأنهم أميون . وأما
العلوم الإسلامية فهي لسانية ودينية وعقلية وكونية وفيها أكثر مباحث الكتاب .
وذكر المؤلف في مقدمته أن من الإفرنج من هضم في كتبه المسلمين أو
العرب ، وغمص حقهم العلمي فلم يعترف بفضلهم ، بل زعم أنهم أفسدوا ما نقلوه ,
ومنهم من أنصف واعترف بفضلهم ، وهم المستشرقون الذين بحثوا وعرفوا ، ولكن
بعض هؤلاء أطنب في مدح العرب ، وذكر لهم من المزايا ما لا يوجد له ذكر في
كتبهم مع أن الكتب العربية هي منبع التاريخ والمعارف الإسلامية ، وأنه هو توسط
بين الطرفين ، ولكن لا يخفى عليه أنه يصح أن نجعل ما بين أيدينا من الكتب هو
الميزان لمعارف العرب , فإن معظم كتب سلفنا قد ضاع من أيدينا ، ولم يُبْقِ لنا
الجهل بقيمة تلك الآثار ، وما يلزمه من سوء الاختيار إلا أدنى الكتب وأقلها فائدة
ومكاتب الإفرنج مملوءة بتلك الذخائر المفقودة ، والآثار الضائعة ، ثم إن الأجنبي
عن الأمة قلما ينصفها في فضلها تمام الإنصاف ، وأقل من ذلك وأبعد عن المعقول
أن يهبها ما ليس لها من المزايا والأوصاف إلا أن يكون الكاتب من أصحاب الأهواء
المعروفة لا من أهل العلم والمعرفة ، ومن الهوى حب الإغراب , والكذب في
المبالغة والإطناب .
وقد قرأنا نبذًا من الكتاب متفرقة فرأيناها شاهدة لما نعتقده في المؤلف من
الإنصاف ، ولكننا رأينا بعض المسلمين يرميه بالتعصب ، ووصلت شكواهم منه
إلى أكبر معاهد العلم الإسلامي في مصر ، وهذه الشكوى لا تزيد على ما كتبه إلينا
بعض أهل العلم في دمياط ، وقد طلب منا كغيره الرد عليه , فرأينا من الظلم أن
نجازي من يتعب في خدمتنا بذكر هفواته قبل التنويه بفائدة كتابه ، ولذلك بادر إلى
تقريظه قبل مطالعته ، وهذا نص الكتاب الوارد من دمياط :
( قرأت ما نشر صاحب الهلال في هذه الأيام الأخيرة من تاريخ التمدن
الإسلامي ؛ فوجدته وإن نوه بما للإسلام والمسلمين من الفضل إلا أن في طوايا
الكتاب وزوايا الكثير من صحائفه ما يرمي المسلمين في العصر الأول بالجمود
والتعصب الديني فإن لم يتيسر لك تصفح الكتاب فانظر الصحيفة التاسعة والثلاثين .
ليس هذا كل ما أقصد من الكتابة لحضرة الفاضل صاحب المنار ، وإنما أهم
ما دعاني إلى الكتابة استلفات نظره إلى مسألة دينية أشار لها حضرة الكاتب تحت
عنوان ( المأمون والاعتزال ) صحيفة 141 , وهي مسألة الخلاف في القرآن هل
هو مخلوق أو غير مخلوق فإنه حرفها بظنه ، وفسرها برأيه حيث قال بعد أن نوه
بفطنة المأمون ، وميله إلى البحث العقلي ما نصه : ( فتمكن من مذهب الاعتزال ,
وأخذ يناصر أشياعه , وصرح بأقوال لم يكونوا يستطيعون التصريح بها خوفًا من
غضب الفقهاء , ومن جملتها القول بخلق القرآن , أي أنه غير مُنْزَل ) فنستلفت
نظرك أيها الفاضل لقوله : أي أنه غير مُنْزَل بل إلى الكتاب كله والسلام ) .
( المنار )
أما ما جاء في ( ص 39 ) فهو منتقد ، ولكنه معتقد المؤلف فيما أرى , ولم
يقصد به إهانة الإسلام والنيل منه ، قال : كان الإسلام في أول أمره نهضة عربية ,
والمسلمون هم العرب ، وكان اللفظان مترادفين , فإذا قالوا : العرب ؛ أرادوا
المسلمين , وبالعكس .
ولأجل هذه الغاية أمر عمر بن الخطاب بإخراج غير المسلمين من جزيرة
العرب . ونقول : إن هذا غلط سرى للمؤلف من استعمال الأجانب من عهد بعيد
فأطلقه ، والصواب أن المسلمين في صدر الإسلام كانوا يطلقون كلمة العرب أحيانًا
في مقابلة المسلمين فيعنون بهم المشركين ، ولم يكن اللفظان مترادفين عند المسلمين
في وقت ما على الإطلاق ، بل كانوا يطلقون لفظ المسلم والمسلمين على كل من
دخل في الإسلام ، وإذا أطلق على العرب خاصة كان تجوزًا يعرف بالقرينة . ولم
يخرج عمر غير المسلمين من الجزيرة اجتهادًا منه ، بل عملاً بأمر النبي - صلى
الله عليه وآله وسلم - فقد أوصى بذلك في مرض موته , ثم قال المؤلف :
( وأما الإسلام وقوامه القرآن ففي تأييده تأييد الإسلام والعرب ، وتمكن هذا
الاعتقاد في الصحابة لما فازوا في فتوحهم ، وتغلبوا على دولتي الروم و الفرس
فنشأ في اعتقادهم أنه لا ينبغي أن يسود غير العرب ، ولا يتلى غيرالقرآن ، وشاع
هذا الاعتقاد خصوصًا في أيام بني أمية ، وقد بالغوا فيه حتى آل ذلك فيهم إلى نقمة
سائر الأمم عليهم ) .
ونقول : إن القرآن بلا شك أساس الإسلام ، ولكن ليس فيه ما يدل على أن
العرب يجب أن يكونوا ممتازين على غيرهم , بل يقول : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا
خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } ( الحجرات : 13 ) نعم ، إن تأييد العرب له تأييد لهم إذ لولاه لم يخرجوا من
ظلمة جاهليتهم , ولكن فتح بلاد الروم والفرس لم يزد الصحابة اعتقادًا بما ذكره ,
وإنما كانوا يعتقدون كما يعتقد كل مسلم إلى الآن وإلى ما شاء الله أنه لا يصح أن
يعتقد بأن شيئًا من الدين إلا ما جاء في القرآن والسنة ، أو أرشد إليه الكتاب أو
السنة ، وهذا الاعتقاد لا يمنع جواز قراءة كل كتاب نافع والانتفاع بكل علم في أمر
الدينا ، ولاسيما وقد قال لنا نبينا : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) وأمرنا أن نطلب
العلم ولو بالصين , وأن نأخذ الحكمة أينما وجدت . وما كان من أمر بني أمية ؛
فهو من الأثرة والطمع ولم يميزوا أنفسهم على الأعاجم وحدهم ، بل ميزوها قبل
كل شيء على آل بيت النبي عليه وعليهم السلام ثم قال :
( أما في الصدر الأول فقد كان الاعتقاد العام أن الإسلام يهدم ما قبله ، فرسخ
في الأذهان أنه لا ينبغي أن ينظر في كتاب غير القرآن ؛ لأنه جاء ناسخًا لكل كتاب
قبله ) اهـ . ونقول : إن معنى هدم الإسلام لما هو قبله أن من دخل فيه لا يؤاخذ
على الكفر والمعاصي التي كان عليها قبله كما يعلم من النصوص الصريحة ، وليس
معناه أنه أبطل العلوم والفنون الدينية والدنيوية معًا ، كيف وأكثر المسلمين يقولون
إلى اليوم بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد عندنا ما ينسخه بخصوصه ، وأما
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر في كتب اليهود ، وعن تصديقهم وتكذيبهم
فسببه عدم الثقة بما ينقلونه عن كتبهم على أنها محرفة ، وقد { نَسُوا حَظاًّ مِّمَّا
ذُكِّرُوا بِهِ } ( المائدة : 13 ) ومثلهم في هذا النصارى ، وقد خالف هذا النهي بعض
الرواة ، فأدخلوا في كتب المسلمين من الإسرائيليات ما شوه كتب السير والتفسير
والحديث بالأكاذيب والخرافات ، ولولا نقد الحفاظ لاختلط علينا الأمر بسوء قصدهم ,
أو فهمهم كما اختلط على من قبلنا . وقد جعل المؤلف هذه النبذة مقدمة للنبذة التي
يرجح فيها أن العرب هم الذين أحرقوا مكتبة الإسكندرية ، وما كان أغناه عن ذلك .
هذا ما أشار إليه الدمياطي عن ( ص39 ) وأما تفسير المؤلف لخلق القرآن بما
فسره به في ( ص141 ) فهو من اجتهاده الغريب الذي انفرد به ، ولم يخطر على
بال أحد قبله من المعتزلة ، ولا من أهل السنة , فإن هؤلاء لا يكفرون المعتزلة
بالقول بخلق القرآن , والفريقان مع سائر الفرق الإسلامية على إجماع واتفاق على
كفر من يقول : إن القرآن غير منزل ؛ لأن هذا القول تكذيب صريح للقرآن وللنبي
لا يحتمل التأويل ولا التعليل ، والذي يقول به يستحيل أن يلتزم شيئًا من عقائد
المسلمين وعباداتهم . وإنما يعنون بخلق القرآن ما كانوا يسمونه مسألة اللفظ ، وهو
أن ألفاظ القرآن التي يكيفها التالي بصوته مخلوقة ، ومن فوائد إنكار أهل السنة
والجماعة لهذا القول : أنه ربما يفضي إلى أن يقول بعض الناس إنه يلزم من
حدوث ألفاظ القرآن أن لا يكون منزلاً من الله تعالى - كما قال المؤلف - فيخرجوا
من الإسلام .
وإنا لنعلم أن كثيرًا من المسلمين يظنون أن المؤلف يتعمد أمثال هذا القول
طعنًا في الدين وتشكيكًا في الإسلام ، وقد صرحنا من قبل باعتقادنا فيه ، وأنه يقول
ما وصل إليه علمه بحسن نية ، وأنه ليس من متعصبي النصارى الذين يرضون
تعصبهم بإفساد العلم كاليسوعيين الذين حرفوا كتب المسلمين لهذا الغرض ، حتى لا
ثقة بكتاب يطبع عندهم ، وبينا سبب وقوع هذه الأغلاط في كتب جرجي أفندي
زيدان ، وهي أنه لم يدرس المسائل الإسلامية ، ويأخذها عن أهلها من كتبها ، وإنما
يتناول نتفًا منها من كتب التاريخ والأدب وغيرها ؛ فيجيء بيانه للمسألة أو حكمه
عليها خطأ في بعض الأحيان مهما كانت ظاهرة جلية في مواضعها كما صرحنا
بذلك في تقريظ الجزء الثاني من هذا الكتاب . وعذر الذين يسيئون الظن فيه أنه
يقول في الإسلام بما لم يقل به أحد , ويعزو إلى أهله ما لم يخطر لأحد منهم ببال
من غير دليل , كتفسيره مسألة خلق القرآن بأنه غير منزل من الله ، والحقيقة ما
قلناه , وليس لنا أن نعد ما هو بديهي عندنا بديهيًّا عند المخالفين لنا في الدين الذين
لم يدرسوه دراستنا لعدم حاجتهم إلى ذلك . نعم ، كان ينبغى لهذا المؤلف الذي نعهد
فيه الإنصاف وحب الحقيقة أن يعرض المسائل الدينية الإسلامية المحضة على عالم
مسلم قبل تدوينها , وهي قليلة لا تزيد في عنائه على مراجعة الكتب في المكتبة
المصرية . وفي الكتاب مباحث أخرى تستحق النقد ، ربما نعود إليها في وقت آخر ,
وفيه فوائد كثيرة لا تجدها مجموعة في كتاب عربي .
وإننا مع هذا نشكر للمؤلف عنايته واجتهاده وسبقه إلى إدخال أساليب التأليف
الحديثة في اللغة العربية ، ونرجو أن يزيد في التحري مع الاعتراف بأنه لا عصمة
لأحد في اجتهاده ، ونحث أهل العلم والبحث على النظر في كتبه هذه ، ومن كان
ينتقدها على الإطلاق فليأتنا بخير منها ؛ نكن له من السامعين الشاكرين . وصفحات
هذا الجزء 314 , وثمن النسخة عشرون قرشًا .
__________
آثار علمية وأدبية
( تاريخ التمدن الإسلامي )
صدر الجزء الثالث من هذا الكتاب لمؤلفه جرجي أفندى زيدان صاحب مجلة
الهلال وهو يبحث ( فى العلم والأدب ، وما كان منهما عند العرب قبل الإسلام من
التغيير في القرائح والعقول , وما نقل عن اللغات الأجنبية من العلوم , وما كان من
تأثير التمدن الإسلامي في كل ذلك ) فما كان قبل الإسلام هو النجوم والأنواء
والميثولوجيا والكهانة ، ويعني بالميثولوجيا : الخرافات المتعلقة بتأليه النجوم
والأنواء ، والميثولوجيا الخرافات وأما العلم الحقيقي الذي كان عندهم فهو التاريخ ,
والأنساب فرع منه والأدب , ومنه الشعر والخطابة , وما هو ممزوج من الحقيقة
والوهم وهو الطب ، وقد ذكر المؤلف هذه كلها سردًا على وجه التقسيم ، وكانوا
يعرفون علومًا أخرى لم يتكلم عنها كعلم الريافة ( استنباط المياه من الأرض )
والقيافة والعيافة والزجر وغير ذلك ، ولم يكن شيء من هذه العلوم مدونًا في
الصحف والكتب ، بل كان مما يعملون به ويتناقلونه باللسان لأنهم أميون . وأما
العلوم الإسلامية فهي لسانية ودينية وعقلية وكونية وفيها أكثر مباحث الكتاب .
وذكر المؤلف في مقدمته أن من الإفرنج من هضم في كتبه المسلمين أو
العرب ، وغمص حقهم العلمي فلم يعترف بفضلهم ، بل زعم أنهم أفسدوا ما نقلوه ,
ومنهم من أنصف واعترف بفضلهم ، وهم المستشرقون الذين بحثوا وعرفوا ، ولكن
بعض هؤلاء أطنب في مدح العرب ، وذكر لهم من المزايا ما لا يوجد له ذكر في
كتبهم مع أن الكتب العربية هي منبع التاريخ والمعارف الإسلامية ، وأنه هو توسط
بين الطرفين ، ولكن لا يخفى عليه أنه يصح أن نجعل ما بين أيدينا من الكتب هو
الميزان لمعارف العرب , فإن معظم كتب سلفنا قد ضاع من أيدينا ، ولم يُبْقِ لنا
الجهل بقيمة تلك الآثار ، وما يلزمه من سوء الاختيار إلا أدنى الكتب وأقلها فائدة
ومكاتب الإفرنج مملوءة بتلك الذخائر المفقودة ، والآثار الضائعة ، ثم إن الأجنبي
عن الأمة قلما ينصفها في فضلها تمام الإنصاف ، وأقل من ذلك وأبعد عن المعقول
أن يهبها ما ليس لها من المزايا والأوصاف إلا أن يكون الكاتب من أصحاب الأهواء
المعروفة لا من أهل العلم والمعرفة ، ومن الهوى حب الإغراب , والكذب في
المبالغة والإطناب .
وقد قرأنا نبذًا من الكتاب متفرقة فرأيناها شاهدة لما نعتقده في المؤلف من
الإنصاف ، ولكننا رأينا بعض المسلمين يرميه بالتعصب ، ووصلت شكواهم منه
إلى أكبر معاهد العلم الإسلامي في مصر ، وهذه الشكوى لا تزيد على ما كتبه إلينا
بعض أهل العلم في دمياط ، وقد طلب منا كغيره الرد عليه , فرأينا من الظلم أن
نجازي من يتعب في خدمتنا بذكر هفواته قبل التنويه بفائدة كتابه ، ولذلك بادر إلى
تقريظه قبل مطالعته ، وهذا نص الكتاب الوارد من دمياط :
( قرأت ما نشر صاحب الهلال في هذه الأيام الأخيرة من تاريخ التمدن
الإسلامي ؛ فوجدته وإن نوه بما للإسلام والمسلمين من الفضل إلا أن في طوايا
الكتاب وزوايا الكثير من صحائفه ما يرمي المسلمين في العصر الأول بالجمود
والتعصب الديني فإن لم يتيسر لك تصفح الكتاب فانظر الصحيفة التاسعة والثلاثين .
ليس هذا كل ما أقصد من الكتابة لحضرة الفاضل صاحب المنار ، وإنما أهم
ما دعاني إلى الكتابة استلفات نظره إلى مسألة دينية أشار لها حضرة الكاتب تحت
عنوان ( المأمون والاعتزال ) صحيفة 141 , وهي مسألة الخلاف في القرآن هل
هو مخلوق أو غير مخلوق فإنه حرفها بظنه ، وفسرها برأيه حيث قال بعد أن نوه
بفطنة المأمون ، وميله إلى البحث العقلي ما نصه : ( فتمكن من مذهب الاعتزال ,
وأخذ يناصر أشياعه , وصرح بأقوال لم يكونوا يستطيعون التصريح بها خوفًا من
غضب الفقهاء , ومن جملتها القول بخلق القرآن , أي أنه غير مُنْزَل ) فنستلفت
نظرك أيها الفاضل لقوله : أي أنه غير مُنْزَل بل إلى الكتاب كله والسلام ) .
( المنار )
أما ما جاء في ( ص 39 ) فهو منتقد ، ولكنه معتقد المؤلف فيما أرى , ولم
يقصد به إهانة الإسلام والنيل منه ، قال : كان الإسلام في أول أمره نهضة عربية ,
والمسلمون هم العرب ، وكان اللفظان مترادفين , فإذا قالوا : العرب ؛ أرادوا
المسلمين , وبالعكس .
ولأجل هذه الغاية أمر عمر بن الخطاب بإخراج غير المسلمين من جزيرة
العرب . ونقول : إن هذا غلط سرى للمؤلف من استعمال الأجانب من عهد بعيد
فأطلقه ، والصواب أن المسلمين في صدر الإسلام كانوا يطلقون كلمة العرب أحيانًا
في مقابلة المسلمين فيعنون بهم المشركين ، ولم يكن اللفظان مترادفين عند المسلمين
في وقت ما على الإطلاق ، بل كانوا يطلقون لفظ المسلم والمسلمين على كل من
دخل في الإسلام ، وإذا أطلق على العرب خاصة كان تجوزًا يعرف بالقرينة . ولم
يخرج عمر غير المسلمين من الجزيرة اجتهادًا منه ، بل عملاً بأمر النبي - صلى
الله عليه وآله وسلم - فقد أوصى بذلك في مرض موته , ثم قال المؤلف :
( وأما الإسلام وقوامه القرآن ففي تأييده تأييد الإسلام والعرب ، وتمكن هذا
الاعتقاد في الصحابة لما فازوا في فتوحهم ، وتغلبوا على دولتي الروم و الفرس
فنشأ في اعتقادهم أنه لا ينبغي أن يسود غير العرب ، ولا يتلى غيرالقرآن ، وشاع
هذا الاعتقاد خصوصًا في أيام بني أمية ، وقد بالغوا فيه حتى آل ذلك فيهم إلى نقمة
سائر الأمم عليهم ) .
ونقول : إن القرآن بلا شك أساس الإسلام ، ولكن ليس فيه ما يدل على أن
العرب يجب أن يكونوا ممتازين على غيرهم , بل يقول : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا
خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } ( الحجرات : 13 ) نعم ، إن تأييد العرب له تأييد لهم إذ لولاه لم يخرجوا من
ظلمة جاهليتهم , ولكن فتح بلاد الروم والفرس لم يزد الصحابة اعتقادًا بما ذكره ,
وإنما كانوا يعتقدون كما يعتقد كل مسلم إلى الآن وإلى ما شاء الله أنه لا يصح أن
يعتقد بأن شيئًا من الدين إلا ما جاء في القرآن والسنة ، أو أرشد إليه الكتاب أو
السنة ، وهذا الاعتقاد لا يمنع جواز قراءة كل كتاب نافع والانتفاع بكل علم في أمر
الدينا ، ولاسيما وقد قال لنا نبينا : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ) وأمرنا أن نطلب
العلم ولو بالصين , وأن نأخذ الحكمة أينما وجدت . وما كان من أمر بني أمية ؛
فهو من الأثرة والطمع ولم يميزوا أنفسهم على الأعاجم وحدهم ، بل ميزوها قبل
كل شيء على آل بيت النبي عليه وعليهم السلام ثم قال :
( أما في الصدر الأول فقد كان الاعتقاد العام أن الإسلام يهدم ما قبله ، فرسخ
في الأذهان أنه لا ينبغي أن ينظر في كتاب غير القرآن ؛ لأنه جاء ناسخًا لكل كتاب
قبله ) اهـ . ونقول : إن معنى هدم الإسلام لما هو قبله أن من دخل فيه لا يؤاخذ
على الكفر والمعاصي التي كان عليها قبله كما يعلم من النصوص الصريحة ، وليس
معناه أنه أبطل العلوم والفنون الدينية والدنيوية معًا ، كيف وأكثر المسلمين يقولون
إلى اليوم بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد عندنا ما ينسخه بخصوصه ، وأما
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر في كتب اليهود ، وعن تصديقهم وتكذيبهم
فسببه عدم الثقة بما ينقلونه عن كتبهم على أنها محرفة ، وقد { نَسُوا حَظاًّ مِّمَّا
ذُكِّرُوا بِهِ } ( المائدة : 13 ) ومثلهم في هذا النصارى ، وقد خالف هذا النهي بعض
الرواة ، فأدخلوا في كتب المسلمين من الإسرائيليات ما شوه كتب السير والتفسير
والحديث بالأكاذيب والخرافات ، ولولا نقد الحفاظ لاختلط علينا الأمر بسوء قصدهم ,
أو فهمهم كما اختلط على من قبلنا . وقد جعل المؤلف هذه النبذة مقدمة للنبذة التي
يرجح فيها أن العرب هم الذين أحرقوا مكتبة الإسكندرية ، وما كان أغناه عن ذلك .
هذا ما أشار إليه الدمياطي عن ( ص39 ) وأما تفسير المؤلف لخلق القرآن بما
فسره به في ( ص141 ) فهو من اجتهاده الغريب الذي انفرد به ، ولم يخطر على
بال أحد قبله من المعتزلة ، ولا من أهل السنة , فإن هؤلاء لا يكفرون المعتزلة
بالقول بخلق القرآن , والفريقان مع سائر الفرق الإسلامية على إجماع واتفاق على
كفر من يقول : إن القرآن غير منزل ؛ لأن هذا القول تكذيب صريح للقرآن وللنبي
لا يحتمل التأويل ولا التعليل ، والذي يقول به يستحيل أن يلتزم شيئًا من عقائد
المسلمين وعباداتهم . وإنما يعنون بخلق القرآن ما كانوا يسمونه مسألة اللفظ ، وهو
أن ألفاظ القرآن التي يكيفها التالي بصوته مخلوقة ، ومن فوائد إنكار أهل السنة
والجماعة لهذا القول : أنه ربما يفضي إلى أن يقول بعض الناس إنه يلزم من
حدوث ألفاظ القرآن أن لا يكون منزلاً من الله تعالى - كما قال المؤلف - فيخرجوا
من الإسلام .
وإنا لنعلم أن كثيرًا من المسلمين يظنون أن المؤلف يتعمد أمثال هذا القول
طعنًا في الدين وتشكيكًا في الإسلام ، وقد صرحنا من قبل باعتقادنا فيه ، وأنه يقول
ما وصل إليه علمه بحسن نية ، وأنه ليس من متعصبي النصارى الذين يرضون
تعصبهم بإفساد العلم كاليسوعيين الذين حرفوا كتب المسلمين لهذا الغرض ، حتى لا
ثقة بكتاب يطبع عندهم ، وبينا سبب وقوع هذه الأغلاط في كتب جرجي أفندي
زيدان ، وهي أنه لم يدرس المسائل الإسلامية ، ويأخذها عن أهلها من كتبها ، وإنما
يتناول نتفًا منها من كتب التاريخ والأدب وغيرها ؛ فيجيء بيانه للمسألة أو حكمه
عليها خطأ في بعض الأحيان مهما كانت ظاهرة جلية في مواضعها كما صرحنا
بذلك في تقريظ الجزء الثاني من هذا الكتاب . وعذر الذين يسيئون الظن فيه أنه
يقول في الإسلام بما لم يقل به أحد , ويعزو إلى أهله ما لم يخطر لأحد منهم ببال
من غير دليل , كتفسيره مسألة خلق القرآن بأنه غير منزل من الله ، والحقيقة ما
قلناه , وليس لنا أن نعد ما هو بديهي عندنا بديهيًّا عند المخالفين لنا في الدين الذين
لم يدرسوه دراستنا لعدم حاجتهم إلى ذلك . نعم ، كان ينبغى لهذا المؤلف الذي نعهد
فيه الإنصاف وحب الحقيقة أن يعرض المسائل الدينية الإسلامية المحضة على عالم
مسلم قبل تدوينها , وهي قليلة لا تزيد في عنائه على مراجعة الكتب في المكتبة
المصرية . وفي الكتاب مباحث أخرى تستحق النقد ، ربما نعود إليها في وقت آخر ,
وفيه فوائد كثيرة لا تجدها مجموعة في كتاب عربي .
وإننا مع هذا نشكر للمؤلف عنايته واجتهاده وسبقه إلى إدخال أساليب التأليف
الحديثة في اللغة العربية ، ونرجو أن يزيد في التحري مع الاعتراف بأنه لا عصمة
لأحد في اجتهاده ، ونحث أهل العلم والبحث على النظر في كتبه هذه ، ومن كان
ينتقدها على الإطلاق فليأتنا بخير منها ؛ نكن له من السامعين الشاكرين . وصفحات
هذا الجزء 314 , وثمن النسخة عشرون قرشًا .
رجب - 1326هـ
أغسطس - 1908م
أغسطس - 1908م
( تاريخ العرب قبل الإسلام )
كتاب جديد يؤلفه جرجي أفندي زيدان ، المؤرخ العربي الشهير ، وقد أنجز
الجزء الأول منه ، فإذا هو قد استمد مسائله من الكتب العربية ، والكتب الإفرنجية
في اللغات المختلفة . ولبعض الكتب الإفرنجية مزية على العربية في هذا الموضوع
بما اكتشفوه من الآثار القديمة في بلاد العرب . وقد اقتبس المؤلف شيئًا منها لا
يستغني عن الاطلاع عليه قراء العربية ، وهو على قلته يصحّ أن يتمثل فيه بقول
الشاعر :
قليل ما أمرت به ولكن ... قليلك لا يقال له قليل
وقد نظرنا في الكتاب نظرة إجمالية ، فألفيناه حسن الترتيب جامعًا لكثير من
المباحث النافعة ، ولكن لم يتح لنا مطالعته لنحكم فيه على علم بما نرجو أن يكون قد
جاء به من التحقيق فعسى أن ينتدب بعض من قرأه من أهل العلم والرأي إلى
موافاتنا بمقال حافل في تقريظه ونقده ، إظهارًا لقيمته ، وشكرًا لفضل مؤلفه ، أما
ثمن هذا الجزء الذي صدر من الكتاب فعشرون قرشًا مصريًّا ، ويطلب من مكتبة
الهلال بالفجالة .
-
كتاب جديد يؤلفه جرجي أفندي زيدان ، المؤرخ العربي الشهير ، وقد أنجز
الجزء الأول منه ، فإذا هو قد استمد مسائله من الكتب العربية ، والكتب الإفرنجية
في اللغات المختلفة . ولبعض الكتب الإفرنجية مزية على العربية في هذا الموضوع
بما اكتشفوه من الآثار القديمة في بلاد العرب . وقد اقتبس المؤلف شيئًا منها لا
يستغني عن الاطلاع عليه قراء العربية ، وهو على قلته يصحّ أن يتمثل فيه بقول
الشاعر :
قليل ما أمرت به ولكن ... قليلك لا يقال له قليل
وقد نظرنا في الكتاب نظرة إجمالية ، فألفيناه حسن الترتيب جامعًا لكثير من
المباحث النافعة ، ولكن لم يتح لنا مطالعته لنحكم فيه على علم بما نرجو أن يكون قد
جاء به من التحقيق فعسى أن ينتدب بعض من قرأه من أهل العلم والرأي إلى
موافاتنا بمقال حافل في تقريظه ونقده ، إظهارًا لقيمته ، وشكرًا لفضل مؤلفه ، أما
ثمن هذا الجزء الذي صدر من الكتاب فعشرون قرشًا مصريًّا ، ويطلب من مكتبة
الهلال بالفجالة .
-
الكاتب : أحمد الإسكندري
رمضان - 1326هـ
أكتوبر - 1908م
رمضان - 1326هـ
أكتوبر - 1908م
إلمامة بكتاب تاريخ العرب قبل الإسلام
لحضرة الفاضل جرجي أفندي زيدان
[*]
عرف الناس في مصر من حضرة الفاضل جرجي أفندي زيدان معلمًا فمترجمًا
فصحافيًّا ففيلسوفًا لغويًّا فنسابة فروائيًّا مبتدعًا فمتفرّسًا فمؤرخًا خياليًّا قصاصًا . ثم
هم يستقبلون منه الآن مؤرخًا إسلاميًّا محققًا ، ولا ندري ما يعرف منه أهل سورية
قبل هجرته إلى مصر ، كل هذه صفات فاضلة ومواهب جليلة قلما يخلص بعضها
لأفذاذ العلماء ونوابغ الرجال . وهي بخلوصها لحضرته أفادت من لا يُحصَى عددهم
من قراء العربية ولا سِيَّمَا المسيحيين منهم وعلماء الشرقيات من الأوربيين وغيرهم
ممن لا يحبون مطالعة الكتب العربية أو لا يستفيدون منها لو لم تشكل بالأشكال التي
رسمها جرجي أفندي زيدان لمؤلفاته العديدة .
كان هذا الفاضل يؤلف الكتب الروائية ، ويأتي فيها بالممكن والمستحيل
والمستملح والمستنكر ، فكنا لا نتعرض لها بمسخ أو نسخ ، لعِلْمِنا أن الذي قاده إلى
هذه المواقف هو استرسال الخيال ، وهو قد يفضي بصاحبه في النثر إلى مثل ما
يفضي به في الشعر ، فيكون أعذبه أكذبه ، ولاعتقادنا أن نفعها أكبر من إثمها ، وأن
الكتب العربية الصحيحة لا تزال بعد منتشرة في جميع أرجاء العالم ، ناطقة ببيان
الغث من السمين ، والصحيح من الباطل ، على أنه ما من كتاب وضعه بشر إلا
وكان فيه لهوى النفس والسخائم الدينية والعصبية الجنسية بله الخطأ والغفلة أثر أي
أثر ، إلا ما شذ وندر ، فلما قرأت تقريظ حضرة الفاضل ( المغربي ) أحد محرري
المؤيد لكتاب ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) ، وهو آخر ما أُخرج للناس بعدُ مِنْ كُتُب
مؤلفنا المذكور وجدته قد ملأ ما يقرب من صفحة من صفحات المؤيد بعبارات
الإطراء والتهويل والإعجاب والإغراب مما لو قبله القارئ لم يشك أن العرب خلقت
خلقًا جديدًا أو أن تاريخ جاهليتها الأولى المقبور في بطون القدم قد نبشه المؤلف من
ناوُوسه ، فرابني قولُه - والمبالغة تريب - ولم أَرَ الأمر يخرج عن إحدى خصال
ثلاث ، إما أن يكون قرظه ولم يقرأه كعادة أكثر محرري الصحف لضيق وقتهم ؛
وإما أن يكون قرأه وصانع المؤلف لصداقة بينهما - وللصداقة حقوق - وإما أن يكون
المؤلف قد وفق حقيقة للعثور على الضالة المنشودة والحلقة المفقودة من تاريخ
جاهلية العرب ، وما ذلك بعزيز على نشاط الرجل واجتهاده .
ولما كنت ممن عُنِيَ بهذا الموضوع عناية شديدة ، قرأت الكتاب بإلهاف ، أخذ
يتناقص بتناقص أوراق الكتاب ، فإذا به - والحق أقول - خير مؤلفات الرجل ، ولا
أنكر أنه أفادني بعض فوائد ثمينة ، هاجت في نفسي ميلاً إلى نقده ولا يُنْقَد إلا كل
ذي قيمة .
يقع كتاب ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) في 250 صفحة ، كتب في 30
صفحةً منها مقدمة طويلة ، ليست من موضوع الكتاب في شيء ، وإنما ذكر فيها
كعادته في كتبه غموض تاريخ العرب وصعوبة التأليف فيه أو تعذره ، إلا على
من كان من أهل الجسارة أو الاطلاع الواسع ، والمعرفة بكثير من اللغات الحية
والميتة والبحث والتنقيب في آثار الأمم الخالية ، ثم ذكر شبه فهرس مطول ، ثم
تمهيدًا في مصادر تاريخ العرب ، وهي الكتب العربية وغير العربية من اليونانية
والرومانية والنقوش الأثرية ، وقد تحامل على العرب فيها ما شاء أن يتحامل ، مما
يظن معه قارئه ابتداء أن أكثر مصادر الكتاب أثرية أو يونانية قديمة أو أوربية
حديثة ، لكثرة أسماء الكتب والرحلات التي ذكرها ، وهي نحو السبعين كتابًا ، غير
الموسوعات والمعاجم الكبرى التاريخية والأثرية وغيرها ( كما يقول ) فإذا هو قرأ
الكتاب وجد أن نحو أربعة أخماسه عربي المصدر ، وأن لا ذكر لهذه الكتب
والمعاجم إلا نزرًا يسيرًا في ذيل الكتاب ، يعرف ذلك مَنِ اطّلع على الكتاب بإمعان ،
ومن رأيي أن هذه المقدمة تجارية أكثر منها علمية .
* * *
فائدة المؤرخ من الكتاب
إن الذي لا يعرف اللغات الأوربية يستفيد من الكتاب :
أولاً : ما ترجمه المؤلف من آراء بعض قدماء اليونان في الجغرافية العربية
غثّة كانت أو سمينة .
ثانيًا : ما ترجمه من آراء بعض سياح الأوربيين قي شمال جزيرة العرب وجنوبها على قلة في ذلك .
ثالثًا : بعض الصور والرسوم والخطوط والنقود التي نقلها من رحلات هؤلاء
السياح ، مثل رسم سد مأرب ، وبعض قصور اليمن ، وهيكل تدمر وبطرا .
رابعًا : معرفة كيف كان يختلف اللسان النبطي والتدمري عن العربي الفصيح ،
وهي فوائد تشكر للمؤلف إذاعتها في كتاب مستقل .
* * *
الأمور التي تؤخذ على المؤلف
الأمر الأول : تردده أو إنكاره بعض الحقائق التاريخية البديهية في موضع ،
وتشبثه بتحقيق بعض الظنون والتخرصات في موضع آخر ، اعتمادًا على أوهام
وتخيلات قامت بذهنه فقط .
فمثال الأول : أنه عندما أراد التكلم على تقسيم عرب أواسط الجزيرة وشماليها
إلى قحطانيين ( يمانيين ) وعدنانيين ، مال إلى إنكار هذا التقسيم ، ورأى رأيًا
عجيبًا لا يخطر على بال مؤرخ ولا قارئ ، وهو أن هؤلاء العرب كلهم عدنانيون ،
فعنده أن مثل طَيِّئ و كندة و لخم و جذام و مذحج و همدان و مازن و الأوس
والخزرج عدنانيون . ونورد هنا ما قاله في ذلك ( صفحة 182 و183 ) قال :
وكل هذه البطون أو القبائل قد رأيت أنها ترجع بأنسابها إلى كهلان بن سبأ ،
أي أنهم قحطانية ، ذلك ما أجمع عليه العرب ، ولكن لنا رأيًا في هذا الإجماع ، لا
يخلو ذكره من فائدة .
قد رأيت في ما ذكرناه عن الفروق بين القحطانية والعدنانية ، أن لكل منهما
خصائص في اللغة والاجتماع والعادات والدين وأسماء الأعلام . وإذا تدبرت أحوال
هذه الدول من غسان ولخم وكندة رأيتها تنطبق على العدنانية أكثر مما ( كذا ) على
القحطانية ، مِن حيثُ اللغةُ ، فإننا لم نَرَ في كلامهم وأقوالهم ما يدل على أنهم كانوا
يتكلمون لغة حِمْيَر ، بل لغة العدنانية أو عرب الشمال في الطور الثاني . وقد يقال :
إنهم اقتبسوا لغة الوسط الذي انتقلوا إليه ، ولكنا نستبعد ذلك ، لأن الغالب في اقتباس
لغة الآخرين أن يقع من الضعيف نحو القوي - فلو كان أولئك القوم قادمين من بلاد
اليمن لَحافظوا على لسانهم وسائر عاداتهم ، لأنهم كانوا يومئذ أرفع منزلة من بدو
الشمال ، وكان هؤلاء ينظرون إلى اليمنية نظرهم إلى أهل الدولة ويعدونهم الملوك ،
كما ينظر البدوي الأمي إلى المتمدنين أصحاب الصولة والعلم . وزد على ذلك أن
اليمنية كانوا يكتبون بالحرف المسند ولا نرى لهذا الحرف ذكرًا في أخبارهم ، ولا
أثرًا في أطلالهم .
وقد علمت أن الكهلانيين أهل حضارة كما رأيت في ما ذكرناه من حديث سيل
العرم ، وكيف أن الكهلانيين كانوا أهل حدائق وقصور باعوها وانتقلوا . فلو صح
ذلك لاختاروا الإقامة في بلد آخر من اليمن غير مأرب وما جاورها ؛ لأن السيل لم
يخرب إلا جزءًا صغيرًا من اليمن . فلم يكونوا يعدمون مكانًا يقيمون فيه ، كما كان
يقيم سواهم من قبائل الحضر ، وإخوانهم الحميريون مازالوا أهل دولة وعمران
وظلوا في رغد ورخاء وسَعَة من العيش إلى ظهور الإسلام .
فما كان أغنى الكهلانيين عن الرحلة إلى بادية الشام أو العراق والرجوع إلى
البداوة ، وهي شاقة على من تعود الحضارة والرخاء .
واعتبر ذلك في معبوداتهم ، فإنها من معبودات عرب الشمال أو العدنانية ، ولم
نجد عندهم ما يميزهم عن هؤلاء من هذا القبيل . ولو كانوا من عرب اليمن ،
لوجدنا بين معبوداتهم اسم عشتار أو إيل أو نحوها .
وهكذا يقال في أسمائهم وليس فيها رائحة الأعلام السَّبَئِيَّة أو المعينية ، بل هي
مثل أسماء سائر عرب الشمال ، ولا سِيَّمَا الذين سكنوا مشارف الشام قبلهم كالأنباط
ونحوهم ، ومنها الحارث و ثعلبة و جبلة و النعمان وغيرها . ولا يعترض بما ذكره
العرب بين أسماء ملوك حمير من أمثال هذه ، فإن أكثرها مبدل بأسماء شمالية ،
وإنما عمدتنا في ما ذكرناه على الأسماء التي وقفوا عليها في الآثار المنقوشة .
فلا دليل على قحطانية هذه الأمم إلا أقوال النسابين ، وهي أضعف من أن
يعول عليها في هذا الشأن ، لاحتمال أن تكون تلك الأمم قد انتحلت الانتساب إلى
عرب اليمن التماسًا للفخر بين قوم لا يعرفونهم ، ولا سِيَّمَا بعد أن تقربوا من الروم
أو الفرس وصاروا من عمالهم ا هـ .
* * *
ونقول في دحض هذه الأقوال :
( 1 ) أما عدم الاختلاف في اللغة ، فإن الاختلاف فيها إما أن يكون في
الأصول ، وإما في الفروع ، أما الأصول فلم يكن بينها خلاف جوهري ؛ لأن لغات
العرب كلها من أصل واحد ، كما اعترفت به حضرته ، وأما الفروع فلم ينكر أحد
سواه وقوع الاختلاف فيها حتى في لغات القبائل التي لم تخرج من اليمن ،
فالاختلاف في الإعراب والتصريف والقلب والإعلال والإبدال مملوء به كتب النحو
والصرف والاختلافات في معاني الكلمات المفردة لم تهملها كتب اللغة والأدب ،
ولذلك وقائعُ وحكايات جر الخطأ في التفاهم بسببها إلى إزهاق الأرواح ، كما في
حكاية قتل مالك بن نويرة وقومه ، وكلنا يعرف ما هي العجعجة والشنشنة
والاستنطاء في لغات اليمانية .
ولو كان بعض الاتفاق في اللغات بين القبائل المختلفة يجعلها من أصل واحد ،
لقد كان المحتم على حضرة المؤرخ أن تقول : إن قبائل حمير التي لم تخرج من اليمن
عدنانية أيضًا ، لاتحادها مع العدنانيين في الأصول واختلافها عنها في بعض الفروع
إبّانَ ظهور الإسلام ، وقد حفظ لنا التاريخ الصحيح وكتب السنة الصحيحة كثيرًا من
مقالات وفود الحميريين على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي لا تختلف عن
العدنانية إلا في معاني بعض المفردات . وإنما حدث هذا التقارب في اللهجة واللغة
لتقاربهم في البيئة ( الوسط ) وللمجامع والأسواق التي كانوا يقيمونها ، وأما أن
الضعيف يقتبس لغة القوي ، وزعمه أن اليمانيين كانوا هم الأقوياء الغالبين ، فذلك
على فرض تسليمه ، لا ينهض حجة على إثبات دعواه ، لما كانت عليه العرب في
القرون القريبة من ظهور الإسلام من التقارب في جميع الأحوال ، حتى قبائل حمير
نفسها بعد غلبة الحبشة والفرس عليها .
( 2 ) وأمّا إنه لم يوجد أثر للحرف المسند من جهات الشمال ، فذلك قد كذبه
بنفسه في موضع آخر عند تكلمه على عرب الصفا ، حيث أتى بهذا العنوان لأمم
سبئية في الشمال ، وذكر تحت هذا العنوان كلامًا كثيرًا عن أن أمم حمير انتقلت
إلى الشمال ووجد لها أنواع من الخط المسند ، كالقلم الصفوي والثمودي واللحياني ،
وقال : إن الباحثين لا يزالون في أول البحث .
( 3 ) أمّا إنه لا حامل للقحطانيين على الهجرة من بلادهم وجناتهم وقصورهم
إلى الصحاري المجدبة بلا سبب عظيم ، وأن سيل العرم لا يكفي لتفرقهم أيادي سبأ ،
فإن الأسباب الحقيقية لهذه الهجرة لا تزال مجهولةً ، كأسباب هجرة أكثر الأمم
القديمة ، وإنما كان من أهمها حادثة سيل العَرِم ، مضافة إلى منازعات وحروب
أهلية أو مجاعات أو أن الأرض قد ضاقت عليهم ، فالتمسوا غيرها من بلاد الله ،
ولم تكن وجهتهم في رحلتهم هذه القفار ، بل كانت ريف العراق ومشارف الشام ،
ولا تنكر حضرة المؤرخ عظم دولتهم في الحيرة و الأنبار وفي سوريا و فلسطين ،
فلقد احتلوا في الأولى جميع الأراضي التي بين دجلة والفرات ، حتى سميت العراق
العربي ، وفي الثانية أكثر بلاد فلسطين وسورية و حلب ، ولا شَكّ أن هذه كانت
أخصب من بلادهم ، وبقية اليمانيين الذين سكنوا البدو منهم ، فإنما تراجعوا إليه بعد
منافسات مع بني عمهم في الشمال مع بُعْد عهدهم باليمن وخصبه ، وأما اكتفاء
المؤرخين بذكر حادثة سيل العَرِم ، فذلك وَهْم سرى إليهم من تعقيب ذكر قصة السيل
في القرآن الكريم بقوله تعالى : { وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ
مُمَزَّقٍ } ( سبأ : 19 ) , فإن الظاهر من الآية أن التمزيق سببه ظلم أنفسهم ،
والظلم يأتي بأسباب كثيرة اعتدائية ، لا بسبب خارجي فجائي لا دخل لهم فيه ، مثل
انفجار السد .
( 4 ) وأما دعوى اتحادهم في المعبودات ، فلا نسلم أنها كلها كانت عدنانية ،
بل كانت خليطًا من كل الأديان ، فقد عبد كثير من العدنانيين الشمس والقمر
والكواكب ، وهي من معبودات أهل الجنوب ، كما تهود وتنصر أهل الجنوب ،
واليهودية والنصرانية من أديان أهل الشمال .
( 5 ) وأما توافق أسمائهم ، فذلك إرث من طبيعة الجوار والبيئة وتمازجهم
في كل شيء ، كما يسمي الأقباط الآن أنفسهم بأسماء عربية وتركية بعدما زالت
سيطرة العرب والترك ، وكما يسمي الترك أنفسهم بأسماء عربية مع أنهم هم
الغالبون للعرب ، وكما يسمي السوريون أنفسهم بأسماء إنجليزية وفرنسية ، على أن
هذا المؤرخ الذي أنكر في غير موضع من كتابه وجود أسماء عدنانية بين أسماء
الحميربين نقض كلامه في صفحة ( 159 ) حيث نقل عن غلازر الألماني ، أحد
الأثرين اللذين وجدهما في أطلال السد ، وهذا كتبه أبرهة قبيل ظهور الإسلام ، وفيه
يذكر الأقيال الذين قهرهم أو ولاهم عنه ، مثل يزيد بن كبش و مرة و ثمامة و حنش
ومرثد ، وكل هذه أسماء عدنانية ، كما أن معد يكرب الزبيدي اسمه حميري ،
وهو من القبائل التي ينكر المؤرخ حميريتها .
وأما الأدلة الوجودية على أن القبائل المذكورة قحطانية ، فأكثر من أن نأتي بها
جميعها في هذه المقالة ، وهي بالغة بصراحتها إلى أفق البديهيات .
فمنها اعتراف جميع هذه القبائل بأنها يمانية ، حتى بعد أن ظهرت مضر
عليهم في وقائع عديدة ، وبعد أن خضعوا للمضريين بعد الإسلام وتعصب المضرية
واليمانية في الفتن التي وقعت في الصدر الأول غصت به كتب التاريخ والأدب .
ومنها إجماع النسابين والمؤرخين باعتراف حضرته على أن القبائل المذكورة
قحطانية .
ومنها ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مما يشير إلى هذه التفرقة . ولو أردنا
ذكر الشواهد التاريخية من الوقائع والمفاخرات وقصائد الشعر من الحماسة والمدح
والهجاء وجميع الأحاديث النبوية لإثبات أن هذه القبائل قحطانية ، لوضعنا في ذلك
كتابًا يزيد عن كتاب جرجي أفندي زيدان أضعافًا .
((يتبع بمقال تالٍ))
__________
(*) بقلم الشيخ أحمد الإسكندري .
لحضرة الفاضل جرجي أفندي زيدان
[*]
عرف الناس في مصر من حضرة الفاضل جرجي أفندي زيدان معلمًا فمترجمًا
فصحافيًّا ففيلسوفًا لغويًّا فنسابة فروائيًّا مبتدعًا فمتفرّسًا فمؤرخًا خياليًّا قصاصًا . ثم
هم يستقبلون منه الآن مؤرخًا إسلاميًّا محققًا ، ولا ندري ما يعرف منه أهل سورية
قبل هجرته إلى مصر ، كل هذه صفات فاضلة ومواهب جليلة قلما يخلص بعضها
لأفذاذ العلماء ونوابغ الرجال . وهي بخلوصها لحضرته أفادت من لا يُحصَى عددهم
من قراء العربية ولا سِيَّمَا المسيحيين منهم وعلماء الشرقيات من الأوربيين وغيرهم
ممن لا يحبون مطالعة الكتب العربية أو لا يستفيدون منها لو لم تشكل بالأشكال التي
رسمها جرجي أفندي زيدان لمؤلفاته العديدة .
كان هذا الفاضل يؤلف الكتب الروائية ، ويأتي فيها بالممكن والمستحيل
والمستملح والمستنكر ، فكنا لا نتعرض لها بمسخ أو نسخ ، لعِلْمِنا أن الذي قاده إلى
هذه المواقف هو استرسال الخيال ، وهو قد يفضي بصاحبه في النثر إلى مثل ما
يفضي به في الشعر ، فيكون أعذبه أكذبه ، ولاعتقادنا أن نفعها أكبر من إثمها ، وأن
الكتب العربية الصحيحة لا تزال بعد منتشرة في جميع أرجاء العالم ، ناطقة ببيان
الغث من السمين ، والصحيح من الباطل ، على أنه ما من كتاب وضعه بشر إلا
وكان فيه لهوى النفس والسخائم الدينية والعصبية الجنسية بله الخطأ والغفلة أثر أي
أثر ، إلا ما شذ وندر ، فلما قرأت تقريظ حضرة الفاضل ( المغربي ) أحد محرري
المؤيد لكتاب ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) ، وهو آخر ما أُخرج للناس بعدُ مِنْ كُتُب
مؤلفنا المذكور وجدته قد ملأ ما يقرب من صفحة من صفحات المؤيد بعبارات
الإطراء والتهويل والإعجاب والإغراب مما لو قبله القارئ لم يشك أن العرب خلقت
خلقًا جديدًا أو أن تاريخ جاهليتها الأولى المقبور في بطون القدم قد نبشه المؤلف من
ناوُوسه ، فرابني قولُه - والمبالغة تريب - ولم أَرَ الأمر يخرج عن إحدى خصال
ثلاث ، إما أن يكون قرظه ولم يقرأه كعادة أكثر محرري الصحف لضيق وقتهم ؛
وإما أن يكون قرأه وصانع المؤلف لصداقة بينهما - وللصداقة حقوق - وإما أن يكون
المؤلف قد وفق حقيقة للعثور على الضالة المنشودة والحلقة المفقودة من تاريخ
جاهلية العرب ، وما ذلك بعزيز على نشاط الرجل واجتهاده .
ولما كنت ممن عُنِيَ بهذا الموضوع عناية شديدة ، قرأت الكتاب بإلهاف ، أخذ
يتناقص بتناقص أوراق الكتاب ، فإذا به - والحق أقول - خير مؤلفات الرجل ، ولا
أنكر أنه أفادني بعض فوائد ثمينة ، هاجت في نفسي ميلاً إلى نقده ولا يُنْقَد إلا كل
ذي قيمة .
يقع كتاب ( تاريخ العرب قبل الإسلام ) في 250 صفحة ، كتب في 30
صفحةً منها مقدمة طويلة ، ليست من موضوع الكتاب في شيء ، وإنما ذكر فيها
كعادته في كتبه غموض تاريخ العرب وصعوبة التأليف فيه أو تعذره ، إلا على
من كان من أهل الجسارة أو الاطلاع الواسع ، والمعرفة بكثير من اللغات الحية
والميتة والبحث والتنقيب في آثار الأمم الخالية ، ثم ذكر شبه فهرس مطول ، ثم
تمهيدًا في مصادر تاريخ العرب ، وهي الكتب العربية وغير العربية من اليونانية
والرومانية والنقوش الأثرية ، وقد تحامل على العرب فيها ما شاء أن يتحامل ، مما
يظن معه قارئه ابتداء أن أكثر مصادر الكتاب أثرية أو يونانية قديمة أو أوربية
حديثة ، لكثرة أسماء الكتب والرحلات التي ذكرها ، وهي نحو السبعين كتابًا ، غير
الموسوعات والمعاجم الكبرى التاريخية والأثرية وغيرها ( كما يقول ) فإذا هو قرأ
الكتاب وجد أن نحو أربعة أخماسه عربي المصدر ، وأن لا ذكر لهذه الكتب
والمعاجم إلا نزرًا يسيرًا في ذيل الكتاب ، يعرف ذلك مَنِ اطّلع على الكتاب بإمعان ،
ومن رأيي أن هذه المقدمة تجارية أكثر منها علمية .
* * *
فائدة المؤرخ من الكتاب
إن الذي لا يعرف اللغات الأوربية يستفيد من الكتاب :
أولاً : ما ترجمه المؤلف من آراء بعض قدماء اليونان في الجغرافية العربية
غثّة كانت أو سمينة .
ثانيًا : ما ترجمه من آراء بعض سياح الأوربيين قي شمال جزيرة العرب وجنوبها على قلة في ذلك .
ثالثًا : بعض الصور والرسوم والخطوط والنقود التي نقلها من رحلات هؤلاء
السياح ، مثل رسم سد مأرب ، وبعض قصور اليمن ، وهيكل تدمر وبطرا .
رابعًا : معرفة كيف كان يختلف اللسان النبطي والتدمري عن العربي الفصيح ،
وهي فوائد تشكر للمؤلف إذاعتها في كتاب مستقل .
* * *
الأمور التي تؤخذ على المؤلف
الأمر الأول : تردده أو إنكاره بعض الحقائق التاريخية البديهية في موضع ،
وتشبثه بتحقيق بعض الظنون والتخرصات في موضع آخر ، اعتمادًا على أوهام
وتخيلات قامت بذهنه فقط .
فمثال الأول : أنه عندما أراد التكلم على تقسيم عرب أواسط الجزيرة وشماليها
إلى قحطانيين ( يمانيين ) وعدنانيين ، مال إلى إنكار هذا التقسيم ، ورأى رأيًا
عجيبًا لا يخطر على بال مؤرخ ولا قارئ ، وهو أن هؤلاء العرب كلهم عدنانيون ،
فعنده أن مثل طَيِّئ و كندة و لخم و جذام و مذحج و همدان و مازن و الأوس
والخزرج عدنانيون . ونورد هنا ما قاله في ذلك ( صفحة 182 و183 ) قال :
وكل هذه البطون أو القبائل قد رأيت أنها ترجع بأنسابها إلى كهلان بن سبأ ،
أي أنهم قحطانية ، ذلك ما أجمع عليه العرب ، ولكن لنا رأيًا في هذا الإجماع ، لا
يخلو ذكره من فائدة .
قد رأيت في ما ذكرناه عن الفروق بين القحطانية والعدنانية ، أن لكل منهما
خصائص في اللغة والاجتماع والعادات والدين وأسماء الأعلام . وإذا تدبرت أحوال
هذه الدول من غسان ولخم وكندة رأيتها تنطبق على العدنانية أكثر مما ( كذا ) على
القحطانية ، مِن حيثُ اللغةُ ، فإننا لم نَرَ في كلامهم وأقوالهم ما يدل على أنهم كانوا
يتكلمون لغة حِمْيَر ، بل لغة العدنانية أو عرب الشمال في الطور الثاني . وقد يقال :
إنهم اقتبسوا لغة الوسط الذي انتقلوا إليه ، ولكنا نستبعد ذلك ، لأن الغالب في اقتباس
لغة الآخرين أن يقع من الضعيف نحو القوي - فلو كان أولئك القوم قادمين من بلاد
اليمن لَحافظوا على لسانهم وسائر عاداتهم ، لأنهم كانوا يومئذ أرفع منزلة من بدو
الشمال ، وكان هؤلاء ينظرون إلى اليمنية نظرهم إلى أهل الدولة ويعدونهم الملوك ،
كما ينظر البدوي الأمي إلى المتمدنين أصحاب الصولة والعلم . وزد على ذلك أن
اليمنية كانوا يكتبون بالحرف المسند ولا نرى لهذا الحرف ذكرًا في أخبارهم ، ولا
أثرًا في أطلالهم .
وقد علمت أن الكهلانيين أهل حضارة كما رأيت في ما ذكرناه من حديث سيل
العرم ، وكيف أن الكهلانيين كانوا أهل حدائق وقصور باعوها وانتقلوا . فلو صح
ذلك لاختاروا الإقامة في بلد آخر من اليمن غير مأرب وما جاورها ؛ لأن السيل لم
يخرب إلا جزءًا صغيرًا من اليمن . فلم يكونوا يعدمون مكانًا يقيمون فيه ، كما كان
يقيم سواهم من قبائل الحضر ، وإخوانهم الحميريون مازالوا أهل دولة وعمران
وظلوا في رغد ورخاء وسَعَة من العيش إلى ظهور الإسلام .
فما كان أغنى الكهلانيين عن الرحلة إلى بادية الشام أو العراق والرجوع إلى
البداوة ، وهي شاقة على من تعود الحضارة والرخاء .
واعتبر ذلك في معبوداتهم ، فإنها من معبودات عرب الشمال أو العدنانية ، ولم
نجد عندهم ما يميزهم عن هؤلاء من هذا القبيل . ولو كانوا من عرب اليمن ،
لوجدنا بين معبوداتهم اسم عشتار أو إيل أو نحوها .
وهكذا يقال في أسمائهم وليس فيها رائحة الأعلام السَّبَئِيَّة أو المعينية ، بل هي
مثل أسماء سائر عرب الشمال ، ولا سِيَّمَا الذين سكنوا مشارف الشام قبلهم كالأنباط
ونحوهم ، ومنها الحارث و ثعلبة و جبلة و النعمان وغيرها . ولا يعترض بما ذكره
العرب بين أسماء ملوك حمير من أمثال هذه ، فإن أكثرها مبدل بأسماء شمالية ،
وإنما عمدتنا في ما ذكرناه على الأسماء التي وقفوا عليها في الآثار المنقوشة .
فلا دليل على قحطانية هذه الأمم إلا أقوال النسابين ، وهي أضعف من أن
يعول عليها في هذا الشأن ، لاحتمال أن تكون تلك الأمم قد انتحلت الانتساب إلى
عرب اليمن التماسًا للفخر بين قوم لا يعرفونهم ، ولا سِيَّمَا بعد أن تقربوا من الروم
أو الفرس وصاروا من عمالهم ا هـ .
* * *
ونقول في دحض هذه الأقوال :
( 1 ) أما عدم الاختلاف في اللغة ، فإن الاختلاف فيها إما أن يكون في
الأصول ، وإما في الفروع ، أما الأصول فلم يكن بينها خلاف جوهري ؛ لأن لغات
العرب كلها من أصل واحد ، كما اعترفت به حضرته ، وأما الفروع فلم ينكر أحد
سواه وقوع الاختلاف فيها حتى في لغات القبائل التي لم تخرج من اليمن ،
فالاختلاف في الإعراب والتصريف والقلب والإعلال والإبدال مملوء به كتب النحو
والصرف والاختلافات في معاني الكلمات المفردة لم تهملها كتب اللغة والأدب ،
ولذلك وقائعُ وحكايات جر الخطأ في التفاهم بسببها إلى إزهاق الأرواح ، كما في
حكاية قتل مالك بن نويرة وقومه ، وكلنا يعرف ما هي العجعجة والشنشنة
والاستنطاء في لغات اليمانية .
ولو كان بعض الاتفاق في اللغات بين القبائل المختلفة يجعلها من أصل واحد ،
لقد كان المحتم على حضرة المؤرخ أن تقول : إن قبائل حمير التي لم تخرج من اليمن
عدنانية أيضًا ، لاتحادها مع العدنانيين في الأصول واختلافها عنها في بعض الفروع
إبّانَ ظهور الإسلام ، وقد حفظ لنا التاريخ الصحيح وكتب السنة الصحيحة كثيرًا من
مقالات وفود الحميريين على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي لا تختلف عن
العدنانية إلا في معاني بعض المفردات . وإنما حدث هذا التقارب في اللهجة واللغة
لتقاربهم في البيئة ( الوسط ) وللمجامع والأسواق التي كانوا يقيمونها ، وأما أن
الضعيف يقتبس لغة القوي ، وزعمه أن اليمانيين كانوا هم الأقوياء الغالبين ، فذلك
على فرض تسليمه ، لا ينهض حجة على إثبات دعواه ، لما كانت عليه العرب في
القرون القريبة من ظهور الإسلام من التقارب في جميع الأحوال ، حتى قبائل حمير
نفسها بعد غلبة الحبشة والفرس عليها .
( 2 ) وأمّا إنه لم يوجد أثر للحرف المسند من جهات الشمال ، فذلك قد كذبه
بنفسه في موضع آخر عند تكلمه على عرب الصفا ، حيث أتى بهذا العنوان لأمم
سبئية في الشمال ، وذكر تحت هذا العنوان كلامًا كثيرًا عن أن أمم حمير انتقلت
إلى الشمال ووجد لها أنواع من الخط المسند ، كالقلم الصفوي والثمودي واللحياني ،
وقال : إن الباحثين لا يزالون في أول البحث .
( 3 ) أمّا إنه لا حامل للقحطانيين على الهجرة من بلادهم وجناتهم وقصورهم
إلى الصحاري المجدبة بلا سبب عظيم ، وأن سيل العرم لا يكفي لتفرقهم أيادي سبأ ،
فإن الأسباب الحقيقية لهذه الهجرة لا تزال مجهولةً ، كأسباب هجرة أكثر الأمم
القديمة ، وإنما كان من أهمها حادثة سيل العَرِم ، مضافة إلى منازعات وحروب
أهلية أو مجاعات أو أن الأرض قد ضاقت عليهم ، فالتمسوا غيرها من بلاد الله ،
ولم تكن وجهتهم في رحلتهم هذه القفار ، بل كانت ريف العراق ومشارف الشام ،
ولا تنكر حضرة المؤرخ عظم دولتهم في الحيرة و الأنبار وفي سوريا و فلسطين ،
فلقد احتلوا في الأولى جميع الأراضي التي بين دجلة والفرات ، حتى سميت العراق
العربي ، وفي الثانية أكثر بلاد فلسطين وسورية و حلب ، ولا شَكّ أن هذه كانت
أخصب من بلادهم ، وبقية اليمانيين الذين سكنوا البدو منهم ، فإنما تراجعوا إليه بعد
منافسات مع بني عمهم في الشمال مع بُعْد عهدهم باليمن وخصبه ، وأما اكتفاء
المؤرخين بذكر حادثة سيل العَرِم ، فذلك وَهْم سرى إليهم من تعقيب ذكر قصة السيل
في القرآن الكريم بقوله تعالى : { وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ
مُمَزَّقٍ } ( سبأ : 19 ) , فإن الظاهر من الآية أن التمزيق سببه ظلم أنفسهم ،
والظلم يأتي بأسباب كثيرة اعتدائية ، لا بسبب خارجي فجائي لا دخل لهم فيه ، مثل
انفجار السد .
( 4 ) وأما دعوى اتحادهم في المعبودات ، فلا نسلم أنها كلها كانت عدنانية ،
بل كانت خليطًا من كل الأديان ، فقد عبد كثير من العدنانيين الشمس والقمر
والكواكب ، وهي من معبودات أهل الجنوب ، كما تهود وتنصر أهل الجنوب ،
واليهودية والنصرانية من أديان أهل الشمال .
( 5 ) وأما توافق أسمائهم ، فذلك إرث من طبيعة الجوار والبيئة وتمازجهم
في كل شيء ، كما يسمي الأقباط الآن أنفسهم بأسماء عربية وتركية بعدما زالت
سيطرة العرب والترك ، وكما يسمي الترك أنفسهم بأسماء عربية مع أنهم هم
الغالبون للعرب ، وكما يسمي السوريون أنفسهم بأسماء إنجليزية وفرنسية ، على أن
هذا المؤرخ الذي أنكر في غير موضع من كتابه وجود أسماء عدنانية بين أسماء
الحميربين نقض كلامه في صفحة ( 159 ) حيث نقل عن غلازر الألماني ، أحد
الأثرين اللذين وجدهما في أطلال السد ، وهذا كتبه أبرهة قبيل ظهور الإسلام ، وفيه
يذكر الأقيال الذين قهرهم أو ولاهم عنه ، مثل يزيد بن كبش و مرة و ثمامة و حنش
ومرثد ، وكل هذه أسماء عدنانية ، كما أن معد يكرب الزبيدي اسمه حميري ،
وهو من القبائل التي ينكر المؤرخ حميريتها .
وأما الأدلة الوجودية على أن القبائل المذكورة قحطانية ، فأكثر من أن نأتي بها
جميعها في هذه المقالة ، وهي بالغة بصراحتها إلى أفق البديهيات .
فمنها اعتراف جميع هذه القبائل بأنها يمانية ، حتى بعد أن ظهرت مضر
عليهم في وقائع عديدة ، وبعد أن خضعوا للمضريين بعد الإسلام وتعصب المضرية
واليمانية في الفتن التي وقعت في الصدر الأول غصت به كتب التاريخ والأدب .
ومنها إجماع النسابين والمؤرخين باعتراف حضرته على أن القبائل المذكورة
قحطانية .
ومنها ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مما يشير إلى هذه التفرقة . ولو أردنا
ذكر الشواهد التاريخية من الوقائع والمفاخرات وقصائد الشعر من الحماسة والمدح
والهجاء وجميع الأحاديث النبوية لإثبات أن هذه القبائل قحطانية ، لوضعنا في ذلك
كتابًا يزيد عن كتاب جرجي أفندي زيدان أضعافًا .
((يتبع بمقال تالٍ))
__________
(*) بقلم الشيخ أحمد الإسكندري .
(11/681)
الكاتب : أحمد الإسكندري
شوال - 1326هـ
نوفمبر - 1908م
شوال - 1326هـ
نوفمبر - 1908م
إلمامة بكتاب تاريخ العرب قبل الإسلام
لحضرة جرجي أفندي زيدان
( 2 )
ذكرنا في مقالنا الآنف الأمر الأول من الأمور التي تؤخذ على المؤلف وهو
( تردده أو إنكاره بعض الحقائق التاريخية البديهية في موضع . وتشبثه بتحقيق
بعض الظنون والتخرصات في موضع آخر اعتمادًا على أوهام وتخيلات قامت
بذهنه فقط ) ومَثَّلنا للشق الأول من هذا الأمر وأدحضناه بما عرفه القراء . والآن
نمثل للثاني ونأتي على بقية الأمور التي تؤخذ على المؤلف ، فنقول :
مثال الثاني - أنه عندما تكلم على دولة النبط في بطرا نقل عن التوراة وعن
كاتر مير الفرنسي وعن كوسين دي برسفال وعن آخرين ما يفيد أن الأنباط ليسوا
عربًا , وأنهم آراميّون أتوا من الشرق فأجلوا الأدوميين عن بطرا واحتلوها , ثم
رفض كل هذه النصوص والآراء وغيرها من النصوص التي لم يذكرها مما جاء في
السفر الأول من أسفار المكابيين وفي تاريخ يوسفيوس من غير أن يذكر برهانًا
واحدًا على نقضها ، واستنبط هو بنفسه أنهم عرب ، وذكر لذلك دليلَيْنِ :
الأول أن اليونان حيثما ذكروهم سموهم عربًا ( ولعله يعني تقسيمهم جزيرة
العرب إلى عرب بترية في الشمال وسعيدة في الجنوب ) .
والثاني أن أسماء ملوكهم عربية . وهما دليلان يتضاءلان أمام النصوص
التاريخية ، ولا سِيَّمَا إذا كان ثمة ما يجعل هذين الدليلين ينعكسان على غير مراد
المؤلف ، فيكونان حُجَّةً عليه لا له . ونحن ننفي أولاً هذين الدليلين ثم نأتي بأدلتنا
الوجودية على آرامية النبط ، أما الدليل الأول فإن تسمية اليونان لسكان الشمال
العربي من جزيرة العرب بالعرب البترية هي تسمية جغرافية ، كما أننا نسمي ما
وراء أسوان بالسودان ، مع أن أكثرهم عرب لا زنوج ، وكما نسمي الصحراء
الشرقية من مصر الصحراء العربية مع أن سكانها من البشارية والبجاة ، لا يعرفون
العربية . على أن جميع ما عرف من حروب القائد اليوناني أنتيفونوس وابنه
ديمتريوس أنه وجد حولهم قبائل يظاهرونهم ويستجيبون لصراخهم ، ويؤيد ذلك ما
نقله حضرة العلامة المفضال جبر ضومط عن يوسفيوس ( جزء ثالث . مجلد 33
مقطتف ) على أن سِفْر المكابيين من التوراة سماهم نبطًا وجعل العرب أحلافًا لهم
حينما استعان بهم يهوذا المكابي ، وهو كان معاصرًا لهم أيضًا .
وأما الدليل الثاني - فإن ما عثر عليه من أسماء الملوك العربية لا يثبت أن
الشعب عربي ، فقد ثبت أن النبط في آخر أمرهم خضعوا للعرب وخصوصًا قضاعة ،
وأن الملوك الذين عاصروا منهم ملوك اليونان هم عرب حكموا أمة النبط ، كما
يستفاد من تاريخ يوسفيوس . وكما أننا لا نسمي الأمم الهندية إنجليزًا ؛ لأن
إمبراطور الهند إنجليزي ، كذلك لا نسمي النبط عربًا ؛ لأن ملوكها في بعض
الأحيان كانوا عربًا ، على أن هذه الأسماء لم تكن خاليةً من التحريف والصبغة
الآرامية والعبرية ، مع أننا عثرنا على كثير منها مكتوب بالخط النبطي نفسه لا
اليوناني الذي مظنة التحريف ، وأما كون لغة الكتابة عند النبط غيرَ لغةِ التخاطب ،
فهو مما لم يقم عليه دليل ، وما كان أحوج المؤلف إلى ذكره لو وجده .
أما أدلتنا على أن النبط ليسوا عربًا وأنهم خليط من الأدوميين القدماء ومن
الآراميين الذين جاءوا مع بُخْتَنَصَّرَ ومن اليهود ومن العرب ، فهي :
( 1 ) ما هو مشاع مستفيض عن العرب قبل الإسلام وبعده أن النبط غير
العرب ، وأنهم كانوا يعيرون العربي بأنه نبطي ، واعتبر كثير من الفقهاء أن نداء
العربي بِيَا نبطيُّ قَذْف وسبّ ، ناهيك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لا
تكونوا كنبط السواد إذا سئل عن نسبه قال : أنا من بلد كذا .
( 2 ) أن لغتهم لغة خاصة بهم تخالف العربية وتنال حظًّا من الآرامية وحظًّا
من العبرية وحظًّا من العربية . بل فيها كثير من اليونانية .
( 3 ) أن جميع النصوص التاريخية من التوراة في إشارة أرميا و حزقيال
وفي أسفار المكابيين ما يفيد أن النبط غير العرب ، وأن الإله انتقم من الأدوميين
وضربهم بغارة بختنصر ، فدمر عليهم وأورث الأرض من بعدهم الكلدانيين الذين
جاءوا معه من بابل ، وأن النبط كانوا في بعض أدوارهم أحلافًا ليهوذا المكابي ،
وأنهم استأجروا جيوشًا من العرب يظاهرونهم ، وهذا يدل على أن المستأجر غير
الأجير .
( 4 ) ما جاء في تاريخ يوسفيوس من أن النبط بقوا مستقلين عن العرب إلى
أيام الإسكندر مانيوس بن أرستو بولوس بن يوحنا هركاتوس بن سمعان أخي يوناتان
و يهوذا المكابي اليهودي ، فإنه بعد وفاة هذا الملك أخضعهم العرب وقام منهم عليهم
عدة ملوك ، كانوا يسمون تارةًَ ملوك النبط وتارة ملوك العرب ، وإن كانت الجنسية
متميزة بينهما ، وبقوا كذلك إلى أن استولى عليهم الرومان سنة 105 م .
( 5 ) حقق كل من كاتر مير الفرنسي و كوسين دي برسفال وغيرهما من
علماء الآثار أن سكان بطرا بعد الأدوميين هم أمم نازحة من العراق وبابل ، ولا
ينطبق ذلك إلا على زمن بختنصر ، إذ سكان بطرا قبل بختنصر لم يعرفوا إلا باسم
الأدوميين ، وبعده لم يعرفوا إلا باسم النبط ، من أنه من الثابت أن بختنصر أباد
الأدوميين تحقيقًا لوعيد حزقيال وأرميا النبيين ، مع أن الله ينزل عليهم بلاءه ويجعل
جبال عيصو خرابًا وميراثًا لذئاب البرية ، وأنه حارب العرب حتى كاد يفنيهم ، فلو
كان النبط عربًا لما استبقاهم فيها ، فظهر من ذلك أن الأنباط بقايا القبائل الآرامية
التي أسكنها بختنصر في بطرا ليكونوا حراسًا ونقلة لتجارة بابل ؛ لأن فتوحاته كانت
كلها تجارية ، ثم امتزجوا بغيرهم من اليهود والعرب ، وما يرى في لغاتهم من
الألفاظ العربية لا يربو على ما يوجد في العربية المضرية من الألفاظ العبرية .
على أن المؤلف لما أحس بضعف دليله عن تبريره تلك الحلية التي هاجها في
أكثر من خمس صفحات من كتابه مع تيقنه أن المكتوب من آثارهم ليس عربيًّا ،
زعم بلا دليل أن لغة تخاطبهم غير لغة كتابهم ، ثم رجع وقال :
( على أننا لا نظن اللغة العربية التي كان يتفاهم بها النبطيون هي نفس اللغة
العربية التي عرفناها في صدر الإسلام ، ولا بُدَّ من فرق بينهما اقتضاه ناموس
الارتقاء ) .
هذا مع علمنا أن النبط دخلوا في حوزة الرومان في أوائل القرن الثاني بعد
الميلاد ، وإننا نروي كثيرًا من شعر العرب وأمثالهم منذ القرن الرابع من الميلاد ،
مما يظهر لنا تمام الإظهار أن هذه اللغة العربية الفصيحة بإعرابها واشتقاقها وكثرة
أساليبها التي لا تتناهى قد تكونت بهذه الصورة قبل ذلك بكثير أي وقت ما كان النبط
نبطًا ، بل قبل هذا الوقت ، ولا سِيَّمَا إذا علمنا أن اللغة العربية هي لغة أهل بادية ،
وهم أبعد الناس عن الانقلابات اللغوية ، كما يصرح بذلك حضرة المؤلف في أكثر
من موضع من كتابه .
( 6 ) إن النبط الذين كانوا في الشرق في صحراء الكوفة وعلى ضفاف
الفرات وبقوا متميزين عن العرب إلى ما بعد الإسلام بنحو مائة وخمسين سنةً ، هم
يشبهون نبط الشام من أكثر الوجوه ، بدليل أن ما وجد من آثارهم ومعبوداتهم
وخطوطهم يدل على أنهم من عنصر واحد ، وأطلال تدمر والخط التدمري صِنْو
النبطي تشهد بذلك ، فإن كان نبط الشام خالطوا قضاعة ، فنبط العراق خالطوا لخمًا
وجذامًا وبكرًا وتغلبَ وعبادًا .
ومن أمثلة الشق الثاني ، وهو تشبثه بتحقيق بعض الظنون إلخ ، أنه عندما
تكلم على دول اليمن ذكر من بينها دولة ، زعم أن العرب لم تعرفها ، وهي أهل
( معين ) ، وقَفَّى على إثر ذلك بأن استظهر أنها أمة قديمة جدًّا تبتدئ أخبارها منذ
أربعين قرنًا قبل الميلاد لعثورهم على أثر قديم من آثار بابل ذكر فيه بالخط
المسماري : ( أن زام سين حمل على مغان وقهر ملكها معنيوم ) واستنتج أن مغان
هذه هي مغان طور سيناء ، وأن الميم في ( معنيوم ) للتنوين ، وبالطبع يعتقد أن
اللفظ حرف واختزل حتى صار ( معينًا ) ، وكذلك نقل عن سفر الأخبار ( أن الله
أعان عزريا على الفلسطينيين وعلى العرب المقيمين بجوار بعل وعلى المعونيين )
أي المجاورين طبعًا للفلسطينيين ، وكل هذه الحوادث حدثت في برية الشام والأمة
يمانية .
أيها المنكح الثريا سهيلا ... عمرك الله كيف يلتقيان
هي شامية إذا ما استقلت ... وسهيل إذا استقل يماني
ولو كان الشبه بين لفظين يكفي أن يبنى عليه تاريخ أُمّتين ، لقد حقّ لنا أن نقول على التاريخ العفاء .
ثم اقتضب الكلام ورأى رأيًا أخيرًا ، أنهم من جالية الآراميين ، أتوا من العراق
في هذه العصور السحيقة واستعمروا اليمن ، ثم أشكل عليه الأمر بأن المعينيين لو
كانوا من العراق لكتبوا بالخط المسماري ، مع أن آثارهم مكتوبة بالخط المسند المشتق
من الفينيقي ، فلم يَرَ حَلاًّ لهذا المشكل سوى ادعائه بأنهم استبدلوا بالخط المسماري
الخط الفينيقي لسهولة هذا الأخير في نظره ! ! ! ولكن كل هذه العراقة في القدم لم
تمنعه من وصفهم في موضع آخر أنهم كانوا معاصرين للسَّبَئبِيِّين الذين لم تبتدئ
دولتهم على رأيه إلا في القرن الثامن قبل الميلاد ، ونقل عن اليونان في صفحة
( 116 ) أن هذه الأمم وغيرها كانت متعاصرة ، وأن عاصمتهم ( مأرب ) ثم
يتشبث في موضع آخر بأن القحطانيين السبئيين كانوا بعد المعينيين ، أو أنهم
ورثتهم أو أنهم حبشان أوانهم عمالقة جاءوا من مصر ، هذا إلى اضطرابات
وتناقضات توقع طالب التاريخ في حيرة وارتباك ، يهون عليه معهما نبذ كل هذه
التخرصات ، والاعتقاد بأن كل هذه الأمم كانت قبائل متجاورة في مخاليف
متقاربة أعظمها مأرب .
الأمر الثاني من الأمور التي تؤخذ على المؤلف - تناقض عبارات كتابه في
عدة مواضع .
منها ادعاؤه أن أسماء ملوك حمير لم يكن بينها أسماء عدنانية ، حتى قال في
صفحة ( 166 ) لم نجد لذلك أثرًا في الآثار المنقوشة ، ثم نقل في صفحة ( 159 )
أثرًا عظيمًا لأبرهة الحبشي ، وفيه يسمي ولاته من حمير وأقْيالهم يزيد وكبشة ومرة
وثمامة وحنشًا ومرثدًا كما تقدم .
ومنها تناقضه في أن الجبائيين لم يعرفهم العرب ، بل عرفهم اليونان وحدهم ثم
ذكر في صفحة ( 134 ) أن الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب ، قال : ( جبأ
مدينة المفاخر وهي لآل الكرندي من بين ثمامة آل حمير الأصغر ) مع أن اليونان
لم يذكروهم بأكثر من أنها قبيلة تجارية .
ومنها تناقضه في استظهار أن السبئيين حبشان ، ثم ذكر في صفحة ( 136 )
أن المعينيين القادمين من العراق نقلوا معهم حضارة العراق ونظام حكومته ،
وقسموا اليمن إلى محافد وقصور ، وطمعوا في جيرانهم وأخضعوهم ، وأنشئوا
الدولة المعينية والسبئية والحميرية .
ومنها تناقضه في أن المعينيين لم تعرفهم العرب ، مع أنه نقل في صفحة
( 111 ) عن الهمداني في كتاب الإكليل ، أن ( محافد اليمن براقش ومعين ، وهما
بأسفل جوف الرحب مقتبلتان ، فمعين بين مدينة نشان وبين درب شراقة ) وروي أن
مالك بن حريم الدلاني يقول فيها :
ونحمي الجوف ما دامت معين ... بأسفله مقابلة عرادا
وفيها وفي براقش يقول فروة بن مسيك :
أحل يحابر جدي عطيفًا ... معين الملك من بين البنينا
وملكنا براقش دون أعلى ... وأنعم إخوتي وبني أبينا
ومنها تناقضه في أن العرب لم يعرفوا دولة النبط في الشام ، ثم ذكر في
عدة حوادث أنهم عرفوها خصوصًا في صفحة ( 79 ) ، حيث نقل عن ابن خلدون
وحمزة الأصفهاني معرفتهما لنبط الشام ، وأن بطرا كانت تسمى بعد الإسلام الرقيم ،
ولهم فيها شعر ، هذا إلى مناقضات كثيرة لا تسع سردها ولا تفصيلها هذه المجلة .
الأمر الثالث من الأمور التي تؤخذ على المؤلف ، جسارته على وضع الأسماء
والتقسيمات التاريخية مع ضعف الاستظهار ، كتقسيماته أدوار تاريخ العرب ،
وكتسميته الأمة التي سماها استرابون اليوناني جرهيين ، بالقرييين ، نسبة إلى قرية ،
وهي اسم اليمامة قديمًا ، وهم الذين قال فيهم استرابون : ( إنهم أغنى أهل الأرض ،
ويكثرون من آنية الذهب والفضة ، ويزينون جدران منازلهم بالعاج والذهب والفضة
والأحجار الكريمة ) ، فمتى كان أهل اليمامة أغنى أهل الأرض ؟ ومتى كان لهم
جدران تزين بالذهب والفضة والأحجار الكريمة ؟ ! ! أليس كلام استرابون أشبه
بالخرافات التي تقال عن مدينة شداد بن عاد ( إرم ذات العماد ) التي يبكت حضرة
جرجي أفندي زيدان جهلة مؤرخينا على ذكرهم لها ! ولكنه لا يبكت استرابون ،
بل لم يكتف بقوله حتى حرف لفظه ( جرها ) بلفظ ( قرية ) وجعل أهلها دولة لم
تعرفها العرب وفتح بابًا لها خاصًّا في كتابه ، ورسمها على المصور الجغرافي ! !
الأمر الرابع من الأمور التي تؤخذ على المؤلف ، ارتياب القارئ في تهجينه
أخبار العرب في حوادث الفخر والغلبة ، كفتوحات شمر يرعش و أسعد ذي كرب في
آسيا وأفريقس في أفريقيا وحسان بن تبع . وتصديقه خرافات استرابون
وهيريدوت ، مع أنهما لم يدخلا بلاد العرب ولم يرياها . واقرأ ما نقله عن استرابون
في صفحة ( 138 ) تتحقق صدق ما نقول ، وهذا نصه :
وذكر استرابون ضربًا من الاشتراكية عند أولئك العرب غريبًا في بابه ، فبعد
أن أورد اشتراك كل عائلة بالأموال والمتاع بين أفرادها ، وأن رئيسها أكبر رجالها
سنًا ، قال : والزواج مشترك عندهم ، يتزوج الإخوة امرأة واحدة ، فمن دخل منهم
إليها أولاً ترك عصاه بالباب ، والليل خاصّ بأكبرهم ، وهو شيخهم ، وقد يأتون
أمهاتهم ، ومن تزوج من غير عائلته عوقب بالموت . كان لأحد ملوك العرب
ابنة بارعة في الجمال ، لها 15 أخًا ، كل واحد منهم يهواها حتى ملتهم ، واحتالت
على منعهم بعصا اصطنعتها تشبه عصيّهم ، وكان لكل منهم عصا عليها علامته .
فكانت إذا خرج أحدهم من عندها حمل عصاه ومضى ، فتضع هي مكانها العصا التي
اصطنعتها على مثالها ، فيتوهم سائر الإخوة أنه لا يزال عندها ، وقد يجيء أحد
يتفقد الباب ، ولما يرى العصا بجانبه يرجع ، فتبدل العصا الأولى بعصا مثل
عصاه وهكذا . فاتفق مرة أن الإخوة كانوا جميعًا في ساحة ، ورأى أحدهم بباب أخته
عصا ، وليس من إخوته أحد غائبًا ، فظن فيها السوء فشكاها إلى أبيها ، ولما اطلع
على عذرها برأها . هذه حكاية استرابون ، ولم نذكرها إلا لغرابتها ، ولا نعلم مقدار
ما فيها من الصحة . ا هـ
يذكر هذه الحكاية هنا بالتفصيل ويعتذر بهذا العذر ، مع أنه عندما يقتضي
المقام شيئًا صحيحًا تاريخيًّا عن العرب يدمجه ويجمل فيه ويحيل القارئ على الكتب
الأخرى ! .
الأمر الخامس سوء التعبير من الوجهة الدينية في عبارات الكتاب ، كقوله
في صفحة ( 10 ) أقدم المصادر العربية المدونة عن تاريخ العرب وأقربها إلى
الصحة القرآن ( ؟ ) .
الأمر السادس من الأمور التي تؤخذ على المؤلف أنه أغفل مدة حكم الفرس
على اليمن بعد ذي يزن ، فلم يذكر أحدًا من عمالهم مع أن عمال كسرى استمروا
يحكمون اليمن إلى الإسلام ، فكان آخرهم باذان ، الذي كان على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، وأسلم ثم صارت اليمن إلى الإسلام .
الأمر السابع من الأمور التي تؤخذ على المؤلف ، كثرة شكه وتردده وتناقضه
في أكثر الحوادث ، حتى إنه لا يرى المطلع على كتابه خبرًا مبرهنًا على صحته
بدليل مقنع ، ويظهر ذلك ظهورًا بينًا في آرائه الخاصة واجتهاداته التاريخية .
الأمر الثامن من الأمور التي تؤخذ على المؤلف ، تخريجه الأعلام تخريجًا
غريبًا ، قال : إن اسم امرئ القيس يظنه محرفًا عن مرقس ! ! وأن اسم الحارث
ربما كان ترجمة جيورجيوس ، واسم صخر ، ترجمة بطرس ! ! إلخ ما ذكر من
التخريج .
الأمر التاسع اختصاره التاريخ جدًّا ، وهو أحد العيوب التي عابها على
مؤرخي العرب ، فلم يسلم هو منها ، والكمال لله وحده .
__________
(1) تابع لما نشر في ص 681 م 11 من مقالة الشيخ أحمد الإسكندري .
لحضرة جرجي أفندي زيدان
( 2 )
ذكرنا في مقالنا الآنف الأمر الأول من الأمور التي تؤخذ على المؤلف وهو
( تردده أو إنكاره بعض الحقائق التاريخية البديهية في موضع . وتشبثه بتحقيق
بعض الظنون والتخرصات في موضع آخر اعتمادًا على أوهام وتخيلات قامت
بذهنه فقط ) ومَثَّلنا للشق الأول من هذا الأمر وأدحضناه بما عرفه القراء . والآن
نمثل للثاني ونأتي على بقية الأمور التي تؤخذ على المؤلف ، فنقول :
مثال الثاني - أنه عندما تكلم على دولة النبط في بطرا نقل عن التوراة وعن
كاتر مير الفرنسي وعن كوسين دي برسفال وعن آخرين ما يفيد أن الأنباط ليسوا
عربًا , وأنهم آراميّون أتوا من الشرق فأجلوا الأدوميين عن بطرا واحتلوها , ثم
رفض كل هذه النصوص والآراء وغيرها من النصوص التي لم يذكرها مما جاء في
السفر الأول من أسفار المكابيين وفي تاريخ يوسفيوس من غير أن يذكر برهانًا
واحدًا على نقضها ، واستنبط هو بنفسه أنهم عرب ، وذكر لذلك دليلَيْنِ :
الأول أن اليونان حيثما ذكروهم سموهم عربًا ( ولعله يعني تقسيمهم جزيرة
العرب إلى عرب بترية في الشمال وسعيدة في الجنوب ) .
والثاني أن أسماء ملوكهم عربية . وهما دليلان يتضاءلان أمام النصوص
التاريخية ، ولا سِيَّمَا إذا كان ثمة ما يجعل هذين الدليلين ينعكسان على غير مراد
المؤلف ، فيكونان حُجَّةً عليه لا له . ونحن ننفي أولاً هذين الدليلين ثم نأتي بأدلتنا
الوجودية على آرامية النبط ، أما الدليل الأول فإن تسمية اليونان لسكان الشمال
العربي من جزيرة العرب بالعرب البترية هي تسمية جغرافية ، كما أننا نسمي ما
وراء أسوان بالسودان ، مع أن أكثرهم عرب لا زنوج ، وكما نسمي الصحراء
الشرقية من مصر الصحراء العربية مع أن سكانها من البشارية والبجاة ، لا يعرفون
العربية . على أن جميع ما عرف من حروب القائد اليوناني أنتيفونوس وابنه
ديمتريوس أنه وجد حولهم قبائل يظاهرونهم ويستجيبون لصراخهم ، ويؤيد ذلك ما
نقله حضرة العلامة المفضال جبر ضومط عن يوسفيوس ( جزء ثالث . مجلد 33
مقطتف ) على أن سِفْر المكابيين من التوراة سماهم نبطًا وجعل العرب أحلافًا لهم
حينما استعان بهم يهوذا المكابي ، وهو كان معاصرًا لهم أيضًا .
وأما الدليل الثاني - فإن ما عثر عليه من أسماء الملوك العربية لا يثبت أن
الشعب عربي ، فقد ثبت أن النبط في آخر أمرهم خضعوا للعرب وخصوصًا قضاعة ،
وأن الملوك الذين عاصروا منهم ملوك اليونان هم عرب حكموا أمة النبط ، كما
يستفاد من تاريخ يوسفيوس . وكما أننا لا نسمي الأمم الهندية إنجليزًا ؛ لأن
إمبراطور الهند إنجليزي ، كذلك لا نسمي النبط عربًا ؛ لأن ملوكها في بعض
الأحيان كانوا عربًا ، على أن هذه الأسماء لم تكن خاليةً من التحريف والصبغة
الآرامية والعبرية ، مع أننا عثرنا على كثير منها مكتوب بالخط النبطي نفسه لا
اليوناني الذي مظنة التحريف ، وأما كون لغة الكتابة عند النبط غيرَ لغةِ التخاطب ،
فهو مما لم يقم عليه دليل ، وما كان أحوج المؤلف إلى ذكره لو وجده .
أما أدلتنا على أن النبط ليسوا عربًا وأنهم خليط من الأدوميين القدماء ومن
الآراميين الذين جاءوا مع بُخْتَنَصَّرَ ومن اليهود ومن العرب ، فهي :
( 1 ) ما هو مشاع مستفيض عن العرب قبل الإسلام وبعده أن النبط غير
العرب ، وأنهم كانوا يعيرون العربي بأنه نبطي ، واعتبر كثير من الفقهاء أن نداء
العربي بِيَا نبطيُّ قَذْف وسبّ ، ناهيك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، لا
تكونوا كنبط السواد إذا سئل عن نسبه قال : أنا من بلد كذا .
( 2 ) أن لغتهم لغة خاصة بهم تخالف العربية وتنال حظًّا من الآرامية وحظًّا
من العبرية وحظًّا من العربية . بل فيها كثير من اليونانية .
( 3 ) أن جميع النصوص التاريخية من التوراة في إشارة أرميا و حزقيال
وفي أسفار المكابيين ما يفيد أن النبط غير العرب ، وأن الإله انتقم من الأدوميين
وضربهم بغارة بختنصر ، فدمر عليهم وأورث الأرض من بعدهم الكلدانيين الذين
جاءوا معه من بابل ، وأن النبط كانوا في بعض أدوارهم أحلافًا ليهوذا المكابي ،
وأنهم استأجروا جيوشًا من العرب يظاهرونهم ، وهذا يدل على أن المستأجر غير
الأجير .
( 4 ) ما جاء في تاريخ يوسفيوس من أن النبط بقوا مستقلين عن العرب إلى
أيام الإسكندر مانيوس بن أرستو بولوس بن يوحنا هركاتوس بن سمعان أخي يوناتان
و يهوذا المكابي اليهودي ، فإنه بعد وفاة هذا الملك أخضعهم العرب وقام منهم عليهم
عدة ملوك ، كانوا يسمون تارةًَ ملوك النبط وتارة ملوك العرب ، وإن كانت الجنسية
متميزة بينهما ، وبقوا كذلك إلى أن استولى عليهم الرومان سنة 105 م .
( 5 ) حقق كل من كاتر مير الفرنسي و كوسين دي برسفال وغيرهما من
علماء الآثار أن سكان بطرا بعد الأدوميين هم أمم نازحة من العراق وبابل ، ولا
ينطبق ذلك إلا على زمن بختنصر ، إذ سكان بطرا قبل بختنصر لم يعرفوا إلا باسم
الأدوميين ، وبعده لم يعرفوا إلا باسم النبط ، من أنه من الثابت أن بختنصر أباد
الأدوميين تحقيقًا لوعيد حزقيال وأرميا النبيين ، مع أن الله ينزل عليهم بلاءه ويجعل
جبال عيصو خرابًا وميراثًا لذئاب البرية ، وأنه حارب العرب حتى كاد يفنيهم ، فلو
كان النبط عربًا لما استبقاهم فيها ، فظهر من ذلك أن الأنباط بقايا القبائل الآرامية
التي أسكنها بختنصر في بطرا ليكونوا حراسًا ونقلة لتجارة بابل ؛ لأن فتوحاته كانت
كلها تجارية ، ثم امتزجوا بغيرهم من اليهود والعرب ، وما يرى في لغاتهم من
الألفاظ العربية لا يربو على ما يوجد في العربية المضرية من الألفاظ العبرية .
على أن المؤلف لما أحس بضعف دليله عن تبريره تلك الحلية التي هاجها في
أكثر من خمس صفحات من كتابه مع تيقنه أن المكتوب من آثارهم ليس عربيًّا ،
زعم بلا دليل أن لغة تخاطبهم غير لغة كتابهم ، ثم رجع وقال :
( على أننا لا نظن اللغة العربية التي كان يتفاهم بها النبطيون هي نفس اللغة
العربية التي عرفناها في صدر الإسلام ، ولا بُدَّ من فرق بينهما اقتضاه ناموس
الارتقاء ) .
هذا مع علمنا أن النبط دخلوا في حوزة الرومان في أوائل القرن الثاني بعد
الميلاد ، وإننا نروي كثيرًا من شعر العرب وأمثالهم منذ القرن الرابع من الميلاد ،
مما يظهر لنا تمام الإظهار أن هذه اللغة العربية الفصيحة بإعرابها واشتقاقها وكثرة
أساليبها التي لا تتناهى قد تكونت بهذه الصورة قبل ذلك بكثير أي وقت ما كان النبط
نبطًا ، بل قبل هذا الوقت ، ولا سِيَّمَا إذا علمنا أن اللغة العربية هي لغة أهل بادية ،
وهم أبعد الناس عن الانقلابات اللغوية ، كما يصرح بذلك حضرة المؤلف في أكثر
من موضع من كتابه .
( 6 ) إن النبط الذين كانوا في الشرق في صحراء الكوفة وعلى ضفاف
الفرات وبقوا متميزين عن العرب إلى ما بعد الإسلام بنحو مائة وخمسين سنةً ، هم
يشبهون نبط الشام من أكثر الوجوه ، بدليل أن ما وجد من آثارهم ومعبوداتهم
وخطوطهم يدل على أنهم من عنصر واحد ، وأطلال تدمر والخط التدمري صِنْو
النبطي تشهد بذلك ، فإن كان نبط الشام خالطوا قضاعة ، فنبط العراق خالطوا لخمًا
وجذامًا وبكرًا وتغلبَ وعبادًا .
ومن أمثلة الشق الثاني ، وهو تشبثه بتحقيق بعض الظنون إلخ ، أنه عندما
تكلم على دول اليمن ذكر من بينها دولة ، زعم أن العرب لم تعرفها ، وهي أهل
( معين ) ، وقَفَّى على إثر ذلك بأن استظهر أنها أمة قديمة جدًّا تبتدئ أخبارها منذ
أربعين قرنًا قبل الميلاد لعثورهم على أثر قديم من آثار بابل ذكر فيه بالخط
المسماري : ( أن زام سين حمل على مغان وقهر ملكها معنيوم ) واستنتج أن مغان
هذه هي مغان طور سيناء ، وأن الميم في ( معنيوم ) للتنوين ، وبالطبع يعتقد أن
اللفظ حرف واختزل حتى صار ( معينًا ) ، وكذلك نقل عن سفر الأخبار ( أن الله
أعان عزريا على الفلسطينيين وعلى العرب المقيمين بجوار بعل وعلى المعونيين )
أي المجاورين طبعًا للفلسطينيين ، وكل هذه الحوادث حدثت في برية الشام والأمة
يمانية .
أيها المنكح الثريا سهيلا ... عمرك الله كيف يلتقيان
هي شامية إذا ما استقلت ... وسهيل إذا استقل يماني
ولو كان الشبه بين لفظين يكفي أن يبنى عليه تاريخ أُمّتين ، لقد حقّ لنا أن نقول على التاريخ العفاء .
ثم اقتضب الكلام ورأى رأيًا أخيرًا ، أنهم من جالية الآراميين ، أتوا من العراق
في هذه العصور السحيقة واستعمروا اليمن ، ثم أشكل عليه الأمر بأن المعينيين لو
كانوا من العراق لكتبوا بالخط المسماري ، مع أن آثارهم مكتوبة بالخط المسند المشتق
من الفينيقي ، فلم يَرَ حَلاًّ لهذا المشكل سوى ادعائه بأنهم استبدلوا بالخط المسماري
الخط الفينيقي لسهولة هذا الأخير في نظره ! ! ! ولكن كل هذه العراقة في القدم لم
تمنعه من وصفهم في موضع آخر أنهم كانوا معاصرين للسَّبَئبِيِّين الذين لم تبتدئ
دولتهم على رأيه إلا في القرن الثامن قبل الميلاد ، ونقل عن اليونان في صفحة
( 116 ) أن هذه الأمم وغيرها كانت متعاصرة ، وأن عاصمتهم ( مأرب ) ثم
يتشبث في موضع آخر بأن القحطانيين السبئيين كانوا بعد المعينيين ، أو أنهم
ورثتهم أو أنهم حبشان أوانهم عمالقة جاءوا من مصر ، هذا إلى اضطرابات
وتناقضات توقع طالب التاريخ في حيرة وارتباك ، يهون عليه معهما نبذ كل هذه
التخرصات ، والاعتقاد بأن كل هذه الأمم كانت قبائل متجاورة في مخاليف
متقاربة أعظمها مأرب .
الأمر الثاني من الأمور التي تؤخذ على المؤلف - تناقض عبارات كتابه في
عدة مواضع .
منها ادعاؤه أن أسماء ملوك حمير لم يكن بينها أسماء عدنانية ، حتى قال في
صفحة ( 166 ) لم نجد لذلك أثرًا في الآثار المنقوشة ، ثم نقل في صفحة ( 159 )
أثرًا عظيمًا لأبرهة الحبشي ، وفيه يسمي ولاته من حمير وأقْيالهم يزيد وكبشة ومرة
وثمامة وحنشًا ومرثدًا كما تقدم .
ومنها تناقضه في أن الجبائيين لم يعرفهم العرب ، بل عرفهم اليونان وحدهم ثم
ذكر في صفحة ( 134 ) أن الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب ، قال : ( جبأ
مدينة المفاخر وهي لآل الكرندي من بين ثمامة آل حمير الأصغر ) مع أن اليونان
لم يذكروهم بأكثر من أنها قبيلة تجارية .
ومنها تناقضه في استظهار أن السبئيين حبشان ، ثم ذكر في صفحة ( 136 )
أن المعينيين القادمين من العراق نقلوا معهم حضارة العراق ونظام حكومته ،
وقسموا اليمن إلى محافد وقصور ، وطمعوا في جيرانهم وأخضعوهم ، وأنشئوا
الدولة المعينية والسبئية والحميرية .
ومنها تناقضه في أن المعينيين لم تعرفهم العرب ، مع أنه نقل في صفحة
( 111 ) عن الهمداني في كتاب الإكليل ، أن ( محافد اليمن براقش ومعين ، وهما
بأسفل جوف الرحب مقتبلتان ، فمعين بين مدينة نشان وبين درب شراقة ) وروي أن
مالك بن حريم الدلاني يقول فيها :
ونحمي الجوف ما دامت معين ... بأسفله مقابلة عرادا
وفيها وفي براقش يقول فروة بن مسيك :
أحل يحابر جدي عطيفًا ... معين الملك من بين البنينا
وملكنا براقش دون أعلى ... وأنعم إخوتي وبني أبينا
ومنها تناقضه في أن العرب لم يعرفوا دولة النبط في الشام ، ثم ذكر في
عدة حوادث أنهم عرفوها خصوصًا في صفحة ( 79 ) ، حيث نقل عن ابن خلدون
وحمزة الأصفهاني معرفتهما لنبط الشام ، وأن بطرا كانت تسمى بعد الإسلام الرقيم ،
ولهم فيها شعر ، هذا إلى مناقضات كثيرة لا تسع سردها ولا تفصيلها هذه المجلة .
الأمر الثالث من الأمور التي تؤخذ على المؤلف ، جسارته على وضع الأسماء
والتقسيمات التاريخية مع ضعف الاستظهار ، كتقسيماته أدوار تاريخ العرب ،
وكتسميته الأمة التي سماها استرابون اليوناني جرهيين ، بالقرييين ، نسبة إلى قرية ،
وهي اسم اليمامة قديمًا ، وهم الذين قال فيهم استرابون : ( إنهم أغنى أهل الأرض ،
ويكثرون من آنية الذهب والفضة ، ويزينون جدران منازلهم بالعاج والذهب والفضة
والأحجار الكريمة ) ، فمتى كان أهل اليمامة أغنى أهل الأرض ؟ ومتى كان لهم
جدران تزين بالذهب والفضة والأحجار الكريمة ؟ ! ! أليس كلام استرابون أشبه
بالخرافات التي تقال عن مدينة شداد بن عاد ( إرم ذات العماد ) التي يبكت حضرة
جرجي أفندي زيدان جهلة مؤرخينا على ذكرهم لها ! ولكنه لا يبكت استرابون ،
بل لم يكتف بقوله حتى حرف لفظه ( جرها ) بلفظ ( قرية ) وجعل أهلها دولة لم
تعرفها العرب وفتح بابًا لها خاصًّا في كتابه ، ورسمها على المصور الجغرافي ! !
الأمر الرابع من الأمور التي تؤخذ على المؤلف ، ارتياب القارئ في تهجينه
أخبار العرب في حوادث الفخر والغلبة ، كفتوحات شمر يرعش و أسعد ذي كرب في
آسيا وأفريقس في أفريقيا وحسان بن تبع . وتصديقه خرافات استرابون
وهيريدوت ، مع أنهما لم يدخلا بلاد العرب ولم يرياها . واقرأ ما نقله عن استرابون
في صفحة ( 138 ) تتحقق صدق ما نقول ، وهذا نصه :
وذكر استرابون ضربًا من الاشتراكية عند أولئك العرب غريبًا في بابه ، فبعد
أن أورد اشتراك كل عائلة بالأموال والمتاع بين أفرادها ، وأن رئيسها أكبر رجالها
سنًا ، قال : والزواج مشترك عندهم ، يتزوج الإخوة امرأة واحدة ، فمن دخل منهم
إليها أولاً ترك عصاه بالباب ، والليل خاصّ بأكبرهم ، وهو شيخهم ، وقد يأتون
أمهاتهم ، ومن تزوج من غير عائلته عوقب بالموت . كان لأحد ملوك العرب
ابنة بارعة في الجمال ، لها 15 أخًا ، كل واحد منهم يهواها حتى ملتهم ، واحتالت
على منعهم بعصا اصطنعتها تشبه عصيّهم ، وكان لكل منهم عصا عليها علامته .
فكانت إذا خرج أحدهم من عندها حمل عصاه ومضى ، فتضع هي مكانها العصا التي
اصطنعتها على مثالها ، فيتوهم سائر الإخوة أنه لا يزال عندها ، وقد يجيء أحد
يتفقد الباب ، ولما يرى العصا بجانبه يرجع ، فتبدل العصا الأولى بعصا مثل
عصاه وهكذا . فاتفق مرة أن الإخوة كانوا جميعًا في ساحة ، ورأى أحدهم بباب أخته
عصا ، وليس من إخوته أحد غائبًا ، فظن فيها السوء فشكاها إلى أبيها ، ولما اطلع
على عذرها برأها . هذه حكاية استرابون ، ولم نذكرها إلا لغرابتها ، ولا نعلم مقدار
ما فيها من الصحة . ا هـ
يذكر هذه الحكاية هنا بالتفصيل ويعتذر بهذا العذر ، مع أنه عندما يقتضي
المقام شيئًا صحيحًا تاريخيًّا عن العرب يدمجه ويجمل فيه ويحيل القارئ على الكتب
الأخرى ! .
الأمر الخامس سوء التعبير من الوجهة الدينية في عبارات الكتاب ، كقوله
في صفحة ( 10 ) أقدم المصادر العربية المدونة عن تاريخ العرب وأقربها إلى
الصحة القرآن ( ؟ ) .
الأمر السادس من الأمور التي تؤخذ على المؤلف أنه أغفل مدة حكم الفرس
على اليمن بعد ذي يزن ، فلم يذكر أحدًا من عمالهم مع أن عمال كسرى استمروا
يحكمون اليمن إلى الإسلام ، فكان آخرهم باذان ، الذي كان على عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، وأسلم ثم صارت اليمن إلى الإسلام .
الأمر السابع من الأمور التي تؤخذ على المؤلف ، كثرة شكه وتردده وتناقضه
في أكثر الحوادث ، حتى إنه لا يرى المطلع على كتابه خبرًا مبرهنًا على صحته
بدليل مقنع ، ويظهر ذلك ظهورًا بينًا في آرائه الخاصة واجتهاداته التاريخية .
الأمر الثامن من الأمور التي تؤخذ على المؤلف ، تخريجه الأعلام تخريجًا
غريبًا ، قال : إن اسم امرئ القيس يظنه محرفًا عن مرقس ! ! وأن اسم الحارث
ربما كان ترجمة جيورجيوس ، واسم صخر ، ترجمة بطرس ! ! إلخ ما ذكر من
التخريج .
الأمر التاسع اختصاره التاريخ جدًّا ، وهو أحد العيوب التي عابها على
مؤرخي العرب ، فلم يسلم هو منها ، والكمال لله وحده .
__________
(1) تابع لما نشر في ص 681 م 11 من مقالة الشيخ أحمد الإسكندري .
(11/780)
الكاتب : شبلي النعماني
المحرم - 1330هـ
يناير - 1912م
المحرم - 1330هـ
يناير - 1912م
نقد تاريخ التمدن الإسلامي
الشيخ شبلي النعمانى
( 1 )
تمهيد للمنار
تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي أفندي زيدان صاحب الهلال مشهور ، وقد
سبق لنا تقريظه في المنار ونقد بعض مباحثه ، وذكرنا أننا كنا نود لو نجد سعة من
الوقت لمطالعته كله ونقده نقدًا تفصيليًّا . ولما عرضه مؤلفه على نظارة المعارف
المصرية وطلب منها أن تقرره للتدريس في مدارسها عهدت النظارة إلى بعض
أساتذتها بمطالعته وإبداء رأيهم فيه ، فلما طالعوه بينوا للنظارة أن فيه غلطًا كثيرًا
وأنه غير جدير بأن يعتمد عليه في التدريس ولا المطالعة ، فلأجل هذا لم تقرره
النظارة . وكنت انتقدت الأساتذة الذين طالعوا الكتاب وانتقدوه أنهم لما يكتبوا ما
رأوه فيه من الغلط وبينوه للناس وللمصنف أيضًا لعله يرجع إلى الصواب إذا ظهر
له ، فإنه يدعو الكتاب دائمًا على نقد كتبه .
نعم إن بعض من قرأه قد انتقده بمقالات نشرت في جريدة المؤيد وأجاب
المصنف عن بعض ما انتقد عليه واعترف ببعض ، وقد ذكرت هذا في المنار .
ويرى بعض الناقدين لهذا التاريخ قولاً وكتابة أن مؤلفه يتعمد التحامل على العرب
وعلى الإسلام نفسه ، وكنت إذا سمعت ذلك منهم أعارضهم وأرجح أنه غير متعمد ،
وأن السبب في أكثر ما أخطأ به هو عدم فهم بعض المسائل كتفسيره لمسألة القول
بخلق ألفاظ القرآن بأن القرآن غير منزل من عند الله وكخطئه فيما ذكره عن ثروة
المسلمين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مما انتقدناه عليه في المنار ،
وإما جعل بعض الوقائع الجزئية قواعد كلية عامة ، وهذا معهود في جميع مؤلفاته ،
ولكن ظهر لنا مما كتبه بعد ذلك ومن بعض حديثه معنا ومع غيرنا من أصحابه أنه
يكاد يكون من الشعوبية الذين يتحاملون على العرب ويفضلون العجم عليهم وكان
هذا سبب ترجمة هذا الكتاب بالتركية .
وقد انبرى في هذه الأيام الشيخ شبلي النعماني العلامة المصلح الشهير مؤسس
جمعية ندوة العلماء في الهند ومحرر مجلتها إلى الرد على هذا التاريخ ، وكتب إلينا
أنه يريد أن يرسل إلينا ما يكتبه ويطبعه من هذا الرد بالتدريج لننشره في المنار ،
كلما طبع منه شيئًا في ( لكنؤ ) أرسله إلى أن يتم ، ولما كان الانتقاد من مثل هذا
العالم المؤرخ هو ضالتنا وضالة صديقنا وصديقه المؤلف ، بادرنا إلى نشره
معتذرين عما في أوله من شدة الحكم ، وودنا لو لم يصرح به وإن أثبته ، ولولا أنه
طبعه لحذفناه منه . قال :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه
أجمعين إن الدهر دار العجائب . ومن إحدى عجائبه أن رجلاً من رجال العصر [1]
يؤلف في تاريخ تمدن الإسلام كتابًا يرتكب فيه تحريف الكلم وتمويه الباطل ، وقلب
الحكاية ، والخيانة في النقل ، وتعمد الكذب ما يفوق الحد ، ويتجاوز النهاية ، وينشر
هذا الكتاب في مصر وهي غرة البلاد ، وقبة الإسلام ، ومغرس العلوم ، ثم يزداد
انتشارًا في العرب والعجم ، ومع هذا كله لا يتفطن أحد لدسائسه [2] { إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ
عُجَابٌ } ( ص : 5 ) .
لم يكن المرء ليجترئ على مثل هذه الفظيعة في مبتدأ الأمر ولكن تدرج إلى
ذلك شيئًا فشيئًا ، فإنه أصدر الجزء الثاني من الكتاب وذكر فيه مثالب العرب دسيسة
يتطلع بها على إحساس الأمة وعواطفها ، ولما لم يتنبه لذلك أحد ، ولم ينبض لأحد
عرق ، ووجد الجو صافيًا ، أرخى العنان ، وتمادى في الغي ، وأسرف في النكاية ،
في العرب عمومًا وخلفاء بني أمية خصوصًا .
وكان يمنعني عن النهوض إلى كشف دسائسه اشتغالي بأمر ندوة العلماء ,
ولكن لما عم البلاء ، واتسع الخرق ، وتفاقم الشر ، لم أطق الصبر ، فاختلست من
أوقاتي أيامًا وتصديت للكشف عن عوار هذا التأليف والإبانة عما فيه من أنواع
الإفك والزور وأصناف التحريف والتدليس .
معذرة إلى المؤلف
إني أيها الفاضل المؤلف غير جاحد لمننك فإنك قد نوهت باسمي في تأليفك
هذا وجعلتني موضع الثقة منك ، واستشهدت بأقوالي ونصوصي ، ووصفتني بكوني
من أشهر علماء الهند ، مع أنى أقلهم بضاعة ، وأقصرهم باعًا ، وأخملهم ذكرًا ،
ولكن مع كل ذلك هل كنت أرضى أن تمدحني وتهجو العرب غرضًا لسهامك ودريّة
لرمحك ، ترميهم بكل معيبة وشين ، وتعزو إليهم كل دنية وشر ، حتى تقطعهم إربًا
إربًا ، وتمزقهم كل ممزق ، وهل كنت أرضى بأن تجعل بني أمية لكونهم عربًا
بحتًا من أشر خلق الله وأسوئهم ، يفتكون بالناس ، ويسومونهم سوء العذاب ،
ويهلكون الحرث والنسل ، ويقتلون الذرية وينهبون الأموال ، وينتهكون الحرمات ،
ويهدمون الكعبة ويستخفون بالقرآن .
وهل كنت أرضى بأن تنسب حريق خزانة الإسكندرية إلى عمر بن الخطاب ،
الذي قامت [1] بعدله الأرض والسماء ، وهل كنت أرضى بأن تمدح بني العباس
فتعد من مفاخرهم أنهم نزلوا العرب منزلة الكلب ، حتى ضرب بذلك المثل ، وأن
المنصور بنى القبة الخضراء إرغامًا للكعبة ، وقطع الميرة عن الحرمين استهانة
بهما ، وأن المأمون كان ينكر نزول القرآن ، وأن المعتصم بالله أنشأ كعبة في
( سامرَّا ) وجعل حولها مطافًا واتخذ منى و عرفات .
وهب أني عدمت الغيرة على الملة والدين ، وافتخرت كصنيع بعض الأجانب
بأني فلسفي بحت عادم لكل عاطفة ووجدان ، فلا أرضى ولا أغضب ولا أسر ولا
أغاظ ولا أفرح ولا أتألم ، وهب أني حملت نفسي على احتمال الضيم ، وقبول
المكروه ، والصم عن البذاء ، ومجازاة السيئة بالحسنة ، ومكافأة الخبيث بالطيب ،
فهل كنت أرضى بأن تشوه وجه التاريخ ، وتدمغ الحق ، وتروج الكذب ، وتفسد
الرواية ، وتقلب الحقيقة ، وتنفق التهم ، وتعود الناس بالخرافة ، بئس ما زعمت
أيها الفاضل ، فإن في الناس بقايا وإن الحق لا يعدم أنصارًا .
إن الغاية التي توخاها المؤلف ليس إلا تحقير الأمة العربية وإبداء مساويها
ولكن لما كان يخاف ثورة الفتنة غير مجرى القول ، ولبس الباطل بالحق . بيان
ذلك أنه جعل لعصر الإسلام ثلاثة أدوار : دور الخلفاء الراشدين ، ودور بني أمية ،
ودور بني العباس ، فمدح الدور الأول وكذلك الثالث ( ظاهرًا لا باطنًا كما سيجيء )
ولما غر الناس بمدحه الخلفاء الراشدين ، وهم سادتنا وقدوتنا في الدين ، وبمدحه
لبني العباس وهم أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم ، وبهم فخارنا في بث التمدن
وأبهة الملك ، ورأى أن بني أمية ليست لهم وجهة دينية فلا ناصر لهم ، ولا مدافع
عنهم ، تفرغ لهم ، وحمل عليهم حملة شنعاء ، فما ترك سيئة إلا وعزاها إليهم ، وما
خلى حسنة إلا وابتزها منهم ، ثم لو كان هذا لأجل أنهم من آل مروان أو لكونهم من
سلالة أمية لكنا في غنى عن الذب عنهم ، والحماية لهم ، ولكن كل ذنبهم أنهم
العرب على صرافتهم ما شابتهم العجمة مطلقًا كما قال : ( وتمتاز- أي دولة بني
أمية - عن الدولة العباسية بأنها عربية بحتة ) - الجزء الثاني من تمدن الإسلام -
( وجملة القول أن الدولة الأموية دولة عربية أساسها طلب السلطة والتغلب ) -
الجزء الرابع صفحة 103 - .
عصبية العرب على العجم
أطال المؤلف وأطنب في إثبات هذه الدعوى فذكر طرفًا منه في الجزء الثاني
مدسوسًا - انظر صفحة 18 - ثم جعل له عنوانًا خاصًا في الجزء الرابع ( 58 )
وهذه نصوصه :
فإن العرب كانوا يعاملونهم معاملة العبيد ، وإذا صلوا خلفهم في المسجد
حسبوا ذلك تواضعًا لله .
وكانوا يحرمون الموالي من الكنى ولا يدعونهم إلا بالأسماء والألقاب ولا
يمشون في الصف معهم .
وكانوا يقولون لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة حمار أو كلب أو مولى .
فكان العربي يعد نفسه سيدًا على غير العربي ويرى أنه خلق للسيادة وذاك
للخدمة .
فتوهم العرب في أنفسهم الفضل على سائر الأمم حتى في أبدانهم وأمزجتهم
فكانوا يعتقدون أنه لا تحمل في سن الستين إلا قرشية ، وأن الفالج لا يصيب
أبدانهم .
ومنعوا غير العرب من المناصب الدينية المهمة كالقضاء فقالوا لا يصلح
للقضاء إلا عربي وحرموا منصب الخلافة على ابن الأمة ولو كان أبوه قرشيًّا .
ولا يزوجون الأعجمي عربية ولو كان أميرًا وكانت هي من أحقر القبائل
وكان الأمويون في أيام معاوية يعدون الموالي أتباعًا وأرقاء وتكاثروا فأدرك
معاوية الخطر من تكاثرهم على دولة العرب فهمَّ أن يأمر بقتلهم كلهم أو بعضهم .
اعلم أن للمؤلف في إنفاق باطله أطوارًا شتى :
فمنها تعمُّد الكذب كما سترى ، ومنها تعميمه لواقعة جزئية ، ومنها الخيانة في
النقل وتحريف الكلم عن مواضعه .
ومنها الاستشهاد بمصادر غير موثوقة مثل كتب المحاضرات والفكاهات .
وهاك أمثلة من كل نوع منها قال : ( إذا صلوا خلفهم في المسجد حسبوا ذلك
تواضعًا لله وكانوا يحرمون الموالي من الكنى إلخ , وكانوا يقولون لا يقطع الصلاة
إلا ثلاثة إلخ ) .
غير خافٍ على من له إلمام بتاريخ الفرس والعرب أن الفرس كانت قبل
الإسلام تحتقر العرب وتزدريهم ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه
إلى كسرى العجم اشمأز وقال عبدي يكتب إليَّ ! ! وكتب يزدجرد إلى سعد بن أبي
وقاص فاتح القادسية أن العرب مع شرب ألبان الإبل وأكل الضب بلغ بهم الحال
إلى أن أفنوا دولة العجم فأفٍّ لك أيها الدهر الدائر , وكانت ملوك الحيرة تحت إمرة
ملوك العجم .
ثم لما شرف الله العرب بالإسلام انتصفت العرب من العجم واستنكفوا من
سيادتهم عليهم ، وجاءت الشريعة الإسلامية ماحية لكل فخر ونخوة فقال رسول الله
في خطبته الأخيرة في حجة الوداع ، أن لا فضل للعربي على العجمي ولا للعجمي
على العربي كلكم أبناء آدم ) .
وحينئذ ارتفع التمايز وتساوى الناس ولكن مع ذلك بقيت في بعض الناس من
كلا الطرفين حزازات كامنة في صدورهم كانت سببًا لحدوث حزبين متقابلين يسمى
أحدهما الشعوبة وهي التي تحتقر العرب وترميه بكل معيبة حتى إن أبا عبيدة
صنف كتبًا عديدة يطعن فيها على أنساب كل قبيلة من قبائل العرب ، والثاني
المتعصبون للعرب . وقد عقد العلامة ابن عبد ربه في كتابه العِقْد الفريد بابًا في
حجج كِلا الطرفين وأقوالهما . ومعظم ما نقله المؤلف في إثبات عصبية العرب هي
أقوال ذكرها صاحب العقد في هذا الباب ، كما لوَّح به المؤلف في هامش الكتاب .
وإذا تصفحت الكتب يظهر لك أن الأقوال التي نسبها إلى العرب عمومًا إنما
هي أقوال شرذمة خاصة موسومة بأصحاب العصبية ، وصاحب العقد حيثما ذكر
هذه الأقوال صدرها بقوله ( قال أصحاب العصبية من العرب ) وأنت تعلم أن هذه
العصبة ليست كافة العرب ولا أكثرها ، بل ولا عشر معشارها ، فإنك سترى أن
هؤلاء أناس شرذمة مغمورون في الناس . ثم إن المؤلف ما اقتنع بذلك بل ربما
نسب قول رجل معين معلوم الاسم إلى العرب عامة .
فقال ناقلاً عن كتاب العقد : ( وكانوا يكرهون أن يصلُّوا خلف الموالي وإذا
صلوا خلفهم قالوا : إنا نفعل ذلك تواضعًا لله ) قال صاحب العقد : نسب هذا القول
إلى نافع بن جبير فأخذه المؤلف وجعله قولاً عامًّا للعرب ، وهذه الصنيعة أعني
تعميم الواقعة الجزئية هي أكبر الحيل التي يرتكبها المؤلف لترويج باطله بل هي
قطب رحى تأليفه .
قال المؤلف : ( فأدرك معاوية الخطر من تكاثرهم على دولة العرب فهمَّ أن
يأمر بقتلهم كلهم أو بعضهم ) - الجزء الرابع صفحة 59 - إن نص معاوية الذي
نقله المؤلف بعد هذه العبارة هو هذا ( كأني أنظر إلى وثبة منهم على العرب
والسلطان فرأيت أن أقتل شطرًا وأدع شطرًا ) فأنت ترى أن الرواية على تقدير
صحتها ليس فيها إلا أن معاوية رأى أن يقتل شطرًا منهم . ولكن المؤلف زاد على
العبارة وقال : إن معاوية همَّ أن يأمر بقتلهم كلهم .
قال المؤلف : فكانوا يعتقدون أن الفالج لا يصيب أبدانهم ، - الجزء الرابع
صفحة 6 - استشهد في هذه الدعوى بطبقات الأطباء كما لوح في هامش الكتاب .
وايم الله لو كنت تقف على عبارة الطبقات لوقعت في أشد حيرة من اجتراء المؤلف
على قلب الحكاية ، وتغيير الرواية ، ذكر صاحب الطبقات تحت ترجمة عيسى
الطبيب ( الراجح أنه نصراني ) أن المهدي ضربه فالج فحضر المتطببون ومنهم
عيسى صاحب الترجمة فقال ( المهدي بن المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله
بن عباس يضربه فالج ، لا والله لا يضرب أحدًا من هؤلاء ولا نسلهم فالج أبدًا إلا
أن يبذروا بذورهم في الروميات والصقلبيات وما أشبههن ) .
قد نقل صاحب الطبقات بعد الحكاية المذكورة عن يوسف الطبيب أن إبراهيم
بن المهدي لما اعتل بعلة شبيهة بالفالج دعا يوسف وقال له : ما العلة عندك في
عروض هذه العلة لي ؟ ( قال يوسف ) : فعلمت أنه كان حفظ عن أمه قول عيسى
أبي قريش في المهدي وولده أنه لا يعرض لعقبه الفالج إلا أن يبذروا بذورهم في
الروميات وأنه قد أمل أن يكون الذي به فالجًا لا عارض الموت . فقلت : لا أعرف
لإنكارك هذه العلة معنى إذ كانت أمك التي قامت عنك دنباوندية و ( دنباوند ) أشد
بردًا من كل أرض الروم ، فكأنه تفرج إلى قولي وصدقني وأظهر السرور .
فأنت ترى أن الظن ببراءتهم من الفالج إنما كان مبناه حَرّ أرض العرب وليس
له أدنى مساس بشرف النسل . ولو كان كما يتبادر إلى الذهن من عد أسماء آباء
المهدي فهو يختص بعائلة النبي عليه السلام لا يفهم منه العموم مطلقًا ، ولذلك لما
ذكر لإبراهيم ( وهو ابن الخليفة المهدي ) أن أمه من ( دنباوند ) وهو أشد بردًا من
كل أرض الروم ، ذهب عنه استغرابه عروض الفالج له .
فانظر كيف كان مجرى الحكاية فغيرها المؤلف وارتكب لذلك خيانات تترى ،
ثم إن هذا قول عيسى الطبيب ولا يدرى أنه عربي أم لا وغالب الظن أنه نصراني
وهب أنه عربي فهو رجل من حاشية الدولة يريد التزلف إلى الخليفة والتملق له
فهل يكون قوله قول العرب كافة ؟ .
قال المؤلف : ومنعوا غير العرب من المناصب الدينية المهمة كالقضاء فقالوا :
لا يصلح للقضاء إلا عربي - الجزء الرابع صفحة 60 - وأسند هذه الرواية إلى
ابن خلكان .
حقيقة هذا القول أن الحجاج لما أسر سعيد بن جبير التابعي المشهور وكان من
الموالي قال له ممتنًّا عليه : أما جعلتك إمامًا للصلاة في الكوفة ولم يكن في الكوفة إلا
العرب ، قال ابن جبير : نعم ، ثم قال له الحجاج : أليس أني لما أردت أن أوليك
قضاء الكوفة ضجَّ العرب وقالوا : لا يصلح للقضاء إلا عربي ؟ وقد ذكر الرواية
ابن خلكان بطولها ولا يخفى عليك أن كوفة لم يكن إذ ذاك فيها إلا العرب وظاهر أن
القضاء لا يصلح له إلا من كان عارفًا بعوائد الأمة مطلعًا على خصائصهم وكيفية
تعاملهم فيما بينهم ، وسعيد بن جبير لم يكن من العرب ، ولو كان استنكاف أهل
كوفة من قضائه لأجل كونه من الموالي لاستنكفوا من إمامته للصلاة فإن الإمامة
أعظم شرفًا وأرفع محلاً من القضاء . وهذا أبو حنيفة كان من الموالي وأرادوا أن
يولوه القضاء في عصر بني أمية فامتنع ولم يرض بذلك وقد ذكر الواقعة ابن خِلِّكان
مفصلاً .
قال المؤلف ( وحرموا منصب الخلافة على ابن الأَمَة ولو كان قرشيًّا ) نعم
ولكن لم يكن هذا للاستهانة به .
قال الأصمعي : كانت بنو أمية لا تبايع لبني أمهات الأولاد فكان الناس يرون
أن ذلك للاستهانة بهم ولم يكن لذلك ولكن لما كانوا يرون أن زوال ملكهم على يد أم
ولد [1] .
أما ما استدل به المؤلف من قول هشام بن عبد الملك لزيد بن علي : إنك ابن أمة
ولذلك لا تصلح للخلافة ، فقد رده عليه زيد وقال : إن إسماعيل كان ولد الجارية
وكان سيد البشر محمد من سلالته , ومن المعلوم أن زيدًا وهو ابن الإمام زين
العابدين أرفع شأنًا وأعظم محلاًّ وأطيب أرومة وأصدق قولاً من هشام . ثم لو كان
هذا الأمر حقًّا ما كانوا يولُّون الخلافة يزيد بن الوليد الأموي ومروان الحمار وهما
ابنا أمة .
ولما فرغنا من إبداء شطر من خيانات المؤلف ليكون كالعنوان على دأبه في
تأليفاته حان لنا أن نحقق أصل المسألة أي أن العجم والموالي هل كانوا أذلاء
ساقطين مرذولين يعاملون معاملة العبيد في عصر بني أمية كما يدعيه المؤلف أو
كانوا بمحل من الشرف والعزة يعترف لهم العرب بالفضل والسؤدد ، ويوفَّى لهم
أوفى قسط وأكمل حق .
اعلم أن البلاد التي كانت عواصم الأقاليم وقواعدها في عصر بني أمية هي
مكة و المدينة و البصرة و الكوفة و اليمن ومصر و الشام و الجزيرة و خراسان
وكان لكل هذا الأصقاع إمام يقودهم ويسود عليهم وهذه أسماؤهم .
مكة المشرفة عطاء بن أبي رباح هو أستاذ الإمام أبي حنيفة
اليمن ... ... طاوس
الشام ... ... مكحول
مصر ... ... يزيد بن أبي حبيب
الجزيرة ... ميمون بن مهران
خراسان ... ضحاك بن مزاحم
البصرة ... الإمام الحسن البصري
الكوفة ... إبراهيم النخعي
وكل هؤلاء غير إبراهيم النخعي كانوا من الموالي وبعضهم أبناء الإماء ومع
كونهم أعجامًا وكونهم أولاد الإماء كانوا سادة الناس وقادتهم تذعن لهم العرب
وتحترمهم خلفاء بني أمية وولاة الأمر .
فأما ( عطاء بن أبي رباح ) فمع كونه ابن سندية كان شيخ الحرم وإليه
المرجع في الفتوى وعليه المعول في المسائل ، قال ابن خلكان في ترجمته : قال
إبراهيم بن عمرو : ابن كيسان أذكرهم في زمان بني أمية يأمرون في الحج صائحًا
يصيح ( لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح ) وهل يمكن أن ينادى بمثل ذلك من
غير رضى الخلفاء [1] .
وأما ( طاوس ) فلما قضى نحبه بمكة ازدحم الناس في جنازته حتى تعذرت
الصلاة عليه وكان إبراهيم بن هشام إذ ذاك واليًا على مكة فاستعان بالشُّرَطة ومشى
في جنازته عبد الله ابن الإمام حسن عليه السلام واضعًا نعشه على عاتقه وصلى
عليه الخليفة هشام بن عبد الملك الأموي ، ذكر كل هذا العلامة ابن خلكان في
ترجمة طاوس فهل يكون منزلة أعظم من ذلك ؟
وأما ( مكحول الشامي ) فأحد الأئمة المتبوعين وقال الزهري : العلماء أربعة
فلان وفلان ومكحول .
وأما ( يزيد بن أبي حبيب ) فهو الذي أرسله عمر بن عبد العزيز ليفقه الناس
في مصر ويفتيهم في المسائل وهو المعلم الأول لهم كما صرح بذلك السيوطي في
حسن المحاضرة .
وأما ( ميمون بن مهران ) فمع فضيلته وسيادته كان أميرًا على الخراج في
الجزيرة كما صرح به ابن قتيبة في المعارف .
أما ( حسن البصري ) فحدث عن البحر ولا حرج ، يذعن له الملوك والسادة
والقواد وعليه المعول وإليه المنتهى [1] .
ذكر السخاوي في شرح ألفية الحديث للعراقي ( طبع لكهنو صفحة 498
و 499 أن هشامًا قال للزهري : من يسود أهل مكة ؟ . قال : عطاء ، قال : بم
سادهم ؟ قال : بالديانة والرواية ، قال هشام : نعم من كان ذا ديانة حقت الرياسة له
ثم سأل عن يمن قال طاؤس ، وكذلك سأل عن مصر والجزيرة وخراسان
والبصرة والكوفة فأخذ الزهري يعد أسماء سادات هذه البلاد وكلما سمى رجلاً كان
هشام يسأل هل هو عربي أم مولى ؟ وكان يقول الزهري : مولى ، إلى أن أتى
على النخعي وقال : إنه عربي . فقال هشام ( الآن فرَّجت عني والله ليسودن
الموالي العرب ويخطب لهم على المنابر والعرب تحتهم ) .
إن التابعين لهم أعلى محل في تاريخ الإسلام - ورأسهم سعيد بن جبير وهو
أسود وقد ولاه حجاج بن يوسف إمامة الصلاة في الكوفة كما ذكره ابن خلكان في
ترجمته والكوفة إذ ذاك جمجمة العرب وقبة الإسلام ، وهل يصح بعد ذلك دعوى
المؤلف أن العرب كانت تستنكف من الصلاة خلف الموالي .
وهذا سليمان الأعمش أستاذ الثوري كان عبدًا عجميًّا وكان بمنزلة من العز
والشرف أنه لما كتب إليه الخليفة هشام بن عبد الملك أن يكتب له مناقب عثمان
ومساوئ علي أخذ كتاب هشام وألقمه عنزًا كان عنده وقال للرسول قل لهشام هذا
جواب كتابك .
... ... ... ... ... ... ... ( ابن خلكان ترجمة الأعمش )
وهذا حماد الراوية الذي دوَّن المعلقات وله المكانة الكبرى في الأدب والشعر
كان عبدًا أسود وكانت ملوك بني أمية تقدمه وتؤثره وتستزيره كما ذكره ابن
خلكان .
وهذا سالم بن عبد الله بن عمر كان ابن أمة ولما دخل الخليفة هشام بن عبد
الملك المدينة أرسل إليه يدعوه فاعتذر فدخل عليه هشام ووصله بعشرة آلاف ثم لما
حج ورجع كان سالم إذ ذاك مريضًا فذهب لعيادته ولما توفي صلى عليه وقال : لا
أدري بأي الأمرين أنا أسر : بحجتي أم بصلاتي على سالم ؟ ولو أخذنا في تعداد
أمثال هذه الوقائع لطال الكلام ومل الناظرون .
ويظهر مما مر عليه أن الموالي كانوا في أيام بني أمية بأعلى محل من
الشرف والمكانة وكانت العرب تذعن لهم وتقدمهم وتقتدي بهم وترفع شأنهم ، فهل
يصح قول المؤلف بعد ذلك : إن الموالي وأبناء الإماء كانوا في عصر بني أمية
مرذولين ساقطين يزدرى بهم ولا يقام لهم وزن وكان العرب وبنو أمية يعاملونهم
معاملة العبيد ؟
( لها بقية )
((يتبع بمقال تالٍ))
__________
(1) هو جرجي زيدان صاحب مجلة الهلال اهـ من خط المؤلف في هامش الأصل .
(2) المنار : قد علم من التمهيد أن كثيرين قد فطنوا لما في الكتاب من الخطأ وبعضهم انتقدوه .
(3) لعل الأصل شهدت بدل قامت .
(4) انظر الجزء الثاني من العقد الفريد طبع مصر صفحة 330 .
(5) المنار : الأمر أكبر من ذلك ، كان عطاء يشدد في وعظ عبد الملك والوليد فيقبلان منه راجع في صفحة 422 و 423 من مجلد المنار التاسع وعظه لعبد الملك وهو جالس معه على كرسيه وترفعه عن الأخذ منه وقول عبد الملك عند خروجه : (هذا وأبيك الشرف) ومخاطبته للوليد باسمه وتشديده في وعظه حتى أغمي عليه .
(6) راجع في 423 وما بعدها من مجلد المنار التاسع إغلاظ الحسن على الحجاج ، وفي صفحة 498 منه نصيحته لوالي بني أمية على العراق .
(15/58)
الكاتب : شبلي النعماني
صفر - 1330هـ
فبراير - 1912م
صفر - 1330هـ
فبراير - 1912م
نقد تاريخ التمدن الإسلامي
بقلم الشيخ شبلي النعماني
( 2 )
مثالب بني أمية
المقصد الذي جعله المؤلف نصب عينه ومرمى غايته هو أن الأمة العربية إذا بقيت على صرافتها فهي جامعة لجميع أشتات الشر ، أي الجور والقسوة والهمجية وسفك الدماء والفتك بالناس . ولكن لما كان لا يقدر على إظهار هذا المقصد تصريحًا
احتال في ذلك فغمض المذهب وجعل الكلام طيب الظاهر وذلك بأن قسم
عصر الإسلام إلى ثلاثة أدوار - فمدح سياسة الخلفاء الراشدين ، وقال بعد مدحها :
( على أن سياسة الراشدين على الإجمال ليست مما يلائم طبيعة العمران أو
تقتضيه سياسة الملك وإنما هي خلافة دينية توفقت إلى رجال يندر اجتماعهم في
عصر .
فأهل العلم بالعمران لا يرون هذه السياسة تصلح لتدبير الممالك في غير ذلك
العصر العجيب وأن انقلاب تلك الخلافة الدينية إلى الملك السياسي لم يكن منه بد .
( الجزء الرابع صفحة 29 و30 )
فأثبت بذلك أن سياسة الخلفاء الراشدين ليست فيها أسوة للناس ، وأنها من
مستثنيات الطبيعة ، أما دور العباسيين فمدحه ولكن لا لأجل أنه دولة عربية بل
لكونها فارسية مادة وقوامًا مؤتلفًا ونظامًا وصرح بذلك فقال :
( دعونا هذا العصر فارسيًّا مع أنه داخل في عصر الدولة العباسية ؛ لأن تلك
على كونها عريبة من حيث خلفاؤها ولغتها وديانتها فهي فارسية من حيث سياستها
وإدارتها ؛ لأن الفرس نصروها وأيدوها ثم هم نظموا حكومتها وأداروا شئونها
ومنهم وزراؤها وأمراؤها وكتابها وحُجَّابها ) .
( الجزء الرابع صفحة 106 )
ثم أشار في غير موضع إلى أن الدولة العربية الساذجة إنما هي دولة بني أمية
فقال :
( وجملة القول أن الدولة الأموية دولة عربية ) ( الجزء الرابع صفحة
103 ) وظل العرب في أيام بني أمية على بداوتهم وجفاوتهم وكان خلفاؤها يرسلون
أولادهم إلى البادية لإتقان اللغة واكتساب أساليب البدو وآدابهم ( الجزء الرابع
صفحة 61 ) .
ولما أثبت أن خلافة الراشدين لم تكن تلائم النظام الطبيعي وأن دولة بني
العباس دولة فارسية وأن الباقية على صرافتها هي الدولة الأموية أخذ يعدد مثالب
بني أمية تحت عنوانات مستقلة منها الاستخفاف بالدين وأهله ، ومنها الاستهانة
بالقرآن والحرمين ، ومنها الفتك والبطش ، ومنها قتل الأطفال ، ومنها خزانة
الرءوس . وأتى في مطاوي هذه العنوانات من الإفك والاختلاق والتحريف والتبديل
بما تجاوز الحد وخرج عن طور القياس . والآن أذكر نبذًا منها وأكشف عن جلية
حالها .
***
الاستهانة بالقرآن والحرمين
قال المؤلف تحت هذا العنوان :
( أما عبد الملك فكان يرى الشدة ويجاهر بطلب التغلب بالقوة والعنف ولو
خالف الدين ؛ لأنه صرح باستهانة الدين منذ ولي الخلافة .. . ذكروا أنه لما جاءوه
بخبر الخلافة كان قاعدًا والمصحف في حجره فأطبقه وقال : هذا آخر العهد بك -
أو- هذا فراق بيني وبينك . فلا غَرو بعد ذلك إذا أباح لعامله الحجاج أن يضرب
الكعبة بالمنجنيق وأن يقتل ابن الزبير ويحتز رأسه بيده داخل مسجد الكعبة . وظلوا
يقتلون الناس فيها ثلاثًا وهدموا الكعبة وهي بيت الله عندهم وأوقدوا النيران بين
أحجارها وأستارها ) ( الجزء الرابع صفحة 78 و79 ) .
الحكاية على الإجمال أن ابن الزبير ادعى الخلافة فملك الحرمين و العراق
وكاد يغلب على الشام وكان أمره كل يوم في ازدياد وبإزائه بنو أمية في الشام فلما
تولى عبد الملك الخلافة أرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره ولاذ ابن الزبير
بمكة فنصب الحجاج المنجنيق على الزيادة التي كان زادها ابن الزبير ( كما يجيء
تفصيله ) .
يعرف كل من له أدنى إلمام بالتاريخ أن الحجاج ما أراد إلا قتال ابن الزبير
ولكونه لائذًا بالكعبة اضطر إلى نصب المنجنيق على الكعبة ، ولكن مع ذلك تحرز
عن رمي الكعبة فحوَّل وجهها إلى زيادة ابن الزبير . فانظر كيف غير المؤلف
مجرى الحكاية فصدر الباب بالاستهانة بالقرآن والحرمين . ثم ذكر أن عبد الملك
قال للقرآن :
هذا فراق بيني وبينك . وأنه أباح للحجاج ضرب الكعبة بالمنجنيق وهدم
الكعبة وإيقاد النيران بين أستارها ، فالناظر في عبارته يتوهم بل يستيقن أن
عبد الملك تفرغ من بدء الأمر للاستهانة بالدين والقرآن والحرمين وجعل الاستهانة
نصب عينه ومرمى غايته ، وقتل ابن الزبير كان إما لأنه دافع عن مكة أو لكونه
أيضًا جنس الاستهانة بالحرم .
أما تفصيل الواقعة وتعيين بادئ الظلم فهو أن ابن الزبير لما استولى على
الحرمين أخرج بني أمية من المدينة فخرج مروان وابنه عبد الملك وهو عليل مجدر
فاستولى على الشام ، وصدرت من ابن الزبير أفعال نقموا عليه لأجلها فمنها أنه
تحامل على بني هاشم وأظهر لهم العداوة والبغضاء [1] حتى إنه ترك الصلاة على
النبي في الخطبة ولما سألوه عن هذا قال : إن للنبي أهل سوء يرفعون رءوسهم إذا
سمعوا به [2]ومنها أنه هدم الكعبة ومع أن هدمها لم يكن إلا لرمتها وإصلاحها ولكن
لم يكن هذا مألوفًا للناس ، ولذلك تحرز النبي عليه السلام عن إدخال الحطيم في
الكعبة فاتخذ الحجاج هذه الأمور وسيلة لإغراء الناس على ابن الزبير . ولعل ابن
الزبير كان مضطرًّا إلى هذه الأعمال ولكن من شريطة العدل أن نوفي كل واحد
قسطه من الحق ، فإذا اعتذرنا لابن الزبير فعبد الملك أحق منه اعتذارًا ، فإن ابن
الزبير هو البادئ والبادئ أظلم . ويظهر من هذا أن عبد الملك ما أراد الحط من
شأن الكعبة ومس شرفها ولكن اضطر إلى قتال ابن الزبير فوقع ما وقع عرضًا غير
مقصود بالذات ولذلك لما نصب الحجاج المناجيق على الكعبة حولها عن الكعبة
وجعل الغرض الزيادة التي كان زادها ابن الزبير ، صرح بذلك العلامة البشاري في
أحسن التقاسيم . ثم إن من مسائل الفقه أن البغاة إذا تحصنوا بالكعبة لا يمنع هذا
عن قتالهم ولذلك أمر النبي في وقعة الفتح بقتل أحدهم وهو متعلق بأستار الكعبة
وابن الزبير كان عند أهل الشام من البغاة والمارقين عن الدين .
ولو كان أراد الحجاج الاستهانة بالحرم فما كان مراده من رمته وإصلاحه بعد
قتل ابن الزبير ، ومعلوم أن تعمير الحَجاج هو كعبة الإسلام وقبلة المسلمين كافةً .
أما قول عبد الملك للقرآن هذا فراق بيني وبينك ، فحقيقته أن عبد الملك كان
قبل الخلافة ناسكًا منقطعًا إلى العبادة لا يشتغل بشيء من الدنيا ، قال نافع : ما
رأيت في المدينة أشد نُسكًا وعبادة من عبد الملك ، ولما سألوا ابن عمر إلى من
ترجع في الفتوى بعدك ؟ قال ( ولد لمروان ) وكان يقول ابن الزناد الفقهاء في
المدينة سبع أحدهم عبد الملك . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
وقال الإمام الشعبي : ما جالست أحدًا إلا وجدت عليه الفضل إلا عبد الملك
بن مروان . ذكر كل هذه الأقوال العلامة السيوطي في تاريخه للخلفاء . فلما جاءته
الخلافة وهو يقرأ القرآن تصور خطارة الأمر ، وأن مثل هذا العبء لا يمكن تحمله
إلا المنقطع إليه فقال تحسرًا : هذا آخر العهد بك . أي الآن لا يمكن الانقطاع إلى
العبادة وقراءة القرآن كما كان دأبي أولاً ، وليس هذا على سبيل الاستهانة بالدين
مطلقًا فإنا نرى اشتغال عبد الملك بالفرائض والسنن فيما بعد فهو يصوم ويصلي
ويحج قال اليعقوبي في تاريخه : وأقام الحج للناس في ولايته سنة 72 الحجاج بن
يوسف وسنة 73 وسنة 74 الحجاج أيضًا وسنة 75 عبد الملك بن مروان وسنة 76
أبان بن عثمان بن عفان ، وسنة 77 أبان أيضًا وسنة 78 وسنة 79 وسنة 80 أبان
أيضًا وسنة 81 سليمان بن عبد الملك ( وسرد باقي السنوات فتركناها ) وعبد الملك
هو الذي كسا الكعبة الديباج ، فهل هذا صنيع من يريد الاستهانة بالحرم ؟
قال المؤلف :
( ويحتز رأسه بيده داخل مسجد الكعبة ) ( الجزء الرابع صفحة 79 ) استند
المؤلف في هذه الرواية بالعِقد الفريد لابن عبد ربه والاستناد بمثل هذه الكتب في
مثل هذه الوقائع هو من إحدى حيل المؤلف المعتادة بها فأنت تعلم أن حادثة قتل ابن
الزبير مذكورة في الطبري وابن الأثير وغيرها من المصادر التاريخية المتداولة
الموثوق بها وعليها المعوَّل وإليها المرجع لكن لما لم تكن كيفية الحادثة في هذه
الكتب وفق هوى المؤلف أعرض عن هذه كلها وتشبث بكتاب هو في عداد
المحاضرات وإنما يرجع إلى أمثاله إذا لم يكن في الباب مستند غيره ومتى لم
يخالف الأصول .
والمذكور في الطبري وغيره أن عبد الله بن الزبير أصيب في الحجون وقتل
هناك قتله رجل من المراد ، وما احتز رأسه داخل الكعبة .
قال المؤلف : ( وهدموا الكعبة ) .
قدمنا أن الكعبة لم تكن غرضًا للحجاج وإنما كان نصب المناجيق على الزيادة
التي زادها ابن الزبير ، ولما كانت متصلة بالكعبة نالت الأحجار من الكعبة ولكن
كان أول ما فعله الحجاج بعد ما استتب القتال أمره بكنس المسجد الحرام من
الحجارة والدم كما نص عليه ابن الأثير فهل كنس المسجد الحرام من الحجارة والدم
وهدم الكعبة شيء واحد ؟
أما ما نقل المؤلف عن كفر الوليد وأنه أمر بالمصحف فعلقوه وأخذ القوس
والنبل وجعل يرميه حتى مزقه وأنشد :
أتوعد كل جبار عنيد ... فها أنا ذاك جبار عنيد
إذا لاقيت ربك يوم حشر ... فقل لله مزقني الوليد
ونقل هذه الرواية عن الأغاني فهي من خرافات الأغاني ، ومعلوم أن صاحب
الأغاني شيعي ديانته شنآن بني أمية والحط منهم . وأما الأبيات فأثر التوليد ظاهر
عليها ، ومن له أدنى مسكة بالأدب يشهد أن نسجها غير نسج الأوائل ، فأما جهابذة
المحدثين المرجوع إليهم في نقد الروايات والذين قولهم فصل في هذا الباب
فيجحدون أمثال هذه الروايات المختلقة . قال العلامة الذهبي : هو رأس الحديث
ومرجع الرواية - : ( لم يصح عن الوليد كفر ولا زندقة بل اشتهر بالخمر والتلوط
فخرجوا عليه لذلك ) ( تاريخ الخلفاء للسيوطي ترجمة الوليد ) .
ثم إن هناك أمرًا آخر وهو أن الناقم على الوليد وقاتله هو خليفة أموي ،
فكيف ينسب استهانة الدين إلى خلفاء بني أمية عامتهم . ثم إن هذا الذي عزا إليه
صاحب الأغاني الاستهانة بالقرآن قد ذكر له صاحب العقد ما ينبئ عن تعظيمه
للقرآن وتفخيمه شأنه وحث الناس على حفظه وتعهده قال صاحب العقد [1] : إنه
شكا رجل من بني مخزوم دينًا لزمه فقال ( الوليد ) : أقضيه عنك إن كنت لذلك
مستحقًّا قال : يا أمير المؤمنين كيف لا أكون مستحقًّا في منزلتي وقرابتي ؟ قال
قرأت القرآن ؟ قال : لا ، قال فادن مني فدنا منه فنزع العمامة عن رأسه بقضيب
في يده فقرعه قرعة وقال لرجل من جلسائه ضم إليك هذا العِلْج ولا تفارقه حتى
يقرأ القرآن . فقام إليه آخر فقال يا أمير المؤمنين اقض دَيني ، فقال له أتقرأ القرآن ؟
قال نعم فاستقرأه عشرًا من الأنفال وعشرًا من براءة فقرأ ، فقال : نعم نقضي دينك
وأنت أهل لذلك . فأنت ترى أن الوليد يعد من لا يقرأ القرآن عِلْجًا والمؤلف يعد
الوليد علجًا .
فأما ما ذكره المؤلف من أقوال الحجاج وخالد القسري وأنهما كانا يُفضلان
الخلافة على النبوة فمع أن أكثر هذه الأقوال مأخوذ من العقد الفريد وهو من كتب
المحاضرات لسنا نحتاج إلى الذب عن الحجاج وخالد فإنهما من أشرار الأمة حقًّا ،
ولكن كم لنا من أمثال هؤلاء الملاحدة في الدولة العباسية كالعجاردة وابن الرواندي
الذي عمل كتابًا رد فيه على القرآن وسماه بالدامغ ، فإذا كان العباسيون مسئولين
عن أوزار هؤلاء عند المؤلف فكذلك بنو أمية . وإن كان عبد الملك والوليد
يرتضيان بسوء أعمال الحجاج فمعلوم أن غيرهما من بني أمية كانوا ناقمين عليه
كافة حتى أن هشامًا قال ( هل الحجاج استقر في جهنم أو يهوي إلى الآن ) ولما
وصل إلى هشام أن خالدًا القسري استخف بامرأة مؤمنة عزله من الإمارة وسجنه
كما ذكره ابن خلكان .
والحاصل أن المؤلف لو خص رجلاً أو رجلين من بني أمية بالمطاعن لاعترفنا
به ، ولكن من سوء مكيدة المؤلف أنه يجعل الفرد جماعة والفذ توءمًا
والنادر عامًا والشاذ مطردًا .
جور بني أمية
سمعنا بمظالم بختنصر ، وأحطنا علمًا بشنائع جنكيز خان ، واطلعنا على ما
جنته أيدي التتر ، فوالله - لو صدق المؤلف - هم ما كانوا أشد قسوة ولا أفظع
أعمالاً ولا أسفك دماء ولا أجمع لأنواع الفتك من بني أمية .
قال المؤلف ( حتى في أيام معاوية فإنه أرسل بسر بن أرطاة وأرسل معه
جيشًا ويقال : إنه ( أي معاوية ) أوصاهم أن يسيروا في الأرض ويقتلوا كل من
وجدوه من شيعة علي ولا يكفوا أيديهم عن النساء والصبيان ( الجزء الرابع صفحة
82 ) .
قبل أن أكشف عن جلية الأمر لا بد من تقديم مقدمة ، وهي أن المؤلف مدح
بني العباس وجعل أعمالهم مناطًا للعدل ودلالة على الرفق فقال :
( ولا غرابة فيما تقدم من عمران البلاد في ظل الدولة العباسية فإن العدالة توطد
دعائم الأمن ، وإذا أمن الناس على أرواحهم وحقوقهم تفرغوا للعمل فتعمر
البلاد ويرفه أهلها ويكثر خراجها ( الجزء الثاني صفحة 81 ) .
وعلى هذا إذا وجدنا بني أمية معادلين لنبي العباس في جميع أعمالهم سواء
بسواء كان اختصاصهم بالذم دون بني العباس جورًا فاحشًا وميلاً عظيمًا . ثم إن
هناك أمرًا آخر وهو أن المؤرخين بأسرهم كانوا في عصر بني العباس ومن المعلوم
أنه لم يكن يستطيع أحد أن يذكر محاسن بني أمية في دولة العباسيين ، فإذا صدر
من أحد شيء من ذلك فلتة كان يقاسي قائلها أنواعًا من الهتك والإيذاء ووخامة
العاقبة ، وكم لنا من أمثال هذه في أسفار التاريخ . ومع أننا نفخر بأن مؤلفي الإسلام
كانوا أصدق الناس رواية وأجرأهم على إظهار الحق ما كان يمنعهم عن بيان
الحقيقة سلطة ملك ولا مهابة جائر ، ولكن مع ذلك فرق بين تعمد الكذب والسكوت
عن الحق ، ولذلك نعتقد أنهم ما قالوا شيئًا افتراء على بني أمية ولكن إن قلنا :
إنهم كثيرًا ما سكتوا عن محاسنهم فذلك شيء لا يدفع وليس فيه غض منهم .
أما بنو العباس فكانوا في عصرهم ولاة البلاد ، وملاك رقاب الناس ، رضاهم
الحياة ، وسخطهم الموت ، فالوقيعة فيهم والأخذ عليهم ما كان يمكن إلا بعد
مخاطرة النفس والاقتحام في الهلاك ونصب النفس للموت .
رجعنا إلى قول المؤلف : إن معاوية أمر بقتل النساء والصبيان اعلم أن هذه
الواقعة أي إرسال ( بسر بن أرطاة ) إلى شيعة علي من أشهر الوقائع المذكورة في
سائر كتب التواريخ ، وليس في أحد منها قتل النساء والصبيان بل فيها ما يخالف
هذه الرواية قال المؤرخ اليعقوبي : ( ووجه معاوية بسر بن أرطاة وقيل : ابن أبي
أرطأة العامري من بني عامر بن لؤي في ثلاثة آلاف رجل فقال له : سر حتى تمر
بالمدينة فاطرد أهلهم وأَخِفْ من مررت بها وانهب مال من أصبت له مالاً ممن لم
يكن دخل في طاعتنا وأوهمْ أهل المدينة أنك تريد أنفسهم وأنه لا براءة لهم عندك...
حتى تدخل مكة ولا تعرض فيهما لأحد وأرهب الناس فيما بين مكة والمدينة ثم
امض حتى تأتي صنعاء فإن لنا بها شيعة وقد جاءني كتابهم . فخرج بسر فجعل لا
يمر بحي من أحياء العرب إلا فعل ما أمره معاوية ( اليعقوبي طبع أوربا صفحة
231 من الجزء الثاني ) .
فترى في هذه العبارة أنه لم يكن هناك إلا تخويف وتهديد وإيهام . ولما رأى
المؤلف أن المصادر التاريخية الموثوق بها لا يوجد فيها ما يوافق هواه جنح إلى
الأغاني ونقل أمر معاوية بقتل النساء والصبيان ثم اعتذر عن معاوية بأن المظنون
خلاف ذلك لحلمه ودهائه ، والظن أن معاوية أطلق يد بسر ولم يعين له حدودًا وكان
بسر سفاكًا للدماء فلم يستثن طفلاً ولا شيخًا .
قد قلنا : إن الأغاني من كتب المحاضرات ، فإذا كان الأمر هينًا والحديث
فكاهة أو تسللاً من كد العمل إلى استراحة فلا بأس به وبأمثاله أما إذا كان الأمر ذا
بال وكانت الواقعة معترك الاختلاف ومتعفر الأهواء رافعًا لشأن أو هادمًا لأساس
فأمثال هذه الكتب لا يؤذن لها ولا يلتفت إليها مطلقًا .
ثم إن الرجل ( أي صاحب الأغاني ) شيعي إذا جاءه شيء مما يشين معاوية
ويدنسه وجد في نفسه ارتياحًا إلى قبوله ، ولو كان من أوهن الأحاديث وأكذبها .
نعم إن بسر بن أرطاة قتل طفلين ولكن القتل لم يتجاوز الاثنين [1] فأين هذا
من قول المؤلف :
وكان بسر سفاكًا للدماء فلم يستثن طفلاً ولا شيخًا .
قال المؤلف ( فإذا كان هذا حال العمال في أيام معاوية مع حلمه وطول أناته
فكيف في أيام عبد الملك مع شدته وفتكه فهل يستغرب ما يقال عن فتك الحجاج
وكثرة من قتلهم صبرًا ، ولو كانوا 120000 ( الجزء الرابع صفحة 83 ) .
نعم قتل الحجاج مئة ألف أو مائتين ولكن أين هذا من صنيعة أبي مسلم
الخراساني القائم بدعوة بني العباس المؤسس لدولتهم فإنه قتل صبرًا بدون حرب ما
يبلغ ستمائة ألف ، وقد اعترف به المؤلف في هذا التأليف نفسه ( الجزء الثاني
صفحة 112 ) والمؤلف ينتحل لذلك عذرًا ويحسبه من طبيعة السياسة . فالحجاج
أحق بالعذر وأجدر بالعفو ، فإن الحجاج عربي قح طبعه الجفاء والقسوة . أما أبو
مسلم فعجمي تربى في حجر التمدن ، وغذي بلُبان الظرف ودَماثة الأخلاق (! !).
أما قوله إن عبد الملك كان أشد وطأة منه ( أي من الحجاج ) فلم يأت عليه
بشاهد غير غدره بعمر بن سعيد ، وأين هذا من غدر المنصور العباسي بأبي مسلم
الذي هو رب الدولة العباسية ، ولولاه لما قامت للعباسيين قائمة ، ولا كان لهم ذكر،
وكذلك غدر المنصور بابن هبيرة .
وغاية ما يقضي منه العجب أن المؤلف بعدما ذكر فتك بني أمية بقوله :( وقد
نفعتهم هذه السياسة ( أي سياسة الفتك ) في تأييد سلطانهم ( قال ) : صارت سُنَّة
من مَلَك بعدهم من بني العباس وغيرهم وأنت تعلم أن المؤلف يبرئ ساحة العباسية
من الجور والظلم فضلاً عن الفتك ، فهل هذا تناقض في القول أو أراد بهم نفعًا
فضرهم من حيث لا يعلم ؟ لا والله لا هذا ولا ذاك ، بل هي من مكايد المؤلف التي
لا يهتدي إليها إلا فطن خبير لطوية الرجل وكامن ضغنه .
((يتبع بمقال تالٍ))
__________
(1) اليعقوبي طبع أوروبا صفحة 311 من الجزء الثاني .
(2) الجزء الثاني من اليعقوبي صفحة 311 .
(3) الجزء الثاني صفحة 258 .
(4) المنار : في هذا النفي بل فيما أورده الناقد في هذه المسألة نظر فقد نقل الحافظ في الإصابة عن ابن يونس أن معاوية وجه بسرًا إلى اليمن و الحجاز سنة أربعين (وأمره أن ينظر من كان في طاعة علي فيوقع بهم ففعل) فهذا كلام المحدثين لا الشيعة وأهل المحاضرة ، وقد أشار في الإصابة إلى أنه لا ينبغي التشاغل بأخبار بسر الشهيرة في الفتن أي لما قيل من أن له صحبة وهل يعقل أن يكون إيقاعه بالمطيعين لعلي قاصرًا على قتله طفلي ابن عباس رضي الله عنهما ؟ ؟ .
(15/121
- ربيع الآخر - 1330هـ
أبريل - 1912م
أبريل - 1912م
الكاتب : شبلي النعماني
__________
نقد تاريخ التمدن الإسلامي
بقلم الشيخ شبلي النعماني
( 3 )
جور العمال
ذكر المؤلف تحت هذا العنوان أنواعًا من الجور والشدة الصادرة من عمال
بني أمية ونحن نذكر بعضًا منها مع كشف الحقيقة .
قال يذكر جور العمال : ( وإذا أتى أحدهم بالدراهم ليؤديها في خراجه يقتطع
الجابي منها طائفة ويقول : هذا رواجها وصرفها ) ( الجزء الثاني صفحة 22
واستند في الهامش إلى كتاب الخراج لأبي يوسف صفحة 62 ) .
أيها الفاضل المؤلف ! أليس لك وازع من نفسك ؟ أليس لك رادع من ديانتك ؟
أتجترئ على مثل هذا الكذب الظاهر ؟ والمين الفاحش جهرة ؟ فإن القاضي أبا
يوسف ما تكلم في شأن عمال بني أمية ببنت شفة وإنما ذكر عن عمال هارون
الرشيد وإساءتهم العمل في جباية الخراج وكتاب الخراج لأبي يوسف بين أيدينا وقد
طبع في مصر وتداولته الأيدي وتناقلته الألسن . قال المؤلف :
( وفي كلام القاضي أبي يوسف في عروض وصيته للرشيد بشأن عمال
الخراج ما يبين الطرق التي كان أولئك الصغار يجمعون الأموال بها قال: ) بلغني
أنه قد يكون في حاشية العامل أو الوالي جماعة منهم من له به حرمة ، ومنهم من له
إليه وسيلة ليسوا بأبرار ولا صالحين يستعين بهم ويوجههم في أعماله ، يقضي بذلك
الذمامات فليس يحفظون ما يُوكَلون بحفظه ولا ينصفون من يعاملونه إنما مذهبهم
أخذ شيء من الخراج كان أو من أموال الرعية ثم إنهم يأخذون ذلك كله فيما بلغني
بالعسف والظلم والتعدي… ويقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب
الشديد ويعلقون عليهم الجِرار ويقيدونهم بما يمنعهم عن الصلاة وهذا عظيم عند الله
شنيع في الإسلام ( الجزء الثاني صفحة 23 و24 مستندًا إلى كتاب الخراج صفحة
61 و62 ) .
الله أكبر ! هل سمع أحد بأعظم من هذا التدليس والتلبيس ؟ يشتكي القاضي
أبو يوسف من عمال هارون الرشيد ويرفع القضية إليه ويبين ما بلغه مما يرتكب
عماله في أخذ الأموال من الرعايا ، فيأخذ المؤلف أقواله وينقلها من حيث إنها هي
الطرق التي كان عمال بني أمية يجمعون الأموال بها ! ! ها هو كتاب الخراج
بأيدينا قرأناه وقلبناه ظهرًا لبطن وكررنا فيه النظر لا كرة ولا كرتين بل مرات
متوالية متتابعة فما وجدنا فيه كلمة في شأن عمال بني أمية وإنما قال ما قال أبو
يوسف يعظ الرشيد بما بلغه عن عماله إلى أن خاطبه بقوله :
( فلو تقربت إلى الله عز وجل يا أمير المؤمنين بالجلوس لمظالم رعيتك في
الشهر أو الشهرين مجلسًا واحدًا تسمع فيه من المظلوم وتنكر على الظالم رجوت أن
لا تكون ممن احتجب عن حوائج رعيته ولعلك لا تجلس إلا مجلسًا أو مجلسين حتى
يسير ذلك في الأمصار والمدن فيخاف الظالم وقوفك على ظلمه فلا يجترئ على
الظلم .. مع أنه متى علم العمال والولاة أنك تجلس للنظر في أمور الناس يومًا في
السنة ليس يومًا في الشهر تناهوا بإذن الله عن الظلم وأنصفوا من أنفسهم ( كتاب
الخراج صفحة 63 و64 ) .
لا فُضَّ فوك يا أبا يوسف ! فقد صدعت بالحق وأمرت بالمعروف واجترأت
على النهي عن المنكر وأخذت على ملك جبَّار كهارون الرشيد صاحب النكبة
بالبرامكة ، وما أكبر جرأتك أيها الفاضل ؟ ! ( جرجي زيدان ) إنك تتبعت سيرة
عمال بني أمية وبالغت في الإمعان وكابدت في ذلك محنة التقصي فأعوزك كل هذا
وما وجدت في أعمالهم شيئًا من مثل تلك الفظائع فعمدت إلى سيرة عمال الرشيد
وأوهمت الناظرين أنها سيرة عمال بني أمية !
قال المؤلف : ( وكان العمال لا يرون حرجًا في ابتزاز الأموال من أهل البلاد
التي فتحوها عَنوة لاعتقادهم أنها فيء لهم كما تقدم ( الجزء الرابع صفحة 75 ) .
الذي أشار إليه بقوله : ( تقدم ) هو قوله في الجزء الثاني وهذا نصه :
( وكان من جملة نتائج تعصب بني أمية للعرب واحتقارهم سائر الأمم
أنهم اعتبروا أهل البلاد التي فتحوها وما يملكون رزقًا حلالاً لهم - يدل على ذلك قول
سعيد بن العاص عامل العراق : ما السواد إلا بستان وقول عمرو بن
العاص لصاحب أخنا لما سأله عن مقدار ما عليهم من الجزية فقال عمرو : إنما أنتم
خزانة لنا إن كُثّر علينا كثَّرنا عليكم ، وإن خُفف عنا خففنا عنكم ( الجزء الثاني
صفحة 19 ) .
تشبث المؤلف بهذه الأقوال في غير موضع مستدلاًّ على أن العرب وبني أمية
كانوا يتصرفون في أموال الناس كيفما شاءوا ظنًّا منهم أن أموالهم وأعراضهم
أبيحت لهم مطلقًا .
حقيقة القول : أنه لما فتحت البلاد في خلافة الفاروق تقدم بعض الصحابة
كعبد الرحمن بن عوف و بلال وغيرهما وقالوا : إن الأرض مقسومة بيننا كما قسم
رسول الله خيبر وكان الفاروق رأى غير هذا فقام النزاع حتى وفق إلى الاستناد
بنص القرآن فسكتوا ورضوا والقصة مذكورة بتفاصيلها في كتاب الخراج للقاضي
أبي يوسف ، ثم إن بعض البلاد فتحت صلحًا فمتى كان الخراج أو الجزية شيئًا مسمًّى
معيّنًا ما كانوا يرون الزيادة عليه وإن أكثرت الأرض خيراتها وزادت غلاتها ,
وفتح بعضها عنوة فكان الخراج أو الجزية عليها بقدر النقص والزيادة وهذا هو قول
عمرو ( إن كثر علينا كثرنا عليكم وإن خفف عنا خففنا عنكم ) وقد أشار إلى ذلك
المقريزي في تاريخه والعلامة السيوطي في حسن المحاضرة . فأما قول سعيد بن
العاص الذي استند إليه المؤلف فتحريف للكلام عن موضعه على جاري عادته ، فإن
المؤلف نقل هذه الرواية من الأغاني والمذكور فيه ما حاصله : ( إن أحدًا مدح
السواد عند سعيد بن العاص وبالغ فيه فقال بعضهم : نعم ويا ليته كان لأميرنا ،
فقال بعض من حضر : لا نُعطِ أرضنا للأمير فقال الرجل : ولو شاء الأمير لأخذه ،
فأنكروا قوله فقال سعيد بن العاص : ( السواد بستان قريش إلخ ) فقال الرجل : لا !
إنه منايح رماحنا فأنت ترى أن النزاع بين الجند وأمير البلد هنا هو النزاع الذي
كان بين بعض الصحابة وعمر الفاروق وأي متشبَّث في ذلك للمؤلف ؟ فإن سعيد بن
العاص قال ما قال ردًّا على الجند بدعوى أن الأرض لا تقسم بين فاتحي البلاد بل
هي تحت يد الخليفة أو من ينوب عنه وإنما ذكر سعيد قريشًا ؛ لأن الخلافة على
زعمهم لقريش خاصة .
قال المؤلف : ( فكان الخلفاء يكتبون إلى عمالهم بجمع الأموال وحشدها
والعمال لا يبالون كيف يجمعونها فقد كتب معاوية إلى زياد ) اصطفِ لي الصفراء
والبيضاء ( فكتب زياد إلى عماله بذلك وأوصاهم أن يوافوه بالمال ولا يقسموا بين
المسلمين ذهبًا ولا فضة ) ( الجزء الرابع صفحة 75 وأحال الرواية في الهامش
على العقد الفريد صفحة 18 من المجلد الأول ) .
ننقل مآخذ هذه الرواية كما صرح به المؤلف في الهامش لترى خيانات
المؤلف واحدة بعد واحدة ، قال صاحب العقد :
( ونظير هذا القول ما رواه الأعمش عن الشعبي أن زيادًا كتب إلى الحكم بن
عمر الغِفَاري وكان على الطائفة أن أمير المؤمنين كتب إليّ أن أصطفي له الصفراء
والبيضاء فلا تقسم بين الناس ذهبًا ولا فضة فكتب إليه : ( إني وجدت كتاب الله
قبل كتاب أمير المؤمنين ) إلخ ما كتب ثم نادى في الناس فقسم لهم ما اجتمع من
الفيء ) ( العقد الفريد المجلد الأول صفحة 17 أو 18 ) .
فانظر ! ( أولاً ) : إنه ليس في هذه الرواية أن معاوية كتب إلى زياد بل إن
زيادًا كتب إلى الحكم أن أمير المؤمنين كتب إليّ إلخ ، ولعل زيادًا كذب في ذلك أو
فهم غير ما أراد معاوية بقوله .
( ثانيًا ) : إن المؤلف حذف كل ما قال الشعبي وما عمل به من تقسيم الفيء
لدلالته على أن في عمال بني أمية من لا يمنعه عن الصدع بالحق وأداء الواجب
أحد ، لا ولاة الأمصار ولا من فوقهم أي الخليفة نفسه .
( ثالثًا ) : إنه ليس في هذه العبارة ما يستدل به على استئثار معاوية بالمال
لنفسه فإن مراده أن العمال ليس لهم تقسيم الفيء بل الأمر موكول إلى الخليفة فعلى
العامل أن يجمع الأموال ويرسلها إلى الخليفة وللخليفة أن يضعها موضعها .
قال المؤلف : ( فكان العمال يبذلون الجهد في جمع الأموال بأية وسيلة كانت
ومصادرها الجزية والخَرَاج والزكاة والصدقة والعُشور . وأهمها في أول الإسلام
الجزية لكثرة أهل الذمة فكان عمال بني أمية يشددون في تحصيلها فأخذ أهل الذمة
يدخلون في الإسلام فلم يكن ذلك لينجيهم منها ؛ لأن العمال عدوا إسلامهم حيلة
للفرار من الجزية وليس رغبة في الإسلام فطالبوهم بالجزية بعد إسلامهم . وأول
من فعل ذلك الحجاج بن يوسف واقتدى به غيره من عمال بني أمية في إفريقية
و خراسان و ما وراء النهر فارتد الناس عن الإسلام وهم يودون البقاء فيه وخصوصًا
أهل خراسان وما وراء النهر فإنهم ظلوا إلى أواخر أيام بني أمية لا يمنعهم عن
الإسلام إلا ظلم العمال بطلب الجزية منهم بعد إسلامهم ) ( الجزء الرابع صفحة
16 ) .
ذكر المؤلف هذه الواقعة ، أي أَخْذ الجزية بعد الإسلام ، في غير موضع
بعبارات متنوعة ، قوية الأخذ بالنفس ، شديدة الوطأة على القلب ، يتراءى للناظر
فيها أن الناس أحيطوا من كل جانب جورًا وعدوانًا ، فإذا بقوا على الكفر يعانون من
الشدة ما يلجئهم إلى الإسلام ، وإذا أسلموا فالجزية باقية على حالها ، لا يخفف عنهم
العذاب ولا هم ينصرون .
***
تحقيق مسألة الجزية في الإسلام
1- اعلم أن الجزية ليست إلا بدلاً عسكريًّا فمن يذب عن بيضة الملك بنفسه
فهو غير مأخوذ بها أما من ضن بالنفس أو كان لا يصلح لذلك فعليه أن يؤدي شيئًا
من المال ليكون عُدة للعسكر وعونًا له . وأول من سن الجزية وجعل لها وضائع
كسرى أنو شروان كما ذكره ابن الأثير وصرح بأنها هي الوضائع التي اقتدى بها
عمر بن الخطاب ، وكم تجد في البلاذري و الطبري وغيرهما أن أقوامًا من
النصارى في عصر عمر بن الخطاب لما قاموا بالدفاع عن الملك أو دخلوا في الجند
سقطت عنهم الجزية وأعفى عمر بن الخطاب نصارى تغلب من الجزية ، وأضعف
عليها الصدقة . وجملة القول أن الجزية لم تكن في الأصل شيئًا يحد بين الكفر
والإسلام ولكن لما كان غالب الحال أن أهل البلاد من النصارى والمجوس واليهود
كانوا أصحاب حرث وزرع وعمالاً في الديوان وكانوا لا يرضون بمخاطرة النفس
واقتحام الحرب لذلك كانوا مطالبين بالجزية والمسلم لا يمكن له الاعتزال عن
الحرب فإنه مضطر إلى الذب عن بلاد الإسلام طائعًا أو مكرهًا - صارت الجزية
كأنها حد فاصل بين الرئيس والمرءوس ثم بين المسلم وغير المسلم .
2- ولما لم ينفصل الأمر بتةً وبقي للاجتهاد موضع ومتسع كان بعض العمال
يضرب الجزية على حديثي العهد بالإسلام .
3- ولكن مع هذا لم يتفق ذلك في مدة الخلافة الأموية إلا مرات معدودات
يشهد بذلك الفحص والتقصي وإمرار النظر والكد في البحث والتنقيب ومع ذلك
فكلما وقع مثل هذا لم يكن له بقاء فإما أن تكون الأمة هي التي تقيم النكير على
العامل أو يصل الخبر إلى الخليفة فيرد عمله ويمنعه عن الوقوع في مثله آتيًا ففي
سنة 101 لما كتب الحجاج إلى البصرة برد من أسلم من أهل القرى إلى مساكنهم
وضرب الجزية عليهم ضج القراء وخرجوا يبكون مع البكاة من أهل القرى وبايعوا
عبد الرحمن بن الأشعث مشمئزين من عمل الحَجَّاج منكرين عليه كما هو مشروح
في تاريخ الكامل لابن الأثير وكذلك لما اقتدى الجراح الحكمي بصنيع الحجاج كتب
إليه عمر بن عبد العزيز يأمره بإسقاط الجزية ، والواقعة مذكورة في حوادث سنة
100 في تاريخ الكامل ، وكذلك لما فعل يزيد بن أبي مسلم في إفريقية سنة
102 هجرية ألّب الناس عليه وقتلوه وكتبوا إلى الخليفة يزيد بن عبد الملك فكتب
إليهم إني ما كنت مستحسنًا عمل يزيد والقصة مذكورة في الكامل تحت حوادث سنة
102 وكان آخر ما وقع من مثل ذلك ما فعل الأشرس في خراسان فأورث ثورة
واشترك العرب مع الثائرين ونصروهم ، أما خلفاء بني أمية فلم يثبت عن أحد منهم
مثل ذلك وإنما كان أراد عبد الملك وضع الجزية على من أسلم من أهل الذمة
فكلمه ابن حُجْرة فترك . والقصة مذكورة في المَقْريزي بنوع من التفصيل ( انظر
صفحة 28 من الجزء الأول ) .
والآن نقص عليك بعض خيانات المؤلف :
1- ذكر واقعة الحجاج وترك نكير القراء عليه وبيعتهم على يد ابن الأشعث
إنكارًا على صنيع الحجاج .
2- ذكر واقعة الجراح ( الجزء الثاني صفحة 20 ) وترك إنكار عمر بن عبد
العزيز عليه ومنعه عن ضرب الجزية عليهم .
3- ذكر واقعة يزيد بن أبي مسلم وترك أن الناس قتلوه وأن الخليفة يزيد بن
عبد الملك استصوب صنيعهم أي قتلهم يزيد بن أبي مسلم .
4- ذكر واقعة الأشرس ولم يذكر أن العرب قاموا عليه وكانوا مع الثائرين
عليه ولما ثبت أن ضرب الجزية على حديثي العهد بالإسلام لم يأمر به أحد من
خلفاء بني أمية وإنما كان اجتهادًا من بعض العمال بناء على أن إسقاط الجزية
يورث نقصًا في الخراج وأن الخلفاء كلما عثروا على ذلك منعوا العمال عن ضرب
الجزية وردوا عملهم وأنه كلما وقع مثل ذلك تألب العلماء والخيار من الناس وأقاموا
النكير على ضارب الجزية حتى قتلوا بعض العمال واستحسن الخليفة قتله ، فهل
للمؤلف أن يحل أوزار بعض العمال على بني أمية كافة ؟ وهل يصح قوله ؟
( ولم يكن عمال بني أمية يأتون هذه الأعمال من عند أنفسهم دائمًا بل كثيرًا
ما كانوا يفعلونها بأمر خلفائهم كما قد رأيت مما كتبه معاوية إلى وردان ) ( الجزء
الثاني صفحة 22 ) .
أما كتاب معاوية إلى وردان فقد مر ذكره وليس فيه للمؤلف موضع حجة .
قال المؤلف ( ورأى هؤلاء ) أي أهل الذمة ( أن اعتناق الإسلام لا ينجيهم من
ذلك فعمد بعضهم إلى التلبس بثوب الرهبنة ؛ لأن الرهبان لا جزية عليهم . فأدرك
العمال غرضهم من ذلك فوضعوا الجزية على الرهبان . وأول من فعل ذلك منهم
عبد العزيز بن مروان عامل مصر فأمر بإحصاء الرُّهبان وفرض على كل راهب
دينارًا ) ( الجزء الثاني صفحة 20 مستندًا إلى المقريزي صفحة 392 من الجزء
الثاني ) .
أيها الفاضل المؤلف ! ما هذا الاجتراء ؟ ما هذا الاختلاق ؟ ما هذا الكذب
الظاهر ؟
هاك نص المقريزي ( ثم قدم اليعاقبة في سنة إحدى وثمانين الإسكندروس فقام
أربعًا وعشرين سنة ونصفًا وقيل : خمسًا وعشرين سنة ومات سنة ست ومئة
ومرت به شدائد صودر فيها مرتين أخذ منه فيهما ستة آلاف دينار وفي أيامه أمر
عبد العزيز بن مروان فأمر بإحصاء الرهبان فأحصوا وأخذت منهم الجزية على كل
راهب دينار وهي أول جزية أُخذت من الرهبان ، ( الجزء الثاني من المقريزي
صفحة 393 أو 394 ) .
فهل تجد في هذه العبارة أدنى إشارة إلى أن عبد العزيز أو أحدًا غيره شدّد في
الجزية فاختاروا الرهبنة طلبًا للنجاة من الجزية فما نفعهم ؟ لا وإنما فيها أن عبد
العزيز بن مروان وضع الجزية على الرهبان وهذا ليس فيه كبير شيء فإن الرهبان
وإن كانوا معافون من الجزية ولكن لما لم يكن الأمر منصوصًا لا في الكتاب ولا في
السنة كان للاجتهاد فيه مساغ فاجتهد عبد العزيز وأخطأ .
***
إنهاء هذا البحث
لو سردنا كل ما قال المؤلف عن جور بني أمية وعمالهم واستئثارهم بالأموال
وإسرافهم في استلابها وبينا ما في كل قول من التحريف والتدليس وتغيير المعنى
والخيانة في النقل وصرف العبارة عن وجهها لطال الكلام واحتجنا إلى عمل كتاب
منفرد بنفسه ؛ فلأجل ذلك اقتصرنا على كشف بعض دسائسه مع أنه قلّ من كل
وغَيْض من فيض[1] .
ونقول بعد كل ذلك : إن موضوع الكتاب ليس إلا بيان تمدن الإسلام فأي
متعلق في ذلك لإبداء مساوئ بني أمية ؟ ولعلك تقول : لا بد في تاريخ تمدن الإسلام
من بيان منهج السياسة وأنها هل كانت مؤسسة على الاستبداد والجور أو العدل
والنصفة فجرّ ذلك إلى كشف عوار بني أمية عرضًا . ولكن أناشدك بالله أما كان
لأحد منهم مأثرة تذكر ، ومَنْقبة تنقل ، وسياسة تنفع البلاد ، ومعدلة تعم الناس ؟ ؟
نعم إن بني أمية لا يوزنون بالخلفاء الراشدين وليس هذا عارًا عليهم ولا فيه حط
لمنزلتهم فإن إدراك شأو الراشدين واللحوق بهم أمر خارج عن طوق البشر ، وليس
فيه مطمع لأحد ، ولا موضع رجاء لمجتهد ، ولكن التوازن والتكايل بين الأموية
والعباسية وإنما هم ملوك فيهم المحسن والمسيء ، والعادل والجائر ، والناسك
والخليع ، والحازم والمغفل ، بل الذي أعدلهم سيرة وأمثلهم طريقة وأوفاهم ذممًا
وأرضاهم طورًا لا يخلو من عثرات لا تقال وهنات لا تذكر - فلو لزم المؤلف جادة
الإنصاف ووفى لكل أحد قسطه وأعطى كل ذي حق حقه لاستراح واسترحنا ولكنه
مال إلى واحد فأطرى في مدحه ، ونال من الآخر فأسرف في تهجينه وذمه ، ثم إنه
لم يفارق في مدحه وذمه عمود الكتاب أي ذم العرب والحط من شأنهم فإنه ذم بني
أمية ؛ لأنهم العرب بحتة ومدح العباسيين لا لأنهم العرب أو أنهم من سلالة هاشم أو
من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم ؛ بل لأن دولتهم دولة أعجمية وقد مر نصه
في ذلك سابقًا .
وحان لنا أن نذكر طرفًا من مآثر بني أمية وسيرتهم ومبلغهم من حسن السياسة
وتعمير البلاد وتمهيد السبل وتوطيد الأمن وإقامة المرافق وتعميم المعارف .
اعلم أن دولة بني أمية عبارة عن معاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان
و الوليد و سليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، و هشام فأما ما عداهم فلم تطل مدتهم
وليس العبرة بهم إن أحسنوا أو أساءوا .
***
سيرة معاوية في دولته
فأما معاوية فنذكر من سيرته ما ذكره المؤرخ المسعودي في مُروجه مع نوع
من الاختصار قال :
( كان من أخلاق معاوية أنه كان يؤذن في اليوم والليلة خمس مرات ، كان
إذا صلى الفجر جلس للقصَّاص حتى يفرغ من قصصه فيخرج إلى المسجد فيسند
ظهره إلى المقصورة ويجلس على الكرسي ويقوم الأحداث فيتقدم إليه الضعيف
والأعرابي والصبي والمرأة ومن لا أحد له فيقول : ظلمت ، فيقول : أعزّوه ،
ويقول : عُدي إليَّ ، فيقول : ابعثوا معه ، ويقول : صنع بي ، فيقول : انظروا في
أمره ، حتى إذا لم يبق أحد دخل فجلس على السرير ثم يقول : ائذنوا للناس على
قدر منازلهم فإذا استووا جلوسًا قال : يا هؤلاء إنما سميتم أشرافًا لأنكم شرفتم من
دونكم بهذا المجلس ، ارفعوا إلينا حوائج من لا يصل إلينا ، فيقوم الرجل فيقول :
شهد فلان ، فيقول : افرضوا له ، ويقول آخر : غاب فلان عن أهله ، فيقول :
تعاهدوهم واقضوا حوائجهم ، ثم يؤتى بالغداء والكاتب يقرأ كتابه فيأمر فيه حتى
يأتي على أصحاب الحوائج كلهم وربما قدم إليه من أصحاب الحوائج أربعون أو
نحوهم على قدر الغداء .
وأطال المسعودي في بيان أعمال معاوية يوميًّا ، ثم قال بعد حكاية معترضة :
( فلنرجع الآن إلى أخبار معاوية وسياسته وما وسع الناس من أخلاقه وما أفاض
عليهم من بره وعطائه وشملهم من إحسانه مما اجتذب به القلوب واستدعى به
النفوس حتى آثروه على الأهل والقرابات ) ثم ذكر بعد ذلك عدة وقائع تركناها هربًا
من الإطناب .
***
سيرة عبد الملك بن مروان في دولته
وأما عبد الملك فقال المدايني ( كان يقال : معاوية أحلم ، وعبد الملك أحزم ،
وهو الذي جعل على بيوت الأموال والخزائن رجاء بن حَيْوة ذلك المحدث المشهور
وعلى كتابة الخراج والجند سرحون بن منصور الرومي ) وهو نصراني ( وحول
الدواوين من الرومية والفارسية إلى العربية وزاد على ما مكان فرض معاوية
للموالي خمسة فبلغها عشرين ودخل في بيعته عبد الله بن عمر ومحمد بن الحنفية )
ذكر كل ذلك صاحب العقد في ترجمته ، وقد سبق من نسكه وعبادته ما فيه كفاية
فيما مر .
ومما ينقم عليه تأميره الحجاج ولكن الدولة تحتاج في إبّانها وأول نشأتها إلى
أمثال ذلك وهذا أبو مسلم الخراساني مؤسس الدولة العباسية قتل ستمائة ألف رجل
صبرًا وهذا أبو جعفر المنصور فعل بالهاشميين ما لم يسبق له نظير في الإسلام
ومع ذلك فإني أعوذ بالله أن أقوم ذابًّا عن الحجاج ومدافعًا عنه .
***
سيرة الوليد في دولته
وأما الوليد فكان أهل الشام يفتخرون به وحق لهم ذلك قال صاحب العقد الفريد :
( كان الوليد عند أهل الشام أفضل خلفائهم وأكثرهم فتوحًا ، وأعظمهم نفقة في
سبيل الله ، بنى مسجد دمشق ومسجد المدينة ووضع المنابر وأعطى المجذومين
حتى أغناهم عن سؤال الناس وأعطى كل مقعد خادمًا وكل ضريرًا قائدًا ، وكان يمر
بالبقال فيتناول قبضة فيقول : بكم هذه ؟ فيقول بفلس فيقول : زد فيها فإنك تربح )
وهو الذي وسع مسجد النبي وذهَّب البيت .
قال اليعقوبي : ( إن الوليد بعث إلى ملك الروم يعلمه أنه قد هدم مسجد رسول
الله فليعنه فيه فبعث إليه بمائة ألف مثقال ذهبًا ومائة فاعل وأربعين جملاً فسيفساء ،
وبعث الوليد إلى خالد بن عبد الله القَسْري وهو على مكة بثلاثين ألف دينار
فضربت صفائح وجعلت على باب الكعبة ، فكان أول من ذهَّب البيت في الإسلام
وحج الوليد سنة 91 لينظر إلى البيت وإلى المسجد وما أصلح منه وإلى البيت
وتذهيبه ) .
وقال اليعقوبي : ( كان أول من عمل البيمارستان للمرضى ودار الضيافة ،
وأول من أجرى على العميان والمساكين والمجذومين الأرزاق ) .
وقال السيوطي في تاريخه للخلفاء : ( وكان مع ذلك ) أي كونه جبارًا ظلومًا
( يختن الأيتام ويرتب لهم المؤدّين ) .
***
فتوحات بني أمية
ثم إن الدول تعرف أقدارها بآثارها ويقضى بفضلها بعملها وأخلد الآثار التي
تتفاضل بها مقادير الملوك وتتطاول بها رتب الدول كثرة الفتوح واستتباب أمور
الملك والرعية وتوطد دعائم العدل وانتشار العلم ودولة بني أمية قد أخذت من كل
ذلك قسطًا وضربت في كل ذلك بسهم .
أما كثرة الفتوح فقد بلغت دولتهم منها غاية ليس وراءها مطلع لطامح .
انقضت أيام الخلافة الراشدة والإسلام يزخر عُبابه في جزيرة العرب وديار الشام
ومصر وبلاد الفرس فلما تسنَّم بنو أمية عرش الخلافة ازداد الإسلام فتوحًا ،
واتسعت ممالكه وغلب سلطانه ، وامتدت سطوته ، ودخلت البلاد النائية المترامية
الأكناف في حوزة حكمه ، فملكوا ما لم يملكه أحد من ملوك الإسلام قبلهم ولا بعدهم .
فتحوا طرابلس وطَنْجة وسائر بلاد المغرب والأندلس وبلاد الديلم ، والأتراك
والمغول والسند وقبرص وأقريطش ( كريد ) ورودس وغيرها من جزائر البحر .
وغزوا صقلية وصالحوا النوبة وتوغلوا في بلاد الروم حتى بلغوا سور
القسطنطينية وضربوا السيف على أبوابها ، وافتتح السند محمد الثقفي أحد أبناء
قوادهم وهو ابن سبع عشرة سنة ، وقد وطئت جيوشهم ثغور الصين وثغور بلاد
الإفرنج وعاصمة بلاد الروم ، وحدود بلاد الهند ، وملكوا من السند إلى ثغور بلاد
الإفرنج طولاً ومن البحر الأحمر إلى بلاد الخزر عرضًا ، ودخل في حوزة ملكهم
العرب وديار الشام والعراق والجزيرة ومصر والبجة وبرقة وطرابلس وتونس
ومراكش والأندلس وأرمينية وخراسان وفارس وتوران والديلم وبلاد الران
وطبرستان وجرجان وسجستان وخوارزم وما وراء النهر وبلاد الخزر وأفغانستان
والسند وبعض بلاد الهند . فمن يدانيهم من الملوك في سعة الملك ؟ ومن يباريهم في
كثرة الفتوح ؟
***
استتباب أمور الملك والرعية
ليس في سعة الملك كبير فضل إذا لم يكن هناك تأنق في أمور المملكة ،
ونظر في أمور الرعية ، وقيام بمصالح العباد ، وتشمير في عمارة البلاد ، ولذلك
كان الذين فتحوا البلاد ولم ينظروا في أمور أهلها ليسوا عند ذوي الخبرة من أهل
التاريخ أسمى منزلة وأعلى مكانة من قطاع الطريق الذين يعيثون في الأرض
مفسدين . أما ملوك بني أمية فقد جمعوا بين بيعة الملك والنظر في أمور العباد ،
وكثرة الفتوح وعمارة البلاد ، حفروا الأنهار ، وعمروا الطرق ، وشادوا المصانع ،
وابتنوا المساجد ، وبذلوا الأموال ، وقضوا الحوائج ، وكشفوا المظالم ، وغمروا
المجذومين والعميان والمقعدين والصعاليك بالجزيل من الإحسان ، وأجروا لهم
الأرزاق . ثم رتبوا المصالح ودونوا الدواوين وحصنوا الحصون وبنوا المدن
والقصور وقد مر من ذلك شيء كثير فيما تقدم من سيرهم وأعمالهم وإليك هذه
العجالة التي هي كالطل من الوابل .
( يتلى )
((يتبع بمقال تالٍ))
__________
(1) ومما يناسب ذكره في هذا المقام أن المؤلف لما أنجز الجزء الأول من كتابه أرسله إلىّ فكتبت إليه بعد الإعجاب به : إنه لا بد من ذكر مصادر الروايات في كل موضع ؛ وذلك لأجل أني كنت أخاف عليه التدليس ، فأظهر المؤلف في مقدمة الجزء الثاني أنه عمل بذلك ، ويذكر الكتاب والجزء والصفحة ولكن من الأسف أن كل هذا ما أجدى نفعًا فإنه ما يذكر المطبعة ؛ ولأجل هذا كابدت في تطبيق مصادر كتابه محنة عظيمة فإن النسخ مختلفة ولا يُدرى أي نسخة أرادها وبسبب ذلك ما اهتدينا إلى أكثر خياناتها ومن المحقق المتيقن به أنه ما نقل عبارة إلا وعمل فيها شيئًا من التحريف والتغيير ومن كان في ريب من ذلك فليراجع الأصول ويكابد محنة التطبيق ليؤمن بما قلته مع حيرة واندهاش - 12 .
__________
نقد تاريخ التمدن الإسلامي
بقلم الشيخ شبلي النعماني
( 3 )
جور العمال
ذكر المؤلف تحت هذا العنوان أنواعًا من الجور والشدة الصادرة من عمال
بني أمية ونحن نذكر بعضًا منها مع كشف الحقيقة .
قال يذكر جور العمال : ( وإذا أتى أحدهم بالدراهم ليؤديها في خراجه يقتطع
الجابي منها طائفة ويقول : هذا رواجها وصرفها ) ( الجزء الثاني صفحة 22
واستند في الهامش إلى كتاب الخراج لأبي يوسف صفحة 62 ) .
أيها الفاضل المؤلف ! أليس لك وازع من نفسك ؟ أليس لك رادع من ديانتك ؟
أتجترئ على مثل هذا الكذب الظاهر ؟ والمين الفاحش جهرة ؟ فإن القاضي أبا
يوسف ما تكلم في شأن عمال بني أمية ببنت شفة وإنما ذكر عن عمال هارون
الرشيد وإساءتهم العمل في جباية الخراج وكتاب الخراج لأبي يوسف بين أيدينا وقد
طبع في مصر وتداولته الأيدي وتناقلته الألسن . قال المؤلف :
( وفي كلام القاضي أبي يوسف في عروض وصيته للرشيد بشأن عمال
الخراج ما يبين الطرق التي كان أولئك الصغار يجمعون الأموال بها قال: ) بلغني
أنه قد يكون في حاشية العامل أو الوالي جماعة منهم من له به حرمة ، ومنهم من له
إليه وسيلة ليسوا بأبرار ولا صالحين يستعين بهم ويوجههم في أعماله ، يقضي بذلك
الذمامات فليس يحفظون ما يُوكَلون بحفظه ولا ينصفون من يعاملونه إنما مذهبهم
أخذ شيء من الخراج كان أو من أموال الرعية ثم إنهم يأخذون ذلك كله فيما بلغني
بالعسف والظلم والتعدي… ويقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب
الشديد ويعلقون عليهم الجِرار ويقيدونهم بما يمنعهم عن الصلاة وهذا عظيم عند الله
شنيع في الإسلام ( الجزء الثاني صفحة 23 و24 مستندًا إلى كتاب الخراج صفحة
61 و62 ) .
الله أكبر ! هل سمع أحد بأعظم من هذا التدليس والتلبيس ؟ يشتكي القاضي
أبو يوسف من عمال هارون الرشيد ويرفع القضية إليه ويبين ما بلغه مما يرتكب
عماله في أخذ الأموال من الرعايا ، فيأخذ المؤلف أقواله وينقلها من حيث إنها هي
الطرق التي كان عمال بني أمية يجمعون الأموال بها ! ! ها هو كتاب الخراج
بأيدينا قرأناه وقلبناه ظهرًا لبطن وكررنا فيه النظر لا كرة ولا كرتين بل مرات
متوالية متتابعة فما وجدنا فيه كلمة في شأن عمال بني أمية وإنما قال ما قال أبو
يوسف يعظ الرشيد بما بلغه عن عماله إلى أن خاطبه بقوله :
( فلو تقربت إلى الله عز وجل يا أمير المؤمنين بالجلوس لمظالم رعيتك في
الشهر أو الشهرين مجلسًا واحدًا تسمع فيه من المظلوم وتنكر على الظالم رجوت أن
لا تكون ممن احتجب عن حوائج رعيته ولعلك لا تجلس إلا مجلسًا أو مجلسين حتى
يسير ذلك في الأمصار والمدن فيخاف الظالم وقوفك على ظلمه فلا يجترئ على
الظلم .. مع أنه متى علم العمال والولاة أنك تجلس للنظر في أمور الناس يومًا في
السنة ليس يومًا في الشهر تناهوا بإذن الله عن الظلم وأنصفوا من أنفسهم ( كتاب
الخراج صفحة 63 و64 ) .
لا فُضَّ فوك يا أبا يوسف ! فقد صدعت بالحق وأمرت بالمعروف واجترأت
على النهي عن المنكر وأخذت على ملك جبَّار كهارون الرشيد صاحب النكبة
بالبرامكة ، وما أكبر جرأتك أيها الفاضل ؟ ! ( جرجي زيدان ) إنك تتبعت سيرة
عمال بني أمية وبالغت في الإمعان وكابدت في ذلك محنة التقصي فأعوزك كل هذا
وما وجدت في أعمالهم شيئًا من مثل تلك الفظائع فعمدت إلى سيرة عمال الرشيد
وأوهمت الناظرين أنها سيرة عمال بني أمية !
قال المؤلف : ( وكان العمال لا يرون حرجًا في ابتزاز الأموال من أهل البلاد
التي فتحوها عَنوة لاعتقادهم أنها فيء لهم كما تقدم ( الجزء الرابع صفحة 75 ) .
الذي أشار إليه بقوله : ( تقدم ) هو قوله في الجزء الثاني وهذا نصه :
( وكان من جملة نتائج تعصب بني أمية للعرب واحتقارهم سائر الأمم
أنهم اعتبروا أهل البلاد التي فتحوها وما يملكون رزقًا حلالاً لهم - يدل على ذلك قول
سعيد بن العاص عامل العراق : ما السواد إلا بستان وقول عمرو بن
العاص لصاحب أخنا لما سأله عن مقدار ما عليهم من الجزية فقال عمرو : إنما أنتم
خزانة لنا إن كُثّر علينا كثَّرنا عليكم ، وإن خُفف عنا خففنا عنكم ( الجزء الثاني
صفحة 19 ) .
تشبث المؤلف بهذه الأقوال في غير موضع مستدلاًّ على أن العرب وبني أمية
كانوا يتصرفون في أموال الناس كيفما شاءوا ظنًّا منهم أن أموالهم وأعراضهم
أبيحت لهم مطلقًا .
حقيقة القول : أنه لما فتحت البلاد في خلافة الفاروق تقدم بعض الصحابة
كعبد الرحمن بن عوف و بلال وغيرهما وقالوا : إن الأرض مقسومة بيننا كما قسم
رسول الله خيبر وكان الفاروق رأى غير هذا فقام النزاع حتى وفق إلى الاستناد
بنص القرآن فسكتوا ورضوا والقصة مذكورة بتفاصيلها في كتاب الخراج للقاضي
أبي يوسف ، ثم إن بعض البلاد فتحت صلحًا فمتى كان الخراج أو الجزية شيئًا مسمًّى
معيّنًا ما كانوا يرون الزيادة عليه وإن أكثرت الأرض خيراتها وزادت غلاتها ,
وفتح بعضها عنوة فكان الخراج أو الجزية عليها بقدر النقص والزيادة وهذا هو قول
عمرو ( إن كثر علينا كثرنا عليكم وإن خفف عنا خففنا عنكم ) وقد أشار إلى ذلك
المقريزي في تاريخه والعلامة السيوطي في حسن المحاضرة . فأما قول سعيد بن
العاص الذي استند إليه المؤلف فتحريف للكلام عن موضعه على جاري عادته ، فإن
المؤلف نقل هذه الرواية من الأغاني والمذكور فيه ما حاصله : ( إن أحدًا مدح
السواد عند سعيد بن العاص وبالغ فيه فقال بعضهم : نعم ويا ليته كان لأميرنا ،
فقال بعض من حضر : لا نُعطِ أرضنا للأمير فقال الرجل : ولو شاء الأمير لأخذه ،
فأنكروا قوله فقال سعيد بن العاص : ( السواد بستان قريش إلخ ) فقال الرجل : لا !
إنه منايح رماحنا فأنت ترى أن النزاع بين الجند وأمير البلد هنا هو النزاع الذي
كان بين بعض الصحابة وعمر الفاروق وأي متشبَّث في ذلك للمؤلف ؟ فإن سعيد بن
العاص قال ما قال ردًّا على الجند بدعوى أن الأرض لا تقسم بين فاتحي البلاد بل
هي تحت يد الخليفة أو من ينوب عنه وإنما ذكر سعيد قريشًا ؛ لأن الخلافة على
زعمهم لقريش خاصة .
قال المؤلف : ( فكان الخلفاء يكتبون إلى عمالهم بجمع الأموال وحشدها
والعمال لا يبالون كيف يجمعونها فقد كتب معاوية إلى زياد ) اصطفِ لي الصفراء
والبيضاء ( فكتب زياد إلى عماله بذلك وأوصاهم أن يوافوه بالمال ولا يقسموا بين
المسلمين ذهبًا ولا فضة ) ( الجزء الرابع صفحة 75 وأحال الرواية في الهامش
على العقد الفريد صفحة 18 من المجلد الأول ) .
ننقل مآخذ هذه الرواية كما صرح به المؤلف في الهامش لترى خيانات
المؤلف واحدة بعد واحدة ، قال صاحب العقد :
( ونظير هذا القول ما رواه الأعمش عن الشعبي أن زيادًا كتب إلى الحكم بن
عمر الغِفَاري وكان على الطائفة أن أمير المؤمنين كتب إليّ أن أصطفي له الصفراء
والبيضاء فلا تقسم بين الناس ذهبًا ولا فضة فكتب إليه : ( إني وجدت كتاب الله
قبل كتاب أمير المؤمنين ) إلخ ما كتب ثم نادى في الناس فقسم لهم ما اجتمع من
الفيء ) ( العقد الفريد المجلد الأول صفحة 17 أو 18 ) .
فانظر ! ( أولاً ) : إنه ليس في هذه الرواية أن معاوية كتب إلى زياد بل إن
زيادًا كتب إلى الحكم أن أمير المؤمنين كتب إليّ إلخ ، ولعل زيادًا كذب في ذلك أو
فهم غير ما أراد معاوية بقوله .
( ثانيًا ) : إن المؤلف حذف كل ما قال الشعبي وما عمل به من تقسيم الفيء
لدلالته على أن في عمال بني أمية من لا يمنعه عن الصدع بالحق وأداء الواجب
أحد ، لا ولاة الأمصار ولا من فوقهم أي الخليفة نفسه .
( ثالثًا ) : إنه ليس في هذه العبارة ما يستدل به على استئثار معاوية بالمال
لنفسه فإن مراده أن العمال ليس لهم تقسيم الفيء بل الأمر موكول إلى الخليفة فعلى
العامل أن يجمع الأموال ويرسلها إلى الخليفة وللخليفة أن يضعها موضعها .
قال المؤلف : ( فكان العمال يبذلون الجهد في جمع الأموال بأية وسيلة كانت
ومصادرها الجزية والخَرَاج والزكاة والصدقة والعُشور . وأهمها في أول الإسلام
الجزية لكثرة أهل الذمة فكان عمال بني أمية يشددون في تحصيلها فأخذ أهل الذمة
يدخلون في الإسلام فلم يكن ذلك لينجيهم منها ؛ لأن العمال عدوا إسلامهم حيلة
للفرار من الجزية وليس رغبة في الإسلام فطالبوهم بالجزية بعد إسلامهم . وأول
من فعل ذلك الحجاج بن يوسف واقتدى به غيره من عمال بني أمية في إفريقية
و خراسان و ما وراء النهر فارتد الناس عن الإسلام وهم يودون البقاء فيه وخصوصًا
أهل خراسان وما وراء النهر فإنهم ظلوا إلى أواخر أيام بني أمية لا يمنعهم عن
الإسلام إلا ظلم العمال بطلب الجزية منهم بعد إسلامهم ) ( الجزء الرابع صفحة
16 ) .
ذكر المؤلف هذه الواقعة ، أي أَخْذ الجزية بعد الإسلام ، في غير موضع
بعبارات متنوعة ، قوية الأخذ بالنفس ، شديدة الوطأة على القلب ، يتراءى للناظر
فيها أن الناس أحيطوا من كل جانب جورًا وعدوانًا ، فإذا بقوا على الكفر يعانون من
الشدة ما يلجئهم إلى الإسلام ، وإذا أسلموا فالجزية باقية على حالها ، لا يخفف عنهم
العذاب ولا هم ينصرون .
***
تحقيق مسألة الجزية في الإسلام
1- اعلم أن الجزية ليست إلا بدلاً عسكريًّا فمن يذب عن بيضة الملك بنفسه
فهو غير مأخوذ بها أما من ضن بالنفس أو كان لا يصلح لذلك فعليه أن يؤدي شيئًا
من المال ليكون عُدة للعسكر وعونًا له . وأول من سن الجزية وجعل لها وضائع
كسرى أنو شروان كما ذكره ابن الأثير وصرح بأنها هي الوضائع التي اقتدى بها
عمر بن الخطاب ، وكم تجد في البلاذري و الطبري وغيرهما أن أقوامًا من
النصارى في عصر عمر بن الخطاب لما قاموا بالدفاع عن الملك أو دخلوا في الجند
سقطت عنهم الجزية وأعفى عمر بن الخطاب نصارى تغلب من الجزية ، وأضعف
عليها الصدقة . وجملة القول أن الجزية لم تكن في الأصل شيئًا يحد بين الكفر
والإسلام ولكن لما كان غالب الحال أن أهل البلاد من النصارى والمجوس واليهود
كانوا أصحاب حرث وزرع وعمالاً في الديوان وكانوا لا يرضون بمخاطرة النفس
واقتحام الحرب لذلك كانوا مطالبين بالجزية والمسلم لا يمكن له الاعتزال عن
الحرب فإنه مضطر إلى الذب عن بلاد الإسلام طائعًا أو مكرهًا - صارت الجزية
كأنها حد فاصل بين الرئيس والمرءوس ثم بين المسلم وغير المسلم .
2- ولما لم ينفصل الأمر بتةً وبقي للاجتهاد موضع ومتسع كان بعض العمال
يضرب الجزية على حديثي العهد بالإسلام .
3- ولكن مع هذا لم يتفق ذلك في مدة الخلافة الأموية إلا مرات معدودات
يشهد بذلك الفحص والتقصي وإمرار النظر والكد في البحث والتنقيب ومع ذلك
فكلما وقع مثل هذا لم يكن له بقاء فإما أن تكون الأمة هي التي تقيم النكير على
العامل أو يصل الخبر إلى الخليفة فيرد عمله ويمنعه عن الوقوع في مثله آتيًا ففي
سنة 101 لما كتب الحجاج إلى البصرة برد من أسلم من أهل القرى إلى مساكنهم
وضرب الجزية عليهم ضج القراء وخرجوا يبكون مع البكاة من أهل القرى وبايعوا
عبد الرحمن بن الأشعث مشمئزين من عمل الحَجَّاج منكرين عليه كما هو مشروح
في تاريخ الكامل لابن الأثير وكذلك لما اقتدى الجراح الحكمي بصنيع الحجاج كتب
إليه عمر بن عبد العزيز يأمره بإسقاط الجزية ، والواقعة مذكورة في حوادث سنة
100 في تاريخ الكامل ، وكذلك لما فعل يزيد بن أبي مسلم في إفريقية سنة
102 هجرية ألّب الناس عليه وقتلوه وكتبوا إلى الخليفة يزيد بن عبد الملك فكتب
إليهم إني ما كنت مستحسنًا عمل يزيد والقصة مذكورة في الكامل تحت حوادث سنة
102 وكان آخر ما وقع من مثل ذلك ما فعل الأشرس في خراسان فأورث ثورة
واشترك العرب مع الثائرين ونصروهم ، أما خلفاء بني أمية فلم يثبت عن أحد منهم
مثل ذلك وإنما كان أراد عبد الملك وضع الجزية على من أسلم من أهل الذمة
فكلمه ابن حُجْرة فترك . والقصة مذكورة في المَقْريزي بنوع من التفصيل ( انظر
صفحة 28 من الجزء الأول ) .
والآن نقص عليك بعض خيانات المؤلف :
1- ذكر واقعة الحجاج وترك نكير القراء عليه وبيعتهم على يد ابن الأشعث
إنكارًا على صنيع الحجاج .
2- ذكر واقعة الجراح ( الجزء الثاني صفحة 20 ) وترك إنكار عمر بن عبد
العزيز عليه ومنعه عن ضرب الجزية عليهم .
3- ذكر واقعة يزيد بن أبي مسلم وترك أن الناس قتلوه وأن الخليفة يزيد بن
عبد الملك استصوب صنيعهم أي قتلهم يزيد بن أبي مسلم .
4- ذكر واقعة الأشرس ولم يذكر أن العرب قاموا عليه وكانوا مع الثائرين
عليه ولما ثبت أن ضرب الجزية على حديثي العهد بالإسلام لم يأمر به أحد من
خلفاء بني أمية وإنما كان اجتهادًا من بعض العمال بناء على أن إسقاط الجزية
يورث نقصًا في الخراج وأن الخلفاء كلما عثروا على ذلك منعوا العمال عن ضرب
الجزية وردوا عملهم وأنه كلما وقع مثل ذلك تألب العلماء والخيار من الناس وأقاموا
النكير على ضارب الجزية حتى قتلوا بعض العمال واستحسن الخليفة قتله ، فهل
للمؤلف أن يحل أوزار بعض العمال على بني أمية كافة ؟ وهل يصح قوله ؟
( ولم يكن عمال بني أمية يأتون هذه الأعمال من عند أنفسهم دائمًا بل كثيرًا
ما كانوا يفعلونها بأمر خلفائهم كما قد رأيت مما كتبه معاوية إلى وردان ) ( الجزء
الثاني صفحة 22 ) .
أما كتاب معاوية إلى وردان فقد مر ذكره وليس فيه للمؤلف موضع حجة .
قال المؤلف ( ورأى هؤلاء ) أي أهل الذمة ( أن اعتناق الإسلام لا ينجيهم من
ذلك فعمد بعضهم إلى التلبس بثوب الرهبنة ؛ لأن الرهبان لا جزية عليهم . فأدرك
العمال غرضهم من ذلك فوضعوا الجزية على الرهبان . وأول من فعل ذلك منهم
عبد العزيز بن مروان عامل مصر فأمر بإحصاء الرُّهبان وفرض على كل راهب
دينارًا ) ( الجزء الثاني صفحة 20 مستندًا إلى المقريزي صفحة 392 من الجزء
الثاني ) .
أيها الفاضل المؤلف ! ما هذا الاجتراء ؟ ما هذا الاختلاق ؟ ما هذا الكذب
الظاهر ؟
هاك نص المقريزي ( ثم قدم اليعاقبة في سنة إحدى وثمانين الإسكندروس فقام
أربعًا وعشرين سنة ونصفًا وقيل : خمسًا وعشرين سنة ومات سنة ست ومئة
ومرت به شدائد صودر فيها مرتين أخذ منه فيهما ستة آلاف دينار وفي أيامه أمر
عبد العزيز بن مروان فأمر بإحصاء الرهبان فأحصوا وأخذت منهم الجزية على كل
راهب دينار وهي أول جزية أُخذت من الرهبان ، ( الجزء الثاني من المقريزي
صفحة 393 أو 394 ) .
فهل تجد في هذه العبارة أدنى إشارة إلى أن عبد العزيز أو أحدًا غيره شدّد في
الجزية فاختاروا الرهبنة طلبًا للنجاة من الجزية فما نفعهم ؟ لا وإنما فيها أن عبد
العزيز بن مروان وضع الجزية على الرهبان وهذا ليس فيه كبير شيء فإن الرهبان
وإن كانوا معافون من الجزية ولكن لما لم يكن الأمر منصوصًا لا في الكتاب ولا في
السنة كان للاجتهاد فيه مساغ فاجتهد عبد العزيز وأخطأ .
***
إنهاء هذا البحث
لو سردنا كل ما قال المؤلف عن جور بني أمية وعمالهم واستئثارهم بالأموال
وإسرافهم في استلابها وبينا ما في كل قول من التحريف والتدليس وتغيير المعنى
والخيانة في النقل وصرف العبارة عن وجهها لطال الكلام واحتجنا إلى عمل كتاب
منفرد بنفسه ؛ فلأجل ذلك اقتصرنا على كشف بعض دسائسه مع أنه قلّ من كل
وغَيْض من فيض[1] .
ونقول بعد كل ذلك : إن موضوع الكتاب ليس إلا بيان تمدن الإسلام فأي
متعلق في ذلك لإبداء مساوئ بني أمية ؟ ولعلك تقول : لا بد في تاريخ تمدن الإسلام
من بيان منهج السياسة وأنها هل كانت مؤسسة على الاستبداد والجور أو العدل
والنصفة فجرّ ذلك إلى كشف عوار بني أمية عرضًا . ولكن أناشدك بالله أما كان
لأحد منهم مأثرة تذكر ، ومَنْقبة تنقل ، وسياسة تنفع البلاد ، ومعدلة تعم الناس ؟ ؟
نعم إن بني أمية لا يوزنون بالخلفاء الراشدين وليس هذا عارًا عليهم ولا فيه حط
لمنزلتهم فإن إدراك شأو الراشدين واللحوق بهم أمر خارج عن طوق البشر ، وليس
فيه مطمع لأحد ، ولا موضع رجاء لمجتهد ، ولكن التوازن والتكايل بين الأموية
والعباسية وإنما هم ملوك فيهم المحسن والمسيء ، والعادل والجائر ، والناسك
والخليع ، والحازم والمغفل ، بل الذي أعدلهم سيرة وأمثلهم طريقة وأوفاهم ذممًا
وأرضاهم طورًا لا يخلو من عثرات لا تقال وهنات لا تذكر - فلو لزم المؤلف جادة
الإنصاف ووفى لكل أحد قسطه وأعطى كل ذي حق حقه لاستراح واسترحنا ولكنه
مال إلى واحد فأطرى في مدحه ، ونال من الآخر فأسرف في تهجينه وذمه ، ثم إنه
لم يفارق في مدحه وذمه عمود الكتاب أي ذم العرب والحط من شأنهم فإنه ذم بني
أمية ؛ لأنهم العرب بحتة ومدح العباسيين لا لأنهم العرب أو أنهم من سلالة هاشم أو
من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم ؛ بل لأن دولتهم دولة أعجمية وقد مر نصه
في ذلك سابقًا .
وحان لنا أن نذكر طرفًا من مآثر بني أمية وسيرتهم ومبلغهم من حسن السياسة
وتعمير البلاد وتمهيد السبل وتوطيد الأمن وإقامة المرافق وتعميم المعارف .
اعلم أن دولة بني أمية عبارة عن معاوية ويزيد وعبد الملك بن مروان
و الوليد و سليمان ، وعمر بن عبد العزيز ، و هشام فأما ما عداهم فلم تطل مدتهم
وليس العبرة بهم إن أحسنوا أو أساءوا .
***
سيرة معاوية في دولته
فأما معاوية فنذكر من سيرته ما ذكره المؤرخ المسعودي في مُروجه مع نوع
من الاختصار قال :
( كان من أخلاق معاوية أنه كان يؤذن في اليوم والليلة خمس مرات ، كان
إذا صلى الفجر جلس للقصَّاص حتى يفرغ من قصصه فيخرج إلى المسجد فيسند
ظهره إلى المقصورة ويجلس على الكرسي ويقوم الأحداث فيتقدم إليه الضعيف
والأعرابي والصبي والمرأة ومن لا أحد له فيقول : ظلمت ، فيقول : أعزّوه ،
ويقول : عُدي إليَّ ، فيقول : ابعثوا معه ، ويقول : صنع بي ، فيقول : انظروا في
أمره ، حتى إذا لم يبق أحد دخل فجلس على السرير ثم يقول : ائذنوا للناس على
قدر منازلهم فإذا استووا جلوسًا قال : يا هؤلاء إنما سميتم أشرافًا لأنكم شرفتم من
دونكم بهذا المجلس ، ارفعوا إلينا حوائج من لا يصل إلينا ، فيقوم الرجل فيقول :
شهد فلان ، فيقول : افرضوا له ، ويقول آخر : غاب فلان عن أهله ، فيقول :
تعاهدوهم واقضوا حوائجهم ، ثم يؤتى بالغداء والكاتب يقرأ كتابه فيأمر فيه حتى
يأتي على أصحاب الحوائج كلهم وربما قدم إليه من أصحاب الحوائج أربعون أو
نحوهم على قدر الغداء .
وأطال المسعودي في بيان أعمال معاوية يوميًّا ، ثم قال بعد حكاية معترضة :
( فلنرجع الآن إلى أخبار معاوية وسياسته وما وسع الناس من أخلاقه وما أفاض
عليهم من بره وعطائه وشملهم من إحسانه مما اجتذب به القلوب واستدعى به
النفوس حتى آثروه على الأهل والقرابات ) ثم ذكر بعد ذلك عدة وقائع تركناها هربًا
من الإطناب .
***
سيرة عبد الملك بن مروان في دولته
وأما عبد الملك فقال المدايني ( كان يقال : معاوية أحلم ، وعبد الملك أحزم ،
وهو الذي جعل على بيوت الأموال والخزائن رجاء بن حَيْوة ذلك المحدث المشهور
وعلى كتابة الخراج والجند سرحون بن منصور الرومي ) وهو نصراني ( وحول
الدواوين من الرومية والفارسية إلى العربية وزاد على ما مكان فرض معاوية
للموالي خمسة فبلغها عشرين ودخل في بيعته عبد الله بن عمر ومحمد بن الحنفية )
ذكر كل ذلك صاحب العقد في ترجمته ، وقد سبق من نسكه وعبادته ما فيه كفاية
فيما مر .
ومما ينقم عليه تأميره الحجاج ولكن الدولة تحتاج في إبّانها وأول نشأتها إلى
أمثال ذلك وهذا أبو مسلم الخراساني مؤسس الدولة العباسية قتل ستمائة ألف رجل
صبرًا وهذا أبو جعفر المنصور فعل بالهاشميين ما لم يسبق له نظير في الإسلام
ومع ذلك فإني أعوذ بالله أن أقوم ذابًّا عن الحجاج ومدافعًا عنه .
***
سيرة الوليد في دولته
وأما الوليد فكان أهل الشام يفتخرون به وحق لهم ذلك قال صاحب العقد الفريد :
( كان الوليد عند أهل الشام أفضل خلفائهم وأكثرهم فتوحًا ، وأعظمهم نفقة في
سبيل الله ، بنى مسجد دمشق ومسجد المدينة ووضع المنابر وأعطى المجذومين
حتى أغناهم عن سؤال الناس وأعطى كل مقعد خادمًا وكل ضريرًا قائدًا ، وكان يمر
بالبقال فيتناول قبضة فيقول : بكم هذه ؟ فيقول بفلس فيقول : زد فيها فإنك تربح )
وهو الذي وسع مسجد النبي وذهَّب البيت .
قال اليعقوبي : ( إن الوليد بعث إلى ملك الروم يعلمه أنه قد هدم مسجد رسول
الله فليعنه فيه فبعث إليه بمائة ألف مثقال ذهبًا ومائة فاعل وأربعين جملاً فسيفساء ،
وبعث الوليد إلى خالد بن عبد الله القَسْري وهو على مكة بثلاثين ألف دينار
فضربت صفائح وجعلت على باب الكعبة ، فكان أول من ذهَّب البيت في الإسلام
وحج الوليد سنة 91 لينظر إلى البيت وإلى المسجد وما أصلح منه وإلى البيت
وتذهيبه ) .
وقال اليعقوبي : ( كان أول من عمل البيمارستان للمرضى ودار الضيافة ،
وأول من أجرى على العميان والمساكين والمجذومين الأرزاق ) .
وقال السيوطي في تاريخه للخلفاء : ( وكان مع ذلك ) أي كونه جبارًا ظلومًا
( يختن الأيتام ويرتب لهم المؤدّين ) .
***
فتوحات بني أمية
ثم إن الدول تعرف أقدارها بآثارها ويقضى بفضلها بعملها وأخلد الآثار التي
تتفاضل بها مقادير الملوك وتتطاول بها رتب الدول كثرة الفتوح واستتباب أمور
الملك والرعية وتوطد دعائم العدل وانتشار العلم ودولة بني أمية قد أخذت من كل
ذلك قسطًا وضربت في كل ذلك بسهم .
أما كثرة الفتوح فقد بلغت دولتهم منها غاية ليس وراءها مطلع لطامح .
انقضت أيام الخلافة الراشدة والإسلام يزخر عُبابه في جزيرة العرب وديار الشام
ومصر وبلاد الفرس فلما تسنَّم بنو أمية عرش الخلافة ازداد الإسلام فتوحًا ،
واتسعت ممالكه وغلب سلطانه ، وامتدت سطوته ، ودخلت البلاد النائية المترامية
الأكناف في حوزة حكمه ، فملكوا ما لم يملكه أحد من ملوك الإسلام قبلهم ولا بعدهم .
فتحوا طرابلس وطَنْجة وسائر بلاد المغرب والأندلس وبلاد الديلم ، والأتراك
والمغول والسند وقبرص وأقريطش ( كريد ) ورودس وغيرها من جزائر البحر .
وغزوا صقلية وصالحوا النوبة وتوغلوا في بلاد الروم حتى بلغوا سور
القسطنطينية وضربوا السيف على أبوابها ، وافتتح السند محمد الثقفي أحد أبناء
قوادهم وهو ابن سبع عشرة سنة ، وقد وطئت جيوشهم ثغور الصين وثغور بلاد
الإفرنج وعاصمة بلاد الروم ، وحدود بلاد الهند ، وملكوا من السند إلى ثغور بلاد
الإفرنج طولاً ومن البحر الأحمر إلى بلاد الخزر عرضًا ، ودخل في حوزة ملكهم
العرب وديار الشام والعراق والجزيرة ومصر والبجة وبرقة وطرابلس وتونس
ومراكش والأندلس وأرمينية وخراسان وفارس وتوران والديلم وبلاد الران
وطبرستان وجرجان وسجستان وخوارزم وما وراء النهر وبلاد الخزر وأفغانستان
والسند وبعض بلاد الهند . فمن يدانيهم من الملوك في سعة الملك ؟ ومن يباريهم في
كثرة الفتوح ؟
***
استتباب أمور الملك والرعية
ليس في سعة الملك كبير فضل إذا لم يكن هناك تأنق في أمور المملكة ،
ونظر في أمور الرعية ، وقيام بمصالح العباد ، وتشمير في عمارة البلاد ، ولذلك
كان الذين فتحوا البلاد ولم ينظروا في أمور أهلها ليسوا عند ذوي الخبرة من أهل
التاريخ أسمى منزلة وأعلى مكانة من قطاع الطريق الذين يعيثون في الأرض
مفسدين . أما ملوك بني أمية فقد جمعوا بين بيعة الملك والنظر في أمور العباد ،
وكثرة الفتوح وعمارة البلاد ، حفروا الأنهار ، وعمروا الطرق ، وشادوا المصانع ،
وابتنوا المساجد ، وبذلوا الأموال ، وقضوا الحوائج ، وكشفوا المظالم ، وغمروا
المجذومين والعميان والمقعدين والصعاليك بالجزيل من الإحسان ، وأجروا لهم
الأرزاق . ثم رتبوا المصالح ودونوا الدواوين وحصنوا الحصون وبنوا المدن
والقصور وقد مر من ذلك شيء كثير فيما تقدم من سيرهم وأعمالهم وإليك هذه
العجالة التي هي كالطل من الوابل .
( يتلى )
((يتبع بمقال تالٍ))
__________
(1) ومما يناسب ذكره في هذا المقام أن المؤلف لما أنجز الجزء الأول من كتابه أرسله إلىّ فكتبت إليه بعد الإعجاب به : إنه لا بد من ذكر مصادر الروايات في كل موضع ؛ وذلك لأجل أني كنت أخاف عليه التدليس ، فأظهر المؤلف في مقدمة الجزء الثاني أنه عمل بذلك ، ويذكر الكتاب والجزء والصفحة ولكن من الأسف أن كل هذا ما أجدى نفعًا فإنه ما يذكر المطبعة ؛ ولأجل هذا كابدت في تطبيق مصادر كتابه محنة عظيمة فإن النسخ مختلفة ولا يُدرى أي نسخة أرادها وبسبب ذلك ما اهتدينا إلى أكثر خياناتها ومن المحقق المتيقن به أنه ما نقل عبارة إلا وعمل فيها شيئًا من التحريف والتغيير ومن كان في ريب من ذلك فليراجع الأصول ويكابد محنة التطبيق ليؤمن بما قلته مع حيرة واندهاش - 12 .
(15/270)
جمادى الأولى - 1330هـ
مايو - 1912م
مايو - 1912م
الكاتب : شبلي النعماني
__________
نقد تاريخ التمدن الإسلامي
بقلم الشيخ شبلي النعماني
( 4 )
أما المصانع - فإن هشامًا حصَّن المثقب على يد حسان بن ماهون الأنطاكي
وحفر له خندقًا وبنى حصن قطر غاش ، وحصن مورة ، وحصن بوفا من عمل
أنطاكية . وبنى سعيد بن عبد الملك سور الموصل وهو الذي هدمه الرشيد . وفرش
الموصل بالحجارة ابن تليد صاحب شرطة المروانيين . وسار العباس بن الوليد إلى
مرعش فعمرها وحصنها ونقل الناس إليها وبنى لها مسجدًا جامعًا ، وأسكن مسلمة
بن عبد الملك مدينة الباب أربعة وعشرين ألفًا من أهل الشام على العطاء وبنى هريًا
( مخزنًا ) للطعام وهريًا للشعير وخزانة للسلاح وأمر بكبس الصهريج ورمّ المدينة
وشرفها , وأحدث الحجاج أحد أمرائهم في سنة 83 مدينة واسط بين الكوفة
والبصرة وبنى مسجدها وقصرها والقبة الخضراء بها ، وأحدث سليمان بن عبد
الملك في ولايته مدينة الرملة ومصرها وبنى فيها القصور ومسجدًا وحفر الآبار
والقنى والصهاريج . وبنى أحد قوادهم عقبة بن نافع الفهري بإفريقية قيروانها
وأحدثوا غيرها من المدن والحصون والأرباض في الأندلس وحدود بلاد الروم
والسند .
ثم أمنوا الطرق وعمروا السبل فكان موضع قيروان غيضة ذات طرفاء
وشجر لا يُرام من السباع والحيات والعقارب فأحدثوا فيه تلك المدينة الزهراء
فأصبحت طرق إفريقية آمنة مستأنسة بعدما كانت مستوحشة ذات مخاوف ومهالك ,
وكانت الطريق فيما بين أنطاكية والمصيصة مسبعة يعترض للناس فيها الأسد
فوجه الوليد إليها أربعة آلاف من الجاموس نفع الله بها , وأذكر ما كتب ابن الأثير
في حوادث سنة 88 : ( إن الوليد كتب إلى البلدان جميعها بإصلاح الطرق وعمل
الآبار ) وكان الموضع الذي فيه نهر سعيد بن عبد الملك غيضة ذات سباع فأقطعه
إياها الوليد فحفر وعمَّر ما هناك . ولما بغى سيل الجراف بمكة في سنة 80 في
زمن عبد الملك أمر عامله بعمل ضفائر الدور الشارعة على الوادي وضفائر المسجد
وعمل الردم على أفواه السكك . وحفر عديّ عامل البصرة من قِبَل عمر بن عبد
العزيز بأمره نهر عدي .
ومن الأخبار التي تدل على شدة حبهم للرعية وكثرة بذلهم في إزاحة خللها
وإماطة أذاها - أنه شكا أهل البصرة إلى عامل يزيد على العراق ملوحة مائهم فكتب
بذلك إلى يزيد فكتب إليه : إن بلغت نفقة هذا النهر خراج العراق فأنفقه عليه ،
فحفر لهم النهر الذي يعرف بنهر ابن عمر وحفر عمالهم الجائرون الغاشمون ( كما
يقول جرجي أفندي زيدان ) والمنتسبون إليهم كثيرًا من الأنهار غير ما ذكر كنهر
معقل ، ونهر ديبس ، ونهر الأساورة ، ونهر عمرو ، ونهر أم حبيب ، ونهر
حرب ، ونهر بزيدان ، ونهر سلم ، ونهر ناقد ، ونهر خيرتان ، ونهر مرة ،
ونهر بشار ، ونهر بزور ، ونهر حبيب ، ونهر ذراع ، ونهر أبي بكرة ،
وغيرها من الأنهار وهذه الأنهار كلها حفروها [1] بالبصرة فما بال غيرها من
البلاد ؟
أما ما بذلوا من الأموال وأفرغوا من الجهد في بناء المسجد النبوي وتذهيب
البيت و المسجد الأموي الذي هو معدود من إحدى العجائب في كثرة نفقاته وعظمة
بنائه ودقة صنعه وبهجة منظره وحسن نظامه فهو أشهر من نار على علم .
وبنو أمية هم أول من اتخذ دار الضرب في الإسلام فكسوا به الإسلام رفعة
وأغنوه عن نقود الروم والفرس ونجوه مما أوعده الروم بنقش شتم النبي صلى الله
عليه وسلم عليها ، وهم الذين نقلوا الدفاتر والدواوين من الفارسية والرومية والقبطية
إلى العربية [2] فزادت العربية انتشارًا ونفوذًا ولم يمض برهة من الدهر حتى
أصبحت هذه البلاد عربية النزعة واللسان ، وهم أول من بنى مستشفى في الإسلام -
بنوه بدمشق سنة ثمان وثمانين ، جعلوا فيه الأطباء وأمروا بحبس المجذومين
وأجروا لهم الأرزاق ، وهم أول من أنشأ دارًا للعُميان ، وهم أول من عمر دار
الضيافة [3] بعد عمر بن الخطاب ، وهم أول من رثى للأيتام وتحنن عليهم ورتب
لهم المؤدبين ليعلموهم [4] .
***
نشر المعارف والعلم
أما العلم - فقد زخر بهم بحره ، وأزهر بدره ، فالقرآن الذي هو عمود
الإسلام ، ورأس العلوم ، وينبوع المعارف ، أدرك الأمة قبل اختلافها فيه عثمان بن
عفان وهو أموي . ثم بعد ذلك اختلطت العرب بالعجم واحتكت بهم ففسدت لغتها
وأسلمت العجم فلم تستطع السلامة من اللحن فكثر التصحيف في القرآن وانتشر
بالعراق ففزع الحجاج وهو أحد أمراء بني أمية إلى كتابه فوضعوا النقط والأعجام
[5] فعصموا به كتاب الله أن يتطرق إليه التصحيف والتحريف تطرقهما إلى التوراة
والإنجيل ، ووالله هذا أعظم مبرة برَّ بها الإسلام لا تساويها مبرَّة وأعظم منة منَّ بها
على الدين لا توازيها منة . ثم كتب الحجاج المصاحف وفرقها في الأمصار وكان
الوليد - الذي رماه صاحبنا بالاستهانة بالقرآن - يحث الناس على حفظ القرآن
وكان يجزل الصلات لحفظته ويضرب الذين لم يحفظوه [6] فكثر حفظته وعظم
قدرهم وجلت رتبتهم .
أما التفسير - ففي أيامهم نبغت أجلَّة المفسرين من التابعين ، وفي أيامهم دُوِّن
التفسير في الصحف فأول من وضع في التفسير ابن جبير بأمر عبد الملك [7] ثم
مجاهد .
أما الحديث - فكانوا يدرون على أهله الصلات ويبعثون إليهم بالهدايا
ويجرون لهم الأرزاق لينقطعوا إلى حفظ الحديث وروايته ونقله وكانوا يكرمون
الفقهاء ويجلون مقامهم ويراعون جانبهم ، فقد كان يصيح صائح من بني مروان في
موسم الحج : ألا لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح إجلالاً لشأنه ولكثرة علمه
بالمناسك [8] وكان عبد الملك أمر الحجاج وهو أميره على الموسم أن يقدم ابن عمر
في الحج ويقتص أثره في المناسك ، وكان سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد
والشعبي وميمون بن مهران والزهري وأيوب بن أبي تميمة وقبيصة بن ذؤيب
ورجاء بن الحياة أعزة عند بني أمية وكان أكثرهم عمالاً لهم وهم أساطين
الحديث وأئمة الرواية وأعلام النقل . وأنت تعلم أن أحاديث الرسول صلى الله عليه
وسلم لولا أنها استودعت بطون الصحف لضاعت بهلاك العلماء وإسراع الموت فيهم
، فأسألك بحرمة التاريخ مَنْ أمر أهل هذا الشأن بتدوينها في الكتب - أليس هو عمر
بن عبد العزيز الأموي ؟ فجاء في الآثار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الآفاق :
( انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه ) وكتب إلى أبي بكر
بن حزم رأس المحدثين ( أن انظر ما كان من سُنة أو حديث فاكتبه لي فإني خفت
دروس العلم وذهاب العلماء ) وقد كتب ابن حزم كتبًا في الحديث فتوفي عمر ثم
وضع الكتب فيه ربيع بن صبيح وكان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار
يعلمهم السنن والفقه [9] .
أما أصول اللغة ونحوها - فقد كان تدوينها بأمر أمراء بني أمية ، ذكر ابن
خلكان ( الملجد الأول صفحة 240 ) أن أبا الأسود الدؤلي استأذن زيادَ ابن أبيه -
وهو والي العراقين يومئذ - أن يضع للعرب ما يقيمون به لسانهم فأبى ثم بدا له
صواب رأيه فدعا الدؤلي وقال له : ضع للناس الذي نهيتك أن تضع لهم فوضعه
وأخذ عنه ما وضعه عتبة بن مهران المهري وعنه ميمون وعنه عبد الله الحضري
وعنه عيسى بن عمر وعنه الخليل [10] وهؤلاء كلهم كانوا في عصر بني أمية وهم
واضعو النحو ومدونو أصوله .
أما الشعر - ففي عصرهم فتقت ألسنة الشعراء وارتفع قدرهم وانتشر ذكرهم
ففحول الشعر وأمراء القول وفرسان القريض هم الفرزدق الدارمي و جرير الخطفي
و الأخطل التغلبي و عمر بن أبي ربيعة القرشي و كثير عزة و جميل بثينة
و مجنون ليلى و ذو الرمة غيلان ونصيب وهؤلاء كلهم كانوا يقصدونهم بجياد
قصائدهم فكانوا يغمرونهم بالجوائز فنطقت ألسنتهم بما أصبح زهرة للأدب وزينة
للغة .
وكانوا يحثون الناس على اقتناء الأدب وتناشد الشعر وتدارس أخبار الشعراء ،
وكانوا يستوفدون الشعراء ويستزيدونهم ويجيزونهم بالأموال الجزيلة وكانوا
يرسلون أبناءهم إلى البادية ليتلقنوا الأدب ويتلقفوا اللغة من أفواه الأعراب وأهل
البادية ، وقد جمع الوليد بن يزيد بن عبد الملك ديوان العرب وأشعارها وأخبارها
وأنسابها ولغاتها [11] .
أما علم التاريخ والسير والمغازي - فبعصرهم افتتح عصره ، وبأمرهم ارتفع
أمره ، ففحول أصحاب السيَر والمغازي هم : وهب بن منبه عالم اليمن المتوفى سنة
114 ومحمد بن مسلم الزهري صاحب عبد الملك المتوفى سنة 124 وموسى بن
عقبة المتوفى سنة 141 ولهؤلاء كلهم كتب في التاريخ والسير والمغازي[12]
ووضع في أيامهم عوانة المتوفى سنة 147 كتاب التاريخ ، وكتاب سيرة معاوية
وبني أمية ، وكان لملوك بني أمية رغبة شديدة في استطلاع الأخبار الماضية
وحوادث الأمم الخالية . قال المسعودي : إنه كان معاوية يجلس لأصحاب الأخبار
في كل ليلة بعد العشاء إلى ثلث الليل ويقوم فيأتيه غلمان وعندهم كتب
فيقرءون عليه ما في الكتب من أخبار الأمم وسير الملوك وسياسات الدول ، ولم
يصبر على ذلك حتى استحضر عالم عصره عُبيد بن شربة من صنعاء اليمن وسأله
عن الأخبار المتقدمة وملوك العجم وسبب تبلبل الألسنة وأمر افتراق الناس في البلاد ،
وأمره أن يدوّن ما علمه ، وعاش عبيد إلى أيام عبد الملك وتوفي وله من الكتب
كتاب الأمثال وكتاب أخبار الماضين [13] وأخذ عنه أناس سماهم ابن النديم وكان من
رواته زيد الكلابي في أيام يزيد بن معاوية عارف بأيام العرب وأحاديثها ( الفهرست )
صفحة 90 ( وقد كان هشام مشغوفًا بالسير والأخبار فنقل له جبلة بعض كتب
سير الفرس من الفارسية إلى العربية [14] وأمر هشام النقلة فنقلوا له كتاب تاريخ
ملوك الفرس وقوانين دولتهم وتراجم رجالهم وكان هذا الكتاب مصورًا ، ثم نقله سنة
113 رآه المسعودي سنة 303 في مدينة اصطخر كما ذكر في التنبيه صفحة
( 106 ) .
أما علوم الفلسفة ومنها الطب والكيمياء - فكان لهم في نقلهما إلى العربية
آثار صالحة فنقل ابن آثال لمعاوية كتب الطب من اليونانية وهذا أول نقل في
الإسلام ، وكان في البصرة في أيام مروان بن الحكم طبيب ماهر يهودي النِّحلة
عارف بالعربية اسمه ماسرجويه فنقل ماسرجويه هذا كناش القس أهرون بن أعين
من السريانية إلى العربية فلما تولى عمر بن عبد العزيز وجد هذا الكتاب في خزائن
الكتب في الشام فأخرجه للناس وبثه في أيديهم [15] و خالد بن يزيد بن معاوية حكيم
آل أمية أول من طلب علوم الفلسفة في الإسلام ، وخبره أنه كان يطمع في الخلافة
فلما وثب مروان عليها رغب خالد عنها إلى طلب العلم فاستقدم جماعة من فلاسفة
اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر ومنهم مريانوس الرومي الذي أخذ عنه صنعة
الكيمياء والطب وأمرهم بنقل الكتب من اليونانية والقبطية إلى العربية فنقلوها له
ولخالد كلام في الكيمياء والطب - وكان بصيرًا بهذين العلمين متقنًا لهما - وله
رسائل دالة على معرفته وبراعته كما أخبر به ابن خلكان ، وقد ذكر له ترجمة
صالحة ابن النديم في فهرسته ونقل سالم كاتب هشام - وهو أبو جبلة المار ذكره -
رسائل أرسطاطاليس إلى الإسكندر فبناء على ما قدمنا من القول بنو أمية هم أول
من استقدم الفلاسفة واستدناهم في الإسلام ، هم أول من أمر بنقل العلوم إلى العربية
في الإسلام ، هم أول من أنشأ خزائن للكتب في الإسلام ، وقد ضربنا صفحًا عما
كان لآل أمية بالأندلس في السياسة والعلم من المآثر الحسنة والأعمال الجليلة والسير
العادلة . فهل لك أيها الفاضل المؤلف إلى الإذعان للحق من سبيل ، وإلى الرجوع
عن ضلال الرأي من طريق ؟
***
صنيع المؤلف بالعباسية
عهدنا الوحوش الضارية مع جفاء طبعها وقسوة قلبها وكونها مطبوعة على
الافتراس والفتك والارتواء بالدم وإذا دخلت غابتها وأحاطت بها عائلتها تبدل القسوة
بالرحمة والغلظة باللطف والغضب بالحنان ، فبينما أحدها عبوس كاشر عن الأنياب
كالح الوجه مستبشع المنظر كريه الهيئة إذ هو هش بش حنون عطوف يذوب لطفًا
ورِقَّة ، وكذلك شأن قواد الجند وأبطال الحرب فإنك ترى أحدهم إذا قاتل الأكفاء
وناطح الأقران فهو شهاب ينقضّ ، ونار تلتهب ، وسعير تفور ، وإذا عاشر
الأصحاب فهو ألينهم جانبًا ، وأحلاهم خلقًا ، وأوسعهم حلمًا ، وأرقهم طبعًا ، وقد
جربنا المؤلف وعجمنا عوده في معاملته مع أعدائه ( بني أمية ) فلننظر كيف حاله
في معاشرته مع أصدقائه ( العباسية ) .
قال المؤلف :
( فحبب بعضهم إلى المنصور أن يستبدل الكعبة بما يقوم مقامها [16] في
العراق وتكون حجًّا للناس فبنى بناءً سماه القبة الخضراء تصغيرًا للكعبة وقطع
المِيرة في البحر عن المدينة ) ( الجزء الثاني صفحة 30 ) .
وقال : ( وأراد المعتصم أن يستغني عن بلاد العرب جميعًا وكان قد بنى
سامرَّا بقُرب بغداد وأقام فيها جنده فأنشأ فيها كعبة وجعل حولها طوافًا واتخذ مِنى
و عرفات إلخ ) ( الجزء الثاني صفحة 32 ) .
وقال : ( فلما أفضت الخلافة إلى المأمون إلخ - ثم قال : فأخذ يناظر أشياعه
وصرح بأقوال لم يكونوا يستطيعون التصريح بها خوفًا من غضب الفقهاء وفي
جملتها القول بخلق القرآن أي أنه غير منزَّل ) ( الجزء الثالث صفحة 141 ) .
غير خافٍ على أحد أن العباسية إن افتخروا وتطاولوا على منازعيهم في
الرئاسة فمعظم فخرهم وأبين حُججهم أنهم بنُو عم النبي وسَدنة البيت وخدمة الحرم
ودعاة الإسلام ونقباء القرآن وصاحبنا يقول : ( إن المنصور وهو مؤسس دولتهم
وفاتحة خلفائهم بنى القبة الخضراء إرغامًا للكعبة وقطع المِيرة عن المدينة تضييقًا
على أهلها وأن المأمون - وهو أفضل خلفائهم دينًا وورعًا - كان يُنكر نزول القرآن
. وإن المعتصم - وهو فحلهم وواسطة عقدهم - بنى كعبة في سامرَّا وجعل لها
طوافًا . ولعلك تقول : إن الحاكم بالعدل والقائم بالقسط ليس له حميم ولا عدو فهو
يتحرى الصدق ويدور مع الحق كيفما دار . ...
فالمؤلف إذا أتته سيئة من بني العباس قضى عليهم من غير محاباة لهم ولا
ميل إليهم ، وكذلك إذا عرضت له حسنة من بني أمية فهو يوفيهم حقهم من
الاستحسان وحسن القول وتنويه الذكر - هيهات هذا كان رجاؤنا فخاب الظن
وكذب الأمل وذهبت الثقة فإن المؤلف لما ذكر بني أمية عقد لمثالبهم أبوابًا منها :
استخفافهم بالدين ، وذكر فيه قتال عبد الملك مع ابن الزبير فقلب الرواية كما سبق
ذكره ، فلو كان مغزى المؤلف الصدق وبيان الحقيقة لكان يعقد بابًا للعباسية أيضًا
يذكر فيه استخفافهم بالكعبة وإنكارهم لنزول القرآن ، وههنا موضع نظر إلى دقة
مكيدة المؤلف وحسن احتياله فإنه يريد من طرف الغض من الكعبة والحط من
القرآن ومن طرف الانتصار للعباسية والذب عنهم ؛ لأجل أنهم كسروا شوكة
العرب واتخذوا العجم بطانتهم وعمود دولتهم فذكر استخفافهم بالكعبة ولكن مغموسًا
مبددًا تحت عنوان ثروة الدولة الإسلامية ليأخذ بطرفي المطلوب ويفوز ببغيتيه معًا .
أما كشف الجلية عن أصل الحال فالأمر أن من يدعي الخلافة ( وهي منصب
ديني ) ويرشح لها نفسه لا يجد إلى ذلك سبيلاً إلا بالتظاهر بالدين ، والتصبغ به
ونصب نفسه لإعلاء كلمته ورفع مناره وحمل الناس على تعظيم شعائره والتدلي إلى
خاصة القائم به ؛ ليجلب عطف القلوب وجذب الأميال ورضاء العامة والتحبب إلى
الناس ؛ ولذلك كان الخلفاء ( بنو أمية والعباسية كلاهما ) يصلُّون بالناس ويؤمونهم
ويحضرون الموسم ويحجون بهم أو يرسلون مِن خاصتهم مَن ينوب منابهم
ويخطبون على المنابر ؛ ولذلك لما أراد أهل الشام الميكدة بعلي رضي الله عنه
ورفعوا المصاحف كفَّ أصحاب علي عن القتال ؛ ولما قال عليّ ٌ هذه خديعة منهم .
قالوا : إذا لم تذعن لهذا خلعناك ، فلم يقدر على خلافهم ورضي بما لم يكن وفق
رضاه ، ولما فعل يزيد ما فعل ضج الناس وكادوا يسطون عليه لولا أنه مات عاجلاً ،
ولما أراد الحجاج قتال ابن الزبير أغراهم بأن ابن الزبير ألحد في الدين ، وزاد
على الكعبة ولذلك نصب المناجيق تلقاء الزيادة التي كان زادها ابن الزبير ( رضي
الله عنه ) ولما جاهر الوليد بن يزيد بالفسق قاموا عليه وقتلوه ، ولما قال أبو نواس
يمدح الأمين وصدَّر القصيدة بهذا البيت :
ألا فاسقني خمرًا وقل لي : هي الخمر ... ولا تسقني سرًّا فقد أمكن الجهر
اتخذ المأمون هذا وسيلة لإغراء الناس على مخالفة الأمين . فهل تصدق بعد
كل ذلك بأن المنصور أو المعتصم كان يقدر أو يسوغ له أن يصغر شأن الكعبة
ويمس من شرفها ؟ وهل كان يقدر المأمون أن يحمل الناس على إنكار القرآن
والعياذ بالله ؟ فأما استشهاد المؤلف في هذه الواقعة بابن الأثير وغيره فكله تحريف
وتدليس وسوء تأول ، ولولا أنني سئمت من كشف دسائسه مرة بعد أخرى
لأوضحتُ الأمر وبينت حقيقة الحال .
قال المؤلف : ولما تولى المعتصم سنة 218 هـ واصطنع الأتراك والفراعنة
ازداد العرب احتقارًا في عيون أهل الدولة وتقاصرت أيديهم عن أعمالها حتى في
مصر .. . - إلى أن قال - : فأصبح لفظ ( عربي ) مرادفًا لأحقر الأوصاف عندهم ،
ومن أقوالهم : العربي بمنزلة الكلب اطرح له كسرة واضرب رأسه ، وقولهم : لا
يفلح أحد من العرب إلا أن يكون معه نبي ينصره الله به ( الجزء الثاني صفحة 31
و32 ) .
من أحسن أعمال آل عباس عند المؤلف أنهم صغروا شأن العرب وساموهم
الخسف وسلطوا عليهم الأعاجم والأتراك وجعلوا هؤلاء ولاة البلاد ، بيدهم الأمر
والنهي والرفع والخفض والعقد والحل والنقض والإبرام . ذكر ذلك في غير موضع ،
وكلما ذكره وجد من نفسه ارتياحًا إليه وشفاء لحزازته وهزة لعطفه ونيلاً لأربه ،
ومع أن الواقعة مكذوبة أو محرفة على جري عادته فنحن لا ننازعه في ذلك ونطوي
الحديث على غرته ولكن نقول : إذا مدح أحد مثلاً دولة فرنسة ، وقال : إنهم ذللوا
الفرنسيين وأرغموا أنوفهم واستلبوهم المناصب وقلدوا الولاياتِ الأجانبَ ، وجعلوهم
قابضي أزمَّة الأمور يولون ويعزلون ، وينفقون ويمسكون ، فهل هذا يكون مدحًا
ترضى به دولة فرنسة أو يكون هذا عارًا يُسْتَحى منه ؟ ومسبّة يستنكف عنها ،
وشناعة تشمئز منها القلوب ؟ وأنصف من نفسك ما كان حظ العباسيين من تولية
الأعاجم . أما آل برمك فلا ننكر فضلهم ومحاسن آثارهم ، ولكنهم مع كل ذلك
استأثروا بالأموال وانفردوا بالأعمال حتى لم يكن حظ الخلفاء من الخلافة إلا الاسم
فقط ، فاضطر الرشيد إلى النكبة بهم وإزالة دولتهم .
وأما الأتراك فصاروا يلعبون بالخلافة كل ملعب ، فكم قتلوا من الخلفاء
وسجنوا وعذبوا بأنواع العذاب وتركوهم يموتون جوعًا يسألون الناس ولا يعطون .
فهل هذه سياسة تمدح ومأثرة تذكر وفضيلة يفتخر بها ؟
***
الخلفاء الراشدون
المؤلف حرفته تأليف الكتب متكسبًا بها ، وهو يعرف حق المعرفة أنه لو انتقد
على الخلفاء الراشدين ، ونال منهم تصريحًا كَسَدَ سوقُه ، وخابت صفقته ، فدبر
لذلك حيلاً لا يكاد يتفطن لها اللبيب المتيقظ فضلاً عن البليد المتساهل ، فعمد إلى
رءوس المثالب ونسبها إليهم بأنواع الاحتيال ، فتارةً بتبديدها في ثنيات الكلام
وإبعادها عن موضع العناية ، وتارةً بإيرادها عرضًا مُوهمًا عدم الاعتناء بها ، وتارةً
بذكرها محتالاً لها عذرًا . وإذا كررت النظر في كلامه وتصفحت ما فيه وجمعت ما
هو مبدَّد ، ونَظَمْت ما هو مفرَّق تكاد تستيقن أن الخلفاء كانوا من أشد أعداء العلم ،
وأنهم أبادوا الكتب والخزانات ، واضطهدوا أهل الذمة وجعلوهم أذلاء لا يؤذن لهم
ولا يُؤْبَه بهم .
أما كونهم أعداء العلم فبيَّن المؤلف ذلك إجمالاً وتفصيلاً فقال : ( كان الإسلام
في أول أمره نهضة عربية ، والمسلمون هم العرب ، وكان اللفظان مترادفين ، فإذا
قالوا : العرب أرادوا المسلمين ، وبالعكس ؛ ولأجل هذه الغاية أمر عمر بن الخطاب
بإخراج غير المسلمين من جزيرة العرب .. .. - إلى أن قال : - وتمكن هذا
الاعتقاد في الصحابة لما فازوا في فتوحهم وتغلبوا على دولتي الروم والفرس ، فنشأ
في اعتقادهم أنه لا ينبغي أن يسود غير العرب ولا يتلى غير القرآن إلخ ) .
( أما في الصدر الأول فقد كان الاعتقاد العام أن الإسلام يهدم ما كان قبله
فرسَخ في الأذهان أنه لا ينبغي أن ينظر في كتاب غير القرآن إلخ .
( فتوطدت العزائم على الاكتفاء به عن كل كتاب سواه ، ومحو ما كان قبله
من كتب العلم في دولتي الروم والفرس كما حاولوا بعدئذ هدم إيوان كسرى و أهرام
مصر وغيرها من آثار الدول السابقة ) إلخ ( الجزء الثالث صفحة 39 ) .
( وبناء على ذلك هان عليهم إحراق ما عثروا عليه من كتب اليونان والفرس
في الإسكندرية و فارس ) إلخ ( الجزء الثالث صفحة 135 ) .
***
حريق خزانة الإسكندرية
لم يقتنع المؤلف بذلك فعقد بابًا لإثبات أن حريق خزانة الإسكندرية كان بأمر
عمر بن الخطاب وأطال وأطنب في ذلك واستدل عليه بستة دلائل [17] نحن نذكرها
مع الرد عليها إجمالاً :
قال : أولاً - ( قد رأيت فيما تقدم رغبة العرب في صدر الإسلام في محو كل
كتاب غير القرآن بالإسناد إلى الأحاديث النبوية وتصريح مقدمي الصحابة ) الذي
ذكر قبل ذلك ( انظر صفحة 39 9 ) وحُوِّل عليه ههنا أقوال منها : ( إن الإسلام يهدم
ما كان قبله ) وكلنا يعرف أن المراد به إبطال عوائد الجاهلية ومزعوماتها وليس
المراد محو الكتب أو إحراق الخزائن ولكن لما كان المؤلف دخيلاً فينا غريب الذوق
والمعرفة حمل الكلام على غير محله أو لعله عارف يتجاهل وبصير يتعامى .
ومنها قول النبي عليه السلام : ( لا تصدِّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا
آمنا بالذي أُنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ) وأي متعلق في هذا ؟ بل هو
مخالف لما يريده المؤلف فإن الحديث يأمر بالإيمان بما أنزل إلى أهل الكتاب ، أما
الإغفال عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم فلأجل كون أهل الكتاب غير موثوق بهم
في الرواية ، ومنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( رأى في يد عمر ورقة من
التوراة فغضب حتى تبين الغضب في وجهه ثم قال : ألم آتكم بها بيضاء نقية ، والله
لو كان موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعي ) وهذا لا مستند فيه للمؤلف فإن النبي صلى
الله عليه وسلم خاف على عمر عنايته بالتوراة والتصديق بكل ما فيها مع كونها
مغيَّرة لعبت بها أيدي النَّقَلة ؛ ولذلك قال : ألم آتكم بها بيضاء نقية وهذا لا يستلزم
بل ليس فيه أدنى إشارة إلى محوها وإلحاق الضرر بها ونزيدك إيضاحًا للكلام بما
فيه ثلج الصدر وفصل الخطاب ، فاعلم أن عمود الإسلام وقطب رحاه هو القرآن
وعليه المعول وهو المستمسك في كل باب وكان هو العروة الوثقى في ذلك العصر
للصحابة وأهل القرن الأول ، والقرآن له عناية كبرى بالتوراة والإنجيل وهو الذي
نوّه بذكرهما وعظم شأنهما ، فقال : { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } ( النحل : 43 ) ، ( والمراد بالذكر التوراة ) - { إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى } ( المائدة : 44 ) - { وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ
لأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم } ( المائدة : 66 ) - { وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرَاةِ } ( آل عمران : 50 ) - { مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ
يَدَيْهِ } ( يوسف : 111 ) ، ( أي التوراة والإنجيل ) .
ولأجل ذلك كان عدة من أجِلَّة الصحابة منقطعين إلى قراءة التوراة والإنجيل
والاعتناء بحفظهما ودرسهما ولم يكتفوا بها بل أخذوا يروون ويتفاوضون كل ما
وجدوا من أقاصيص أهل الكتاب ومروياتهم وقد اعترف بذلك المؤلف نفسه فقال :
( وقد رأيت أن العمدة في التفسير على النقل بالتواتر والإسناد من النبي
فالصحابة فالتابعين ، والعرب يومئذ أميون لا كتابة عندهم فكانوا إذا تشوقوا إلى
معرفة شيء مما تتوق إليه نفوسهم البشرية من أسباب الوجود وبدء الخلقة وأسرارها
سألوا عنه أهل الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى - إلى أن قال - : فكانوا إذا
سُئلوا عن شيء أجابوا بما عندهم من أقاصيص التلمود والتوراة بغير تحقيق
فامتلأت كتب التفسير من هذه المنقولات ( الجزء الثالث صفحة 64 ) .
( يتلى )
((يتبع بمقال تالٍ))
__________
(1) راجع لكل ذلك البلاذري .
(2) راجع لكل ذلك فتوح البلدان للبلاذري .
(3) اليعقوبي ذكر الوليد .
(4) السيوطي ذكر الوليد .
(5) ابن خلكان ذكر الحجاج .
(6) العقد أخبار الوليد ص 239 وابن الأثير سنة 88 .
(7) ميزان الاعتدال للذهبي ذكر عطاء بن دينار .
(8) ابن خلكان ذكر عطاء .
(9) مقدمة الزرقاني على الموطأ .
(10) ابن خلكان مجلد 2 ص 380 .
(11) الفهرست صفحة 91 .
(12) راجع كشف الظنون وتذكرة الحفاظ .
(13) كتاب الفهرست صفحة 244 .
(14) راجع الفهرست أيضًا .
(15) أخبار الحكماء وعيون الأبناء .
(16) كانت العبارة أن يقول : أن يستبدل بالكعبة إلخ اهـ مصحح .
(17) الجزء الثالث من تمدن الإسلام ص 40 .
__________
نقد تاريخ التمدن الإسلامي
بقلم الشيخ شبلي النعماني
( 4 )
أما المصانع - فإن هشامًا حصَّن المثقب على يد حسان بن ماهون الأنطاكي
وحفر له خندقًا وبنى حصن قطر غاش ، وحصن مورة ، وحصن بوفا من عمل
أنطاكية . وبنى سعيد بن عبد الملك سور الموصل وهو الذي هدمه الرشيد . وفرش
الموصل بالحجارة ابن تليد صاحب شرطة المروانيين . وسار العباس بن الوليد إلى
مرعش فعمرها وحصنها ونقل الناس إليها وبنى لها مسجدًا جامعًا ، وأسكن مسلمة
بن عبد الملك مدينة الباب أربعة وعشرين ألفًا من أهل الشام على العطاء وبنى هريًا
( مخزنًا ) للطعام وهريًا للشعير وخزانة للسلاح وأمر بكبس الصهريج ورمّ المدينة
وشرفها , وأحدث الحجاج أحد أمرائهم في سنة 83 مدينة واسط بين الكوفة
والبصرة وبنى مسجدها وقصرها والقبة الخضراء بها ، وأحدث سليمان بن عبد
الملك في ولايته مدينة الرملة ومصرها وبنى فيها القصور ومسجدًا وحفر الآبار
والقنى والصهاريج . وبنى أحد قوادهم عقبة بن نافع الفهري بإفريقية قيروانها
وأحدثوا غيرها من المدن والحصون والأرباض في الأندلس وحدود بلاد الروم
والسند .
ثم أمنوا الطرق وعمروا السبل فكان موضع قيروان غيضة ذات طرفاء
وشجر لا يُرام من السباع والحيات والعقارب فأحدثوا فيه تلك المدينة الزهراء
فأصبحت طرق إفريقية آمنة مستأنسة بعدما كانت مستوحشة ذات مخاوف ومهالك ,
وكانت الطريق فيما بين أنطاكية والمصيصة مسبعة يعترض للناس فيها الأسد
فوجه الوليد إليها أربعة آلاف من الجاموس نفع الله بها , وأذكر ما كتب ابن الأثير
في حوادث سنة 88 : ( إن الوليد كتب إلى البلدان جميعها بإصلاح الطرق وعمل
الآبار ) وكان الموضع الذي فيه نهر سعيد بن عبد الملك غيضة ذات سباع فأقطعه
إياها الوليد فحفر وعمَّر ما هناك . ولما بغى سيل الجراف بمكة في سنة 80 في
زمن عبد الملك أمر عامله بعمل ضفائر الدور الشارعة على الوادي وضفائر المسجد
وعمل الردم على أفواه السكك . وحفر عديّ عامل البصرة من قِبَل عمر بن عبد
العزيز بأمره نهر عدي .
ومن الأخبار التي تدل على شدة حبهم للرعية وكثرة بذلهم في إزاحة خللها
وإماطة أذاها - أنه شكا أهل البصرة إلى عامل يزيد على العراق ملوحة مائهم فكتب
بذلك إلى يزيد فكتب إليه : إن بلغت نفقة هذا النهر خراج العراق فأنفقه عليه ،
فحفر لهم النهر الذي يعرف بنهر ابن عمر وحفر عمالهم الجائرون الغاشمون ( كما
يقول جرجي أفندي زيدان ) والمنتسبون إليهم كثيرًا من الأنهار غير ما ذكر كنهر
معقل ، ونهر ديبس ، ونهر الأساورة ، ونهر عمرو ، ونهر أم حبيب ، ونهر
حرب ، ونهر بزيدان ، ونهر سلم ، ونهر ناقد ، ونهر خيرتان ، ونهر مرة ،
ونهر بشار ، ونهر بزور ، ونهر حبيب ، ونهر ذراع ، ونهر أبي بكرة ،
وغيرها من الأنهار وهذه الأنهار كلها حفروها [1] بالبصرة فما بال غيرها من
البلاد ؟
أما ما بذلوا من الأموال وأفرغوا من الجهد في بناء المسجد النبوي وتذهيب
البيت و المسجد الأموي الذي هو معدود من إحدى العجائب في كثرة نفقاته وعظمة
بنائه ودقة صنعه وبهجة منظره وحسن نظامه فهو أشهر من نار على علم .
وبنو أمية هم أول من اتخذ دار الضرب في الإسلام فكسوا به الإسلام رفعة
وأغنوه عن نقود الروم والفرس ونجوه مما أوعده الروم بنقش شتم النبي صلى الله
عليه وسلم عليها ، وهم الذين نقلوا الدفاتر والدواوين من الفارسية والرومية والقبطية
إلى العربية [2] فزادت العربية انتشارًا ونفوذًا ولم يمض برهة من الدهر حتى
أصبحت هذه البلاد عربية النزعة واللسان ، وهم أول من بنى مستشفى في الإسلام -
بنوه بدمشق سنة ثمان وثمانين ، جعلوا فيه الأطباء وأمروا بحبس المجذومين
وأجروا لهم الأرزاق ، وهم أول من أنشأ دارًا للعُميان ، وهم أول من عمر دار
الضيافة [3] بعد عمر بن الخطاب ، وهم أول من رثى للأيتام وتحنن عليهم ورتب
لهم المؤدبين ليعلموهم [4] .
***
نشر المعارف والعلم
أما العلم - فقد زخر بهم بحره ، وأزهر بدره ، فالقرآن الذي هو عمود
الإسلام ، ورأس العلوم ، وينبوع المعارف ، أدرك الأمة قبل اختلافها فيه عثمان بن
عفان وهو أموي . ثم بعد ذلك اختلطت العرب بالعجم واحتكت بهم ففسدت لغتها
وأسلمت العجم فلم تستطع السلامة من اللحن فكثر التصحيف في القرآن وانتشر
بالعراق ففزع الحجاج وهو أحد أمراء بني أمية إلى كتابه فوضعوا النقط والأعجام
[5] فعصموا به كتاب الله أن يتطرق إليه التصحيف والتحريف تطرقهما إلى التوراة
والإنجيل ، ووالله هذا أعظم مبرة برَّ بها الإسلام لا تساويها مبرَّة وأعظم منة منَّ بها
على الدين لا توازيها منة . ثم كتب الحجاج المصاحف وفرقها في الأمصار وكان
الوليد - الذي رماه صاحبنا بالاستهانة بالقرآن - يحث الناس على حفظ القرآن
وكان يجزل الصلات لحفظته ويضرب الذين لم يحفظوه [6] فكثر حفظته وعظم
قدرهم وجلت رتبتهم .
أما التفسير - ففي أيامهم نبغت أجلَّة المفسرين من التابعين ، وفي أيامهم دُوِّن
التفسير في الصحف فأول من وضع في التفسير ابن جبير بأمر عبد الملك [7] ثم
مجاهد .
أما الحديث - فكانوا يدرون على أهله الصلات ويبعثون إليهم بالهدايا
ويجرون لهم الأرزاق لينقطعوا إلى حفظ الحديث وروايته ونقله وكانوا يكرمون
الفقهاء ويجلون مقامهم ويراعون جانبهم ، فقد كان يصيح صائح من بني مروان في
موسم الحج : ألا لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح إجلالاً لشأنه ولكثرة علمه
بالمناسك [8] وكان عبد الملك أمر الحجاج وهو أميره على الموسم أن يقدم ابن عمر
في الحج ويقتص أثره في المناسك ، وكان سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد
والشعبي وميمون بن مهران والزهري وأيوب بن أبي تميمة وقبيصة بن ذؤيب
ورجاء بن الحياة أعزة عند بني أمية وكان أكثرهم عمالاً لهم وهم أساطين
الحديث وأئمة الرواية وأعلام النقل . وأنت تعلم أن أحاديث الرسول صلى الله عليه
وسلم لولا أنها استودعت بطون الصحف لضاعت بهلاك العلماء وإسراع الموت فيهم
، فأسألك بحرمة التاريخ مَنْ أمر أهل هذا الشأن بتدوينها في الكتب - أليس هو عمر
بن عبد العزيز الأموي ؟ فجاء في الآثار أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الآفاق :
( انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه ) وكتب إلى أبي بكر
بن حزم رأس المحدثين ( أن انظر ما كان من سُنة أو حديث فاكتبه لي فإني خفت
دروس العلم وذهاب العلماء ) وقد كتب ابن حزم كتبًا في الحديث فتوفي عمر ثم
وضع الكتب فيه ربيع بن صبيح وكان عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار
يعلمهم السنن والفقه [9] .
أما أصول اللغة ونحوها - فقد كان تدوينها بأمر أمراء بني أمية ، ذكر ابن
خلكان ( الملجد الأول صفحة 240 ) أن أبا الأسود الدؤلي استأذن زيادَ ابن أبيه -
وهو والي العراقين يومئذ - أن يضع للعرب ما يقيمون به لسانهم فأبى ثم بدا له
صواب رأيه فدعا الدؤلي وقال له : ضع للناس الذي نهيتك أن تضع لهم فوضعه
وأخذ عنه ما وضعه عتبة بن مهران المهري وعنه ميمون وعنه عبد الله الحضري
وعنه عيسى بن عمر وعنه الخليل [10] وهؤلاء كلهم كانوا في عصر بني أمية وهم
واضعو النحو ومدونو أصوله .
أما الشعر - ففي عصرهم فتقت ألسنة الشعراء وارتفع قدرهم وانتشر ذكرهم
ففحول الشعر وأمراء القول وفرسان القريض هم الفرزدق الدارمي و جرير الخطفي
و الأخطل التغلبي و عمر بن أبي ربيعة القرشي و كثير عزة و جميل بثينة
و مجنون ليلى و ذو الرمة غيلان ونصيب وهؤلاء كلهم كانوا يقصدونهم بجياد
قصائدهم فكانوا يغمرونهم بالجوائز فنطقت ألسنتهم بما أصبح زهرة للأدب وزينة
للغة .
وكانوا يحثون الناس على اقتناء الأدب وتناشد الشعر وتدارس أخبار الشعراء ،
وكانوا يستوفدون الشعراء ويستزيدونهم ويجيزونهم بالأموال الجزيلة وكانوا
يرسلون أبناءهم إلى البادية ليتلقنوا الأدب ويتلقفوا اللغة من أفواه الأعراب وأهل
البادية ، وقد جمع الوليد بن يزيد بن عبد الملك ديوان العرب وأشعارها وأخبارها
وأنسابها ولغاتها [11] .
أما علم التاريخ والسير والمغازي - فبعصرهم افتتح عصره ، وبأمرهم ارتفع
أمره ، ففحول أصحاب السيَر والمغازي هم : وهب بن منبه عالم اليمن المتوفى سنة
114 ومحمد بن مسلم الزهري صاحب عبد الملك المتوفى سنة 124 وموسى بن
عقبة المتوفى سنة 141 ولهؤلاء كلهم كتب في التاريخ والسير والمغازي[12]
ووضع في أيامهم عوانة المتوفى سنة 147 كتاب التاريخ ، وكتاب سيرة معاوية
وبني أمية ، وكان لملوك بني أمية رغبة شديدة في استطلاع الأخبار الماضية
وحوادث الأمم الخالية . قال المسعودي : إنه كان معاوية يجلس لأصحاب الأخبار
في كل ليلة بعد العشاء إلى ثلث الليل ويقوم فيأتيه غلمان وعندهم كتب
فيقرءون عليه ما في الكتب من أخبار الأمم وسير الملوك وسياسات الدول ، ولم
يصبر على ذلك حتى استحضر عالم عصره عُبيد بن شربة من صنعاء اليمن وسأله
عن الأخبار المتقدمة وملوك العجم وسبب تبلبل الألسنة وأمر افتراق الناس في البلاد ،
وأمره أن يدوّن ما علمه ، وعاش عبيد إلى أيام عبد الملك وتوفي وله من الكتب
كتاب الأمثال وكتاب أخبار الماضين [13] وأخذ عنه أناس سماهم ابن النديم وكان من
رواته زيد الكلابي في أيام يزيد بن معاوية عارف بأيام العرب وأحاديثها ( الفهرست )
صفحة 90 ( وقد كان هشام مشغوفًا بالسير والأخبار فنقل له جبلة بعض كتب
سير الفرس من الفارسية إلى العربية [14] وأمر هشام النقلة فنقلوا له كتاب تاريخ
ملوك الفرس وقوانين دولتهم وتراجم رجالهم وكان هذا الكتاب مصورًا ، ثم نقله سنة
113 رآه المسعودي سنة 303 في مدينة اصطخر كما ذكر في التنبيه صفحة
( 106 ) .
أما علوم الفلسفة ومنها الطب والكيمياء - فكان لهم في نقلهما إلى العربية
آثار صالحة فنقل ابن آثال لمعاوية كتب الطب من اليونانية وهذا أول نقل في
الإسلام ، وكان في البصرة في أيام مروان بن الحكم طبيب ماهر يهودي النِّحلة
عارف بالعربية اسمه ماسرجويه فنقل ماسرجويه هذا كناش القس أهرون بن أعين
من السريانية إلى العربية فلما تولى عمر بن عبد العزيز وجد هذا الكتاب في خزائن
الكتب في الشام فأخرجه للناس وبثه في أيديهم [15] و خالد بن يزيد بن معاوية حكيم
آل أمية أول من طلب علوم الفلسفة في الإسلام ، وخبره أنه كان يطمع في الخلافة
فلما وثب مروان عليها رغب خالد عنها إلى طلب العلم فاستقدم جماعة من فلاسفة
اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر ومنهم مريانوس الرومي الذي أخذ عنه صنعة
الكيمياء والطب وأمرهم بنقل الكتب من اليونانية والقبطية إلى العربية فنقلوها له
ولخالد كلام في الكيمياء والطب - وكان بصيرًا بهذين العلمين متقنًا لهما - وله
رسائل دالة على معرفته وبراعته كما أخبر به ابن خلكان ، وقد ذكر له ترجمة
صالحة ابن النديم في فهرسته ونقل سالم كاتب هشام - وهو أبو جبلة المار ذكره -
رسائل أرسطاطاليس إلى الإسكندر فبناء على ما قدمنا من القول بنو أمية هم أول
من استقدم الفلاسفة واستدناهم في الإسلام ، هم أول من أمر بنقل العلوم إلى العربية
في الإسلام ، هم أول من أنشأ خزائن للكتب في الإسلام ، وقد ضربنا صفحًا عما
كان لآل أمية بالأندلس في السياسة والعلم من المآثر الحسنة والأعمال الجليلة والسير
العادلة . فهل لك أيها الفاضل المؤلف إلى الإذعان للحق من سبيل ، وإلى الرجوع
عن ضلال الرأي من طريق ؟
***
صنيع المؤلف بالعباسية
عهدنا الوحوش الضارية مع جفاء طبعها وقسوة قلبها وكونها مطبوعة على
الافتراس والفتك والارتواء بالدم وإذا دخلت غابتها وأحاطت بها عائلتها تبدل القسوة
بالرحمة والغلظة باللطف والغضب بالحنان ، فبينما أحدها عبوس كاشر عن الأنياب
كالح الوجه مستبشع المنظر كريه الهيئة إذ هو هش بش حنون عطوف يذوب لطفًا
ورِقَّة ، وكذلك شأن قواد الجند وأبطال الحرب فإنك ترى أحدهم إذا قاتل الأكفاء
وناطح الأقران فهو شهاب ينقضّ ، ونار تلتهب ، وسعير تفور ، وإذا عاشر
الأصحاب فهو ألينهم جانبًا ، وأحلاهم خلقًا ، وأوسعهم حلمًا ، وأرقهم طبعًا ، وقد
جربنا المؤلف وعجمنا عوده في معاملته مع أعدائه ( بني أمية ) فلننظر كيف حاله
في معاشرته مع أصدقائه ( العباسية ) .
قال المؤلف :
( فحبب بعضهم إلى المنصور أن يستبدل الكعبة بما يقوم مقامها [16] في
العراق وتكون حجًّا للناس فبنى بناءً سماه القبة الخضراء تصغيرًا للكعبة وقطع
المِيرة في البحر عن المدينة ) ( الجزء الثاني صفحة 30 ) .
وقال : ( وأراد المعتصم أن يستغني عن بلاد العرب جميعًا وكان قد بنى
سامرَّا بقُرب بغداد وأقام فيها جنده فأنشأ فيها كعبة وجعل حولها طوافًا واتخذ مِنى
و عرفات إلخ ) ( الجزء الثاني صفحة 32 ) .
وقال : ( فلما أفضت الخلافة إلى المأمون إلخ - ثم قال : فأخذ يناظر أشياعه
وصرح بأقوال لم يكونوا يستطيعون التصريح بها خوفًا من غضب الفقهاء وفي
جملتها القول بخلق القرآن أي أنه غير منزَّل ) ( الجزء الثالث صفحة 141 ) .
غير خافٍ على أحد أن العباسية إن افتخروا وتطاولوا على منازعيهم في
الرئاسة فمعظم فخرهم وأبين حُججهم أنهم بنُو عم النبي وسَدنة البيت وخدمة الحرم
ودعاة الإسلام ونقباء القرآن وصاحبنا يقول : ( إن المنصور وهو مؤسس دولتهم
وفاتحة خلفائهم بنى القبة الخضراء إرغامًا للكعبة وقطع المِيرة عن المدينة تضييقًا
على أهلها وأن المأمون - وهو أفضل خلفائهم دينًا وورعًا - كان يُنكر نزول القرآن
. وإن المعتصم - وهو فحلهم وواسطة عقدهم - بنى كعبة في سامرَّا وجعل لها
طوافًا . ولعلك تقول : إن الحاكم بالعدل والقائم بالقسط ليس له حميم ولا عدو فهو
يتحرى الصدق ويدور مع الحق كيفما دار . ...
فالمؤلف إذا أتته سيئة من بني العباس قضى عليهم من غير محاباة لهم ولا
ميل إليهم ، وكذلك إذا عرضت له حسنة من بني أمية فهو يوفيهم حقهم من
الاستحسان وحسن القول وتنويه الذكر - هيهات هذا كان رجاؤنا فخاب الظن
وكذب الأمل وذهبت الثقة فإن المؤلف لما ذكر بني أمية عقد لمثالبهم أبوابًا منها :
استخفافهم بالدين ، وذكر فيه قتال عبد الملك مع ابن الزبير فقلب الرواية كما سبق
ذكره ، فلو كان مغزى المؤلف الصدق وبيان الحقيقة لكان يعقد بابًا للعباسية أيضًا
يذكر فيه استخفافهم بالكعبة وإنكارهم لنزول القرآن ، وههنا موضع نظر إلى دقة
مكيدة المؤلف وحسن احتياله فإنه يريد من طرف الغض من الكعبة والحط من
القرآن ومن طرف الانتصار للعباسية والذب عنهم ؛ لأجل أنهم كسروا شوكة
العرب واتخذوا العجم بطانتهم وعمود دولتهم فذكر استخفافهم بالكعبة ولكن مغموسًا
مبددًا تحت عنوان ثروة الدولة الإسلامية ليأخذ بطرفي المطلوب ويفوز ببغيتيه معًا .
أما كشف الجلية عن أصل الحال فالأمر أن من يدعي الخلافة ( وهي منصب
ديني ) ويرشح لها نفسه لا يجد إلى ذلك سبيلاً إلا بالتظاهر بالدين ، والتصبغ به
ونصب نفسه لإعلاء كلمته ورفع مناره وحمل الناس على تعظيم شعائره والتدلي إلى
خاصة القائم به ؛ ليجلب عطف القلوب وجذب الأميال ورضاء العامة والتحبب إلى
الناس ؛ ولذلك كان الخلفاء ( بنو أمية والعباسية كلاهما ) يصلُّون بالناس ويؤمونهم
ويحضرون الموسم ويحجون بهم أو يرسلون مِن خاصتهم مَن ينوب منابهم
ويخطبون على المنابر ؛ ولذلك لما أراد أهل الشام الميكدة بعلي رضي الله عنه
ورفعوا المصاحف كفَّ أصحاب علي عن القتال ؛ ولما قال عليّ ٌ هذه خديعة منهم .
قالوا : إذا لم تذعن لهذا خلعناك ، فلم يقدر على خلافهم ورضي بما لم يكن وفق
رضاه ، ولما فعل يزيد ما فعل ضج الناس وكادوا يسطون عليه لولا أنه مات عاجلاً ،
ولما أراد الحجاج قتال ابن الزبير أغراهم بأن ابن الزبير ألحد في الدين ، وزاد
على الكعبة ولذلك نصب المناجيق تلقاء الزيادة التي كان زادها ابن الزبير ( رضي
الله عنه ) ولما جاهر الوليد بن يزيد بالفسق قاموا عليه وقتلوه ، ولما قال أبو نواس
يمدح الأمين وصدَّر القصيدة بهذا البيت :
ألا فاسقني خمرًا وقل لي : هي الخمر ... ولا تسقني سرًّا فقد أمكن الجهر
اتخذ المأمون هذا وسيلة لإغراء الناس على مخالفة الأمين . فهل تصدق بعد
كل ذلك بأن المنصور أو المعتصم كان يقدر أو يسوغ له أن يصغر شأن الكعبة
ويمس من شرفها ؟ وهل كان يقدر المأمون أن يحمل الناس على إنكار القرآن
والعياذ بالله ؟ فأما استشهاد المؤلف في هذه الواقعة بابن الأثير وغيره فكله تحريف
وتدليس وسوء تأول ، ولولا أنني سئمت من كشف دسائسه مرة بعد أخرى
لأوضحتُ الأمر وبينت حقيقة الحال .
قال المؤلف : ولما تولى المعتصم سنة 218 هـ واصطنع الأتراك والفراعنة
ازداد العرب احتقارًا في عيون أهل الدولة وتقاصرت أيديهم عن أعمالها حتى في
مصر .. . - إلى أن قال - : فأصبح لفظ ( عربي ) مرادفًا لأحقر الأوصاف عندهم ،
ومن أقوالهم : العربي بمنزلة الكلب اطرح له كسرة واضرب رأسه ، وقولهم : لا
يفلح أحد من العرب إلا أن يكون معه نبي ينصره الله به ( الجزء الثاني صفحة 31
و32 ) .
من أحسن أعمال آل عباس عند المؤلف أنهم صغروا شأن العرب وساموهم
الخسف وسلطوا عليهم الأعاجم والأتراك وجعلوا هؤلاء ولاة البلاد ، بيدهم الأمر
والنهي والرفع والخفض والعقد والحل والنقض والإبرام . ذكر ذلك في غير موضع ،
وكلما ذكره وجد من نفسه ارتياحًا إليه وشفاء لحزازته وهزة لعطفه ونيلاً لأربه ،
ومع أن الواقعة مكذوبة أو محرفة على جري عادته فنحن لا ننازعه في ذلك ونطوي
الحديث على غرته ولكن نقول : إذا مدح أحد مثلاً دولة فرنسة ، وقال : إنهم ذللوا
الفرنسيين وأرغموا أنوفهم واستلبوهم المناصب وقلدوا الولاياتِ الأجانبَ ، وجعلوهم
قابضي أزمَّة الأمور يولون ويعزلون ، وينفقون ويمسكون ، فهل هذا يكون مدحًا
ترضى به دولة فرنسة أو يكون هذا عارًا يُسْتَحى منه ؟ ومسبّة يستنكف عنها ،
وشناعة تشمئز منها القلوب ؟ وأنصف من نفسك ما كان حظ العباسيين من تولية
الأعاجم . أما آل برمك فلا ننكر فضلهم ومحاسن آثارهم ، ولكنهم مع كل ذلك
استأثروا بالأموال وانفردوا بالأعمال حتى لم يكن حظ الخلفاء من الخلافة إلا الاسم
فقط ، فاضطر الرشيد إلى النكبة بهم وإزالة دولتهم .
وأما الأتراك فصاروا يلعبون بالخلافة كل ملعب ، فكم قتلوا من الخلفاء
وسجنوا وعذبوا بأنواع العذاب وتركوهم يموتون جوعًا يسألون الناس ولا يعطون .
فهل هذه سياسة تمدح ومأثرة تذكر وفضيلة يفتخر بها ؟
***
الخلفاء الراشدون
المؤلف حرفته تأليف الكتب متكسبًا بها ، وهو يعرف حق المعرفة أنه لو انتقد
على الخلفاء الراشدين ، ونال منهم تصريحًا كَسَدَ سوقُه ، وخابت صفقته ، فدبر
لذلك حيلاً لا يكاد يتفطن لها اللبيب المتيقظ فضلاً عن البليد المتساهل ، فعمد إلى
رءوس المثالب ونسبها إليهم بأنواع الاحتيال ، فتارةً بتبديدها في ثنيات الكلام
وإبعادها عن موضع العناية ، وتارةً بإيرادها عرضًا مُوهمًا عدم الاعتناء بها ، وتارةً
بذكرها محتالاً لها عذرًا . وإذا كررت النظر في كلامه وتصفحت ما فيه وجمعت ما
هو مبدَّد ، ونَظَمْت ما هو مفرَّق تكاد تستيقن أن الخلفاء كانوا من أشد أعداء العلم ،
وأنهم أبادوا الكتب والخزانات ، واضطهدوا أهل الذمة وجعلوهم أذلاء لا يؤذن لهم
ولا يُؤْبَه بهم .
أما كونهم أعداء العلم فبيَّن المؤلف ذلك إجمالاً وتفصيلاً فقال : ( كان الإسلام
في أول أمره نهضة عربية ، والمسلمون هم العرب ، وكان اللفظان مترادفين ، فإذا
قالوا : العرب أرادوا المسلمين ، وبالعكس ؛ ولأجل هذه الغاية أمر عمر بن الخطاب
بإخراج غير المسلمين من جزيرة العرب .. .. - إلى أن قال : - وتمكن هذا
الاعتقاد في الصحابة لما فازوا في فتوحهم وتغلبوا على دولتي الروم والفرس ، فنشأ
في اعتقادهم أنه لا ينبغي أن يسود غير العرب ولا يتلى غير القرآن إلخ ) .
( أما في الصدر الأول فقد كان الاعتقاد العام أن الإسلام يهدم ما كان قبله
فرسَخ في الأذهان أنه لا ينبغي أن ينظر في كتاب غير القرآن إلخ .
( فتوطدت العزائم على الاكتفاء به عن كل كتاب سواه ، ومحو ما كان قبله
من كتب العلم في دولتي الروم والفرس كما حاولوا بعدئذ هدم إيوان كسرى و أهرام
مصر وغيرها من آثار الدول السابقة ) إلخ ( الجزء الثالث صفحة 39 ) .
( وبناء على ذلك هان عليهم إحراق ما عثروا عليه من كتب اليونان والفرس
في الإسكندرية و فارس ) إلخ ( الجزء الثالث صفحة 135 ) .
***
حريق خزانة الإسكندرية
لم يقتنع المؤلف بذلك فعقد بابًا لإثبات أن حريق خزانة الإسكندرية كان بأمر
عمر بن الخطاب وأطال وأطنب في ذلك واستدل عليه بستة دلائل [17] نحن نذكرها
مع الرد عليها إجمالاً :
قال : أولاً - ( قد رأيت فيما تقدم رغبة العرب في صدر الإسلام في محو كل
كتاب غير القرآن بالإسناد إلى الأحاديث النبوية وتصريح مقدمي الصحابة ) الذي
ذكر قبل ذلك ( انظر صفحة 39 9 ) وحُوِّل عليه ههنا أقوال منها : ( إن الإسلام يهدم
ما كان قبله ) وكلنا يعرف أن المراد به إبطال عوائد الجاهلية ومزعوماتها وليس
المراد محو الكتب أو إحراق الخزائن ولكن لما كان المؤلف دخيلاً فينا غريب الذوق
والمعرفة حمل الكلام على غير محله أو لعله عارف يتجاهل وبصير يتعامى .
ومنها قول النبي عليه السلام : ( لا تصدِّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا
آمنا بالذي أُنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ) وأي متعلق في هذا ؟ بل هو
مخالف لما يريده المؤلف فإن الحديث يأمر بالإيمان بما أنزل إلى أهل الكتاب ، أما
الإغفال عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم فلأجل كون أهل الكتاب غير موثوق بهم
في الرواية ، ومنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( رأى في يد عمر ورقة من
التوراة فغضب حتى تبين الغضب في وجهه ثم قال : ألم آتكم بها بيضاء نقية ، والله
لو كان موسى حيًّا ما وسعه إلا اتباعي ) وهذا لا مستند فيه للمؤلف فإن النبي صلى
الله عليه وسلم خاف على عمر عنايته بالتوراة والتصديق بكل ما فيها مع كونها
مغيَّرة لعبت بها أيدي النَّقَلة ؛ ولذلك قال : ألم آتكم بها بيضاء نقية وهذا لا يستلزم
بل ليس فيه أدنى إشارة إلى محوها وإلحاق الضرر بها ونزيدك إيضاحًا للكلام بما
فيه ثلج الصدر وفصل الخطاب ، فاعلم أن عمود الإسلام وقطب رحاه هو القرآن
وعليه المعول وهو المستمسك في كل باب وكان هو العروة الوثقى في ذلك العصر
للصحابة وأهل القرن الأول ، والقرآن له عناية كبرى بالتوراة والإنجيل وهو الذي
نوّه بذكرهما وعظم شأنهما ، فقال : { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } ( النحل : 43 ) ، ( والمراد بالذكر التوراة ) - { إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى } ( المائدة : 44 ) - { وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ
لأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم } ( المائدة : 66 ) - { وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرَاةِ } ( آل عمران : 50 ) - { مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ
يَدَيْهِ } ( يوسف : 111 ) ، ( أي التوراة والإنجيل ) .
ولأجل ذلك كان عدة من أجِلَّة الصحابة منقطعين إلى قراءة التوراة والإنجيل
والاعتناء بحفظهما ودرسهما ولم يكتفوا بها بل أخذوا يروون ويتفاوضون كل ما
وجدوا من أقاصيص أهل الكتاب ومروياتهم وقد اعترف بذلك المؤلف نفسه فقال :
( وقد رأيت أن العمدة في التفسير على النقل بالتواتر والإسناد من النبي
فالصحابة فالتابعين ، والعرب يومئذ أميون لا كتابة عندهم فكانوا إذا تشوقوا إلى
معرفة شيء مما تتوق إليه نفوسهم البشرية من أسباب الوجود وبدء الخلقة وأسرارها
سألوا عنه أهل الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى - إلى أن قال - : فكانوا إذا
سُئلوا عن شيء أجابوا بما عندهم من أقاصيص التلمود والتوراة بغير تحقيق
فامتلأت كتب التفسير من هذه المنقولات ( الجزء الثالث صفحة 64 ) .
( يتلى )
((يتبع بمقال تالٍ))
__________
(1) راجع لكل ذلك البلاذري .
(2) راجع لكل ذلك فتوح البلدان للبلاذري .
(3) اليعقوبي ذكر الوليد .
(4) السيوطي ذكر الوليد .
(5) ابن خلكان ذكر الحجاج .
(6) العقد أخبار الوليد ص 239 وابن الأثير سنة 88 .
(7) ميزان الاعتدال للذهبي ذكر عطاء بن دينار .
(8) ابن خلكان ذكر عطاء .
(9) مقدمة الزرقاني على الموطأ .
(10) ابن خلكان مجلد 2 ص 380 .
(11) الفهرست صفحة 91 .
(12) راجع كشف الظنون وتذكرة الحفاظ .
(13) كتاب الفهرست صفحة 244 .
(14) راجع الفهرست أيضًا .
(15) أخبار الحكماء وعيون الأبناء .
(16) كانت العبارة أن يقول : أن يستبدل بالكعبة إلخ اهـ مصحح .
(17) الجزء الثالث من تمدن الإسلام ص 40 .
(15/342)
جمادى الآخرة - 1330هـ
يونيه - 1912م
يونيه - 1912م
(15/)
الكاتب : شبلي النعماني
__________
نقد تاريخ التمدن الإسلامي
بفلم الشيخ شبلي النعماني
( 5 )
وذكر المؤلف عقيب ذلك وهب بن منبه وأنه قرأ من كتب الله 72 كتابًا ثم قال :
( فكان للعرب ثقة كبرى فيه ) وقال بعد ذلك : ( فكانت كتب التفسير في القرون
الأولى محشوة بالأخبار وفيها الغث والسمين مما نقل إليها من الأديان الأخرى ) .
فانظر كيف يناقض المؤلف نفسه ! فقال :
( فنشأ في اعتقادهم أنه لا ينبغي أن يسود غير العرب ولا يتلى غير القرآن -
فرَسَخ في الأذهان أنه لا ينبغي أن يُنظر في كتاب غير القرآن - فتوطدت
العزائم على الاكتفاء به ( أي القرآن ) عن كل كتاب سواه ومحو ما كان قبله من
كتب العلم ) .
ويقول الآن : إن كتب التفسير في القرون الأولى محشوة بالأخبار .. .. مما
نقل إليها من الأديان الأخرى ، وإنه كان للعرب ثقة كبرى في وهب بن منبه ، وإن
كتب التفسير امتلأت من منقولات أهل الكتاب ، فلو كان أهل القرون الأولى
يبغضون ما سوى القرآن ويمحون ما كان قبله من العلم كما يدعيه المؤلف فمن روى
الإسرائيليات وأقاصيص التلمود والتوراة وحشاها في التفسير ؟ ولما كانت المسألة
موضع زيادة تفصيل نزيدك توضيحًا وتفصيلاً :
كان لعدة من الصحابة وكبراء التابعين عناية كبرى بالتوراة وغيرها من
الكتب السماوية فمنهم أبو هريرة الذي كان ملازمًا للنبي عليه السلام منقطعًا إلى
الرواية - لم يدانه أحد في كثرة الرواية - كان مشغوفًا بقراءة التوراة ودرسها ، قال
العلامة الذهبي في طبقات الحفاظ في ترجمته : ( عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه
لقي كعبًا - وهو حبر لليهود - فجعل يحدثه ويسأله فقال كعب : ما رأيت أحدًا لم
يقرأ التوراة أعلم بما فيها من أبي هريرة ) .
ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص أحد من هاجر قبل الفتح ، قال الذهبي في
طبقات الحفاظ : ( كان من أيام النبي صوّامًا قوامًا تاليًا لكتاب الله طلابةً للعلم كتب
عن النبي صلى الله عليه وسلم علمًا كثيرًا ، وكان أصاب جملة من كتب أهل الكتاب
وأدمن النظر فيها ورأى فيها عجائب ) .
ومنهم عبد الله بن سلام حليف الأنصار أسلم وقت مقدم النبي وفيه ورد قوله
تعالى : { وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكِتَابِ } ( الرعد : 43 ) نقل الذهبي بعد ذكر فضائله
وكونه عالم أهل الكتاب رواية بالإسناد يرفعه إلى عبد الله بن سلام أنه جاء إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني قرأت القرآن والتوراة فقال : اقرأ هذا ليلة
وهذا ليلة ، فهذا إن صح ففي الرخصة في تكرير التوراة وتدبرها .
ومنهم كعب الأحبار كان من كبار أهل الكتاب ، أسلم في زمن أبي بكر ، قال
الذهبي : ( قدم من اليمن في دولة أمير المؤمنين عمر فأخذ عنه الصحابة وغيرهم
وأخذ هو من الكتاب والسنة عن أصحابه ) فهذا كأنه تصريح في أن الصحابة أخذوا
عنه علم أهل الكتاب .
ومنهم وهب بن منبه قال الذهبي في ترجمته : ( وعنده من أهل الكتاب شيء
كثير فإنه صرف عنايته إلى ذلك ، وكان ثقة واسع العلم ينظر بكعب الأحبار في
زمانه ) وعن وهب قال : يقولون : عبد الله بن سلام أعلم أهل زمانه وكعب أعلم
أهل زمانه ) .
فهل بعد كل هذا يصح قول المؤلف : إن الصحابة ومن يليهم كانوا يقولون :
إنه لا ينبغي أن يقرأ كتاب غير القرآن ومحوا ما كان قَبْلهم من العلم ؟ عياذًا بالله .
قال المؤلف : ( ثانيًا جاء في تاريخ مختصر الدول لأبي الفرج - ثم نقل
رواية الإحراق برمتها وأطال في إثبات أن أبا الفرج ليس بأول من روى هذه
الرواية بل ذكرها عبد اللطيف البغدادي عرضًا في ذكره عمود السواري وذكرها
القفطي في تاريخ الحكماء ) .
لا ننازع المؤلف في أن أبا الفرج مسبوق في ذكر هذه الرواية بالقفطي
والبغدادي ولكن ماذا ينفعه ذلك ؟ فإن البغدادي وهو أقدمهما من أهل القرن السادس
للهجرة وذكر الرواية من غير إسناد ومن غير إحالة على كتاب .
تعود المؤلف من صباه قبول مختلقات أهل الكتاب وأوهامهم فسبب ذلك أنه
يزن التاريخ الإسلامي بميزان غير ميزاننا ؛ ولذلك يصغي إلى كل صوت ويستمع
لكل قائل ، لا يعرف أن هذا الفن له أصول ومبادٍ وقواعد وما لم تكن الرواية مطابقة
لهذه الأصول اليقينية لا يلتفت إليها أصلاً ، منها أن الناقل للرواية لا بد أن يكون شهد
الواقعة فإن لم يشهد فليبين سند الرواية ومصدرها حتى تتصل الرواية إلى من
شهدها بنفسه .
ومنها أن يكون رجال السند معروفين بصدقهم وديانتهم ، ومنها أن لا تكون
الرواية تخالف الدراية ومجاري الأحوال ؛ ولذلك اهتم مؤرخو الإسلام قبل كل شيء
بضبط أسماء الرجال والبحث عن سيرهم وأحوالهم وديانتهم ومحلهم من الصدق
فدونوا كتب أسماء الرجال وكابدوا في ذلك محنة يضيق عنها النطاق البشري فعملوا
كتبًا غير محصورة منها الكامل لابن عديّ والثقاة لابن حبان وتهذيب الكمال للمِزِّيِّ
وتهذيب التهذيب لابن حجر وطبقات الصحابة لابن سعد ولابن ماكولا وابن عبد
البر ولابن الأثير ولابن حجر وتهذيب الأسماء للنووي وميزان الاعتدال للذهبي
ولسان الميزان لابن حجر .
وتجد كتب القدماء من مؤرخي الإسلام كلها أو أكثرها كتاريخ البخاري وسيرة
ابن إسحاق وتاريخ الطبري وابن قتيبة وغيره مسلسلة الإسناد مبينة الأسماء ليمكن
نقد الرواية ومعرفة جيدها من زيفها .
فأول شيء يهمنا في هذا البحث أن نرى : هل ذكر القفطي والبغدادي هذه
الرواية مسندة وذكرا مصدر الرواية وأسماء رواتها أم لا ؟
وأنت تعلم أن البغدادي والقفطي من رجال القرن السادس والسابع فأي عبرة
برواية تتعلق بالقرن الأول يذكرانها من غير سند ولا رواية ولا إحالة على كتاب ؟
أما كتب القدماء الموثوق بها فليس لهذه الرواية فيها أثر ولا عين ، هذا تاريخ
الطبري واليعقوبي والمعارف لابن قتيبة والأخبار الطوال للدينوري وفتوح البلدان
للبلاذري والتاريخ الصغير للبخاري وثقاة ابن حبان والطبقات لابن سعد قد
تصفحناها وكررنا النظر فيها ومع أن فتح الإسكندرية مذكور فيها بقضها
وقضيضها فليس لحريق الخزانة فيها ذكر .
وعلاوة على ذلك فإن في فتح مصر كتبًا مختصة بذلك مثل خطط مصر
للكندي وكشف الممالك لابن شاهين وتاريخ مصر لعبد الرحمن الصوفي وتاريخ
مصر لابن بركات النحوي وتاريخ مصر لمحمد بن عبد الله وغيرها مما ذكرها
صاحب كشف الظنون ، والمقريزي جمع وأوعى كل ذلك ولم يترك رواية ولا
خبرًا يتعلق بمصر إلا وذكره عند تفصيل الفتح ولم يذكر هذه الواقعة عند ذكر فتح
الإسكندرية .
قال المؤلف :
( وأما خلو كتب الفتح من ذكر هذه الحادثة فلا بد له من سبب والغالب أنهم
ذكروها ، ثم حذفت بعد نضج التمدن الإسلامي واشتغال المسلمين بالعلم ومعرفتهم
قدر الكتب فاستبعدوا حدوث ذلك في عصر الراشدين فحذفوه أو لعل لذلك سببًا آخر
إلخ ) ( الجزء الثالث صفحة 44 و45 ) .
لا يستبعد مثل هذا الكلام من مثل هذا المؤلف ! وكيف يقدِّر ديانة مؤرخي الإسلام وشدتهم في تحري الصدق ونزاهتهم عن التغيير والتحريف وبراءة
ساحتهم عن الحذف والإسقاط مَن صارت غريزته تعمُّد الكذب والتحريف
والخيانة والمحو والإثبات ؟
قال المؤلف :
( ثالثًا ) ورد في أماكن كثيرة من تواريخ المسلمين ، خبر إحراق مكاتب
فارس وغيرها على الإجمال وقد لخصها صاحب كشف الظنون إلخ ( الجزء الثالث
صفحة 45 ) .
انظر إلى هذا الكذب الفاحش والخديعة الظاهرة فإن صاحب الكشف ذكر ما
ذكر من عند نفسه من غير نقل رواية ولا استناد ولا استشهاد بكتاب ولا ذكر ناقل
أو مؤرخ - وصاحبنا يقول : إنه ورد في أماكن كثيرة من تواريخ المسلمين خبر
إحراق المكاتب وقد لخصها صاحب كشف الظنون ، فأين الأماكن الكثيرة وأين
التلخيص ؟ !
أما قول صاحب كشف الظنون فقد ورد عرضًا وتطفلاً وكذلك قول ابن خلدون
وأمثال هذه المواقع لا تحتاج إلى كبير اعتناء وزيادة احتياط ؛ ولذلك لما ذكر ابن
خلدون فتح مصر والإسكندرية وهو المظنة لذكر هذه الواقعة لم يتفوه بهذه الرواية
أصلاً ، ثم إن ابن خلدون وصاحب كشف الظنون من رجال القرن الثامن وبعده فما
لم يذكرا من أين أخذا هذه الرواية لا يُعبأ بها ولا يلتفت إليها .
قال المؤلف :
( رابعًا ) أن إحراق الكتب كان شائعًا في تلك العصور .. .. . كما فعل عبد
الله بن طاهر بكتب فارسية إلخ ( الجزء الثالث صفحة 45 ) .
يا للعجب ! عبد الله بن طاهر من قواد المأمون ومن رجال الأدب وهذا
العصر يمتاز بكونه عصر العلم والمعارف وقد كانت للدولة ورجال حاشيتها
وغيرهم عناية كبرى بكتب الأوائل وكانوا يستجلبون الكتب من فارس وبلاد الروم
وغيرها - وتجد تفاصيل ذلك في فهرست ابن النديم وطبقات الأطباء وأخبار
الحكماء وغيرها ، فكيف يعوّل على هذه الرواية التي ما ذكرها أحد من ثقاة
المؤرخين وإنما استند المؤلف ( ببراون المعلم الإنكليزي ) وهو نقلها من تذكرة
( دولت شاه ) وهو كتاب جامع لكل غث وسمين ، ولو صح نقلها لكانت على سبيل
الندرة والشذوذ ، فهل يصح قول المؤلف : ( إن إحراق الكتب كان شائعًا في تلك
العصور ) ؟
قال المؤلف :
( خامسًا ) إن أصحاب الأديان في تلك العصور كانوا يعدّون هدم المعابد
القديمة وإحراق كتب أصحابها من قبيل السعي في تأييد الأديان الجديدة ثم ذكر في
تأييد ذلك عمل إمبراطرة الروم وإحراق كتب المعتزلة ج 3 ص 46 .
نعم ولكن الراشدين لا يقاسون بغيرهم ، ثم إن المسألة ليست قياسية فما لم
تثبت بالرواية لا ينفع مجرد القياس .
قال المؤلف :
( سادسًا ) في تاريخ الإسلام جماعة من أئمة المسلمين أحرقوا كتبهم من تلقاء
أنفسهم ( ثم ذكر بعض الحوادث في تأييد ذلك ) ج 3 ص 46 .
عجبًا لمثل هذا الاستدلال ! فإن المرء يجوز له أن يفعل بملكه ما يشاء وأي
حجة في ذلك لإحراق كتب أقوام أخر ؟
إن هذه القياسات الواهية لا تغني شيئًا ولكن لو أردنا أن نستشفي في ذلك
البحث بالقياس والأمارات فعلينا أن ننظر ما كان صنيع الخلفاء الراشدين بآثار أهل
الذمة ومعابدهم وكنائسهم وأمتعتهم وخزائنهم ، إن الأصل في ذلك عهد النبي صلى
الله عليه وسلم الذي كتبه لأهل نجران وقد ذكره القاضي أبو يوسف في كتاب
الخراج بحروفه .
( ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم
وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبِيَعهم وكل ما تحت أيديهم
من قليل أو كثير ) ( كتاب الخراج طبع مصر صفحة 41 ) .
فكان هذا العهد هو العمدة للصحابة عضوا عليه بالنواجذ وتجد في كل عهود
الخلفاء الراشدين كعهد نجران ومصر و الشام و الجزيرة أن هذا الأصل أي ذمة الله
ورسوله على أرضهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير محفوظ باقٍ على حالته
الأصلية وعهد مصر هو هذا .
(هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم ودمهم
وأموالهم وصاعهم ومدهم وعددهم ) .
وذكر في معجم البلدان رواية بزيادة ( أن لهم أرضهم وأموالهم لا يتعرضون
في شيء منها ) وأنت تعلم ما لعمر الفاروق من العناية والشدة في وفاء العهد بأهل
الذمة وغيرهم ومع عهده بأنهم لا يتعرضون في شيء من أموالهم وكل ما تحت
أيديهم كيف كان يتعرض لخزانة كتبهم التي هي من أنفس ذخائرهم وأغلاها ؟
اعلم أن مسألة إحراق خزانة الإسكندرية موضوع مهم عند أهل أوروبة وقد
أطال البحث فيه إثباتًا ونفيًا وممن ألم بهذا البحث إجمالاً وتفصيلاً المعلم ( وايت )
والمعلم ( دساسي ) الفرنسي في ترجمة كتاب الإفادة والاعتبار و ( واشنكتن أدونك )
و ( داربر) الأمريكاني صاحب كتاب الجدال بين العلم والدين و كرجين و سيديو
الفاضل الشهير الفرنسي في تاريخ الإسلام والمعلم رينان الفيلسوف الفرنسي في
خطبته الإسلام والعلم و ( أرتركليين ) ، وللمعلم ( كريل ) الألماني رسالة مستقلة
في هذا البحث قدمها في المؤتمر الشرقي الذي انعقد سنة 1828 م أورد فيها كل ما
كتب الباحثون في هذا البحث نفيًا أو إثباتًا وقد طالعت كل هذه المباحثات والمقالات
وعملت رسالة في اللسان الأردي وترجمت إلى الإنكليزية ثم إلى العربية ترجمها
أحد أهل الشام وطبع شطر منها في جريدة ثمرات الفنون . ومجلة المقتبس .
والحاصل أن محققي أهل أوروبة قضوا بأن الواقعة غير ثابتة أصلاً منهم
( جيين ) المؤرخ الشهير الإنكليزي ودريير الأمريكاني وسيديو الفرنسي وكريل
الألماني والمعلم رينان الفرنسي . عمدتهم في إنكار ذلك أمران الأول أن الواقعة
ليس لها عين ولا أثر في كتب التاريخ الموثوق بها كالطبري وابن الأثير والبلاذري
وغيرها مما مر ذكرها وأول من ذكرها عبد اللطيف البغدادي والقفطي وهما من
رجال القرن السادس والسابع ولم يذكرا مصدرًا للرواية ولا سندًا - والثاني أن
الخزانة كانت ضاعت قبل الإسلام أثبتوا ذلك بدلائل لا يمكن إنكارها .
قال المؤلف :
( قلنا فيما تقدم : إن الخلفاء الراشدين كانوا يخافون الحضارة على العرب - ..
ولذلك منعوهم من تدوين الكتب - .. .. وكان هذا الاعتقاد فاشيًا في الصحابة
والتابعين وتمسك به جماعة من كبارهم وكانوا إذا سئلوا تدوين علمهم أبوا
واستنكفوا ) إلخ ( الجزء الثالث صفحة 50 ) .
أطال المؤلف ونقل أقولاً عديدة في إثبات أن الخلفاء الراشدين والصحابة كانوا
يمنعون الناس عن الكتابة والتأليف ونحن لا ننكر أن هذا كان مذهبًا لبعض الصحابة
والتابعين ولكن الذين رخصوا في ذلك وأمروا بالكتابة والتدوين أكثرهم عددًا
وأرجحهم ميزانًا وأوسعهم نفوذًا ، وقد عقد المحدث المشهور القاضي ابن عبد البر
في كتابه جامع بيان العلم ( انظر 36 طبع مصر ) بابًا في إثبات ذلك ونحن ننقل
شطرًا منه قال ( وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( قيدوا العلم بالكتاب ) وعن عبد الملك بن سفيان عن عمه أنه سمع عمر بن
الخطاب يقول قيدوا العلم بالكتاب وعن معن قال : أخرج إليّ عبد الرحمن بن
عبد الله بن مسعود كتابًا وحلف لي أنه خط أبيه بيده ، وعن أبي بكر قال : سمعت
الضحاك يقول : إذا سمعت شيئًا فاكتبه ولو في حائط .
وعن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس يسمع منه الحديث
فيكتبه في واسطة الرحل فإذا نزل نسخه وعن أبي قلابة قال الكتاب أحب إلينا من
النسيان وعن أبي مليح قال يعيبون علينا الكتاب وقد قال الله { عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي
كِتَابٍ } ( طه : 52 ) وعن عطاء عن عبد الله بن عمرو قلت يا رسول الله أأقيد
العلم ؟ قال : ( قيد العلم ) قال عطاء : قلت : وما تقييد العلم ؟ قال : الكتاب ، وعن
عبد العزيز بن محمد الداروردي قال : أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب ، وعن
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : كنا نكتب الحلال والحرام
وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس .
وعن سوادة بن حيان قال : سمعت معاوية بن قرة يقول : من لم يكتب العلم فلا
تعدوه عالمًا ، وعن محمد بن علي قال سمعت خالد بن خداش البغدادي قال :
ودعت مالك بن أنس فقلت : يا أبا عبد الله أوصني قال : عليك بتقوى الله في
السر والعلانية والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله ، وعن الحسن أنه كان
لا يرى بكتاب العلم بأسًا ، وقد كان أملي التفسير فكتب وعن الأعمش قال : قال
الحسن : إن لنا كتبًا نتعاهدها ، وقال الخليل بن أحمد : اجعل ما تكتب بيت مال وما في صدرك للنفقة ، وعن هام بن عروة عن أبيه أنه احترقت كتبه يوم الحرة
وكان يقول : وددت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي ، وعن سليمان بن موسى
قال : يجلس إلى العالم ثلاثة ، رجل يأخذ كل ما سمع فذلك حاطب ليل - ورجل لا يكتب ويستمع فذلك يقال له : جليس العالم ، ورجل ينتهي وهو خيرهم وهذا
هو العالم .
وعن إسحاق بن منصور قال : قلت لأحمد بن حنبل : من كره كتابة العلم ؟
قال : كرهه قوم ورخص فيه آخرون قلت له : لو لم يكتب العلم لذهب قال : نعم
لولا كتابة العلم أي شيء كنا نحن ؟ قال إٍسحاق : وسألت إسحاق بن راهويه فقال
كما قال أحمد سواء ، وعن حاتم الفاخري - وكان ثقة - قال : سمعت سفيان
الثوري يقول : إني أحب أن أكتب الحديث على ثلاثة أوجه : حديث أكتبه أريد أن
أتخذه دينًا ، وحديث رجل أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به ، وحديث
رجل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ به وقال الأوزاعي : تعلم ما لا يؤخذ به كما
تتعلم ما يؤخذ به وعن سعد بن إبراهيم قال : أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع
السنن فكتبناها دفترًا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترًا ، وعن أبي زرعة قال
سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان : كل من لا يكتب العلم لا يؤمَن
عليه الغلط ، وعن الزهري قال : كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء
الأمراء فرأينا أن لا تمنعه أحدًا من المسلمين ، وذكر المبرد قال : قال الخليل
بن أحمد : ما سمعت شيئًا إلا كتبته ولا كتبته إلا حفظته ولا حفظته إلا
نفعني .
***
الضغط على أهل الذمة
ادَّعى المؤلف أن عمر بن الخطاب كتب عهدًا لنصارى الشام وذكر نصه
منقولاً عن ( سراج الملوك ) للطرطوشي واعترف بأن فيه ضغطًا على النصارى ، ثم
اعتذر لعمر بأن نصارى الشام كانوا يميلون إلى قيصر الروم وكانوا من
بطانته يتجسسون له فلذلك احتيج إلى الشدة بهم والتضييق عليهم .
كل من له أدنى مسكة في التاريخ يعرف أن الطرطوشي ليس من رجال
التاريخ وكتابه كتاب أدب وسياسة لا كتاب تاريخ وهو من رجال القرن السادس
وإنما المعوَّل في هذا البحث على المصادر القديمة الموثوق بها كتاريخ الطبري
والبلاذري واليعقوبي وابن الأثير وغيرها ، وهذا ما كان يخفى على المؤلف ولكن
لأجل هوى نفسه أعرض عن كل هذه وتشبث برواية واهية تخالف الروايات
الصحيحة المذكورة بإسنادها ورجالها ، قال القاضي أبو يوسف وهو - مع كونه من
رجال الفقه - عارف بالمغازي والسير بعد ما نقل عهد نصارى الشام وليس فيه أدنى
ضغط عليهم ولا شدة بهم :
( فلما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين لهم وحسن السيرة فيهم صاروا أشداء على
عدو المسلمين وعونًا للمسلمين على أعدائهم فبعث أهل كل مدينة رسلهم ممن جرى
الصلح بينهم وبين المسلمين رجالاً من قبلهم يتحسسون الأخبار عن الروم وعن
ملكهم وما يريدون أن يصنعوا فأتى أهلَ كل مدينة رسلُهم يخبرونهم بأن الروم قد
جمعوا جمعًا . فكتب أبو عبيدة إلى كل والٍ ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها
يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبي من الجزية والخراج , وكتب إليهم أن يقولوا لهم : إنما رددنا عليكم أموالكم ؛ لأنه قد بلغنا أنه جمع لنا من الجموع وأنكم قد اشترطتم
علينا أن نمنعكم وأنا لا نقدر على ذلك ، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم . فلما قالوا
ذلك لهم وردوا عليهم الأموال التي جبوها منهم قالوا : ردكم الله علينا ونصركم
عليهم فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئًا وأخذوا كل شيء بقي لنا حتى لا يدعوا
شيئًا ) ( كتاب الخراج طبع مصر صفحة 8 و81 ) .
فانظر إلى هذا العدل الذي عجز البشر عن إتيان مثله واعتراف أهل الذمة
بذلك ! وإلى قول المؤلف أن عمر ضغط عليهم وإنما ضغط لأنهم كانوا من
جواسيس الروم !
***
تاريخ العلوم الإسلامية
أما تاريخ العلوم الإسلامية والتقريظ عليها فقد فقدنا اليوم في ملتنا من يقوم
بهذا العبء فكيف برجل دخيل فينا بضاعته مزجاة قليل المعرفة من علومنا إلا
أسماء تلقاها من ظواهر الكتب وأفواه العامة ؟ فإذا تكلم عن شيء منها خبط وخلط
وهاك أمثلة من ذلك قال : ( وكان المسلمون غير العرب هناك أكثرهم الفرس وهم
أهل تمدن وعلم فعمدوا إلى استخدام القياس العقلي في استخراج أحكام الفقه من
القرآن والحديث فخالفوا بذلك أهل المدينة ؛ لأنهم كانوا شديدي التمسك بالتقليد )
( الجزء الثالث ص 71 ) ظن الرجل أن استخدام القياس والرأي من مبتدعات الفرس
مع أن أول من سمي بهذا الاسم هو ربيعة الرأي ، صرح بذلك السمعاني في الأنساب
وهو من أول أهل المدينة وممن أخذ عنهم الإمام مالك ، وأن مالكًا والشافعي وأبا
يوسف والإمام أحمد رضي الله عنهم كلهم يستعملون القياس مع كونهم من العرب
أرومة وموطنًا وأداة وأن الفارق بين أصحاب الرأي والحديث ليس استعمال القياس -
وفصل القضية في ذلك تجده في ( كتاب حجة الله البالغة ) لشاه ولي الله الدهلوي من
متأخري حكماء الإسلام - ثم قال المؤلف ( فكان من جملة مساعي المنصور
في تصغير أمر المدينة وفقهائها وخصوصًا مالك بعد أن أفتى بخلع بيعته ، وأنه
نصر فقهاء العراق القائلين بالقياس وكان كبيرهم يومئذ أبا حنيفة النعمان
في الكوفة فاستقدمه المنصور إلى بغداد وأكرمه وعزز مذهبه ) الجزء
الثالث ص 71 .
ظلمات بعضها فوق بعض ! ! ما كان أبو حنيفة أرفع مكانة عند المنصور من
مالك فإن أبا حنيفة كان هواه مع إبراهيم الخارج على المنصور ، وكان أفتى بنصرة
إبراهيم ، ولذلك أراد المنصور المكيدة به فاستدعاه وعرض عليه القضاء ولما لم
يرض به سجنه وأمر بضربه حتى مات في السجن ، أما ما قال عن تصغير أمر
الإمام مالك فخالف الروايات الصحيحة الثابتة . قال القاضي ابن عبد البر في كتاب
جامع العلم ( صفحة 67 ) عن محمد بن عمر قال : سمعت مالك بن أنس يقول :
لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحدثته وسألني فأجبته فقال :
إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها ( يعني الموطأ ) فينسخ نسخًا ثم أبعث
إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدوها
إلى غيرها ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث فإني رأيت أنَّ أصْل هذا
العلم رواية أهل المدينة وعلمهم إلخ .
قال المؤلف ( وكان أبو حنيفة لا يحب العرب ولا العربية حتى إنه لم يكن
يحسن الإعراب ولا يبالي به ) ( الجزء الثالث صفحة 71 مستندًًا بابن خلكان )
نعوذ بالله من هذا الكذب الظاهر والمين الفاحش ! استشهد المؤلف في هذه الواقعة
بابن خلكان والحال أن ابن خلكان ذكر في تاريخه في ترجمة أبي حنيفة بعد ذكر
محاسنه أن الخطيب البغدادي أطال في مثالب أبي حنيفة ثم أنكر عليه ذلك وقال : ما
كان يعاب أبو حنيفة إلا بقلة العربية فإنه قال ( ولو رماه بأبا قيس ) ثم اعتذر له
بنوع من العذر وليس فيه أقل شيء يومئ إلى أن أبا حنيفة كان لا يحب العرب
والعربية ثم إن أبا حنيفة كان ناقمًا على العباسية المحامين للفرس وكان من شيعة
زيد ابن الإمام زين العابدين وكان تلميذًا لحماد وهو تلميذ لإبراهيم النخعي وكلهم
عرب - ثم أصحابه الملازمون له والناشرون لفقهه والقائمون بدعوته أي أبا يوسف
ومحمدًا وزفر كلهم عرب ، أما لحن أبي حنيفة . فمعلوم أنه عجمي وكم من الأعجام
الذين هم رءوس الأدب ووجوه العربية كحماد الراوية وغيره كانوا يلحنون وكان
هذا طبيعتهم وعزيزتهم .
فمن كان هذا مبلغه من العلم ومحله من النظر هل يصلح لسلوك هذا الطريق
الوعر والخوص في غمار هذا البحث الدقيق الذي يحتاج إلى التضلع في العلوم
الإسلامية والتوسع فيها مع سعة النظر ووفرة المواد وإصابة الرأي وشدة الفحص
وإفراغ الجهد وتكميل الأدوات ، ثم إن الرجل ههنا هو الرجل الذي عهدناه قبل ذلك
في سوء طويته وكامن حقده وتحامله على العرب واعتياده التحريف وتمرنه بسوء
التأول وتلبيس الكلام وهاك أمثلة من هذه :
قال ( تحت عنوان الفقه ) : ( فلما أفضى الأمر إلى بني العباس وأراد المنصور
تصغير العرب وإعظام أمر الفرس ؛ لأنهم أنصارهم وأهل دولتهم كان من جملة
مساعيه في لك تحويل أنظار المسلمين عن الحرمين فبنى بناء سماه القبة الخضراء
حجًّا للناس وقطع الميرة عن الحرمين ، وفقيه المدينة يومئذ الإمام مالك الشهير فاستفتاه
أهلها في أمر المنصور فأفتى لهم بخلع بيعته ) ( الجزء الثالث صفحة 71 ) .
وهذا كله كذب واختلاق والمنصور أبعد محلاًّ وأبرأ ساحة من أن يبني بناء
إرغامًا للكعبة - وقد سبق لنا الكلام فيه ، فأما قطع الميرة عن المدينة فلم يكن إلا
حجرًا - على محمد وتضييقًا عليه لما قام بالخلافة وقد صرح بذلك المقريزي
( الجزء الثاني صفحة 143 ) فقال : وذكر البلاذري أن أبا جعفر المنصور لما ورد
عليه قيام محمد بن عبد الله قال : تكتب الساعة إلى مصر أن تقطع الميرة عن أهل
الحرمين والإمام مالك كان هواه مع محمد يحرض الناس على مؤازرته وأفتى
بخلع بيعة المنصور ( فانظر كيف قلب المؤلف الحكاية وصرفها عن وجهها! )
فخروج محمد وإفتاء الإمام مالك متقدمان على قطع الميرة عن المدينة وخروج محمد
هو السبب في قطع الميرة والمؤلف يقول : إن قطع الميرة إنما كان إرغامًا للحرمين ،
وأن الإمام مالكًا أفتى لذلك بخلع بيعته .
قال المؤلف بعد ما ذكر رغبة بني أمية في الشعر وتنشيطهم للناس تحت
عنوان ( الشعر وبنو أمية ) ( وقد يتبادر إلى الأذهان أنهم كانوا يفعلون ذلك رغبة
في الأدب وتنشيطًا لأهله ؛ لأن الشعر سجية في العرب ودولة الأمويين عربية بحتة
ولكن الأغلب أنهم كانوا يفعلونه للاستعانة بألسنة الشعراء على مقاومة أهل البيت )
إلخ ( الجزء الثالث صفحة 102 ) فانظر إلى هذا التحامل المفرط والحيف الشديد !
فإنه لما لم يجد سبيلاً إلى إنكار ما لبني أمية من الأيادي في ترويج سوق الأدب
ورفع منار الشعر والأخذ بناصر علماء العربية وإعطاء الصلات المتكاثرة للشعراء
احتال لدفعه بإبداء احتمال أنهم كانوا مدفوعين إلى ذلك سياسة .
قال ( وقد تقدم في كلامنا عن الفقه أن المنصور أخذ يناصر أصحاب الرأي
والقياس ، واستقدم أبا حنيفة إلى بغداد ونشطه لهذه الغاية ، وظل الميل إلى القياس
متواصلاً في بني العباس والاعتزال أقرب المذاهب إلى أصحاب الرأي ) إلخ
( الجزء الثالث صفحة 140 ) انظر إلى ما بلغ به حال المؤلف في جهله بالمعارف
الإسلامية حتى أنه يقرن بين الاعتزال والرأي ويعدهما من جنس واحد ! ولم يدر
المسكين أن لا رابط بينهما فإن الاعتزال أحد المذاهب الكلامية والرأي والقياس أحد
أصول الفقه ومعظم أصحاب الرأي والقياس بل كلهم - إلا الشاذ النادر منهم - كأبي
حنيفة ومحمد وأبي يوسف وزفر والطحاوي والخصاف وأبي بكر الرازي والدبوسي
وغيرهم كانوا ناقمين على الاعتزال وكانوا يعدون المعتزلة من أهل الأهواء
والضلالة .
قال ( فلما أفضت الخلافة إلى المأمون أخذ يناصر أشياعه وصرح بأقوال لم
يكونوا يستطيعون التصريح بها خوفًا من غضب الفقهاء وفي جملتها القول بخلق
القرآن أي أنه غير منزل ) ( الجزء الثالث صفحة 141 ) .
وهل يكون كذب أعظم من هذا ؟ ! فإن خلق القرآن أو قدمه لا مساس له
بالتنزيل أو عدمه فإن الاختلاف فى : هل الكلام صفة حادثة تقوم بالله تعالى ؟ أو
هو صفة قديمة ؟ فالمعتزلة قالوا بحدوثه حذرًا من تعدد القدماء ، وأهل السنة وغيرهم
قالوا بقدمه ؛ لأن الحادث لا يقوم بقديم . فأما أن القرآن كلام الله تعالى منزل إلى
الرسول فهذا لا يختلف فيه اثنان .
قال ( وأما الفلسفة بحد ذاتها فقد كان أصحابها متهمين بالكفر وكان الانتساب
إليها مرادفًا للانتساب إلى التعطيل ، وقد شاع ذلك في بغداد بين العامة حتى في أيام
المأمون ولذلك سماه بعضهم أمير الكافرين ) ( الجزء الثالث صفحة 177 ) .
استشهد المؤلف في هذا القول باليعقوبي ونحن ننقل عبارته حتى تعرف مقدار
خديعة المؤلف ، قال اليعقوبي ( وشخص هرثمة من العراق إلى مرو سنة 201
وقيل : إنه انصرف بغير إذن من المأمون فلما دخل على المأمون .. .. قال من
نقرس ولا يمكنني أمشي في محفة .. .. وكلم المأمون بكلام عليه ودخل معه
يحيى بن عامر بن إسماعيل الحارثي فقال : السلام عليك يا أمير الكافرين .
فأخذته السيوف في مجلس المأمون حتى قتل ! فقال هرثمة : قدَّمت هذه المجوس
على أوليائك وأنصارك ؟ وأتوا محمد بن صالح بن المنصور فقالوا : نحن أنصار
دولتكم وقد خشينا أن تذهب هذه الدولة بما حدث فيها من تدبير المجوس )
( اليعقوبي صفحة 546 و547 ) إن المأمون استوزر حسن بن سهل وكان مجوسيًّا
أسلم فنقم العرب على المأمون ، وقالوا : إنك قدمت المجوس وقال له يحيى : السلام
عليك يا أمير الكافرين ، فهذا كله من السياسة لا مساس له بالفلسفة والاعتزال وابن
هرثمة ويحيى بن عامر الحارثي من أهل الجند ما عرفا الفلسفة ولا سمعا بها .
قال المؤلف ( ولكن الإسلام كان أقرب إلى إطلاق حرية الفكر والقول
وخصوصًا في أوائله فلم يكن أحدهم يستنكف من إبداء ما يخطر له ولو كان مخالفًا
لرأي الخليفة ولذلك كثرت الفرق الإسلامية يومئذ وتعددت مذاهب أصحابها في
القراءة والتفسير والفقه وفي كل شيء حتى ذهب بعضهم إلى أن سورة يوسف
ليست من القرآن لأنها قصة من القصص والقائلون بذلك العجاردة ( الجزء الثالث
صفحة 61 ) .
انظر إلى هذه الخديعة يمدح الإسلام بكونه أقرب إلى حرية الفكر ويدس فيه
أن بعض الطوائف الإسلامية كانت تنكر أن سورة يوسف من القرآن وهم العجاردة
يوهم بذلك أن العجاردة فرقة من الفرق الإسلامية وأن إنكار بعض سور القرآن كان
مذهبًا من مذاهب الإسلام مع أن العجاردة وهم حماد عجرد واثنان آخران معروفون
بالإلحاد والزندقة والمروق من الإسلام ذكرهم ابن خلكان و الشهرستاني وغيرهما .
__________
__________
نقد تاريخ التمدن الإسلامي
بفلم الشيخ شبلي النعماني
( 5 )
وذكر المؤلف عقيب ذلك وهب بن منبه وأنه قرأ من كتب الله 72 كتابًا ثم قال :
( فكان للعرب ثقة كبرى فيه ) وقال بعد ذلك : ( فكانت كتب التفسير في القرون
الأولى محشوة بالأخبار وفيها الغث والسمين مما نقل إليها من الأديان الأخرى ) .
فانظر كيف يناقض المؤلف نفسه ! فقال :
( فنشأ في اعتقادهم أنه لا ينبغي أن يسود غير العرب ولا يتلى غير القرآن -
فرَسَخ في الأذهان أنه لا ينبغي أن يُنظر في كتاب غير القرآن - فتوطدت
العزائم على الاكتفاء به ( أي القرآن ) عن كل كتاب سواه ومحو ما كان قبله من
كتب العلم ) .
ويقول الآن : إن كتب التفسير في القرون الأولى محشوة بالأخبار .. .. مما
نقل إليها من الأديان الأخرى ، وإنه كان للعرب ثقة كبرى في وهب بن منبه ، وإن
كتب التفسير امتلأت من منقولات أهل الكتاب ، فلو كان أهل القرون الأولى
يبغضون ما سوى القرآن ويمحون ما كان قبله من العلم كما يدعيه المؤلف فمن روى
الإسرائيليات وأقاصيص التلمود والتوراة وحشاها في التفسير ؟ ولما كانت المسألة
موضع زيادة تفصيل نزيدك توضيحًا وتفصيلاً :
كان لعدة من الصحابة وكبراء التابعين عناية كبرى بالتوراة وغيرها من
الكتب السماوية فمنهم أبو هريرة الذي كان ملازمًا للنبي عليه السلام منقطعًا إلى
الرواية - لم يدانه أحد في كثرة الرواية - كان مشغوفًا بقراءة التوراة ودرسها ، قال
العلامة الذهبي في طبقات الحفاظ في ترجمته : ( عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه
لقي كعبًا - وهو حبر لليهود - فجعل يحدثه ويسأله فقال كعب : ما رأيت أحدًا لم
يقرأ التوراة أعلم بما فيها من أبي هريرة ) .
ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص أحد من هاجر قبل الفتح ، قال الذهبي في
طبقات الحفاظ : ( كان من أيام النبي صوّامًا قوامًا تاليًا لكتاب الله طلابةً للعلم كتب
عن النبي صلى الله عليه وسلم علمًا كثيرًا ، وكان أصاب جملة من كتب أهل الكتاب
وأدمن النظر فيها ورأى فيها عجائب ) .
ومنهم عبد الله بن سلام حليف الأنصار أسلم وقت مقدم النبي وفيه ورد قوله
تعالى : { وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكِتَابِ } ( الرعد : 43 ) نقل الذهبي بعد ذكر فضائله
وكونه عالم أهل الكتاب رواية بالإسناد يرفعه إلى عبد الله بن سلام أنه جاء إلى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني قرأت القرآن والتوراة فقال : اقرأ هذا ليلة
وهذا ليلة ، فهذا إن صح ففي الرخصة في تكرير التوراة وتدبرها .
ومنهم كعب الأحبار كان من كبار أهل الكتاب ، أسلم في زمن أبي بكر ، قال
الذهبي : ( قدم من اليمن في دولة أمير المؤمنين عمر فأخذ عنه الصحابة وغيرهم
وأخذ هو من الكتاب والسنة عن أصحابه ) فهذا كأنه تصريح في أن الصحابة أخذوا
عنه علم أهل الكتاب .
ومنهم وهب بن منبه قال الذهبي في ترجمته : ( وعنده من أهل الكتاب شيء
كثير فإنه صرف عنايته إلى ذلك ، وكان ثقة واسع العلم ينظر بكعب الأحبار في
زمانه ) وعن وهب قال : يقولون : عبد الله بن سلام أعلم أهل زمانه وكعب أعلم
أهل زمانه ) .
فهل بعد كل هذا يصح قول المؤلف : إن الصحابة ومن يليهم كانوا يقولون :
إنه لا ينبغي أن يقرأ كتاب غير القرآن ومحوا ما كان قَبْلهم من العلم ؟ عياذًا بالله .
قال المؤلف : ( ثانيًا جاء في تاريخ مختصر الدول لأبي الفرج - ثم نقل
رواية الإحراق برمتها وأطال في إثبات أن أبا الفرج ليس بأول من روى هذه
الرواية بل ذكرها عبد اللطيف البغدادي عرضًا في ذكره عمود السواري وذكرها
القفطي في تاريخ الحكماء ) .
لا ننازع المؤلف في أن أبا الفرج مسبوق في ذكر هذه الرواية بالقفطي
والبغدادي ولكن ماذا ينفعه ذلك ؟ فإن البغدادي وهو أقدمهما من أهل القرن السادس
للهجرة وذكر الرواية من غير إسناد ومن غير إحالة على كتاب .
تعود المؤلف من صباه قبول مختلقات أهل الكتاب وأوهامهم فسبب ذلك أنه
يزن التاريخ الإسلامي بميزان غير ميزاننا ؛ ولذلك يصغي إلى كل صوت ويستمع
لكل قائل ، لا يعرف أن هذا الفن له أصول ومبادٍ وقواعد وما لم تكن الرواية مطابقة
لهذه الأصول اليقينية لا يلتفت إليها أصلاً ، منها أن الناقل للرواية لا بد أن يكون شهد
الواقعة فإن لم يشهد فليبين سند الرواية ومصدرها حتى تتصل الرواية إلى من
شهدها بنفسه .
ومنها أن يكون رجال السند معروفين بصدقهم وديانتهم ، ومنها أن لا تكون
الرواية تخالف الدراية ومجاري الأحوال ؛ ولذلك اهتم مؤرخو الإسلام قبل كل شيء
بضبط أسماء الرجال والبحث عن سيرهم وأحوالهم وديانتهم ومحلهم من الصدق
فدونوا كتب أسماء الرجال وكابدوا في ذلك محنة يضيق عنها النطاق البشري فعملوا
كتبًا غير محصورة منها الكامل لابن عديّ والثقاة لابن حبان وتهذيب الكمال للمِزِّيِّ
وتهذيب التهذيب لابن حجر وطبقات الصحابة لابن سعد ولابن ماكولا وابن عبد
البر ولابن الأثير ولابن حجر وتهذيب الأسماء للنووي وميزان الاعتدال للذهبي
ولسان الميزان لابن حجر .
وتجد كتب القدماء من مؤرخي الإسلام كلها أو أكثرها كتاريخ البخاري وسيرة
ابن إسحاق وتاريخ الطبري وابن قتيبة وغيره مسلسلة الإسناد مبينة الأسماء ليمكن
نقد الرواية ومعرفة جيدها من زيفها .
فأول شيء يهمنا في هذا البحث أن نرى : هل ذكر القفطي والبغدادي هذه
الرواية مسندة وذكرا مصدر الرواية وأسماء رواتها أم لا ؟
وأنت تعلم أن البغدادي والقفطي من رجال القرن السادس والسابع فأي عبرة
برواية تتعلق بالقرن الأول يذكرانها من غير سند ولا رواية ولا إحالة على كتاب ؟
أما كتب القدماء الموثوق بها فليس لهذه الرواية فيها أثر ولا عين ، هذا تاريخ
الطبري واليعقوبي والمعارف لابن قتيبة والأخبار الطوال للدينوري وفتوح البلدان
للبلاذري والتاريخ الصغير للبخاري وثقاة ابن حبان والطبقات لابن سعد قد
تصفحناها وكررنا النظر فيها ومع أن فتح الإسكندرية مذكور فيها بقضها
وقضيضها فليس لحريق الخزانة فيها ذكر .
وعلاوة على ذلك فإن في فتح مصر كتبًا مختصة بذلك مثل خطط مصر
للكندي وكشف الممالك لابن شاهين وتاريخ مصر لعبد الرحمن الصوفي وتاريخ
مصر لابن بركات النحوي وتاريخ مصر لمحمد بن عبد الله وغيرها مما ذكرها
صاحب كشف الظنون ، والمقريزي جمع وأوعى كل ذلك ولم يترك رواية ولا
خبرًا يتعلق بمصر إلا وذكره عند تفصيل الفتح ولم يذكر هذه الواقعة عند ذكر فتح
الإسكندرية .
قال المؤلف :
( وأما خلو كتب الفتح من ذكر هذه الحادثة فلا بد له من سبب والغالب أنهم
ذكروها ، ثم حذفت بعد نضج التمدن الإسلامي واشتغال المسلمين بالعلم ومعرفتهم
قدر الكتب فاستبعدوا حدوث ذلك في عصر الراشدين فحذفوه أو لعل لذلك سببًا آخر
إلخ ) ( الجزء الثالث صفحة 44 و45 ) .
لا يستبعد مثل هذا الكلام من مثل هذا المؤلف ! وكيف يقدِّر ديانة مؤرخي الإسلام وشدتهم في تحري الصدق ونزاهتهم عن التغيير والتحريف وبراءة
ساحتهم عن الحذف والإسقاط مَن صارت غريزته تعمُّد الكذب والتحريف
والخيانة والمحو والإثبات ؟
قال المؤلف :
( ثالثًا ) ورد في أماكن كثيرة من تواريخ المسلمين ، خبر إحراق مكاتب
فارس وغيرها على الإجمال وقد لخصها صاحب كشف الظنون إلخ ( الجزء الثالث
صفحة 45 ) .
انظر إلى هذا الكذب الفاحش والخديعة الظاهرة فإن صاحب الكشف ذكر ما
ذكر من عند نفسه من غير نقل رواية ولا استناد ولا استشهاد بكتاب ولا ذكر ناقل
أو مؤرخ - وصاحبنا يقول : إنه ورد في أماكن كثيرة من تواريخ المسلمين خبر
إحراق المكاتب وقد لخصها صاحب كشف الظنون ، فأين الأماكن الكثيرة وأين
التلخيص ؟ !
أما قول صاحب كشف الظنون فقد ورد عرضًا وتطفلاً وكذلك قول ابن خلدون
وأمثال هذه المواقع لا تحتاج إلى كبير اعتناء وزيادة احتياط ؛ ولذلك لما ذكر ابن
خلدون فتح مصر والإسكندرية وهو المظنة لذكر هذه الواقعة لم يتفوه بهذه الرواية
أصلاً ، ثم إن ابن خلدون وصاحب كشف الظنون من رجال القرن الثامن وبعده فما
لم يذكرا من أين أخذا هذه الرواية لا يُعبأ بها ولا يلتفت إليها .
قال المؤلف :
( رابعًا ) أن إحراق الكتب كان شائعًا في تلك العصور .. .. . كما فعل عبد
الله بن طاهر بكتب فارسية إلخ ( الجزء الثالث صفحة 45 ) .
يا للعجب ! عبد الله بن طاهر من قواد المأمون ومن رجال الأدب وهذا
العصر يمتاز بكونه عصر العلم والمعارف وقد كانت للدولة ورجال حاشيتها
وغيرهم عناية كبرى بكتب الأوائل وكانوا يستجلبون الكتب من فارس وبلاد الروم
وغيرها - وتجد تفاصيل ذلك في فهرست ابن النديم وطبقات الأطباء وأخبار
الحكماء وغيرها ، فكيف يعوّل على هذه الرواية التي ما ذكرها أحد من ثقاة
المؤرخين وإنما استند المؤلف ( ببراون المعلم الإنكليزي ) وهو نقلها من تذكرة
( دولت شاه ) وهو كتاب جامع لكل غث وسمين ، ولو صح نقلها لكانت على سبيل
الندرة والشذوذ ، فهل يصح قول المؤلف : ( إن إحراق الكتب كان شائعًا في تلك
العصور ) ؟
قال المؤلف :
( خامسًا ) إن أصحاب الأديان في تلك العصور كانوا يعدّون هدم المعابد
القديمة وإحراق كتب أصحابها من قبيل السعي في تأييد الأديان الجديدة ثم ذكر في
تأييد ذلك عمل إمبراطرة الروم وإحراق كتب المعتزلة ج 3 ص 46 .
نعم ولكن الراشدين لا يقاسون بغيرهم ، ثم إن المسألة ليست قياسية فما لم
تثبت بالرواية لا ينفع مجرد القياس .
قال المؤلف :
( سادسًا ) في تاريخ الإسلام جماعة من أئمة المسلمين أحرقوا كتبهم من تلقاء
أنفسهم ( ثم ذكر بعض الحوادث في تأييد ذلك ) ج 3 ص 46 .
عجبًا لمثل هذا الاستدلال ! فإن المرء يجوز له أن يفعل بملكه ما يشاء وأي
حجة في ذلك لإحراق كتب أقوام أخر ؟
إن هذه القياسات الواهية لا تغني شيئًا ولكن لو أردنا أن نستشفي في ذلك
البحث بالقياس والأمارات فعلينا أن ننظر ما كان صنيع الخلفاء الراشدين بآثار أهل
الذمة ومعابدهم وكنائسهم وأمتعتهم وخزائنهم ، إن الأصل في ذلك عهد النبي صلى
الله عليه وسلم الذي كتبه لأهل نجران وقد ذكره القاضي أبو يوسف في كتاب
الخراج بحروفه .
( ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم
وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبِيَعهم وكل ما تحت أيديهم
من قليل أو كثير ) ( كتاب الخراج طبع مصر صفحة 41 ) .
فكان هذا العهد هو العمدة للصحابة عضوا عليه بالنواجذ وتجد في كل عهود
الخلفاء الراشدين كعهد نجران ومصر و الشام و الجزيرة أن هذا الأصل أي ذمة الله
ورسوله على أرضهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير محفوظ باقٍ على حالته
الأصلية وعهد مصر هو هذا .
(هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم ودمهم
وأموالهم وصاعهم ومدهم وعددهم ) .
وذكر في معجم البلدان رواية بزيادة ( أن لهم أرضهم وأموالهم لا يتعرضون
في شيء منها ) وأنت تعلم ما لعمر الفاروق من العناية والشدة في وفاء العهد بأهل
الذمة وغيرهم ومع عهده بأنهم لا يتعرضون في شيء من أموالهم وكل ما تحت
أيديهم كيف كان يتعرض لخزانة كتبهم التي هي من أنفس ذخائرهم وأغلاها ؟
اعلم أن مسألة إحراق خزانة الإسكندرية موضوع مهم عند أهل أوروبة وقد
أطال البحث فيه إثباتًا ونفيًا وممن ألم بهذا البحث إجمالاً وتفصيلاً المعلم ( وايت )
والمعلم ( دساسي ) الفرنسي في ترجمة كتاب الإفادة والاعتبار و ( واشنكتن أدونك )
و ( داربر) الأمريكاني صاحب كتاب الجدال بين العلم والدين و كرجين و سيديو
الفاضل الشهير الفرنسي في تاريخ الإسلام والمعلم رينان الفيلسوف الفرنسي في
خطبته الإسلام والعلم و ( أرتركليين ) ، وللمعلم ( كريل ) الألماني رسالة مستقلة
في هذا البحث قدمها في المؤتمر الشرقي الذي انعقد سنة 1828 م أورد فيها كل ما
كتب الباحثون في هذا البحث نفيًا أو إثباتًا وقد طالعت كل هذه المباحثات والمقالات
وعملت رسالة في اللسان الأردي وترجمت إلى الإنكليزية ثم إلى العربية ترجمها
أحد أهل الشام وطبع شطر منها في جريدة ثمرات الفنون . ومجلة المقتبس .
والحاصل أن محققي أهل أوروبة قضوا بأن الواقعة غير ثابتة أصلاً منهم
( جيين ) المؤرخ الشهير الإنكليزي ودريير الأمريكاني وسيديو الفرنسي وكريل
الألماني والمعلم رينان الفرنسي . عمدتهم في إنكار ذلك أمران الأول أن الواقعة
ليس لها عين ولا أثر في كتب التاريخ الموثوق بها كالطبري وابن الأثير والبلاذري
وغيرها مما مر ذكرها وأول من ذكرها عبد اللطيف البغدادي والقفطي وهما من
رجال القرن السادس والسابع ولم يذكرا مصدرًا للرواية ولا سندًا - والثاني أن
الخزانة كانت ضاعت قبل الإسلام أثبتوا ذلك بدلائل لا يمكن إنكارها .
قال المؤلف :
( قلنا فيما تقدم : إن الخلفاء الراشدين كانوا يخافون الحضارة على العرب - ..
ولذلك منعوهم من تدوين الكتب - .. .. وكان هذا الاعتقاد فاشيًا في الصحابة
والتابعين وتمسك به جماعة من كبارهم وكانوا إذا سئلوا تدوين علمهم أبوا
واستنكفوا ) إلخ ( الجزء الثالث صفحة 50 ) .
أطال المؤلف ونقل أقولاً عديدة في إثبات أن الخلفاء الراشدين والصحابة كانوا
يمنعون الناس عن الكتابة والتأليف ونحن لا ننكر أن هذا كان مذهبًا لبعض الصحابة
والتابعين ولكن الذين رخصوا في ذلك وأمروا بالكتابة والتدوين أكثرهم عددًا
وأرجحهم ميزانًا وأوسعهم نفوذًا ، وقد عقد المحدث المشهور القاضي ابن عبد البر
في كتابه جامع بيان العلم ( انظر 36 طبع مصر ) بابًا في إثبات ذلك ونحن ننقل
شطرًا منه قال ( وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( قيدوا العلم بالكتاب ) وعن عبد الملك بن سفيان عن عمه أنه سمع عمر بن
الخطاب يقول قيدوا العلم بالكتاب وعن معن قال : أخرج إليّ عبد الرحمن بن
عبد الله بن مسعود كتابًا وحلف لي أنه خط أبيه بيده ، وعن أبي بكر قال : سمعت
الضحاك يقول : إذا سمعت شيئًا فاكتبه ولو في حائط .
وعن سعيد بن جبير أنه كان يكون مع ابن عباس يسمع منه الحديث
فيكتبه في واسطة الرحل فإذا نزل نسخه وعن أبي قلابة قال الكتاب أحب إلينا من
النسيان وعن أبي مليح قال يعيبون علينا الكتاب وقد قال الله { عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي
كِتَابٍ } ( طه : 52 ) وعن عطاء عن عبد الله بن عمرو قلت يا رسول الله أأقيد
العلم ؟ قال : ( قيد العلم ) قال عطاء : قلت : وما تقييد العلم ؟ قال : الكتاب ، وعن
عبد العزيز بن محمد الداروردي قال : أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب ، وعن
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : كنا نكتب الحلال والحرام
وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس .
وعن سوادة بن حيان قال : سمعت معاوية بن قرة يقول : من لم يكتب العلم فلا
تعدوه عالمًا ، وعن محمد بن علي قال سمعت خالد بن خداش البغدادي قال :
ودعت مالك بن أنس فقلت : يا أبا عبد الله أوصني قال : عليك بتقوى الله في
السر والعلانية والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله ، وعن الحسن أنه كان
لا يرى بكتاب العلم بأسًا ، وقد كان أملي التفسير فكتب وعن الأعمش قال : قال
الحسن : إن لنا كتبًا نتعاهدها ، وقال الخليل بن أحمد : اجعل ما تكتب بيت مال وما في صدرك للنفقة ، وعن هام بن عروة عن أبيه أنه احترقت كتبه يوم الحرة
وكان يقول : وددت لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي ، وعن سليمان بن موسى
قال : يجلس إلى العالم ثلاثة ، رجل يأخذ كل ما سمع فذلك حاطب ليل - ورجل لا يكتب ويستمع فذلك يقال له : جليس العالم ، ورجل ينتهي وهو خيرهم وهذا
هو العالم .
وعن إسحاق بن منصور قال : قلت لأحمد بن حنبل : من كره كتابة العلم ؟
قال : كرهه قوم ورخص فيه آخرون قلت له : لو لم يكتب العلم لذهب قال : نعم
لولا كتابة العلم أي شيء كنا نحن ؟ قال إٍسحاق : وسألت إسحاق بن راهويه فقال
كما قال أحمد سواء ، وعن حاتم الفاخري - وكان ثقة - قال : سمعت سفيان
الثوري يقول : إني أحب أن أكتب الحديث على ثلاثة أوجه : حديث أكتبه أريد أن
أتخذه دينًا ، وحديث رجل أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به ، وحديث
رجل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ به وقال الأوزاعي : تعلم ما لا يؤخذ به كما
تتعلم ما يؤخذ به وعن سعد بن إبراهيم قال : أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع
السنن فكتبناها دفترًا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترًا ، وعن أبي زرعة قال
سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان : كل من لا يكتب العلم لا يؤمَن
عليه الغلط ، وعن الزهري قال : كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء
الأمراء فرأينا أن لا تمنعه أحدًا من المسلمين ، وذكر المبرد قال : قال الخليل
بن أحمد : ما سمعت شيئًا إلا كتبته ولا كتبته إلا حفظته ولا حفظته إلا
نفعني .
***
الضغط على أهل الذمة
ادَّعى المؤلف أن عمر بن الخطاب كتب عهدًا لنصارى الشام وذكر نصه
منقولاً عن ( سراج الملوك ) للطرطوشي واعترف بأن فيه ضغطًا على النصارى ، ثم
اعتذر لعمر بأن نصارى الشام كانوا يميلون إلى قيصر الروم وكانوا من
بطانته يتجسسون له فلذلك احتيج إلى الشدة بهم والتضييق عليهم .
كل من له أدنى مسكة في التاريخ يعرف أن الطرطوشي ليس من رجال
التاريخ وكتابه كتاب أدب وسياسة لا كتاب تاريخ وهو من رجال القرن السادس
وإنما المعوَّل في هذا البحث على المصادر القديمة الموثوق بها كتاريخ الطبري
والبلاذري واليعقوبي وابن الأثير وغيرها ، وهذا ما كان يخفى على المؤلف ولكن
لأجل هوى نفسه أعرض عن كل هذه وتشبث برواية واهية تخالف الروايات
الصحيحة المذكورة بإسنادها ورجالها ، قال القاضي أبو يوسف وهو - مع كونه من
رجال الفقه - عارف بالمغازي والسير بعد ما نقل عهد نصارى الشام وليس فيه أدنى
ضغط عليهم ولا شدة بهم :
( فلما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين لهم وحسن السيرة فيهم صاروا أشداء على
عدو المسلمين وعونًا للمسلمين على أعدائهم فبعث أهل كل مدينة رسلهم ممن جرى
الصلح بينهم وبين المسلمين رجالاً من قبلهم يتحسسون الأخبار عن الروم وعن
ملكهم وما يريدون أن يصنعوا فأتى أهلَ كل مدينة رسلُهم يخبرونهم بأن الروم قد
جمعوا جمعًا . فكتب أبو عبيدة إلى كل والٍ ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها
يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبي من الجزية والخراج , وكتب إليهم أن يقولوا لهم : إنما رددنا عليكم أموالكم ؛ لأنه قد بلغنا أنه جمع لنا من الجموع وأنكم قد اشترطتم
علينا أن نمنعكم وأنا لا نقدر على ذلك ، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم . فلما قالوا
ذلك لهم وردوا عليهم الأموال التي جبوها منهم قالوا : ردكم الله علينا ونصركم
عليهم فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئًا وأخذوا كل شيء بقي لنا حتى لا يدعوا
شيئًا ) ( كتاب الخراج طبع مصر صفحة 8 و81 ) .
فانظر إلى هذا العدل الذي عجز البشر عن إتيان مثله واعتراف أهل الذمة
بذلك ! وإلى قول المؤلف أن عمر ضغط عليهم وإنما ضغط لأنهم كانوا من
جواسيس الروم !
***
تاريخ العلوم الإسلامية
أما تاريخ العلوم الإسلامية والتقريظ عليها فقد فقدنا اليوم في ملتنا من يقوم
بهذا العبء فكيف برجل دخيل فينا بضاعته مزجاة قليل المعرفة من علومنا إلا
أسماء تلقاها من ظواهر الكتب وأفواه العامة ؟ فإذا تكلم عن شيء منها خبط وخلط
وهاك أمثلة من ذلك قال : ( وكان المسلمون غير العرب هناك أكثرهم الفرس وهم
أهل تمدن وعلم فعمدوا إلى استخدام القياس العقلي في استخراج أحكام الفقه من
القرآن والحديث فخالفوا بذلك أهل المدينة ؛ لأنهم كانوا شديدي التمسك بالتقليد )
( الجزء الثالث ص 71 ) ظن الرجل أن استخدام القياس والرأي من مبتدعات الفرس
مع أن أول من سمي بهذا الاسم هو ربيعة الرأي ، صرح بذلك السمعاني في الأنساب
وهو من أول أهل المدينة وممن أخذ عنهم الإمام مالك ، وأن مالكًا والشافعي وأبا
يوسف والإمام أحمد رضي الله عنهم كلهم يستعملون القياس مع كونهم من العرب
أرومة وموطنًا وأداة وأن الفارق بين أصحاب الرأي والحديث ليس استعمال القياس -
وفصل القضية في ذلك تجده في ( كتاب حجة الله البالغة ) لشاه ولي الله الدهلوي من
متأخري حكماء الإسلام - ثم قال المؤلف ( فكان من جملة مساعي المنصور
في تصغير أمر المدينة وفقهائها وخصوصًا مالك بعد أن أفتى بخلع بيعته ، وأنه
نصر فقهاء العراق القائلين بالقياس وكان كبيرهم يومئذ أبا حنيفة النعمان
في الكوفة فاستقدمه المنصور إلى بغداد وأكرمه وعزز مذهبه ) الجزء
الثالث ص 71 .
ظلمات بعضها فوق بعض ! ! ما كان أبو حنيفة أرفع مكانة عند المنصور من
مالك فإن أبا حنيفة كان هواه مع إبراهيم الخارج على المنصور ، وكان أفتى بنصرة
إبراهيم ، ولذلك أراد المنصور المكيدة به فاستدعاه وعرض عليه القضاء ولما لم
يرض به سجنه وأمر بضربه حتى مات في السجن ، أما ما قال عن تصغير أمر
الإمام مالك فخالف الروايات الصحيحة الثابتة . قال القاضي ابن عبد البر في كتاب
جامع العلم ( صفحة 67 ) عن محمد بن عمر قال : سمعت مالك بن أنس يقول :
لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحدثته وسألني فأجبته فقال :
إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها ( يعني الموطأ ) فينسخ نسخًا ثم أبعث
إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدوها
إلى غيرها ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث فإني رأيت أنَّ أصْل هذا
العلم رواية أهل المدينة وعلمهم إلخ .
قال المؤلف ( وكان أبو حنيفة لا يحب العرب ولا العربية حتى إنه لم يكن
يحسن الإعراب ولا يبالي به ) ( الجزء الثالث صفحة 71 مستندًًا بابن خلكان )
نعوذ بالله من هذا الكذب الظاهر والمين الفاحش ! استشهد المؤلف في هذه الواقعة
بابن خلكان والحال أن ابن خلكان ذكر في تاريخه في ترجمة أبي حنيفة بعد ذكر
محاسنه أن الخطيب البغدادي أطال في مثالب أبي حنيفة ثم أنكر عليه ذلك وقال : ما
كان يعاب أبو حنيفة إلا بقلة العربية فإنه قال ( ولو رماه بأبا قيس ) ثم اعتذر له
بنوع من العذر وليس فيه أقل شيء يومئ إلى أن أبا حنيفة كان لا يحب العرب
والعربية ثم إن أبا حنيفة كان ناقمًا على العباسية المحامين للفرس وكان من شيعة
زيد ابن الإمام زين العابدين وكان تلميذًا لحماد وهو تلميذ لإبراهيم النخعي وكلهم
عرب - ثم أصحابه الملازمون له والناشرون لفقهه والقائمون بدعوته أي أبا يوسف
ومحمدًا وزفر كلهم عرب ، أما لحن أبي حنيفة . فمعلوم أنه عجمي وكم من الأعجام
الذين هم رءوس الأدب ووجوه العربية كحماد الراوية وغيره كانوا يلحنون وكان
هذا طبيعتهم وعزيزتهم .
فمن كان هذا مبلغه من العلم ومحله من النظر هل يصلح لسلوك هذا الطريق
الوعر والخوص في غمار هذا البحث الدقيق الذي يحتاج إلى التضلع في العلوم
الإسلامية والتوسع فيها مع سعة النظر ووفرة المواد وإصابة الرأي وشدة الفحص
وإفراغ الجهد وتكميل الأدوات ، ثم إن الرجل ههنا هو الرجل الذي عهدناه قبل ذلك
في سوء طويته وكامن حقده وتحامله على العرب واعتياده التحريف وتمرنه بسوء
التأول وتلبيس الكلام وهاك أمثلة من هذه :
قال ( تحت عنوان الفقه ) : ( فلما أفضى الأمر إلى بني العباس وأراد المنصور
تصغير العرب وإعظام أمر الفرس ؛ لأنهم أنصارهم وأهل دولتهم كان من جملة
مساعيه في لك تحويل أنظار المسلمين عن الحرمين فبنى بناء سماه القبة الخضراء
حجًّا للناس وقطع الميرة عن الحرمين ، وفقيه المدينة يومئذ الإمام مالك الشهير فاستفتاه
أهلها في أمر المنصور فأفتى لهم بخلع بيعته ) ( الجزء الثالث صفحة 71 ) .
وهذا كله كذب واختلاق والمنصور أبعد محلاًّ وأبرأ ساحة من أن يبني بناء
إرغامًا للكعبة - وقد سبق لنا الكلام فيه ، فأما قطع الميرة عن المدينة فلم يكن إلا
حجرًا - على محمد وتضييقًا عليه لما قام بالخلافة وقد صرح بذلك المقريزي
( الجزء الثاني صفحة 143 ) فقال : وذكر البلاذري أن أبا جعفر المنصور لما ورد
عليه قيام محمد بن عبد الله قال : تكتب الساعة إلى مصر أن تقطع الميرة عن أهل
الحرمين والإمام مالك كان هواه مع محمد يحرض الناس على مؤازرته وأفتى
بخلع بيعة المنصور ( فانظر كيف قلب المؤلف الحكاية وصرفها عن وجهها! )
فخروج محمد وإفتاء الإمام مالك متقدمان على قطع الميرة عن المدينة وخروج محمد
هو السبب في قطع الميرة والمؤلف يقول : إن قطع الميرة إنما كان إرغامًا للحرمين ،
وأن الإمام مالكًا أفتى لذلك بخلع بيعته .
قال المؤلف بعد ما ذكر رغبة بني أمية في الشعر وتنشيطهم للناس تحت
عنوان ( الشعر وبنو أمية ) ( وقد يتبادر إلى الأذهان أنهم كانوا يفعلون ذلك رغبة
في الأدب وتنشيطًا لأهله ؛ لأن الشعر سجية في العرب ودولة الأمويين عربية بحتة
ولكن الأغلب أنهم كانوا يفعلونه للاستعانة بألسنة الشعراء على مقاومة أهل البيت )
إلخ ( الجزء الثالث صفحة 102 ) فانظر إلى هذا التحامل المفرط والحيف الشديد !
فإنه لما لم يجد سبيلاً إلى إنكار ما لبني أمية من الأيادي في ترويج سوق الأدب
ورفع منار الشعر والأخذ بناصر علماء العربية وإعطاء الصلات المتكاثرة للشعراء
احتال لدفعه بإبداء احتمال أنهم كانوا مدفوعين إلى ذلك سياسة .
قال ( وقد تقدم في كلامنا عن الفقه أن المنصور أخذ يناصر أصحاب الرأي
والقياس ، واستقدم أبا حنيفة إلى بغداد ونشطه لهذه الغاية ، وظل الميل إلى القياس
متواصلاً في بني العباس والاعتزال أقرب المذاهب إلى أصحاب الرأي ) إلخ
( الجزء الثالث صفحة 140 ) انظر إلى ما بلغ به حال المؤلف في جهله بالمعارف
الإسلامية حتى أنه يقرن بين الاعتزال والرأي ويعدهما من جنس واحد ! ولم يدر
المسكين أن لا رابط بينهما فإن الاعتزال أحد المذاهب الكلامية والرأي والقياس أحد
أصول الفقه ومعظم أصحاب الرأي والقياس بل كلهم - إلا الشاذ النادر منهم - كأبي
حنيفة ومحمد وأبي يوسف وزفر والطحاوي والخصاف وأبي بكر الرازي والدبوسي
وغيرهم كانوا ناقمين على الاعتزال وكانوا يعدون المعتزلة من أهل الأهواء
والضلالة .
قال ( فلما أفضت الخلافة إلى المأمون أخذ يناصر أشياعه وصرح بأقوال لم
يكونوا يستطيعون التصريح بها خوفًا من غضب الفقهاء وفي جملتها القول بخلق
القرآن أي أنه غير منزل ) ( الجزء الثالث صفحة 141 ) .
وهل يكون كذب أعظم من هذا ؟ ! فإن خلق القرآن أو قدمه لا مساس له
بالتنزيل أو عدمه فإن الاختلاف فى : هل الكلام صفة حادثة تقوم بالله تعالى ؟ أو
هو صفة قديمة ؟ فالمعتزلة قالوا بحدوثه حذرًا من تعدد القدماء ، وأهل السنة وغيرهم
قالوا بقدمه ؛ لأن الحادث لا يقوم بقديم . فأما أن القرآن كلام الله تعالى منزل إلى
الرسول فهذا لا يختلف فيه اثنان .
قال ( وأما الفلسفة بحد ذاتها فقد كان أصحابها متهمين بالكفر وكان الانتساب
إليها مرادفًا للانتساب إلى التعطيل ، وقد شاع ذلك في بغداد بين العامة حتى في أيام
المأمون ولذلك سماه بعضهم أمير الكافرين ) ( الجزء الثالث صفحة 177 ) .
استشهد المؤلف في هذا القول باليعقوبي ونحن ننقل عبارته حتى تعرف مقدار
خديعة المؤلف ، قال اليعقوبي ( وشخص هرثمة من العراق إلى مرو سنة 201
وقيل : إنه انصرف بغير إذن من المأمون فلما دخل على المأمون .. .. قال من
نقرس ولا يمكنني أمشي في محفة .. .. وكلم المأمون بكلام عليه ودخل معه
يحيى بن عامر بن إسماعيل الحارثي فقال : السلام عليك يا أمير الكافرين .
فأخذته السيوف في مجلس المأمون حتى قتل ! فقال هرثمة : قدَّمت هذه المجوس
على أوليائك وأنصارك ؟ وأتوا محمد بن صالح بن المنصور فقالوا : نحن أنصار
دولتكم وقد خشينا أن تذهب هذه الدولة بما حدث فيها من تدبير المجوس )
( اليعقوبي صفحة 546 و547 ) إن المأمون استوزر حسن بن سهل وكان مجوسيًّا
أسلم فنقم العرب على المأمون ، وقالوا : إنك قدمت المجوس وقال له يحيى : السلام
عليك يا أمير الكافرين ، فهذا كله من السياسة لا مساس له بالفلسفة والاعتزال وابن
هرثمة ويحيى بن عامر الحارثي من أهل الجند ما عرفا الفلسفة ولا سمعا بها .
قال المؤلف ( ولكن الإسلام كان أقرب إلى إطلاق حرية الفكر والقول
وخصوصًا في أوائله فلم يكن أحدهم يستنكف من إبداء ما يخطر له ولو كان مخالفًا
لرأي الخليفة ولذلك كثرت الفرق الإسلامية يومئذ وتعددت مذاهب أصحابها في
القراءة والتفسير والفقه وفي كل شيء حتى ذهب بعضهم إلى أن سورة يوسف
ليست من القرآن لأنها قصة من القصص والقائلون بذلك العجاردة ( الجزء الثالث
صفحة 61 ) .
انظر إلى هذه الخديعة يمدح الإسلام بكونه أقرب إلى حرية الفكر ويدس فيه
أن بعض الطوائف الإسلامية كانت تنكر أن سورة يوسف من القرآن وهم العجاردة
يوهم بذلك أن العجاردة فرقة من الفرق الإسلامية وأن إنكار بعض سور القرآن كان
مذهبًا من مذاهب الإسلام مع أن العجاردة وهم حماد عجرد واثنان آخران معروفون
بالإلحاد والزندقة والمروق من الإسلام ذكرهم ابن خلكان و الشهرستاني وغيرهما .
__________
(15/415
الكاتب : محمد رشيد رضا
رمضان - 1330هـ
سبتمبر - 1912م
رمضان - 1330هـ
سبتمبر - 1912م
التقاريظ
( انتقاد تاريخ التمدن الإسلامي وآداب اللغة العربية )
تشر العالم الفاضل شمس العلماء الشيخ شبلي النعماني رئيس جمعية ندوة
العلماء هذا الانتقاد بكتاب خاص ، ونشر جميعه في مجلة المنار ، وقد طبعه على
حدة ، ثم كتب الأستاذ العالم المحقق الشيخ أحمد عمر الإسكندري انتقادًا على الجزء
الثاني من كتاب تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي أفندي زيدان ، ورأينا في مجلة
المشرق انتقادًا آخر لهذا الجزء أيضًا للأستاذ الأب لويس شيخو اليسوعي ، فرأينا
تذييل انتقاد الشيخ النعماني بهذين الانتقادين ، وسيصدر الكتاب في أثناء شهر شوال
المقبل إن شاء الله تعالى ، وإليك ما كتبه صاحب ومنشئ المنار مقدمة لانتقاد الشيخ
شبلي النعماني ، وهو :
بسم الله الرحمن الرحيم
{ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ } ( الأنبياء : 112 ) .
أمّا بعدُ ، فإن علماء الإفرنج قد سبقونا إلى وضع تاريخ سلفنا في القالب
العلمي الحديث . ثم حذا حذوهم رصيفنا الفاضل جرجي أفندي زيدان بكتابه الذي
سماه ( تاريخ التمدن الإسلامي ) فشكر له عمله هذا المسلمون عربهم وعجمهم
بإقبالهم عليه , وترجمتهم إيّاه إلى عِدّة لغات وثنائهم عليه . ولكن الرجل أقدم على
هذا الأمر ولم يعدّ له كل عدته ، ولا أخذ له جميعَ أُهْبَتِهِ ، لما رأى مجال القول
واسعًا ، وميدان الكتابة واسعًا ، وكلاهما خالٍ من فِرْسَانِ الكلام ، حملته أسلات
الأقلام ، وظن أنه يكفيه من الاستعداد لذلك اقتباس أسلوب الإفرنج فيه ,
ومراجعة كتبهم العربية الجامعة لمادته ، ككتب الدين والأدب ، والتاريخ والنسب ،
وإنْ كان لم يأخذ هذه العلوم عن أهلها ، ولا عَرَفَ فَرْعَها ولا أصلَها ، ولعله لم يقرأ
شيئًا من كتبها قراءة دراسة وبحث ، إلا بعض كتب التاريخ المعروفة ؛ لأنه لَمَّا يكُنْ
مسلمًا , ولم يَتَرَبَّ في مدرسة تُقرأُ فيها العلومُ الإسلامية , لم يكن له باعث على
تحصيل هذه العلوم ، وإنما رأى نفسه محتاجًا إلى مراجعة كتبها ، عندما قام في
نفسه الباعث للتأليف فيها ، وَمَنْ كان هذا شأنه لا يتسنّى له فَهْم ما يراجعه مِن
المسائل حقَّ الفهم .
وقد قال الفقهاء : إن نقل المخالف في المذهب لا يعتدّ به ؛ لأن الفِقْهَ - وإنْ كان
فنًّا واحدًا - تختلف اصطلاحات المذاهب وأصولها فيه ، وطرق الترجيح
والتصحيح لمسائله ، فمن يراجع عند الحاجة كتابًا في غير مذهبه الذي تَلَقَّاهُ
بالمدارسة لا يوثق بفهمه لما يراجعه فيه , وكثيرًا ما يغتر بغير الصحيح المعتمد عند
أهله منه ، وإذا كان الأمر كذلك في نقل فقيه مذهب لبعض المسائل مِن مذهب آخرَ ,
فأجدر بالمخالف في أصل الذي ينظر إليه في غير مِرْآتِهِ ، والذي لم يتدارس شيئًا من
علومه ، أنْ لا يُعْتَدَّ بِفَهْمِهِ ، ولا يوثقَ بنقله ، مَهْمَا كان متحريًا للحق ، صدوقًا في
النقل ، ينقل ما ينقله بالحرف ، فإذا كان ينقل بالمعنى كما هو دأب صاحب تاريخ
التمدن في الغالب , فإن خطأَه يكون أكثرَ .
كنت كلما نُشِرَ جزء من أجزاء هذا التاريخ أنظر في بعض صفحاته , فأرى
فيها خطأً وغَلطًا في النقل والرأي , ويظهر أن سببَه ما شَرَحْتُهُ آنِفًا ، أو جعل
الواقعة الجزئية قضيةً كُلِّيَّةً وقاعِدَةً عامَّةً ، وقد نبّهْتُ على ذلك في ( المنار ) غيرَ
مَرّةٍ , واقترحت على أهل الفراغ من أهل التاريخ أن يطالعوا الكتاب كله ، وينتقدوه
انتقادًا عادلاً ، ويبينوا أغلاطه وخطأه في المسائل الإسلامية ، وهضمه للأمة العربية ،
لعل المصنف يصحح ويصلح ما يظهر له من الصواب ، ويبيِّن عذره في غيره
فيتحرر الكتاب ؛ لأنه كثيرًا ما يطالب الكتاب بالانتقاد , واعتذرت عن نفسي إذ لم
تقم بهذا العمل بكثرة الشواغل التي يضيق بها وقتي .
ولما عرض المصنف تاريخه هذا على نظارة المعارف العمومية لتقرره في
مدارسها عهدتُ إلى بعض أصدقائي من أساتذة مدارسها العالية بالنظر فيه , وبيان
رأيهم فيه لها ، فطالعوه وَبَيَّنُوا للنظارة أنه لا يصلح للتدريس لكثرة أغلاطه المعنوية
واللفظية ، وتمنيت يومئذ لو كانوا أحصوا ما ظَهَرَ لَهُمْ مِن ذلك الغَلَطِ , وَنَشَرُوهُ ,
وَاقْتَرَحْتُ ذَلِكَ على بعضِهِمْ فَمَا أَفَادَ الاقْتِرَاحُ ، وإذًا لتيسر تنقيح الكتاب .
وقد انتقد بعض الناظرين الكتاب في المؤيد ، وَرَمَوْا مُؤَلِّفَهُ بِسُوءِ النِّيَّةِ ، وتعمُّدِ
التحريف ، وفسادِ الاستنباط ، وَرَأَوْا أنْ سببَ ذَلِكَ هو التعصُّب الديني والنظر إلى
تاريخ الإسلام وآدابه بعين السخط . وكنت مخالفًا لهم في هذا الرأي ، وجاهرت
بِالرَّدِّ عَلَيْهِمْ فيه ، على علمي بأنه لا يعقل أن ينظر أحد إلى دين لا يدين اللهَ به
بعين الرضا التي يراه بها أهله ؛ لأنني لا أرمي أحدًا بسوء النية ، إلا بِبَيِّنََةٍ وَحُجَّةٍ
قوية .
ثم جاءني في فاتحة هذا العام وَرَقَاتٌ مطبوعةٌ مِن مصنف جديد في الانتقاد
على هذا التاريخ لعالم شهير من علماء الهند ، يعده جرجي أفندي زيدان صديقًا له ،
وهو شمس العلماء الشيخ شبلي النعماني رئيس جمعية ندوة العلماء ، وجاءني معه
كتاب من مؤلفه يرغب إليّ فيه أن أنشر هذا الانتقاد في المنار لِيَعُمَّ نَفْعُهُ . وهذا
الكتاب هو الذي دعاني فيه أول مرة إلى مؤتمر ندوة العلماء ، ورياسة احتفاله
السنوي في هذا العام ، ولما رجحت إجابة الدعوة صار لنشر هذا الانتقاد في المنار
ثلاث دَوَاعٍ : فائدة الانتقاد في نفسه ، وإجابة اقتراح كاتبه لعلمه وفضله ، والحاجة
إلى مادة للمنار في مدة سفري غير ما أكتبه من التفسير وغيره ، إذ لا يتيسر لي أن
أكتب في السفر كل ما يحتاج إليه من المواد .
أذنت بنشر الانتقاد في المنار وسافرت بعد الشروع فيه ، ولم أكن أعلم بكل ما
جاء فيه من الإنحاء الشديد من المنتقد على مؤلف تاريخ التمدن الإسلامي , ورميه
بالتحريف والكذب في النقل ، واتِّهَامه بسوء النية والقصد ، ولم أكن أتصور منه كل
هذه الشدة في التُّهْمَة ، وإبرازها في أقبح صورة ، لعلمي بما بينهما من المودة
الأدبية ، والصحبة القَلَمِيَّة ، ولو علمت بذلك لاستأذنت المنتقد في حذف تلك الألقاب ،
والتلطف في هاتيك العبارات ، ولما لقيته في الهند , وكنت قد قرأت بعض ما
نشر من الانتقاد راجعته القول في سبب هذه الشدة , فعلمت أن سببها الانفعال والتألم
من مؤلف تاريخ التمدن الإسلامي لاعتقاده أنه تعمد التحريف والكذب لأجل تحقير
العرب .. . وسبب هذا الاعتقاد أن ذلك الخطأ الكبير ، والغلط العظيم إما أن يكون
عن جهل ، أو عن سوء قصد ، والمنتقد يستبعد جِدًّا أنْ يكونَ عن جهل ، فترجَّح أو
تعين عنده أنه عن سوء قصد ، هذا ما علمناه منه ، وقد أطلعني على كتاب جاءه من
جرجي أفندي زيدان يقول فيه : إنه رأى الانتقاد على كتاب تاريخ التمدن الإسلامي
منشورًا في المنار معزوًّا إلى صديقه الشيخ شبلي النعماني , فلم يصدق أنه له
ولم يشأ أن يتنازل عن صحبة عشرين سنةً قبل التثبت بسؤاله عنه ، وطلب منه أن
ينكر عزوه إليه ، ولكن الأستاذ لم يجبه بشيء ، ليعلم أن السكوت إقرار ، وأن
الكذب والتزوير لا يَدْنُوانِ مِن مجلة المنار ، وقد عُلم من هذا أن رصيفنا الفاضل
صاحب الهلال الأغر قد أساء الظن بنا ولا شبهة ، بمقدار ما أَحْسَنَّا الظَّنَّ فيه على
كثرة الشُّبه .
وإنني مع هذا أُشْهِدُ اللهَ والناسَ أنني أجد في نفسي أَلَمًا مِن هذا الانتقادِ في
المنار ، مِن حَيْثُُ نَبْذُ الرصيفِ فيه بتلك الألقاب ، ثُمَّ من نشره كذلك في كتاب على
حدته ، بإذن المؤلف وإجازته ، ولكن الدواعي توفرت , والبواعث قد قضت بهذا
النشر .
هذا وإننا نرجو أن يكون لظهور هذا الانتقاد في هذه الأيام فائدة وراء فائدة
تمحيص التاريخ وحمل صاحب تاريخ التمدن الإسلامي على التروي والتدقيق فيما
يكتبه بعد في تاريخ الإسلام ، تلك الفائدة المرجوة هي أن يترجم هذا الانتقاد باللغة
التركية كما ترجم التاريخ المنتقد فيكبح من جِماح دعاة العصبية التركية الذين
استعانوا بنشر ترجمته بلغتهم على تحقير العرب وانتقاص مدنيتهم ، وغمط
حضارتهم ، وتفضيل الأعاجم عليهم ، فكادوا يولدون بذم العرب عصبيةً عربيةً ،
بإزاء ما رفعوا قواعده من العصبية التركية ، ولو كانوا يقسمون الجنسية الإسلامية
إلى عِدَّةِ جنسيات ، من غير مفاضلة ومغامز تثير العصبيات ، وتفرق بين الإخوة
والأخوات لَهَانَ الأمرُ ، وقلّ الضُّرُّ ، وَلَكِنَّهُمْ سَفَكُوا بِهَا دِمَاءَ الألوف الكثيرة ،
وَأَضَاعوا بذلك القناطير المقنطرة من أموال الدولة ، ولا يعلم أحد إلا الله إلى أين
تنتهي عاقبتها ، إذا لم يوفق رجال الدولة إلى تلافي أَمْرها .
ثم المَرْجُوُّ مِنَ الْمُطَّلِعِ على هذا الانتقادِ أنْ يجعل حظه منه تحرير المسائل
التاريحية دون الالتفات إلى مقاصد الكاتبين ، ونِيّات المصيبين والمخطئين ،
{ فَبِشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ
هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ } ( الزمر : 17-18 ) .
... ... ... ... ... ... ... ... ... محمد رشيد رضا
***
الكاتب : أحمد عمر الإسكندري
شوال - 1330هـ
أكتوبر - 1912م
نظرة في الجزء الثاني من كتاب
تاريخ آداب اللغة العربية
[*]
( لحضرة الفاضل جرجي أفندي زيدان )
يتفق جمهور القراء بمصر على أن حضرة الفاضل جرجي أفندي زيدان من
أعظم الكتاب نشاطًا واجتهادًا ، وأسرعهم ترجمةً وتأليفًا ، وأكثرهم قصصًا وكتبًا ،
غير أنهم لا يتفقون على أن هذه القصص والكتب محررة العبارة مضبوطة الرواية
محققة الوقائع مصححة الأحكام .
وأنا مع جمهور المتفقين في الأمر الأول ، ولست مع كل المخالفين في الأمر
الثاني ، وإنما أنا مع مَن ينصف الرجل ، فلا أجحد فضله وتحبيبه المطالعة إلى كثير
من طلاب العربية بكتبه السهلة التناول ، وإن كنت أمقت تهوُّره واستهتاره في أمور .
ولو أتيح لكل كتاب من كتبه ناقد منصف يعلن للملأ ما يزلّ به قلمه لتحترز القراء
من الوقوع في خطئه ولانتفعوا بصوابه ، كما ينتفع المؤلف أيضًا بذلك بتصحيحه
عند إعادة طبعه أو بإلحاق جدول تصحيح به أو بالضرب على الخطأ بالسواد كما
فعل في بعض مواضع من هذا الكتاب الذي سنبحث في بعض مشتملاته الآن .
وأظن المؤلف لا يأنف مِن قَبُول ذلك النقد ، فطالما دعا إليه الكتاب ، وقل من
أجاب ؛ لأن الكتّاب على قِلّتهم في شغل شاغل بمصالحهم ، وأعمال وظائفهم ، عن
أن يُعْنَوْا بمصالح غيرهم ، اللهم إلا بعض نَفَرٍ إذا وَجَدوا مِن وقتهم فرصة اختلسوها
في سبيل المصلحة العامة .
وهذا ما أغرى فريقًا من الطلبة والإخوان في هذه العطلة المدرسية بأن أقفهم
على رأيي في هذا الجزء حتى إذا قرءوه هم أو مَن يريد الاستفادة من كل كتاب جديد
كانوا على بَيِّنَة من موضع الشبه فيه , فاخترت العافية وطويت عن طلبهم كشحًا
إجمامًا لنفسي وترفيهًا لصحتي وإيثارًا لحفظ المعرفة بيني وبين المؤلف ، ولكن
قاتل الله الإلحاح فإنه أنساني هذا كله ، وقرأت الكتاب فوجدته ككل كتاب حديث في
بابه لا يخلو من سمين وغث وسمينه أكثر من غثه ، وذلك ما نحمد عليه المؤلف
ونحث القراء على مطالعة تأليفه مع لفتهم إلى آراء النقادين والمقرظين فيه .
أما ما رأيته من الصواب والخطأ حسبما أستطيع , فسأذكره مجملاً معددًا
كمسائل لفهرست كتاب رفعًا لملل التطويل عن نفسي وعن القارئ .
غير سالك في التقريظ مسلك الذين يجدر بهم أن يكونوا أجراء لشركة
الإعلانات , ولا ناهج في النقد منهج الذين تنطبق عليه المادة ( 261 و262 ) من
قانون العقوبات ولكن قصدًا بين الطرفين وتوخيًا لِكِلْتَا الحُسْنَيَيْنِ .
***
وصف الكتاب في الجملة
الكتاب في ذاته حسن الطبع والورق ، سهل العبارة ، قصير المقدمة ، كثير
الأبواب والأقسام والعنوانات ، قريب الاستطراد ، مختصر التراجم ، متشابه
المقالات المفتتح بها كل عصر من العصور أو كل مبحث من المباحث المختلفة ،
خالٍ من الكلام في الخطابة والخطباء مع تيسر ذلك في العصر الأول من الدولة
العباسية ، قليل الاستشهاد جدًّا على أحوال الكتابة والكتاب ، كثير النقل عن
مستعربي الإفرنج من غير تمحيص لدعاواهم ، فيه كثير من صور فلاسفة اليونان
ونقلة السريان وصور خيالية لخرافات أهل القرون الوسطى من الإفرنج في حروب
الإسكندر المقدوني وتمثيل حداد عاشوراء بإيران في العصر الحاضر وصور خيالية
لبعض المراصد والآلات وصور لابن سينا ومعمل الرازي وصورة سفينة عربية
وغير ذلك مما يَزِيدُ القارئ وُلُوعًا بالمطالعة ، والكتاب بهجة وزينة .
***
محاسن الكتاب ومزاياه
إذا قصدنا إلى ذكر مزاياه فليس ذلك أن نستقصي كل صواب فيه ونذكره ، فإن
ذلك يخرج بنا إلى تأليف كتاب آخر لا يقل عن نصف كتاب المؤلف , وإنما نقصد
إلى بيان محاسن الكتاب ومزاياه في الجملة ، والذي يهم القارئ والمؤلف أن يبين
موضع الضعف والخطأ في الكتاب ليتنبه له كلاهما ، فمن هذه المحاسن والمزايا :
1- سهولة عبارة الكتاب فلا تمتنع على أي طبقة من الطبقات .
2- كثرة تناوله للمباحث المقصودة الآن عند الأوربيين والعصريين من آداب
اللغة بالإضافة إلى أي كتاب طبع إلى الآن في آداب اللغة العربية .
3- عناية المؤلف فيه بذكر كتب المؤلفين وَمَظَانّ وجودها , وأماكن طبعها
ناقلاً أكثر ذلك عن كتاب بروكلمان الألماني مما يتعذر على غير عارف باللغات
الأجنبية معرفته خصوصًا فن أحوال الكتب الذي للأوربيين فيه القدح المعلي , وإنْ
لم يكن من أغراض أبواب اللغة الأساسية ، هذا مع شك في صحة كل ذلك .
4- تعريفه القارئ في أكثر المواضع بالكتب التي تعرضت لها بنوع من
التوسع .
5- تذييل الكتاب بالمراجع التي نقل المؤلف عنها نصوص عباراته , وإن لم
يراع في ذلك الضبط , وبيان نوع طبع الكتاب المكرر الطبع .
6- حسن طبع الكتاب وجودة ورقه .
***
الأمور التي تؤخذ على الكتاب
يكفي القارئ أن أذكر بغاية الاختصار بعض هذه الأمور ، فإذا شاء أو شاء
المؤلف فضل إيضاح لبعض المباحث فصلته تفصيلاً .
ويمكن توزيع هذه الأمور إلى الأنواع الآتية :
1- الخطأ في الحكم الفني . أي تقرير غير الحقيقة العلمية سواءٌ كان ذلك
بقصد من المؤلف أم بغير قصد .
2- الخطأ في الاستنتاج . وهو ما يعذر فيه المؤلف ؛ لأنه اجتهاد من عند
نفسه , فإن أصاب فله الشكر , وإن أخطأ فَمَنْ ذا الذي ما ساء قط .
3- الدعوى بلا دليل وهو ما يقرره المؤلف من غير تدليل عليه وقد يكون في
ذاته صحيحًا , ولكنه في سوقه ساذجًا مجالاً للشك .
4- الخطأ في النقل وهو آتٍ مِن تصرف المؤلف في عبارات المؤلفين بقصد
اختصارها , أو من تسرعه في الجمع وقلة مراجعة الأصول .
5- قلة تحري الحقيقة بمراجعة الكتب المعتبرة والتواريخ الصادقة ووزن كل
عبارة بميزان العقل والإنصاف , وقياس الأمور بأشباهها , بل كثيرًا ما تروج عند
المؤلف أقوال الخصوم في خصومهم وأقوال الكتب الموضوعة لأخبار المُجَّان أو
لذكر عجائب الأمور وغرائبها .
6- تناقض بعض أقوال الكتاب .
7- الاختصار في كثير من التراجم والمباحث , وإهمال ما ليس من شأنه أن
يهمل .
8- إدخال ما ليس من موضوع الفن فيه لغير مناسبة أو لمناسبة ضعيفة جدًّا .
9- الاستدلال بجزئية واحدة على الأمر الكلي وهو كثير الحصول في جميع
كتب المؤلف , وفي أكثر استنتاجاته ودعاواه .
10- تقليد المستشرقين في مزاعمهم أو نقلها عنهم من غير تمحيص .
11- اضطراب المباحث وصعوبة استخراج فائدة منها لاختلال عبارتها أو
لعدم صفاء الموضوع للمؤلف .
12- اضطراب التقسيم والتبويب ؛ إما بِذِكْرِ المباحث في غير موضعها ,
وإما بعدّ رجال عصر في عداد رجال عصر آخر , وربما زاد المؤلف عن ذلك بعدّ
رجال فن في رجال فن آخر .
13- التحريف واللحن , وهما كثيرا الشيوع في جميع كتب المؤلف مع
سهولة الاحتراز عنهما بمراجعة الأصول عند التأليف والطبع واستئجار أحد
المصححين العَالِمِينَ بقواعد العربية .
14- تهافت المؤلف على تطبيق قانون النشوء والارتقاء حتى في الأمور التي
فيها تدلٍّ وانحطاط لا نشوء ولا ارتقاء .
( يتلى )
((يتبع بمقال تالٍ))
__________
تاريخ آداب اللغة العربية
[*]
( لحضرة الفاضل جرجي أفندي زيدان )
يتفق جمهور القراء بمصر على أن حضرة الفاضل جرجي أفندي زيدان من
أعظم الكتاب نشاطًا واجتهادًا ، وأسرعهم ترجمةً وتأليفًا ، وأكثرهم قصصًا وكتبًا ،
غير أنهم لا يتفقون على أن هذه القصص والكتب محررة العبارة مضبوطة الرواية
محققة الوقائع مصححة الأحكام .
وأنا مع جمهور المتفقين في الأمر الأول ، ولست مع كل المخالفين في الأمر
الثاني ، وإنما أنا مع مَن ينصف الرجل ، فلا أجحد فضله وتحبيبه المطالعة إلى كثير
من طلاب العربية بكتبه السهلة التناول ، وإن كنت أمقت تهوُّره واستهتاره في أمور .
ولو أتيح لكل كتاب من كتبه ناقد منصف يعلن للملأ ما يزلّ به قلمه لتحترز القراء
من الوقوع في خطئه ولانتفعوا بصوابه ، كما ينتفع المؤلف أيضًا بذلك بتصحيحه
عند إعادة طبعه أو بإلحاق جدول تصحيح به أو بالضرب على الخطأ بالسواد كما
فعل في بعض مواضع من هذا الكتاب الذي سنبحث في بعض مشتملاته الآن .
وأظن المؤلف لا يأنف مِن قَبُول ذلك النقد ، فطالما دعا إليه الكتاب ، وقل من
أجاب ؛ لأن الكتّاب على قِلّتهم في شغل شاغل بمصالحهم ، وأعمال وظائفهم ، عن
أن يُعْنَوْا بمصالح غيرهم ، اللهم إلا بعض نَفَرٍ إذا وَجَدوا مِن وقتهم فرصة اختلسوها
في سبيل المصلحة العامة .
وهذا ما أغرى فريقًا من الطلبة والإخوان في هذه العطلة المدرسية بأن أقفهم
على رأيي في هذا الجزء حتى إذا قرءوه هم أو مَن يريد الاستفادة من كل كتاب جديد
كانوا على بَيِّنَة من موضع الشبه فيه , فاخترت العافية وطويت عن طلبهم كشحًا
إجمامًا لنفسي وترفيهًا لصحتي وإيثارًا لحفظ المعرفة بيني وبين المؤلف ، ولكن
قاتل الله الإلحاح فإنه أنساني هذا كله ، وقرأت الكتاب فوجدته ككل كتاب حديث في
بابه لا يخلو من سمين وغث وسمينه أكثر من غثه ، وذلك ما نحمد عليه المؤلف
ونحث القراء على مطالعة تأليفه مع لفتهم إلى آراء النقادين والمقرظين فيه .
أما ما رأيته من الصواب والخطأ حسبما أستطيع , فسأذكره مجملاً معددًا
كمسائل لفهرست كتاب رفعًا لملل التطويل عن نفسي وعن القارئ .
غير سالك في التقريظ مسلك الذين يجدر بهم أن يكونوا أجراء لشركة
الإعلانات , ولا ناهج في النقد منهج الذين تنطبق عليه المادة ( 261 و262 ) من
قانون العقوبات ولكن قصدًا بين الطرفين وتوخيًا لِكِلْتَا الحُسْنَيَيْنِ .
***
وصف الكتاب في الجملة
الكتاب في ذاته حسن الطبع والورق ، سهل العبارة ، قصير المقدمة ، كثير
الأبواب والأقسام والعنوانات ، قريب الاستطراد ، مختصر التراجم ، متشابه
المقالات المفتتح بها كل عصر من العصور أو كل مبحث من المباحث المختلفة ،
خالٍ من الكلام في الخطابة والخطباء مع تيسر ذلك في العصر الأول من الدولة
العباسية ، قليل الاستشهاد جدًّا على أحوال الكتابة والكتاب ، كثير النقل عن
مستعربي الإفرنج من غير تمحيص لدعاواهم ، فيه كثير من صور فلاسفة اليونان
ونقلة السريان وصور خيالية لخرافات أهل القرون الوسطى من الإفرنج في حروب
الإسكندر المقدوني وتمثيل حداد عاشوراء بإيران في العصر الحاضر وصور خيالية
لبعض المراصد والآلات وصور لابن سينا ومعمل الرازي وصورة سفينة عربية
وغير ذلك مما يَزِيدُ القارئ وُلُوعًا بالمطالعة ، والكتاب بهجة وزينة .
***
محاسن الكتاب ومزاياه
إذا قصدنا إلى ذكر مزاياه فليس ذلك أن نستقصي كل صواب فيه ونذكره ، فإن
ذلك يخرج بنا إلى تأليف كتاب آخر لا يقل عن نصف كتاب المؤلف , وإنما نقصد
إلى بيان محاسن الكتاب ومزاياه في الجملة ، والذي يهم القارئ والمؤلف أن يبين
موضع الضعف والخطأ في الكتاب ليتنبه له كلاهما ، فمن هذه المحاسن والمزايا :
1- سهولة عبارة الكتاب فلا تمتنع على أي طبقة من الطبقات .
2- كثرة تناوله للمباحث المقصودة الآن عند الأوربيين والعصريين من آداب
اللغة بالإضافة إلى أي كتاب طبع إلى الآن في آداب اللغة العربية .
3- عناية المؤلف فيه بذكر كتب المؤلفين وَمَظَانّ وجودها , وأماكن طبعها
ناقلاً أكثر ذلك عن كتاب بروكلمان الألماني مما يتعذر على غير عارف باللغات
الأجنبية معرفته خصوصًا فن أحوال الكتب الذي للأوربيين فيه القدح المعلي , وإنْ
لم يكن من أغراض أبواب اللغة الأساسية ، هذا مع شك في صحة كل ذلك .
4- تعريفه القارئ في أكثر المواضع بالكتب التي تعرضت لها بنوع من
التوسع .
5- تذييل الكتاب بالمراجع التي نقل المؤلف عنها نصوص عباراته , وإن لم
يراع في ذلك الضبط , وبيان نوع طبع الكتاب المكرر الطبع .
6- حسن طبع الكتاب وجودة ورقه .
***
الأمور التي تؤخذ على الكتاب
يكفي القارئ أن أذكر بغاية الاختصار بعض هذه الأمور ، فإذا شاء أو شاء
المؤلف فضل إيضاح لبعض المباحث فصلته تفصيلاً .
ويمكن توزيع هذه الأمور إلى الأنواع الآتية :
1- الخطأ في الحكم الفني . أي تقرير غير الحقيقة العلمية سواءٌ كان ذلك
بقصد من المؤلف أم بغير قصد .
2- الخطأ في الاستنتاج . وهو ما يعذر فيه المؤلف ؛ لأنه اجتهاد من عند
نفسه , فإن أصاب فله الشكر , وإن أخطأ فَمَنْ ذا الذي ما ساء قط .
3- الدعوى بلا دليل وهو ما يقرره المؤلف من غير تدليل عليه وقد يكون في
ذاته صحيحًا , ولكنه في سوقه ساذجًا مجالاً للشك .
4- الخطأ في النقل وهو آتٍ مِن تصرف المؤلف في عبارات المؤلفين بقصد
اختصارها , أو من تسرعه في الجمع وقلة مراجعة الأصول .
5- قلة تحري الحقيقة بمراجعة الكتب المعتبرة والتواريخ الصادقة ووزن كل
عبارة بميزان العقل والإنصاف , وقياس الأمور بأشباهها , بل كثيرًا ما تروج عند
المؤلف أقوال الخصوم في خصومهم وأقوال الكتب الموضوعة لأخبار المُجَّان أو
لذكر عجائب الأمور وغرائبها .
6- تناقض بعض أقوال الكتاب .
7- الاختصار في كثير من التراجم والمباحث , وإهمال ما ليس من شأنه أن
يهمل .
8- إدخال ما ليس من موضوع الفن فيه لغير مناسبة أو لمناسبة ضعيفة جدًّا .
9- الاستدلال بجزئية واحدة على الأمر الكلي وهو كثير الحصول في جميع
كتب المؤلف , وفي أكثر استنتاجاته ودعاواه .
10- تقليد المستشرقين في مزاعمهم أو نقلها عنهم من غير تمحيص .
11- اضطراب المباحث وصعوبة استخراج فائدة منها لاختلال عبارتها أو
لعدم صفاء الموضوع للمؤلف .
12- اضطراب التقسيم والتبويب ؛ إما بِذِكْرِ المباحث في غير موضعها ,
وإما بعدّ رجال عصر في عداد رجال عصر آخر , وربما زاد المؤلف عن ذلك بعدّ
رجال فن في رجال فن آخر .
13- التحريف واللحن , وهما كثيرا الشيوع في جميع كتب المؤلف مع
سهولة الاحتراز عنهما بمراجعة الأصول عند التأليف والطبع واستئجار أحد
المصححين العَالِمِينَ بقواعد العربية .
14- تهافت المؤلف على تطبيق قانون النشوء والارتقاء حتى في الأمور التي
فيها تدلٍّ وانحطاط لا نشوء ولا ارتقاء .
( يتلى )
((يتبع بمقال تالٍ))
__________