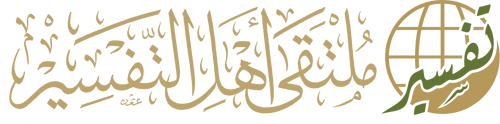مرهف
New member
- إنضم
- 27/04/2003
- المشاركات
- 511
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
- الإقامة
- ـ سوريا
- الموقع الالكتروني
- www.kantakji.org
هل الاشتغال بالتفسير العلمي والإعجاز العلمي بدعة وضلال؟!بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله الذي أكرمنا وشرَّفنا بهذا الكتاب المبين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
لقد أخذت قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم جدلاً واسعاً بين المثقفين كما العلماء، وما زال تداولها بين التأييد والرفض، إما من حيث الأصل أو بالاستناد لمنهج العاملين في الإعجاز العلمي أو التفسير العلمي.
فبعض المعارضين ينتحلون التمحل والتكلف في بعض الأبحاث عذراً لرفضه، وبعض المؤيدين يدافعون عن ذلك بذكر الضوابط والحرص على اجتناب التكلف.
وما تزال الكتابات والمقالات حول قضية التفسير العلمي والإعجاز العلمي في القرآن من كلا الفريقين تتسابق في الطرح والنقاش.
وقد استوقفتني ثلاث مقالات لأحد الكاتبين؛ يختلف الطرح والأسلوب فيها عن غيرها مما قرأته، إذ شدد فيها النكير بعنف على من يؤيد قضية الإعجاز العلمي والمهتمين بها، حتى وصف ذلك بالبدعة، وجعلها تفسيراً لليقين بالظن - كما في عنوان أحدى مقالاته -، ووصف العاملين بالإعجاز العلمي بأصحاب الفكر المنحرف، وممن وسوس فيهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم صرف الناس بالفكر عن الوحي، وبالظن عن اليقين وبالفنون الدنيوية عن علوم الشريعة(1).
واعتبر الكاتب أن الغزالي (505هـ)، ومن بعده الرازي (606هـ) أول المبتدعين لشبهة الإعجاز العلمي في القرآن، ثم زعم أنه زاد في الطين بلة ابن أبي الفضل المرسي (655هـ) بعدهما، كما اعتبر الكواكبي (1320هـ) من السابقين إلى هذا الابتداع في العصر الحديث، واعتبر عاقد لواء بدعة الإعجاز العلمي طنطاوي جوهري (1358هـ) في كتابه تفسير الجواهر، بل واعتبر المشتغلين بالإعجاز العلمي متتبعين لسنن اليهود والنصارى لأنهم بزعمه أول من اشتغل بالإعجاز العلمي في كتبهم قبل المسلمين، ثم ختم أحد مقالاته بالقول: (وبدعة الإعجاز العلمي للقرآن لا تعدو أن تكون إهانة للقرآن، وإعلاء لنظريات الملحدين).
صراحة ما كنت لأقف على هذه المقالات لولا ما فيها من مغالطات وإساءات علمية وأدبية، يخال لقارئها أن علماء الأمة في السابق والآن؛ يتآمرون على الإسلام ويحرفون كلام الله تعالى تحت لواء الإعجاز العلمي، وأن المشتغلين بالإعجاز العلمي من الأفراد والمؤسسات أعداء لهذا الدين، منحرفون ضالون، ويهيج عليهم ولاة الأمور، فرأيت من الواجب العلمي أن أبين أصل المسألة، وأضع إضاءة انطلاق لمن يبحث عن الحق قولاً وعملاً، وأوضح لصاحب المقالات أنه تطرف في الحكم وابتعد عن أصول البحث العلمي في مصادرة الأحكام والانطلاق من أحكام مسبقة متحاملة على القضية قبل تحريها من كافة جوانبها، فأدى به إلى اتهام العلماء اتهاماً وصل إلى الفرية عليهم.
ولذلك فلن أتعرض لتهجمه الشخصي على العلماء والهيئات باختصاصاتهم؛ فهم حجيجه يوم القيامة وهو خصمهم أمام الله، كما سأضرب صفحاً عن أسلوبه النابي الجارح في النقاش، تحت راية نصرة الدين والحمية لمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم.
ولكني أوجه له نصيحة أستهل بها كلامي فأقول: ما هكذا تورد الإبل يا سعد، وما هكذا منهج سلفنا الصالح –إن كنت منتسباً إليهم - في النصيحة والإرشاد؛ أن يكيلوا الناس بالتهم والتجريح والتشكيك بمصداقيتهم لخلفيات شخصية أو غير ذلك.
يفترض في كل باحث عندما يسجل موقفه من قضية علمية؛ أن ينطلق في بحثه من خلفية متجردة مخلصة لله تعالى، وأن يقف من القضية العلمية بين مؤيديها ومعارضيها على مسافة متساوية؛ ويدقق ويبحث بحثاً عملياً لا نظرياً فقط، ثم يسجل رأيه مدعماً بالدليل، لا أن ينطلق من خلفية جاهزة وحكم مسبق، ليس عليه إلا أن يلصق التهم ويوزعها على الناس يميناً ويساراً، فالإنكار والمعارضة دون دراية يحسنها كل أحد، ولكن البحث العلمي يحتاج لرجال.
ويبدو أن كاتب المقالات الثلاث ليس لديه دراية كافية في القضية التي يتكلم فيها من حيث التاريخ والمنهج، وذلك لاعتماده على مرجع واحد في ما سماه "نشأة الإعجاز العلمي"، وكذلك عدم تفريقه بين مسألتين أساسيتين: أحدهما: التفسير العلمي، والثانية: الإعجاز العلمي، وإن كان كلاهما شيئاً واحداً عنده؛ فهذه قضية أخرى، ومع ذلك سأناقش فكرته على العموم من حيث أصلها؛ وهو استنباط المعارف من القرآن الكريم، وتسخير العلوم الكونية والمعارف البشرية في بيان القرآن الكريم، ولن أناقش هذين المصطلحين والفرق بينهما فهذا شأن يطول ويحتاج مبحثاً لوحده؛ هذا مع العلم أن مصطلح "الإعجاز العلمي" مصطلح جديد لم يقصده الغزالي عندما كتب جواهر القرآن، ولكن أشار إليه السيوطي في كتابه معترك الأقران إذ جعل من وجوه إعجاز القرآن اشتماله على العلوم المختلفة المستنبطة منه، واستدل على ذلك بنحو عمله في الإتقان(2).
وقد قسمت البحث إلى مطالب أربعة :
المطلب الأول: استنباط العلوم في عهد النبي والسلف الصالح.
المطلب الثاني: أصل مشروعية الاستفادة من علوم غير المسلمين في بيان أمور الدين.
المطلب الثالث: توسع استنباط المعارف وتسخير العلوم في تفسير كتاب الله.
المطلب الرابع: ملامح الانحراف في اتجاه التفسير العلمي والإعجاز العلمي.
هذا وأسأل الله أن يجعل هذا البحث نافعاً، ويضع الباحث في هذه القضية في الجادة التي ترشده للوصول إلى ما يرضي الله، فما كان من صواب فذلك توفيق من الله، وما كان من زلل فخطأ اجتهاد مني أسأل الله الأجر عليه والحمد لله رب العالمين.
المطلب الأول: استنباط العلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح:
لقد كان أثر القرآن في تصحيح مفاهيم الناس عند نزوله أثراً عظيماً، فقد محا الخرافات المتداولة بين الناس حول الشمس والقمر، وحول نزول المطر، وخلق الإنسان وغير ذلك، كما صحح مفاهيمهم اتجاه القضايا الكونية التي انطبعت في أذهان الجاهلية بالخرافات كالطيرة وغير ذلك، وكان ارتباط تصحيح هذه المفاهيم بالعقيدة ارتباطاً وثيقاً، كما أن منهج الآيات القرآنية في المرحلة المكية كان منهجاً يفتق العقل ويعصف به؛ ليستيقظ من غفوة الجهل ويدرك عظمة الخالق؛ ويتفكر بالآيات القرآنية الدالة على الآيات الكونية، وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان معارف القرآن الكريم، مثال ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ[الانفطار:8] قال: (لكن في الصحيحين عن أبي هُرَيرة أن رَجُلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي وَلَدت غُلامًا أسودَ؟. قال: "هل لك من إبل؟". قال: نعم. قال: "فما ألوانها؟" قال: حُمر. قال: "فهل فيها من أورَق؟" قال: نعم. قال: "فأنى أتاها ذلك؟" قال: عسى أن يكون نزعة عِرْق. قال: "وهذا عسى أن يكون نزعة عرق" ) (3)، وأراد ابن كثير بذلك أن يجعل الحديث بياناً للآية، وبيان ذلك: أن الله تبارك وتعالى يخلق الإنسان ويخلق صفاته وهيأته على شبه أحد أجداده وليس على شبه أحد أبويه، ومرد ذلك لإرادة الله تعالى يجعل المولود في أي صورة من صور أجداده يركبه بها، لأنه تعالى هيأ النطفة حاملة جينات الأجداد الوراثية.
ولم يكن الصحابة يقفون في فهم القرآن على العبادات والتوحيد فقط -كما ذكر صاحب المقالات الثلاث -، وإنما كان استنباطهم وفهمهم أوسع من ذلك بكثير، فقد أدرك سلفنا الصالح أن القرآن جامع للعلوم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: (من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن..) (4).
ويقول مسروق رحمه الله: (من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة) (5)، وكانت معرفتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسليقتهم العربية ومعاينتهم التنزيل مستنداً في فهم معاني كتاب الله تعالى واستنباط العلوم، ومن ذلك يقول "ابن عباس في قوله: مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ (يعني: ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا، ثم ينتقل بعد من طور إلى طور، وحال إلى حال، ولون إلى لون). وهكذا قال عكرمة، ومجاهد، والحسن، والربيع بن أنس: الأمشاج: هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة" (6). وكتب التفسير بالمأثور غنية بالأدلة على ذلك، وما علينا إلا أن نتعب أنفسنا في استخراجها قبل رمي الناس بأحكام جائرة جزافاً دون تحقيق.
المطلب الثاني: أصل مشروعية الاستفادة من علوم غير المسلمين في بيان أمور الدين:
لقد وردت الإشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم في أصل مشروعية الاستفادة من علوم غير المسلمين للاستفادة منها في بيان ما نحتاج من أمور الدين؛ وكان فهم سلفنا الصالح لهذه الإشارة من أسباب الانفتاح على العلوم عند الفتوحات الإسلامية، ففي الحديث الذي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ) (7).
وفي حديث آخر عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى النبي فقال : إني أعزل عن امرأتي ، فقال له رسول الله : لم تفعل ذلك ؟ فقال الرجل : أشفق على ولدها، فقال رسول الله : لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم - وفي لفظ : إن كان لذلك فلا ، ما ضار ذلك فارس ولا الروم) (8).
يقول النووي: (قَالَ الْعُلَمَاء: سَبَب هَمّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْهَا أَنَّهُ يَخَاف مِنْهُ ضَرَر الْوَلَد الرَّضِيع، قَالُوا: وَالْأَطِبَّاء يَقُولُونَ: إِنَّ ذَلِكَ اللَّبَن دَاء وَالْعَرَب تَكْرَههُ وَتَتَّقِيه) (9).
ومن المعلوم أن الروم وفارس كانتا أعلم بكثير من العرب في أمور الطب، ولذلك يقول المناوي في فيض القدير: (يعني لو كان الجماع أو الإرضاع حال الحمل مضرا لضر أولاد الروم وفارس، لأنهم يفعلونه مع كثرة الأطباء فيهم فلو كان مضرا لمنعوه منه فحينئذ لا أنهى عنه) (10)، فاحتج النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الضرر بعمل الروم وفارس لكونهم أعلم بالأمور الطبية، وفي ذلك إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى جواز الاستدلال بعلوم غير المسلمين، والاستفادة من علومهم في تقرير الأحكام الشرعية، التي هي توقيع عن رب العالمين، وكذلك التفسير هو الرواية عن الله تعالى كما يقول مسروق: (اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله).
والتفسير في ضوء المعارف العلمية والحقائق الكونية إنما هو بيان لكلام الله بأفعال الله تعالى إذ هي من خلقه سبحانه، مع ضبط هذا البيان بضوابط التفسير المقررة، واستناداً إلى هذا الأصل بنى الغزالي دعواه إلى استنباط المعارف من القرآن الكريم، ثم عرض الغزالي مثلاً لما ذهب إليه بقوله تعالى: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ [الشعراء:80]، فقال: ( وهذا الفعل لا يعرفه إلا من عرف الطب بكماله، إذ لا معنى للطب إلا معرفة المرض بكماله وعلاماته ومعرفة الشفاء وأسبابه .. ) (11).
أقول : وفي المثال الذي ذكره الغزالي إشارة إلى حاجة إظهار هذه العلوم لمختصين متأهلين للخوض في كتاب الله تعالى منضبطين بمقصد القرآن في الهداية والإرشاد، فإن معاني القرآن مكنونة في ألفاظه وتراكيبه، ولا يستطيع غوص غماره لاستكشاف عجائبه إلا من ألم بآلات العلوم وأصول الاستنباط.
المطلب الثالث: توسع استنباط المعارف وتسخير العلوم في تفسير كتاب الله:
"وبمجيء العصر العباسي واجهت حركة تفسير القرآن تيارات فكرية وتغييرات اجتماعية جديدة، دخلت على المجتمع المسلم نتيجة الاختلاط الحضاري بين الحضارة الإسلامية والحضارات السابقة، التي انتقلت فلسفاتها وعلومها إلى المجتمع الإسلامي، فحاول علماء الإسلام أن يستفيدوا منها لفهم القرآن الكريم وتوسيع معارفهم العقلية والفلسفية والعلمية حول كثير من المسائل التي وردت في آياته، فمن جهة حاولوا فهم كثير من أسرار الشريعة الإسلامية من خلال تطويرهم الكبير للعلوم الكونية والطبيعية، ومن جهة أخرى رأوا أن بناء العقائد الإسلامية التي وردت في القرآن الكريم على المرتكزات العقلية الفلسفية المنطقية غدا أمراً ضرورياً أمام المطاعن التي وجهت إلى الكتاب الكريم من قبل اللاهوتيين من أهل الأديان الأخرى ومنكري النبوات الذين شنوا هجوماً فكرياً مركزاً على أصول تلك العقائد، فانبرى علماء الكلام يفندون آراءهم ويردون اعتراضاتهم ويثبتون إعجاز القرآن العقلي والمنطقي" (12).
وكان من أبرز العلماء الذين عرفوا بهذا الاتجاه: الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله (505هـ)، وذلك في كتابيه إحياء علوم الدين، وجواهر القرآن.
وتبعه القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله (543هـ) في كتابه قانون التأويل، بل إن القاضي رحمه الله – مع معرفتنا بمعارضته للغزالي في قضايا علمية متعددة – فإنه يقول ما قاله الغزالي في عدد العلوم في القرآن دون اعتراض، فقد ذكر في قانون التأويل مقرراً أن "علوم القرآن خمسون علماً وأربع مئة علم، وسبعة آلاف وسبعون ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة، إذ لكل منها ظاهر وباطن وحد ومطلع، هذا مطلق دون اعتبار تركيبه، و[نضم] بعضها إلى بعض وما بينها من روابط على الاستيفاء في ذلك كله، وهذا مما لا يحصى ولا يعلمه إلا الله تعالى" (13) ا.هـ.ويقول الإمام ابن العربي في موطن آخر : (وإنما عني العلماء بقولهم إن العلوم كلها في كتاب الله ما كان علماً لذاته، لا ما وقعت الدعوى فيه أنه علم وهو جهل، وذلك يرجع إلى العلوم الشرعية والحقائق العقلية، فإن جميعها مضمَّن في كتاب الله، والدليل عليه مبيَّن، وكل جهالة أو سخافة ادعتها طائفة فالرد عليها في كتاب الله موجود أيضاً مبيَّن) (14).
ثم طبق الفخر الرازي رحمه الله (606هـ) ذلك في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب، وكان شأنه شأن كل مفسر مجتهد، فأصاب وأخطأ.
وإلى هذا القول – أي أن جميع العلوم في القرآن – ذهب الزركشي في البرهان وذكر أن "العلوم كلها داخلة في أفعال الله وصفاته وفي القرآن شرح ذاته وصفاته وأفعاله"(15) ، وأكثر من النقول عن السلف الصالح وعن العلماء من بعدهم في هذه القضية، ثم أفرد فصلاً في برهانه ليقول: (وفي القرآن علم الأولين والآخرين وما من شيء إلا ويمكن استخراجه منه لمن فهمه الله تعالى) (16).
وكذلك فعل السيوطي في الإتقان عندما عقد (النوع الخامس والستون في العلوم المستنبطة من القرآن) (17) ، صدره بقوله تعالى: مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ [الأنعام:38]، فقال: (وأنا أقول: قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء، أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل؛ إلا وفي القرآن ما يدل عليها، وفيه عجائب المخلوقات وملكوت السموات والأرض، ومافي الأفق الأعلى وتحت الثرى وبدء الخلق و.. و..الخ) (18). وأكد دعواه هذه في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل.
وممن طبق منهج استنباط العلوم والاستدلال على صحتها أوإبطالها باجتهاده على ضوء العلوم والمعارف في عصره من المفسرين: العلامة محمود الآلوسي (1270هـ) في تفسيره روح المعاني، ثم حفيده العلامة السيد محمود شكري الآلوسي (1341هـ) في كتابه: (ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئةَ الجديدةَ القويمةَ البرهانِ) (19) ، عرض الآلوسي الحفيد في كتابه هذا ما تقول به الهيئة الجديدة –هيئة الأفلاك- على ما قاله فيثاغوس، إذ انتشرت في عصره، يقول الآلوسي: (فقد رأيت كثيراً من قواعدها لا يعارض النصوص الواردة في الكتاب والسنة، على أنها لو خالفت شيئاً من ذلك لم يلتفت إليها، ولم تؤول النصوص لأجلها، والتأويل فيهما ليس من مذاهب السلف الحرية بالقبول، بل لا بد أن نقول: إن المخالف لهما مشتمل على خلل فيه، فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، بل كل منهما يصدق الآخر ويؤيده، واعلم أن الشريعة الغراء لم ترد باستيعاب قواعد العلوم الرياضية، إنما وردت بما يستوجب سعادة المكلفين في العاجل والآجل، وبيان ما يتوصلون به إلى الفوز بالنعيم المقيم، وربما أشارت –لهذه الأغراض- إلى ما يستنبط منه بعض القواعد الرياضية،..) (20).
وأما معارضة الإمام الشاطبي رحمه الله قديماً فقد كانت فردية، ولظروف عصرية، ولم تلق أدلته صدى لدى العلماء، إلا في العصر الحديث عندما ظهر الانحراف في التفسير العلمي (21).
المطلب الرابع: ملامح الانحراف في اتجاه التفسير العلمي والإعجاز العلمي:
أما ما ذكره د. نعناعة بأن نزعة "التفسير العلمي" عند الغزالي والرازي لقصد التوفيق بين القرآن وما جد من العلوم (22) ، وتابعه على هذا صاحب المقالات الثلاث؛ فهذا إسقاط لواقع الحال الذي نعيشه نحن من التخلف والكسل، على العصر الذهبي الذي كان العالم الإسلامي ينعم فيه بالعلوم ويصدرها للأمم الأخرى، والمتتبع لتاريخ العلوم يعلم ذلك، وإنما فكرة التوافق بين القرآن وما جد من العلم؛ ظهرت حديثاً في عصر التراجع العلمي وسيطرة الاستعمار والغزو الفكري في عالمنا الإسلامي (23) ، وللرد على من ادعى التناقض بين العلم والدين تأثرأ بالثورة الأوربية على الكنيسة التي حرمت العلم، وأنها ما نهضت إلا بنبذ الدين والأخذ بالعلم، وتجلت فكرة التوافق واضحة على يد المنبهرين بالحضارة الأوربية والتقدم العلمي فيها، الذين ولوا وجوههم شطر أوربة؛ كالسيد أحمد خان(1314هـ) في الهند، وجمال الدين الأفغاني(1314هـ) وتلميذه الشيخ محمد عبده (1323هـ) في البلاد العربية – وليس الكواكبي الأول كما ذكر صاحب المقالات الثلاث -، وعزز ذلك الشيخ رشيد رضا(1354هـ) في نشره تفسير الشيخ محمد عبده في مجلة المنار.
فقد أوّل محمد عبده الطير الأبابيل بالجراثيم مثلاً، وأنكر رشيد رضا بعض المعجزات بحجة تقريب الفكرة للغرب (24) ، وتبعهما على ذلك خلق كثير على شاكلتهم، وبدأ بذلك الانحراف في اتجاه التفسير العلمي من منهج الاستنباط والاستدلال، إلى منهج التطويع والتكلف والتمحل لإثبات العلوم من القرآن الكريم والرد على العلمانيين والقادمين من أوربا من الوفود، الداعين لرفض الدين بحجة التعارض بين العلم والدين، وتمثل هذا المنهج كاملاً في تفسير الشيخ طنطاوي جوهري يرحمه الله، فقد غالى الشيخ طنطاوي جوهري في ذلك كثيراً في تفسيره مع حسن المقصد منه رحمه الله، وحكّم النظريات العلمية والفلسفية في دلالات الآيات القرآنية، وقد أثر منهجه على الباحثين من بعده إلى يومنا هذا، مما دفع ببعض العلماء الأفاضل كالشيخ حسين الذهبي ومن تابعه أن ينكروا هذا العمل، واستدلوا بما استدل به الشاطبي.
ومع ذلك فقد وجدت تفاسير حوت اتجاه التفسير العلمي وتسخير العلوم الكونية في تفسير كتاب الله تعالى بمنهج علمي سليم بحسب القواعد المقررة في التفسير، كما فعل الشيخ سعيد النورسي، والشيخ جمال الدين القاسمي، والشيخ عبد الحميد بن باديس، والشيخ محمد بن الطاهر عاشور، ثم تبنت لجنة الشؤون الإسلامية في الأزهر إخراج التفسير المنتخب على هذا الاتجاه وفيه تعليقات لما يستنبط من العلوم من الآيات، ولا يبعد أن يوجد في عمل هؤلاء العلماء الأفاضل أخطاء اجتهادية، فالتفسير عمل بشري، يخطئ ويصيب، وكل عمل بما أوتيه من علم دون تعدٍّ.
الخاتمة:
إذن فدعوى احتواء القرآن للعلوم ليست مما انفرد به الغزالي، واستنباط العلوم وتسخيرها في فهم القرآن ليس بدعاً من الأمر قام به الغزالي والرازي بقصد تضليل الناس، وإنما هو منهج في التفسير من نشأته وسيبقى إلى يوم القيامة، ولا شك أن هناك تعسفاً وتمحلاً وتكلفاً من بعض المشتغلين بالتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي، لأن دافعهم الحماسي والعاطفي للكتابة في هذا المجال بنية حسنة دون تمكن من العلوم الشرعية، أو من العلوم التي ليست من اختصاصهم أدى بهم لهذا المنزلق الخطير في الكلام في كتاب الله تعالى، لكن هذا لا يعني أن نعلن الحرب الضروس على منهج من مناهج التفسير؛ له أصل شرعي وأصل عملي؛ ونبدع ونضلل المشتغلين فيه جزافاً وتشفياً.
ومن عجائب كلام صاحب المقالات الثلاث قوله: (فليس بين علماء الأمة المعتدّ بهم في القرون المفضلة طبيب ولا فيزيائي ولا فلكي ولا فيلسوف، وكانوا يحصرون العلم والتعليم الديني في الاعتقاد والعبادات والمعاملات من الوحي في الكتاب والسنة وفقه السلف في نصوصهما، ولم يلتفت المسلمون إلى المهن والفنون التي ذكرها إلا بعد مرحلة الضعف والانبهار بالفكر اليوناني والاهتمام بترجمته ثم النّسج على منواله في الفكر المنسوب إلى الدين.)!!
هذا كلام من لم يعرف مفهوم العلم في القرآن والسنة، ولم يكن لديه دراية في تاريخ العلوم الإسلامية، والجواب عنه يحتاج إلى تعليم قائله مراحل تطور العلوم الإسلامية ولا يكفيه أسطر أو صفحات.
وإذا كان الأمركما يقول؛ فلم قام هو بشد الرحال إلى أمريكا وتعلم فيها، وحصل على الماجستير في التربية من جامعة جنوبي كلفورنيا ـ لوس أنجلس كما في ترجمته على موقعه الإلكتروني، ولم يحصر نفسه بهذه العلوم الشرعية اتباعاً لمنهج علماء القرون المفضلة كما يدعي؛ فلم يعهد عنهم أنهم رحلوا لغير العلوم الشرعية، فكيف لو كانت هذه الرحلة إلى بلد تشبعت بدماء المسلمين كأمريكا؟!.
فلا أدري: هل هذه دعوة من صاحب المقالات الثلاث لنبذ المسلمين العلوم وتركهم التعلم؛ بحجة عدم وجود علماء من القرون المفضلة في هذه الاختصاصات.
ثم هل عدم وجود علماء من السلف الصالح اشتغلوا بالعلوم الكونية – على فرض صحة ذلك – يعني تحريم تعلمها وتحريم دراستها، لعل الجواب يعرفه كل مطلع على علم أصول الفقه، فإن ترك السلف الصالح لأمر ما لا يعني تحريمه، كما أن فعلهم لأمر لا يعني وجوبه، فالعبرة في الوجوب والتحريم نصوص الشرع من الكتاب والسنة، لا فعل غير المعصوم (25) ، والله الهادي للصواب والحمد لله رب العالمين.
الحواشي: ـــــــــــــــــــــــــــ
1- انظر مقال: بدعة الانشغال بالإعجاز الظني عن التدبر اليقيني، ومقال الإعجاز العلمي للقرآن، ومقال بدعة الانشغال بالإعجاز الظني عن التدبر اليقيني كلها للشيخ سعد الحصين على موقعه: http://www.saad-alhusayen.com/articles/
وكل النصوص التي استشهدت بها من كلامه موجودة على موقعه قسم المقالات.
2- انظر : معترك الأقران 1/17 وما بعد ط دار الكتاب العربي .
3- تفسير ابن كثير 8 /343 ط دار طيبة.
4- أخرجه سعيد بن منصور كما في الإتقان 2/226 .ط دار الفكر.
5- أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/148 تحقيق كمال يوسف الحوت ط مكتبة الرشد الرياض أولى1409، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 4/ 68 تحقيق شعيب أرناؤط ومجموعة من العلماء ط الرسالة 1413 هـ
6- تفسير ابن كثير 8 / 285ط دار طيبة.
7- مسلم في كتاب النكاح باب جواز الغيلة رقم 1442.، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد في المسند.والغيلة على ما ذكره أهل اللغة أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع فتحمل،
8- أخرجه مسلم في كتاب كتاب النكاح باب جواز الغيلة رقم 1443.
9- شرح النووي لصحيح مسلم.
10- فيض القدير شرح الجامع الصغير 5/280 ضبطه أحمد عبد السلام، ط دار الكتب العلمية، وحبذا لو يرجع للتعليل الطبي الذي ذكره ابن القيم في هذا الحديث كما في فيض القدير ليتبين لنا أن ابن القيم أيضاً استخدم العلوم الكونية في شرح الحديث النبوي.
11- جواهر القرآن صـ 26، 27 .
12- دراسات في أصول تفسير القرآن د محسن عبد الحميد صـ 11، ط دار الثقافة المغرب الثانية 1404
13- قانون التأويل: صـ 540 ، وهذا الكلام قاله الغزالي قبله في الإحياء 1/29 ط الحلبي
14- قانون التأويل للقاضي أبي بكر بن العربي تحقيق د محمد السليماني صـ 418 ط دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن 1406.
15- البرهان 2/ 87 تحقيق المرعشلي ط دار المعرفة عند الكلام على تدبر القرآن . وأعاد هذا الكلام 2/291 في باب معرفة تفسيره وتأويله، ونحن نلاحظ أن الزركشي هنا يعيد كلام الغزالي السابق رحمهما الله .
16- البرهان 2/ 320 .
17- الإتقان 2/125 ط دار الفكر .
18- الإتقان 2/129 .
19- قام بتحقيقة الشيخ زهير الشاويش ط المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 1960.
20- المصدر السابق صـ4، وللآلوسي كتاب يظهر ما كان عند العرب من العلوم وتوارثوها خلفاً عن سلف وقد صحح منها القرآن وأقر منها، وهو كتاب (بلوغ الأرب في أحوال العرب) ي ثلاث مجلدات.
21- ينظر مناقشة رأي الشاطبي في:التفسير العلمي للقرآن في الميزان د أحمد عمر أبو حجر ط دار قتيبة، و القرآن العظيم هدايته وإعجازه للصادق عرجون صـ 269 إلى 273، وبحث: مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في مباحث علوم القرآن وتفسيره د شايع بن عبده بن شايع الأسمري، مجلة الجامعة الإسلامية السعودية العدد 115 لعام 1422 صـ 75، 78 .
22- انظر بدع التفسير صـ79.ط مؤسسة نوار للنشر 1971،الرياض. كما أن الدكتور نعناعة لم يأت بجديد في كتابه بدع التفاسير، بل إنه أخذ كتاب الشيخ حسين الذهبي رحمه الله (الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن) بحرفه دون عزو إليه ووضع له عنوان (بدع التفاسير) ونشره باسمه، قارن بين كتاب بدع التفاسير لرمزي نعناعة ط مؤسسة نوار للنشر 1971، وكتاب الاتجاهات المنحرفة للذهبي ط دار الحديث القاهرة 2005، وقد نبه على ذلك الذهبي في آخر كتابه؛ فلتراجع.
23- انظر: النفسير ورجاله لابن عاشور صـ458 فما بعد. واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري د فهد الرومي 2/716 ط دار البحوث العلمية والإفتاء في السعودية 1407.
24- ينظر: منهج المدرسة العقلية د فهد الرومي من صـ75 فما بعد، وتفسير جزء عم للشيخ محمد عبده صـ158، وكتاب الشيخ محمد رشيد رضا السلفي المصلح د. محمد عبد الله السلمان صـ59 فما بعد، ط جامعة الإمام محمد بن سعود القصيم 1414، وفي الكتاب الأخير رسالة من الشيخ المفسر عبد الرحمن السعدي رحمه الله لرشيد رضا يعاتبه وينكر عليه ما بلغه من إنكار بعض المعجزات.
25- ينظر مبحث فعل الصحابي هل هو حجة أم لا في كتب أصول الفقه.
المقدمة
الحمد لله الذي أكرمنا وشرَّفنا بهذا الكتاب المبين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
لقد أخذت قضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم جدلاً واسعاً بين المثقفين كما العلماء، وما زال تداولها بين التأييد والرفض، إما من حيث الأصل أو بالاستناد لمنهج العاملين في الإعجاز العلمي أو التفسير العلمي.
فبعض المعارضين ينتحلون التمحل والتكلف في بعض الأبحاث عذراً لرفضه، وبعض المؤيدين يدافعون عن ذلك بذكر الضوابط والحرص على اجتناب التكلف.
وما تزال الكتابات والمقالات حول قضية التفسير العلمي والإعجاز العلمي في القرآن من كلا الفريقين تتسابق في الطرح والنقاش.
وقد استوقفتني ثلاث مقالات لأحد الكاتبين؛ يختلف الطرح والأسلوب فيها عن غيرها مما قرأته، إذ شدد فيها النكير بعنف على من يؤيد قضية الإعجاز العلمي والمهتمين بها، حتى وصف ذلك بالبدعة، وجعلها تفسيراً لليقين بالظن - كما في عنوان أحدى مقالاته -، ووصف العاملين بالإعجاز العلمي بأصحاب الفكر المنحرف، وممن وسوس فيهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم صرف الناس بالفكر عن الوحي، وبالظن عن اليقين وبالفنون الدنيوية عن علوم الشريعة(1).
واعتبر الكاتب أن الغزالي (505هـ)، ومن بعده الرازي (606هـ) أول المبتدعين لشبهة الإعجاز العلمي في القرآن، ثم زعم أنه زاد في الطين بلة ابن أبي الفضل المرسي (655هـ) بعدهما، كما اعتبر الكواكبي (1320هـ) من السابقين إلى هذا الابتداع في العصر الحديث، واعتبر عاقد لواء بدعة الإعجاز العلمي طنطاوي جوهري (1358هـ) في كتابه تفسير الجواهر، بل واعتبر المشتغلين بالإعجاز العلمي متتبعين لسنن اليهود والنصارى لأنهم بزعمه أول من اشتغل بالإعجاز العلمي في كتبهم قبل المسلمين، ثم ختم أحد مقالاته بالقول: (وبدعة الإعجاز العلمي للقرآن لا تعدو أن تكون إهانة للقرآن، وإعلاء لنظريات الملحدين).
صراحة ما كنت لأقف على هذه المقالات لولا ما فيها من مغالطات وإساءات علمية وأدبية، يخال لقارئها أن علماء الأمة في السابق والآن؛ يتآمرون على الإسلام ويحرفون كلام الله تعالى تحت لواء الإعجاز العلمي، وأن المشتغلين بالإعجاز العلمي من الأفراد والمؤسسات أعداء لهذا الدين، منحرفون ضالون، ويهيج عليهم ولاة الأمور، فرأيت من الواجب العلمي أن أبين أصل المسألة، وأضع إضاءة انطلاق لمن يبحث عن الحق قولاً وعملاً، وأوضح لصاحب المقالات أنه تطرف في الحكم وابتعد عن أصول البحث العلمي في مصادرة الأحكام والانطلاق من أحكام مسبقة متحاملة على القضية قبل تحريها من كافة جوانبها، فأدى به إلى اتهام العلماء اتهاماً وصل إلى الفرية عليهم.
ولذلك فلن أتعرض لتهجمه الشخصي على العلماء والهيئات باختصاصاتهم؛ فهم حجيجه يوم القيامة وهو خصمهم أمام الله، كما سأضرب صفحاً عن أسلوبه النابي الجارح في النقاش، تحت راية نصرة الدين والحمية لمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم.
ولكني أوجه له نصيحة أستهل بها كلامي فأقول: ما هكذا تورد الإبل يا سعد، وما هكذا منهج سلفنا الصالح –إن كنت منتسباً إليهم - في النصيحة والإرشاد؛ أن يكيلوا الناس بالتهم والتجريح والتشكيك بمصداقيتهم لخلفيات شخصية أو غير ذلك.
يفترض في كل باحث عندما يسجل موقفه من قضية علمية؛ أن ينطلق في بحثه من خلفية متجردة مخلصة لله تعالى، وأن يقف من القضية العلمية بين مؤيديها ومعارضيها على مسافة متساوية؛ ويدقق ويبحث بحثاً عملياً لا نظرياً فقط، ثم يسجل رأيه مدعماً بالدليل، لا أن ينطلق من خلفية جاهزة وحكم مسبق، ليس عليه إلا أن يلصق التهم ويوزعها على الناس يميناً ويساراً، فالإنكار والمعارضة دون دراية يحسنها كل أحد، ولكن البحث العلمي يحتاج لرجال.
ويبدو أن كاتب المقالات الثلاث ليس لديه دراية كافية في القضية التي يتكلم فيها من حيث التاريخ والمنهج، وذلك لاعتماده على مرجع واحد في ما سماه "نشأة الإعجاز العلمي"، وكذلك عدم تفريقه بين مسألتين أساسيتين: أحدهما: التفسير العلمي، والثانية: الإعجاز العلمي، وإن كان كلاهما شيئاً واحداً عنده؛ فهذه قضية أخرى، ومع ذلك سأناقش فكرته على العموم من حيث أصلها؛ وهو استنباط المعارف من القرآن الكريم، وتسخير العلوم الكونية والمعارف البشرية في بيان القرآن الكريم، ولن أناقش هذين المصطلحين والفرق بينهما فهذا شأن يطول ويحتاج مبحثاً لوحده؛ هذا مع العلم أن مصطلح "الإعجاز العلمي" مصطلح جديد لم يقصده الغزالي عندما كتب جواهر القرآن، ولكن أشار إليه السيوطي في كتابه معترك الأقران إذ جعل من وجوه إعجاز القرآن اشتماله على العلوم المختلفة المستنبطة منه، واستدل على ذلك بنحو عمله في الإتقان(2).
وقد قسمت البحث إلى مطالب أربعة :
المطلب الأول: استنباط العلوم في عهد النبي والسلف الصالح.
المطلب الثاني: أصل مشروعية الاستفادة من علوم غير المسلمين في بيان أمور الدين.
المطلب الثالث: توسع استنباط المعارف وتسخير العلوم في تفسير كتاب الله.
المطلب الرابع: ملامح الانحراف في اتجاه التفسير العلمي والإعجاز العلمي.
هذا وأسأل الله أن يجعل هذا البحث نافعاً، ويضع الباحث في هذه القضية في الجادة التي ترشده للوصول إلى ما يرضي الله، فما كان من صواب فذلك توفيق من الله، وما كان من زلل فخطأ اجتهاد مني أسأل الله الأجر عليه والحمد لله رب العالمين.
المطلب الأول: استنباط العلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح:
لقد كان أثر القرآن في تصحيح مفاهيم الناس عند نزوله أثراً عظيماً، فقد محا الخرافات المتداولة بين الناس حول الشمس والقمر، وحول نزول المطر، وخلق الإنسان وغير ذلك، كما صحح مفاهيمهم اتجاه القضايا الكونية التي انطبعت في أذهان الجاهلية بالخرافات كالطيرة وغير ذلك، وكان ارتباط تصحيح هذه المفاهيم بالعقيدة ارتباطاً وثيقاً، كما أن منهج الآيات القرآنية في المرحلة المكية كان منهجاً يفتق العقل ويعصف به؛ ليستيقظ من غفوة الجهل ويدرك عظمة الخالق؛ ويتفكر بالآيات القرآنية الدالة على الآيات الكونية، وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان معارف القرآن الكريم، مثال ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ[الانفطار:8] قال: (لكن في الصحيحين عن أبي هُرَيرة أن رَجُلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي وَلَدت غُلامًا أسودَ؟. قال: "هل لك من إبل؟". قال: نعم. قال: "فما ألوانها؟" قال: حُمر. قال: "فهل فيها من أورَق؟" قال: نعم. قال: "فأنى أتاها ذلك؟" قال: عسى أن يكون نزعة عِرْق. قال: "وهذا عسى أن يكون نزعة عرق" ) (3)، وأراد ابن كثير بذلك أن يجعل الحديث بياناً للآية، وبيان ذلك: أن الله تبارك وتعالى يخلق الإنسان ويخلق صفاته وهيأته على شبه أحد أجداده وليس على شبه أحد أبويه، ومرد ذلك لإرادة الله تعالى يجعل المولود في أي صورة من صور أجداده يركبه بها، لأنه تعالى هيأ النطفة حاملة جينات الأجداد الوراثية.
ولم يكن الصحابة يقفون في فهم القرآن على العبادات والتوحيد فقط -كما ذكر صاحب المقالات الثلاث -، وإنما كان استنباطهم وفهمهم أوسع من ذلك بكثير، فقد أدرك سلفنا الصالح أن القرآن جامع للعلوم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: (من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن..) (4).
ويقول مسروق رحمه الله: (من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة) (5)، وكانت معرفتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسليقتهم العربية ومعاينتهم التنزيل مستنداً في فهم معاني كتاب الله تعالى واستنباط العلوم، ومن ذلك يقول "ابن عباس في قوله: مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ (يعني: ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا، ثم ينتقل بعد من طور إلى طور، وحال إلى حال، ولون إلى لون). وهكذا قال عكرمة، ومجاهد، والحسن، والربيع بن أنس: الأمشاج: هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة" (6). وكتب التفسير بالمأثور غنية بالأدلة على ذلك، وما علينا إلا أن نتعب أنفسنا في استخراجها قبل رمي الناس بأحكام جائرة جزافاً دون تحقيق.
المطلب الثاني: أصل مشروعية الاستفادة من علوم غير المسلمين في بيان أمور الدين:
لقد وردت الإشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم في أصل مشروعية الاستفادة من علوم غير المسلمين للاستفادة منها في بيان ما نحتاج من أمور الدين؛ وكان فهم سلفنا الصالح لهذه الإشارة من أسباب الانفتاح على العلوم عند الفتوحات الإسلامية، ففي الحديث الذي أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ) (7).
وفي حديث آخر عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى النبي فقال : إني أعزل عن امرأتي ، فقال له رسول الله : لم تفعل ذلك ؟ فقال الرجل : أشفق على ولدها، فقال رسول الله : لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم - وفي لفظ : إن كان لذلك فلا ، ما ضار ذلك فارس ولا الروم) (8).
يقول النووي: (قَالَ الْعُلَمَاء: سَبَب هَمّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْهَا أَنَّهُ يَخَاف مِنْهُ ضَرَر الْوَلَد الرَّضِيع، قَالُوا: وَالْأَطِبَّاء يَقُولُونَ: إِنَّ ذَلِكَ اللَّبَن دَاء وَالْعَرَب تَكْرَههُ وَتَتَّقِيه) (9).
ومن المعلوم أن الروم وفارس كانتا أعلم بكثير من العرب في أمور الطب، ولذلك يقول المناوي في فيض القدير: (يعني لو كان الجماع أو الإرضاع حال الحمل مضرا لضر أولاد الروم وفارس، لأنهم يفعلونه مع كثرة الأطباء فيهم فلو كان مضرا لمنعوه منه فحينئذ لا أنهى عنه) (10)، فاحتج النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الضرر بعمل الروم وفارس لكونهم أعلم بالأمور الطبية، وفي ذلك إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى جواز الاستدلال بعلوم غير المسلمين، والاستفادة من علومهم في تقرير الأحكام الشرعية، التي هي توقيع عن رب العالمين، وكذلك التفسير هو الرواية عن الله تعالى كما يقول مسروق: (اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله).
والتفسير في ضوء المعارف العلمية والحقائق الكونية إنما هو بيان لكلام الله بأفعال الله تعالى إذ هي من خلقه سبحانه، مع ضبط هذا البيان بضوابط التفسير المقررة، واستناداً إلى هذا الأصل بنى الغزالي دعواه إلى استنباط المعارف من القرآن الكريم، ثم عرض الغزالي مثلاً لما ذهب إليه بقوله تعالى: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ [الشعراء:80]، فقال: ( وهذا الفعل لا يعرفه إلا من عرف الطب بكماله، إذ لا معنى للطب إلا معرفة المرض بكماله وعلاماته ومعرفة الشفاء وأسبابه .. ) (11).
أقول : وفي المثال الذي ذكره الغزالي إشارة إلى حاجة إظهار هذه العلوم لمختصين متأهلين للخوض في كتاب الله تعالى منضبطين بمقصد القرآن في الهداية والإرشاد، فإن معاني القرآن مكنونة في ألفاظه وتراكيبه، ولا يستطيع غوص غماره لاستكشاف عجائبه إلا من ألم بآلات العلوم وأصول الاستنباط.
المطلب الثالث: توسع استنباط المعارف وتسخير العلوم في تفسير كتاب الله:
"وبمجيء العصر العباسي واجهت حركة تفسير القرآن تيارات فكرية وتغييرات اجتماعية جديدة، دخلت على المجتمع المسلم نتيجة الاختلاط الحضاري بين الحضارة الإسلامية والحضارات السابقة، التي انتقلت فلسفاتها وعلومها إلى المجتمع الإسلامي، فحاول علماء الإسلام أن يستفيدوا منها لفهم القرآن الكريم وتوسيع معارفهم العقلية والفلسفية والعلمية حول كثير من المسائل التي وردت في آياته، فمن جهة حاولوا فهم كثير من أسرار الشريعة الإسلامية من خلال تطويرهم الكبير للعلوم الكونية والطبيعية، ومن جهة أخرى رأوا أن بناء العقائد الإسلامية التي وردت في القرآن الكريم على المرتكزات العقلية الفلسفية المنطقية غدا أمراً ضرورياً أمام المطاعن التي وجهت إلى الكتاب الكريم من قبل اللاهوتيين من أهل الأديان الأخرى ومنكري النبوات الذين شنوا هجوماً فكرياً مركزاً على أصول تلك العقائد، فانبرى علماء الكلام يفندون آراءهم ويردون اعتراضاتهم ويثبتون إعجاز القرآن العقلي والمنطقي" (12).
وكان من أبرز العلماء الذين عرفوا بهذا الاتجاه: الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله (505هـ)، وذلك في كتابيه إحياء علوم الدين، وجواهر القرآن.
وتبعه القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله (543هـ) في كتابه قانون التأويل، بل إن القاضي رحمه الله – مع معرفتنا بمعارضته للغزالي في قضايا علمية متعددة – فإنه يقول ما قاله الغزالي في عدد العلوم في القرآن دون اعتراض، فقد ذكر في قانون التأويل مقرراً أن "علوم القرآن خمسون علماً وأربع مئة علم، وسبعة آلاف وسبعون ألف علم على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة، إذ لكل منها ظاهر وباطن وحد ومطلع، هذا مطلق دون اعتبار تركيبه، و[نضم] بعضها إلى بعض وما بينها من روابط على الاستيفاء في ذلك كله، وهذا مما لا يحصى ولا يعلمه إلا الله تعالى" (13) ا.هـ.ويقول الإمام ابن العربي في موطن آخر : (وإنما عني العلماء بقولهم إن العلوم كلها في كتاب الله ما كان علماً لذاته، لا ما وقعت الدعوى فيه أنه علم وهو جهل، وذلك يرجع إلى العلوم الشرعية والحقائق العقلية، فإن جميعها مضمَّن في كتاب الله، والدليل عليه مبيَّن، وكل جهالة أو سخافة ادعتها طائفة فالرد عليها في كتاب الله موجود أيضاً مبيَّن) (14).
ثم طبق الفخر الرازي رحمه الله (606هـ) ذلك في تفسيره الكبير مفاتيح الغيب، وكان شأنه شأن كل مفسر مجتهد، فأصاب وأخطأ.
وإلى هذا القول – أي أن جميع العلوم في القرآن – ذهب الزركشي في البرهان وذكر أن "العلوم كلها داخلة في أفعال الله وصفاته وفي القرآن شرح ذاته وصفاته وأفعاله"(15) ، وأكثر من النقول عن السلف الصالح وعن العلماء من بعدهم في هذه القضية، ثم أفرد فصلاً في برهانه ليقول: (وفي القرآن علم الأولين والآخرين وما من شيء إلا ويمكن استخراجه منه لمن فهمه الله تعالى) (16).
وكذلك فعل السيوطي في الإتقان عندما عقد (النوع الخامس والستون في العلوم المستنبطة من القرآن) (17) ، صدره بقوله تعالى: مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ [الأنعام:38]، فقال: (وأنا أقول: قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء، أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل؛ إلا وفي القرآن ما يدل عليها، وفيه عجائب المخلوقات وملكوت السموات والأرض، ومافي الأفق الأعلى وتحت الثرى وبدء الخلق و.. و..الخ) (18). وأكد دعواه هذه في كتابه الإكليل في استنباط التنزيل.
وممن طبق منهج استنباط العلوم والاستدلال على صحتها أوإبطالها باجتهاده على ضوء العلوم والمعارف في عصره من المفسرين: العلامة محمود الآلوسي (1270هـ) في تفسيره روح المعاني، ثم حفيده العلامة السيد محمود شكري الآلوسي (1341هـ) في كتابه: (ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئةَ الجديدةَ القويمةَ البرهانِ) (19) ، عرض الآلوسي الحفيد في كتابه هذا ما تقول به الهيئة الجديدة –هيئة الأفلاك- على ما قاله فيثاغوس، إذ انتشرت في عصره، يقول الآلوسي: (فقد رأيت كثيراً من قواعدها لا يعارض النصوص الواردة في الكتاب والسنة، على أنها لو خالفت شيئاً من ذلك لم يلتفت إليها، ولم تؤول النصوص لأجلها، والتأويل فيهما ليس من مذاهب السلف الحرية بالقبول، بل لا بد أن نقول: إن المخالف لهما مشتمل على خلل فيه، فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، بل كل منهما يصدق الآخر ويؤيده، واعلم أن الشريعة الغراء لم ترد باستيعاب قواعد العلوم الرياضية، إنما وردت بما يستوجب سعادة المكلفين في العاجل والآجل، وبيان ما يتوصلون به إلى الفوز بالنعيم المقيم، وربما أشارت –لهذه الأغراض- إلى ما يستنبط منه بعض القواعد الرياضية،..) (20).
وأما معارضة الإمام الشاطبي رحمه الله قديماً فقد كانت فردية، ولظروف عصرية، ولم تلق أدلته صدى لدى العلماء، إلا في العصر الحديث عندما ظهر الانحراف في التفسير العلمي (21).
المطلب الرابع: ملامح الانحراف في اتجاه التفسير العلمي والإعجاز العلمي:
أما ما ذكره د. نعناعة بأن نزعة "التفسير العلمي" عند الغزالي والرازي لقصد التوفيق بين القرآن وما جد من العلوم (22) ، وتابعه على هذا صاحب المقالات الثلاث؛ فهذا إسقاط لواقع الحال الذي نعيشه نحن من التخلف والكسل، على العصر الذهبي الذي كان العالم الإسلامي ينعم فيه بالعلوم ويصدرها للأمم الأخرى، والمتتبع لتاريخ العلوم يعلم ذلك، وإنما فكرة التوافق بين القرآن وما جد من العلم؛ ظهرت حديثاً في عصر التراجع العلمي وسيطرة الاستعمار والغزو الفكري في عالمنا الإسلامي (23) ، وللرد على من ادعى التناقض بين العلم والدين تأثرأ بالثورة الأوربية على الكنيسة التي حرمت العلم، وأنها ما نهضت إلا بنبذ الدين والأخذ بالعلم، وتجلت فكرة التوافق واضحة على يد المنبهرين بالحضارة الأوربية والتقدم العلمي فيها، الذين ولوا وجوههم شطر أوربة؛ كالسيد أحمد خان(1314هـ) في الهند، وجمال الدين الأفغاني(1314هـ) وتلميذه الشيخ محمد عبده (1323هـ) في البلاد العربية – وليس الكواكبي الأول كما ذكر صاحب المقالات الثلاث -، وعزز ذلك الشيخ رشيد رضا(1354هـ) في نشره تفسير الشيخ محمد عبده في مجلة المنار.
فقد أوّل محمد عبده الطير الأبابيل بالجراثيم مثلاً، وأنكر رشيد رضا بعض المعجزات بحجة تقريب الفكرة للغرب (24) ، وتبعهما على ذلك خلق كثير على شاكلتهم، وبدأ بذلك الانحراف في اتجاه التفسير العلمي من منهج الاستنباط والاستدلال، إلى منهج التطويع والتكلف والتمحل لإثبات العلوم من القرآن الكريم والرد على العلمانيين والقادمين من أوربا من الوفود، الداعين لرفض الدين بحجة التعارض بين العلم والدين، وتمثل هذا المنهج كاملاً في تفسير الشيخ طنطاوي جوهري يرحمه الله، فقد غالى الشيخ طنطاوي جوهري في ذلك كثيراً في تفسيره مع حسن المقصد منه رحمه الله، وحكّم النظريات العلمية والفلسفية في دلالات الآيات القرآنية، وقد أثر منهجه على الباحثين من بعده إلى يومنا هذا، مما دفع ببعض العلماء الأفاضل كالشيخ حسين الذهبي ومن تابعه أن ينكروا هذا العمل، واستدلوا بما استدل به الشاطبي.
ومع ذلك فقد وجدت تفاسير حوت اتجاه التفسير العلمي وتسخير العلوم الكونية في تفسير كتاب الله تعالى بمنهج علمي سليم بحسب القواعد المقررة في التفسير، كما فعل الشيخ سعيد النورسي، والشيخ جمال الدين القاسمي، والشيخ عبد الحميد بن باديس، والشيخ محمد بن الطاهر عاشور، ثم تبنت لجنة الشؤون الإسلامية في الأزهر إخراج التفسير المنتخب على هذا الاتجاه وفيه تعليقات لما يستنبط من العلوم من الآيات، ولا يبعد أن يوجد في عمل هؤلاء العلماء الأفاضل أخطاء اجتهادية، فالتفسير عمل بشري، يخطئ ويصيب، وكل عمل بما أوتيه من علم دون تعدٍّ.
الخاتمة:
إذن فدعوى احتواء القرآن للعلوم ليست مما انفرد به الغزالي، واستنباط العلوم وتسخيرها في فهم القرآن ليس بدعاً من الأمر قام به الغزالي والرازي بقصد تضليل الناس، وإنما هو منهج في التفسير من نشأته وسيبقى إلى يوم القيامة، ولا شك أن هناك تعسفاً وتمحلاً وتكلفاً من بعض المشتغلين بالتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي، لأن دافعهم الحماسي والعاطفي للكتابة في هذا المجال بنية حسنة دون تمكن من العلوم الشرعية، أو من العلوم التي ليست من اختصاصهم أدى بهم لهذا المنزلق الخطير في الكلام في كتاب الله تعالى، لكن هذا لا يعني أن نعلن الحرب الضروس على منهج من مناهج التفسير؛ له أصل شرعي وأصل عملي؛ ونبدع ونضلل المشتغلين فيه جزافاً وتشفياً.
ومن عجائب كلام صاحب المقالات الثلاث قوله: (فليس بين علماء الأمة المعتدّ بهم في القرون المفضلة طبيب ولا فيزيائي ولا فلكي ولا فيلسوف، وكانوا يحصرون العلم والتعليم الديني في الاعتقاد والعبادات والمعاملات من الوحي في الكتاب والسنة وفقه السلف في نصوصهما، ولم يلتفت المسلمون إلى المهن والفنون التي ذكرها إلا بعد مرحلة الضعف والانبهار بالفكر اليوناني والاهتمام بترجمته ثم النّسج على منواله في الفكر المنسوب إلى الدين.)!!
هذا كلام من لم يعرف مفهوم العلم في القرآن والسنة، ولم يكن لديه دراية في تاريخ العلوم الإسلامية، والجواب عنه يحتاج إلى تعليم قائله مراحل تطور العلوم الإسلامية ولا يكفيه أسطر أو صفحات.
وإذا كان الأمركما يقول؛ فلم قام هو بشد الرحال إلى أمريكا وتعلم فيها، وحصل على الماجستير في التربية من جامعة جنوبي كلفورنيا ـ لوس أنجلس كما في ترجمته على موقعه الإلكتروني، ولم يحصر نفسه بهذه العلوم الشرعية اتباعاً لمنهج علماء القرون المفضلة كما يدعي؛ فلم يعهد عنهم أنهم رحلوا لغير العلوم الشرعية، فكيف لو كانت هذه الرحلة إلى بلد تشبعت بدماء المسلمين كأمريكا؟!.
فلا أدري: هل هذه دعوة من صاحب المقالات الثلاث لنبذ المسلمين العلوم وتركهم التعلم؛ بحجة عدم وجود علماء من القرون المفضلة في هذه الاختصاصات.
ثم هل عدم وجود علماء من السلف الصالح اشتغلوا بالعلوم الكونية – على فرض صحة ذلك – يعني تحريم تعلمها وتحريم دراستها، لعل الجواب يعرفه كل مطلع على علم أصول الفقه، فإن ترك السلف الصالح لأمر ما لا يعني تحريمه، كما أن فعلهم لأمر لا يعني وجوبه، فالعبرة في الوجوب والتحريم نصوص الشرع من الكتاب والسنة، لا فعل غير المعصوم (25) ، والله الهادي للصواب والحمد لله رب العالمين.
الحواشي: ـــــــــــــــــــــــــــ
1- انظر مقال: بدعة الانشغال بالإعجاز الظني عن التدبر اليقيني، ومقال الإعجاز العلمي للقرآن، ومقال بدعة الانشغال بالإعجاز الظني عن التدبر اليقيني كلها للشيخ سعد الحصين على موقعه: http://www.saad-alhusayen.com/articles/
وكل النصوص التي استشهدت بها من كلامه موجودة على موقعه قسم المقالات.
2- انظر : معترك الأقران 1/17 وما بعد ط دار الكتاب العربي .
3- تفسير ابن كثير 8 /343 ط دار طيبة.
4- أخرجه سعيد بن منصور كما في الإتقان 2/226 .ط دار الفكر.
5- أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/148 تحقيق كمال يوسف الحوت ط مكتبة الرشد الرياض أولى1409، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 4/ 68 تحقيق شعيب أرناؤط ومجموعة من العلماء ط الرسالة 1413 هـ
6- تفسير ابن كثير 8 / 285ط دار طيبة.
7- مسلم في كتاب النكاح باب جواز الغيلة رقم 1442.، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد في المسند.والغيلة على ما ذكره أهل اللغة أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع فتحمل،
8- أخرجه مسلم في كتاب كتاب النكاح باب جواز الغيلة رقم 1443.
9- شرح النووي لصحيح مسلم.
10- فيض القدير شرح الجامع الصغير 5/280 ضبطه أحمد عبد السلام، ط دار الكتب العلمية، وحبذا لو يرجع للتعليل الطبي الذي ذكره ابن القيم في هذا الحديث كما في فيض القدير ليتبين لنا أن ابن القيم أيضاً استخدم العلوم الكونية في شرح الحديث النبوي.
11- جواهر القرآن صـ 26، 27 .
12- دراسات في أصول تفسير القرآن د محسن عبد الحميد صـ 11، ط دار الثقافة المغرب الثانية 1404
13- قانون التأويل: صـ 540 ، وهذا الكلام قاله الغزالي قبله في الإحياء 1/29 ط الحلبي
14- قانون التأويل للقاضي أبي بكر بن العربي تحقيق د محمد السليماني صـ 418 ط دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن 1406.
15- البرهان 2/ 87 تحقيق المرعشلي ط دار المعرفة عند الكلام على تدبر القرآن . وأعاد هذا الكلام 2/291 في باب معرفة تفسيره وتأويله، ونحن نلاحظ أن الزركشي هنا يعيد كلام الغزالي السابق رحمهما الله .
16- البرهان 2/ 320 .
17- الإتقان 2/125 ط دار الفكر .
18- الإتقان 2/129 .
19- قام بتحقيقة الشيخ زهير الشاويش ط المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى 1960.
20- المصدر السابق صـ4، وللآلوسي كتاب يظهر ما كان عند العرب من العلوم وتوارثوها خلفاً عن سلف وقد صحح منها القرآن وأقر منها، وهو كتاب (بلوغ الأرب في أحوال العرب) ي ثلاث مجلدات.
21- ينظر مناقشة رأي الشاطبي في:التفسير العلمي للقرآن في الميزان د أحمد عمر أبو حجر ط دار قتيبة، و القرآن العظيم هدايته وإعجازه للصادق عرجون صـ 269 إلى 273، وبحث: مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في مباحث علوم القرآن وتفسيره د شايع بن عبده بن شايع الأسمري، مجلة الجامعة الإسلامية السعودية العدد 115 لعام 1422 صـ 75، 78 .
22- انظر بدع التفسير صـ79.ط مؤسسة نوار للنشر 1971،الرياض. كما أن الدكتور نعناعة لم يأت بجديد في كتابه بدع التفاسير، بل إنه أخذ كتاب الشيخ حسين الذهبي رحمه الله (الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن) بحرفه دون عزو إليه ووضع له عنوان (بدع التفاسير) ونشره باسمه، قارن بين كتاب بدع التفاسير لرمزي نعناعة ط مؤسسة نوار للنشر 1971، وكتاب الاتجاهات المنحرفة للذهبي ط دار الحديث القاهرة 2005، وقد نبه على ذلك الذهبي في آخر كتابه؛ فلتراجع.
23- انظر: النفسير ورجاله لابن عاشور صـ458 فما بعد. واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري د فهد الرومي 2/716 ط دار البحوث العلمية والإفتاء في السعودية 1407.
24- ينظر: منهج المدرسة العقلية د فهد الرومي من صـ75 فما بعد، وتفسير جزء عم للشيخ محمد عبده صـ158، وكتاب الشيخ محمد رشيد رضا السلفي المصلح د. محمد عبد الله السلمان صـ59 فما بعد، ط جامعة الإمام محمد بن سعود القصيم 1414، وفي الكتاب الأخير رسالة من الشيخ المفسر عبد الرحمن السعدي رحمه الله لرشيد رضا يعاتبه وينكر عليه ما بلغه من إنكار بعض المعجزات.
25- ينظر مبحث فعل الصحابي هل هو حجة أم لا في كتب أصول الفقه.