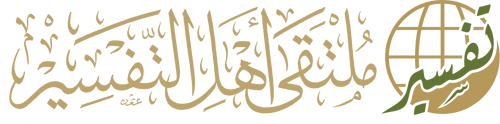آمال ابراهيم أبو خديجة
New member
- إنضم
- 15/08/2010
- المشاركات
- 14
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
يقول الله سبحانه وتعالى :
بسم الله الرحمن الرحيم
من معاني مسمى هذه السورة والذي يحمل بين طياته معاني عظيمة يجب أن تكون مركبة في ذاتية المؤمن، وشخصيته التي يجب أن تتميز عن غيرها من شخصيات الملل الأخرى، وطبيعة تمييز التركيب النفسي والسلوكي، والذي لا يقوم إلا على صحة الاعتقاد والفكر ، كما تبين أن كل من يخالف هذه السمات والطباع، ، لا بد أنه ينتفي عنه الانتساب لصفة الإيمان الحق الذي يريده الله لعباده، فمن مطلع الآية، يشدك اسم السورة ومعناه لتبحر معه بما يحمل من أسرار بالموعظة والتربية الحسنة، فقد جاء في اللغة لمعنى الماعون وهو من العون، ففي كتاب الصحاح في اللغة في معنى العون " المَعونةُ: الإعانةُ. يقال: ما عندك معونةٌ، ولا مَعانةٌ، ولا عَوْنٌ. قال الكسائي: المَعون: المَعونة. وتقول: ما أخلاني فلانٌ من مَعاوِنِهِ، وهو جمع مَعونَة. ورجلٌ مِعْوانٌ: كثير المَعونةِ للناس. واستَعَنْتُ بفلانٍ فأعانَني وعاوَنَني. وفي الدعاء: " رَبِّ أعِنِّي ولا تُعِنْ عَلي " . وتعاونَ القوم، إذا أعانَ بعضُهم بعضاً و'تونوا مثله ".
فاستشعار هذا المعنى يحرك في داخل النفس كل مشاعر الإنسانية، والذي يشدك لتفكر بنفسك ومن حولك، حيث لا تنحصر في دائرة الذات، لتنطلق متوسعا حول محيطك، لتبحث عمن تقدم له كل معونة تدخل على قلبه لحظة سرور، فالآية تركز على فئات في المجتمع، ستكون الأضعف لتدفع المؤمن وتحركه للمشاركة في حمايتهم، فهم الذين لا يملكون ما يقوي وجودهم، سواء من المال أو الطعام أو الشراب أو غيرها من الحاجات الضرورية للحياة الكريمة، وكأن هذه السورة تبني الفرد الذي يتربى على إحساس الشعور الجمعي، والإحساس بالآخرين، وحب الانتماء، والبذل والعطاء، فهي تريد أن تمسح الأنانية الفردية أو الفئوية، أو الشعور بالنرجسية وحب الذات المتعالي، لتجعل عقل الإنسان ومشاعره متوجه لغيره، وليس اتجاه نفسه فقط، فهي تريد أن تعلم الإنسان المؤمن أن يكون فعالا، منجزاً ، طموحاً، ناجحا في حياته الخاصة، كي يستطيع أن يُنجح مجتمعه وأفراده، فيساهم بتربيتهم وتطويرهم، فتلك السورة تحمل في معانيها رفض لكل سلوك لا يؤدي لفائدة للآخرين، وحب التطوير والعمران، وتحقيق للعدالة الاجتماعية التي يجب أن يسعى إليها الفرد والمجتمع، والتي تقوم على بناء ونمو نظام اجتماعي واقتصادي متكافئ، يكفل للجميع حقه، ولا يقام إلا على العدل والقسط بين الناس، وعلى عدم احتقار الأموال لفئة واحده من الناس، لينجح المجتمع الإسلامي في استمرار وجوده وتطوره، ولا يقام كل ذلك ويبنى إلا على صدق الإيمان، والاعتقاد السليم القائم منذ البداية على الإيمان بالغيب .أما في كتاب الأصفهاني فقال عن العون " المعاونة والمظاهرة، يقال فلان عوني أي معيني وقد أعنته، ( فأعينوني بقوة ) ( وأعانه عليه قوم آخرون )، والتعاون التظاهر قال ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) والاستعانة طلب العون قال ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) "
فالمعونة، والمعاون، والتعاون، والعون، كلها معاني تدور في معنى واحد، وتدعوا إلى سلوك واحد، ألا وهو أن يبذل الخير والعطاء لأجل الآخرين، وإشاعة ثقافة التكافل بين الناس، والوحدة المتماسكة بين أفراد المجتمع الإسلامي، وليربى أطفالنا على إحساس المسؤولية اتجاه الآخرين، وخاصة المستضعفين من الناس، والذين لا يجدون من يدافع عن حقوقهم، أو يخرجهم من كربات الدنيا ومصائبها .
بداية السورة ( تصوير مشاهد بالرؤية بالاستفهام والتعجب )
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1)
في هذه الآية تصوير لمشاهد، تجذب البصر والسمع لرؤية حال من أنكروا الحق، وفضح لما صدر عنهم من سلوكيات تعارض طبيعة النفس الإيمانية، أو الصفات الإنسانية التي تُستمد من الفطرة الطبيعية، فالاستفهام هنا يدل على تهويل لما يتصفون به من سلوكيات، وتعجب من حال تلك النفس، التي اعتادت على منطق الإتيان بما هو ضد الحق . ويقول ابن عاشور " أن الاستفهام مستعمل في التعجب من حال المكذبين بالجزاء ، وما أورثهم التكذيب من سوء الصنيع . فالتعجب من تكذيبهم بالدين وما تفرع عليه من دَعّ اليتيم وعدم الحضّ على طعام المسكين ، وقد صيغ هذا التعجب في نظم مشوِّق لأن الاستفهام عن رؤية من ثبتت له صلة الموصول يذهب بذهن السامع مذاهب شتى من تعرف المقصد بهذا الاستفهام ، فإن التكذيب بالدين شائع فيهم فلا يكون مثاراً للتعجب فيترقب السامع ماذا يَرِد بعده وهو قوله : { فذلك الذي يدع اليتيم } .وفي إقحام اسم الإِشارة واسم الموصول بعد الفاء زيادة تشويق حتى تقرع الصلة سمع السامع فتتمكن منه كَمَالَ تَمكُّن ".
أما الإتيان بفعل المضارع للكذب، ليدل على استمرار ذلك الفعل وتكراره، ففي اللغة معنى الكذب فجاء في كتاب الأصفهاني " أنه يقال في المقال والفعال، قال تعالى ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون ) وقوله ( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) أنه كذبهم في اعتقادهم لا في مقالهم، ومقالهم كان صدقا، وقوله ( ليس لوقعتها كاذبة ) لقد نسب الكذب إلى نفس الفعل كقولهم فعلة صادقة وفعلة كاذبة، وقوله ( ناصية كاذبة )ويقال رجل كذاب وكذوب وكذبذب وكيذبان، كل ذلك للمبالغة، ويقال كذبة كذبا وكذابا وأكذبته: وجدته كاذبا، وكذبته نسبته إلى الكذب صادقا كان أو كاذبا، وفي تكذيب الصادق في القرآن ( كذبوا بأياتنا ) ( قال رب انصرني بما كذبون ) ( بل كذبوا بالحق ) ( لا يسمعون فيها لغواً ولا كذّبا ) الكذّاب التكذيب والمعنى لا يكذبون فيكذب بعضهم بعضا، ونفي التكذيب عن الجنة يقتضي نفي الكذب عنها، ويقال كذب لبن الناقة اذا ظن ان يدوم مدة فلم يدم "
فالكذب إذا هو خداع للنفس، وتزين لها بالأوهام والضلالات التي ستؤدي بصاحبها للخسران المبين، فهو يكذب من أجل أن يحقق غايته الدنيوية، فيخفي الحق ولا يسانده، يدّعي عكسه ومخالفته، فهذا من أسوء الأخلاق الإنسانية التي يمكن أن يتصف بها الإنسان، والذي يكذب لا بد أن كذبه سيؤدي للتأثير سلبا على غيره من أبناء مجتمعه، فهو يخفي الحقائق التي كان من الممكن أن تحسن من ظروف وأحوال أفراد المجتمع، ولكنه يسعى من وراء ذلك للتشويه في المجتمع والضلال .
فحتى تُعطى صفة الإيمان للإنسان، لا بد أن يتصف بالصدق، والذي ينبع من صدق الاعتقاد والعاطفة، فهو اعتقاد يقع في القلب، تصدقه الجوارح، وتعمل به مندفعة بالعاطفة والشعور، والتعبير عنه بسلوكيات مشاهدة أو قلبية، وتعامل مع الآخرين، وتفاعل في بناء المجتمع وتعزيز مقوماته .
فالصدق في اللغة كما جاء في كتاب الأصفهاني ( الصدق والكذب أصلهما في القول ماضيا كان أو مستقبلا وعدا كان أو غيره، ولا يكونا في القول إلا في الخبر دون غيره من أصناف الكلام، قال تعالى ( ومن أصدق من الله قيلا ) ( ومن أصدق من الله حديثا ) ( إنه كان صادق الوعد )والصدق مطابقة القول الضمير المخبر عنه معا، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما بل إما لا يوصف بالصدق وإما يوصف تارة بالصدق وتارة بالكذب عل نظيرين مختلفين كقول كافر ( محمد رسول الله ) فهذا يصح أن يقال صدق لكون المخبر عنه كذلك، ويصح أن يقال كذب لمخالفة قوله ضميره، واكذاب الله تعالى المنافقين حيث قالوا ( نشهد إنك لرسول الله ) والصديق من كثر صدقه أو من لا يكذب قط لتعوده الصدق، ويقال لم صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله قال ( واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ) وقد يستعمل الصدق والكذب في كل ما يحق ويحصل في الاعتقاد نحو صدق ظني وكذب، ويستعملان في أفعال الجوارح ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) أي حققوا العهد بما أظهروه من أفعالهم، (ليسئل الصادقين عن صدقهم ) أي يسئل من صدق بلسانه عن صدق فعله تنبيها أنه لا يكفي الاعتراف بالحق دون تحريه بالفعل "
فالصدق إذا ضد الكذب والذي تدل عليه السلوكيات وجوارح الإنسان، وليس ما يعتقده أو يتفوه به، فالذي يصدق بما يقول وما ينادي فيه من مباديء، لا بد أن يظهر قبل ذلك على تصرفاته ما يطابق ذلك الإيمان والسلوك، وأن يستمر منه بصورة دائمة دون مخالفة أو إتباع للهوى، والصدق صفة ملازمة وثابتة في نفسية المؤمن، والتي تنطلق مما يؤمن به من اعتقادات بنيت على منهج الله وما انزل الله على نبيه ورسوله، والمصدق هو الذي إن سمع أي قول أو فعل فيه ما يطابق أمر الله وشريعته بادر مسرعا للامتثال وتحقيق ذلك، دون منازعه ولا جدال .
يقول الامام ابن عاشور في تفسيره " والإِشارة إلى الذي يكذب بالدين باسم الإِشارة لتمييزه أكملَ تمييز حتى يتبصر السامع فيه وفي صفته ، أو لتنزيله منزلة الظاهر الواضح بحيث يشار إليه،الرؤية بصرية يتعدى فعلها إلى مفعول واحد ، فإن المكذبين بالدين معروفون وأعمالهم مشهورة ، فنزّلت شهرتهم بذلك منزلة الأمر المبصَر المشاهد " .
فالإخبار عن المكذبين والتي دلت أفعالهم المشاهدة على حقيقة كذبهم، وجعلت الناس المؤمنين تعرفهم من تلك الأفعال والصفات، ويشيرون إليهم بالبنان، فالذي يكذب بالدين لا بد أنه لا يهتم لأمر الآخرين، فيفعل ما يحلو له، ويعتدي بما يشاء على غيره، دون أن يحسب لله ولا رسوله ولا المؤمنين أي حساب، ظناً منه أنه على حق، وأن لا موت ولا بعث بعد هذه الحياة، والكذب صفة من صفات النفاق، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( أية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان ) متفق عليه . وفي رواية إن صام وصلى وزعم أنه مسلم ) .
فالكذب ضد الصدق ومعاكس له بالفعل، والشعور، والسلوك، فالذي يتصف بصفة الكذب لا بد أن تكون شخصيته مركبة من عدة صفات سلبية أخرى، حيث أن شخصية الإنسان مترابطة ومتفاعلة بسمات من نفس الاعتقاد والشعور، والكذب هنا ليس كذب تبريري لحماية الذات من عقوبة ما، أو خطر محتمل، أو كذب بسبب فقدان الرعاية والاهتمام، أو لجذب أنظار الآخرين إليه، بل هو كذب عن إصرار وتعمد وقوة في اليقين والوعي، فهو كذب قام على إنكار الغيب الذي أمر الله الإيمان به، وجعل دلائل مشاهدة عليه، ولكن رغم معرفة تلك الدلائل ومشاهدتها، تم تكذيبها والإصرار على الكفر وعدم الإيمان، فإذا انتفى الإيمان بالغيب من عقيدة الشخص، ينتفي عندها كل فعل يدل على الإيمان، والكذب بكل سنن أو تشريع أراد الله أن يُطبق ويُتبع في منهج الحياة البشرية، فالتكذيب بالدين هو من أخطر الكذب وأشدها خطورة على قلب الإنسان وإيمانه، فكما جاء باللغة أن الدينُ هو الطاعةُ. ودانَ له، أي أطاعه. ومنه الدينُ؛ والجمع الأدْيانُ. يقال: دانَ بكذا دِيانَةً وتَدَيَّنَ به، فهو دَيِّنٌ ومُتَدَيِّنٌ. ودَيَّنْتُ الرجل تَدْييناً، إذا وكَلْتَهُ إلى دينِه.والدين يقال للطاعة والجزاء واستعير للشريعة، والدين كالملة لكنه يقال اعتبارا بالطاعة والانقياد للشريعة قال تعالى ( ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ) أي طاعة ( وأخلصوا دينهم لله ) "
فالدين هو الهوية الذاتية التي يحملها صاحبها، فيتميز بها عن غيره، وهو التحزب الحق بالانتماء إلى شريعة الله ومنهجه، والعمل على إطاعة أوامره وتصديقها، والبعد عما نهى عنه والسعي وراء التزامها، والدين هو شريعة الله وهو الإسلام، الذي أراد الله للبشر أن ينقادوا مستسلمين إليه، منقادين دون شك أو ريب، والدين هو التعامل والتفاعل مع الآخرين في المجتمع، من خلال العلاقات الإنسانية والاجتماعية، واحترام حقوق الآخرين ضمن منهج الله وشريعته، والدين هو الإيمان بالغيب والبعث وأن لا ملجأ إلا إليه، وأننا إليه راجعون لا محال، والإيمان بالجزاء والثواب، فالإيمان بالغيب هو الرادع الأقوى الذي يعين النفس على ضبط سلوكياتها وتهذيبها وتوجيهها لكل ما يرضى الله، والبعد عن مخالفة أمره ونهيه، فلولا الإيمان بالغيب وبيوم الدين والبعث، ما التزم أحد بشيء فيه حرمان من لذة الشهوات، وما صبرت نفس على الأذى والمصائب والكريات، لكنها الشخصية الإيمانية الصادقة التي قامت على ذلك كله، فتحقق الاعتقاد السليم والإيمان الحق، وسلامة الفطرة، وطهارة النفس والقلب، وإن الإتيان بحرف الباء مع الدين، كأن من واجب الإنسان أن يكون ملاصقا بهذا الدين، والاعتقاد بحقيقة الرجوع إلى الله، فالذي يكذب بالدين، فهو ميز ذاته أكثر ما ميزها أنه كذب بذلك البعث وهذه العودة، فكان منطقة واعتقاده مفصول عن حقيقة الإيمان بوجود يوم للدين والبعث، فكان فكره مرتبط بإنكار البعث .
يقول الإمام ابن عاشور " هذا إيذان بأن الإِيمان بالبعث والجزاء هو الوازع الحق الذي يغرس في النفس جذور الإقبال على الأعمال الصالحة حتى يصير ذلك لها خلقاً إذا شبت عليه ، فزكت وانساقت إلى الخير بدون كلفة ولا احتياج إلى آمر ولا إلى مخافة ممن يقيم عليه العقوبات حتى إذا اختلى بنفسه وآمن الرقباء جاء بالفحشاء والأعمال النَّكراء " .
والدين هو الأمانة التي حملها الله للإنسان، وفرض عليه تأديتها وتحقيقها في الأرض للإصلاح فيها والبعد عن الفساد، فجعل الله دينه أمانه في عنق كل إنسان خلقه وعلمه، فهو مسئول عما أداه وحققه في فترة وجوده على الأرض، وبدء السورة بالحديث عن المكذب بالدين، لهول هذا الأمر وعظمته عند الله، فالإيمان بالدين يحوي كافة السلوكيات المضادة للسلوكيات السلبية التي ذكرت في هذه السورة ودلت على أنه مكذب، فالتصديق الحق بدين الله، لا يكون إلا بمعرفته والإطلاع على ما أمر به ونهى عنه، .
فبعد لفت ذلك الانتباه، وشد النفس للوعي بصورة وحال هذا المكذب بالدين، يأتي التوضيح التفصيلي لأهم السلوكيات التي برزت منه، فجعلت القرآن واصفا له بالمكذب بالدين، المتوعد له، فمن أولى الصفات بعد تكرار واستمرار التكذيب بالدين، فهو المتهم الذي أجرم وطغى بحق نفسه، وبحق الآخرين، فيكشف الله ستار النفاق ليفضح ما في النفس، وما وقر في القلب من خبث الاعتقاد ، ويتحدث عما يجول في الخاطرة، وطبيعة ما يحويه القلب من القسوة حتى على أضعف الضعفاء .
فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2)
يقول ابن عاشور حول الفاء " والفاء لعطف الصفة الثانية على الأولى لإفادة تسبب مجموع الصفتين في الحكم المقصود من الكلام ، وذلك شأنها في عطف الصفات إذا كان موصوفها واحداً مثل قوله تعالى : { والصافات صفاً فالزاجرات زجراً فالتاليات ذكراً } [ الصافات : 1 3 ] .فمعنى الآية عطفُ صفتي : دَع اليتيم ، وعدم إطعام المسكين على جزم التكذيب بالدين " .
ويقول الامام الرازي " والفاء في قوله { فذلك } للسببية أي لما كان كافراً مكذباً كان كفره سبباً لدع اليتيم ، وإنما اقتصر عليهما على معنى أن الصادر عمن يكذب بالدين ليس إلا ذلك ، لأنا نعلم أن المكذب بالدين لا يقتصر على هذين بل على سبيل التمثيل ، كأنه تعالى ذكر في كل واحد من القسمين مثالاً واحداً تنبيهاً بذكره على سائر القبائح ، أو لأجل أن هاتين الخصلتين ، كما أنهما قبيحان منكران بحسب الشرع، فهما أيضاً مستنكران بحسب المروءة والإنسانية "
إنها وحدة الشخصية بطباعها المتقاربة، والتي تتشابه في الغاية والهدف ، وفي الاعتقاد والسلوك، فالكذب ودع اليتيم لهما نفس المصدر في الاعتقاد، فقد انتقل الوصف من حال المكذب بالدين إلى حال الذي يدع اليتيم، وقد جاء في معنى الدع في اللغة أنه من " دعع َدعَعْتُهُ أَدُعُّهُ دَعَّاً، أي دفعته. ومنه قوله تعالى: فذلك الذي يَدُعُّ اليتيم "
قال ابن عاشور حول معنى { يدع } يدفع بعنف وقهر ، قال تعالى : { يوم يدعون إلى نار جهنم دعاً } [ الطور : 13 ] .
فالدع هو الدفع بقوة مع الإعراض وإشاحة الوجه، أو شدة الانفعال والغضب والتحقير لشأن من يُدع، وصرفه عن الاقتراب منه، فمن معنى الماعون والإعانة والتي تقوم على رحمة القلب، وملئه بالعواطف الإنسانية النبيلة، والتي تتحرك اتجاه أي موقف أو شخص ضعيف، محتاج لمد يد العون والرحمة، ومن أحق من اليتيم الذي فقد من يعوله ويلطف به لتلك الإعانة، وإلى توفير ذلك الماعون الذي امتلئ بالحب والعطف والرأفة والشفقة، ليخفف به عن قلبه المحزون، وترسم السعادة والبسمة على تقاسيم وجهه المهموم، فذاك اليتيم والذي لم يبلغ الحلم بعد، وما زال ضعيفا مستضعفا، فريسة سهلة للآخرين للانقضاض عليه، والاعتداء على حقه، والإنقاص من نصيبه، فيلجأ مستغيثاً بمن يملكون سلطان القوة من المال، فيطرقون أبوابهم علهم يمدونهم مما أمدهم الله من فضله عطائه، يتلمسون نظرات الرحمة والعطف، يحتاجون إلى من يسد حرارة جوعهم، ومن يقدم لهم الشفاء لألام قلوبهم وأجسادهم، فذاك اليتيم المسكين، الذي تلهف لمن يستشعر فيه حنان الوالد الرحيم، فيلجأ ليستمد منه ذاك الحب، ليتزود منه طاقة من الأمل والإقبال على الحياة، ولكنه يُدفع خائباً، منكسرا للقلب محزونا، فيكتشف أن من لجأ إليه لا يعرف للرحمة سبيلا ، فيتوقعون من ذاك الذي يكذب بالدين، ولا يؤمن بعقيدة الرحمة والتعاون والتكافل، ولا بمسؤوليته اتجاه المستضعفين من أمته، وهذا الذي لا يؤمن بشريعة خالقه، وما جاء فيها من حض على كفالة اليتيم والرحمة به، فكيف سيلتفت إلى طرقِ أنامل ذلك الصغير ، والتي ضعفت وهزلت من قلة ما تتناوله من غذاء يمدها بالطاقة والنمو، فهو يدفعه بقوة وقهر، يريد أن يتجنب ملاقاته والنظر إليه، فهو يتهرب من المسؤولية التي تلقى عليه من إنسانيته وشريعة ربه، فيدفعه بقوة يديه قابضاً عليه، ناهيا إليه بعدم العودة أو الدخول عليه، فالكبر والغرور وحب الذات، وعدم الانتماء والإحساس بالآخرين، سيطر على ذاتيته، وحب الدنيا، وطول الأمل بالحياة ، منعه من حب الإنفاق والبذل في العطاء ، والشح عن مد العون لليتيم ، والإتيان بالفعل المضارع للدع، ليدل على مدى تكرار ذلك الفعل به، والتصاقه بشخصيته حتى أصبحت صفة ملازمة به، بل هي سمة وطبع من طباع نفسه التي أحبها واختارها لذاته، ويأتي أيضا الدع والدفع لليتيم من قبل من تولى أمره، وسيطر على أملاكه وميراثه، فعندما يلجأ ذلك اليتيم إليه طالباً بعضاً من حقه لينفق عليه، فيدفعه دفعاُ شديدا، فيدّعي عليه الجهل وصغر السن وعدم الحاجة لذلك الإنفاق، مدّعيا لنفسه فقط حق الإنفاق عليه، وهو في الحقيقة مقصراً معه وآكلا لماله وحقوقه، يقول الله سبحانه ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) النساء .
ثم تأتي السورة لتبين صفة أخرى لشخصية من اتخذ الكذب منهجا وسبيلا، ولتبين مدى جشع ذلك الإنسان، وحرصه على نفسه وماله، دون أن يفكر بغيره من أبناء مجتمعه، لعله حتى لم يفكر بأقرب الناس منه، من الأهل والجيران، إن رأى حاجه فيهم وضعف، فتأتي الأية الأخرى تصف حال سلوكه ، بقوله تعالى
وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3)
فبداية الأية بواو العطف مع النفي، فهي عطف على ما سبقها من اعتقاد وفعل، ونفي عما يتصف به الإيمان من الحض على طعام المسكين، فالمؤمن هو الذي يظهر منه المسارعة لإعانة المسكين والوقوف إلى جانبه، وحث الآخرين على دعمه وتقويته، أما الكافر المكذب بالإيمان والبعث، فلم يعرف تلك الصفة، وما اتصف بها يوما ولن يتصف بها مستقبلاً .فالوصف الأخر لتلك الشخصية التي ركبت على حب المنع للخير، والحرص الشديد على ما تملك، وعدم البذل منه، ولو بالجزء القليل لأجل الآخرين، وخاصة المستضعفين وأهل الحاجات، فهذه النفس التي لم تستطع أن تتغلب على شهواتها، لتدعها تسيطر وتعلو عليها، و عدم التأنيب للذات،لتقصيرها بالإنفاق في سبيل الله، فهي منقادة من النفس الأمارة والمسولة بالسوء، والتي زينت لصاحبها الأوهام والضلالات وطول الأمل، والخلود في الحياة بعدم الفناء، فزاد حرصها على كل شهوة، وعلى جرأتها في الاعتداء على المستضعفين وحرمانهم مما يستحقون، وعدم الالتفات إلى ما أمر الله ورسوله، بحب الإنفاق والبذل ومساندة أهل الضعف والحاجة .
فنفي صفة الحض هنا، عمّن أصلا هو مكذب للدين، ويدع لليتيم ويتكبر عليه، دليل على ضعف وخست تلك النفسية، فالحض كما جاء في اللغة " حَضَّهُ على القتال حَضَّاً، أي حَثَّهُ. وحَضّضَهُ، أي حَرَّضَهُ ".
يقول ابن عاشور " والحض : الحث ، وهو أن تطلب غيرك فعلاً بتأكيد " .
فالحض هو استشعار نفسي مع مشاعر مرهفة، قائمة على حب البذل للآخرين، لأجل نيل مرضات الله والفوز العظيم، والإحساس بالأثر النفسي القائم على تحقيق السعادة والأمن الداخلي، والتعديل السلوكي وكل ذلك من أثر حب البذل والعطاء، والحض هو كثرة الحث بإلحاح وتأكيد بالتكرار، خشية النسيان أو الغفلة، سواء كان للنفس أو للآخرين ممن يحيطون به، فمن طبيعة الإنسان إما النسيان أو الفتور والكسل عن الإقبال على عمل الخير والصالحات، حيث تعلو أحيانا حب الذات والشهوات لتسيطر على قلب الإنسان، فتسبب له ذلك النفي أو الضعف والفتور في الإيمان، والإقبال على العمل، وما يعين الإنسان على تقوية الإيمان، والتخلص من سيطرة الشهوات وحب الذات، هو خدمة الآخرين والبذل في العطاء، والحث على التعاون والتكافل ووحدة القلوب على الخير، فكلما تغلب الإنسان على غرائزه وشهواته لأجل الله، كلما أعانه الله على الخير، وزاد من الإيمان والصلاح في دينه، فهنا هذا الذي يكذب بالدين، هو في حقيقة أصله غير مؤمن بالبعث ولا بالجزاء، وهو أساس لحض الإنسان على عمل الخير والصالحات، والإقبال على الله، خوفاً منه وحباً إليه، فكيف به سيفكر بحض نفسه أو غيره على الإنفاق من طعامه الذي رزقه الله، وهو من يدع اليتيم، ويزجره ويمنعه من حق ماله، فكيف سينفق من طعامه على المسكين الضعيف، فكان الأولى أن يرحم اليتيم الصغير، ويؤتيه حقه وماله، فكيف سيلتفت للمسكين وضعفه.فهذه الشخصية التي قد قست في قلبها ومشاعرها، وتحجرت في أحاسيسها وانتمائها لمن حولها، وبقيت محجمه حول ذاتها، لا تُبعد التفكير ولا الرؤية بعيدا عنها، خوفا على مصلحتها وشهواتها .
يقول ابن عاشور " والطعام : اسم الإِطعام ، وهو اسم مصدر مضاف إلى مفعوله إضافة لفظية . ويجوز أن يكون الطعام مراداً به ما يطعم كما في قوله تعالى : { فانظر إلى طعامك وشرابك } [ البقرة : 259 ] فتكون إضافة طعام إلى المسكين معنوية على معنى اللام ، أي الطعام الذي هو حقه على الأغنياء ويكون فيه تقدير مضاف مجرور ب ( على ) تقديره : على إعطاء طعام المسكين " .
يقول الإمام الرازي " لا يحض نفسه على طعام المسكين، وإضافة الطعام إلى المسكين تدل على أن ذلك الطعام حق المسكين ، فكأنه منع المسكين مما هو حقه ، وذلك يدل على نهاية بخله وقسوة قلبه وخساسة طبعه والثاني : لا يحض غيره على إطعام ذلك المسكين، بسبب أنه لا يتقد في ذلك الفعل ثواباً ، والحاصل أنه تعالى جعل علم التكذيب بالقيامة الإقدام على إيذاء الضعيف، ومنع المعروف ، يعني أنه لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد لما صدر عنه ذلك ، فموضع الذنب هو التكذيب بالقيامة "
جاء في كتاب الصحاح معنى طعم " الطَعامُ: ما يُؤكل، وربَّما خُصَّ بالطَعامِ البُرُّ. والطَعْمُ: بالفتح ما يؤديه الذَوق. يقال: طَعْمُهُ مُرٌّ. والطَعْمُ أيضاً: ما يُشْتَهى منه. يقال: ليس له طَعْمٌ. وما فلان بذي طَعْمٍ، إذا كانَ غثًّأ ".
فالمقصود بالطعام هنا وهو الحاجة الأساسية والأولى لبقاء الإنسان واستمراره، وهي من الحقوق الأساسية التي يجب على المجتمع أن يوفرها لأفراده وخاصة الفقراء والمساكين، فإن كان ذلك الذي لا يحض على توفير تلك الحاجة الضرورية للمحتاج إليها من أفراد مجتمعه، حتى يساهم في حفظه، وبقاء توازنه، وعدم انتشار الفساد والفقر والضعف بين أبنائه، فكيف سيقدم ما هو أعظم وأكبر من ذلك لخدمة مجتمعه وأهله ، والإتيان بالفعل المضارع في قوله ( ولا يحض ) يدل على استمرارية الفعل والسلوك، حتى أصبح سمة وطبع من طباع الشخصية والذات .
والمسكين هو الإنسان الذي لا يملك قوت يومه، ولا يملك ما يسد به رمقه، فهذه الحاجة الضرورية كحق إنساني أولا، يجب أن يتمتع به الإنسان لتحفظ كرامته وإنسانيته في الوجود، لذا جعل الله حقا على الأغنياء والقادرين على أن يبذلوا ويعطوا من أموالهم لهؤلاء الفقراء، وجُعل في ذلك عبادة وتقرب إلى الله ، بل هو فرض وواجب على الإنسان المسلم أن ينفق من ماله بأداء حق الزكاة للفقراء والمساكين، وقد جاء في معنى المسكين عند ابن عاشور " الفقير ، ويطلق على الشديد الفقرِ ، وقوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين } " في سورة التوبة ( 60 ) .
فلم خص اليتيم بالدع ؟، وخص المسكين بالحض ؟ ولما قدم اليتيم على المسكين؟ وخص المسكين بالحاجة للطعام ولم يخص اليتيم بذلك ؟
فلعل الحكمة من وراء ذلك أن اليتيم هو الأكثر ضعفا من المسكين، فهو في سن صغيرة لا يملك من يعوله ويدافع عنه، أما المسكين فليس شرطا أن يكون صغيرا، بل يكون راشدا بالغا، ولكنه لا يملك ما يعول به نفسه، فنسبة الضعف تكون أقل مقارنة باليتيم، وخص اليتم وحذر من دعه، وذلك حرصا على نفسيته ومشاعره، فهو في سن تتشكل فيها الشخصية وتبنى للكبر، فإن أصيبت بالأذى في تلك المراحل المبكرة لا بد أن تترك أثرا سلبيا وعميقا على تركيبته الذاتية، وتبقي في نفسه انكسارا وضعفا، أو حقدا وكراهية لمن حوله، مما يفقده الثقة بالآخرين أو بنفسه، فيحول ذلك دون أن يحسن من حاله ويقوي ذاته عند الكبر، وذلك نتيجة للإحباط والصد الذي تعرض له في الصغر، أما المسكين فحذر من عدم الحض على إطعامه وتوفير حاجاته الأساسية، لأن ذلك فيه حفظا لكرامته وأخلاقه، فإن بقي محروما ولم يبالي أحدا من أفراد مجتمعه بأمر حاجته، فلا بد أن يضطر للانحراف إما بالسرقة أو الجريمة لأجل أن ينال حاجته، أو سيبقى يعاني من مشاعر القهر والحرمان وعدم شيوع العدالة والإنصاف مقارنة بغيره من أفراد مجتمعه، والمسكين أُولى حاجاته الطعام، وهي الغريزة الأساسية للحياة والبقاء بالعيش بكرامة، فعندما توفر تلك الحاجة ويكون مطمئناً على وجودها، سيُدفع للتفكير والبحث عن حلول لفقره وحاجاته، وهو في حالة طمأنينة وعدم الخوف من الجوع، كما بين الله سبحانه حالة ضعف اليتيم في كثير من الأيات في كتابه، وحذر من التعامل معه دون رحمة ولا إنسانية، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، باللطف به وبمشاعره فقال ( فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر ) الضحى، فقهر اليتيم مسألة ذات تأثير سلبي عميق على شخصيته ومشاعره في مراحل نموه، فالقهر لليتيم هو عندما يأخذ حقه الذي قدره الله له، أو ورثه من والدية، فيأتي من يقهره ويستولي قهرا على نصيبه وماله، ويستغل ضعفه وصغر سنه، أما السائل وهو الفقير المحتاج، الذي يدعوا الله سبحانه لعدم إغلاق الباب في وجهه، ونهره والإساءة له، وهو من يحتاج ما يعول به نفسه، وقال الله سبحانه عن اليتيم أيضا ( وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين )البقرة
فأيضاً هنا جعل الله العطف على اليتيم واللطف به والرحمة عليه، بعد أقرب الأقربين إلى الإنسان وهو علاقته بربه، ثم والديه ثم قرابته ثم يأتي اليتيم بعد ذلك والمسكين، ليدل على أن الله أراد أن يجعل الإنسان مرتبطا بهذه الفئة ومستشعرا بدوره اتجاه دعمها وتقويتها لأنها الفئة الأضعف في المجتمع، وأن العمل على الوقوف والدعم لها سيكون من طاعة الله والعبودية وتحقيق لعمارة الأرض وصلاحها، وكذلك المسكين الذي يرتبط دائما باليتيم وتكون الرعاية لاحقة له، فهو من العبودية لله في حالة أن تم رعايته ونصرته وتوفير متطلبات حياته كلها .
ولعل الإتيان بحرف على في قوله ( على طعام ) كأن الله سبحانه أراد للنفس الإنسانية أن تتعالى عن شهواتها وغرائزها لتعلو فوقها، وتصبح هي من تقودها وتنظمها وتهذبها بما يريده الله، وحسب القنوات والطرق المشروعة من شريعته، أما إن علت الشهوات وارتفعت فوق النفس الإيمانية، فسوف تكون عبده لتلك الشهوات، ومنقاده إليها، وستنحط النفس وتنزل لأدني الدرجات الدنيوية والأرضية، والتي ستقلل من كرامة الإنسان، وعلو خلقه وسلوكه، فيكون مقاداً لأمر الشهوات والغرائز، وليس بأمر الله والإيمان .
ثم تأتي النقلة الأخرى قي هذه السورة، والتي تبين أن الإيمان الحقيقي لا يقوم إلا على صدق الاعتقاد وقوته، فلا يمكن أن يقوم الإيمان على حركات ظاهرية وتعبدية، بل لا بد من نقاء وطهارة داخلية، فالقلب هو مصدر الطاقة الإيمانية، وهو منبع السلوك السوي، وهو مخزن العقل والإدراك والشعور، فإذا لم يخالط الإيمان ذلك القلب، ويخرج معه تلك المشاعر والانفعالات التي تعبر عن صدق تحركات الإنسان في مجتمعه، فذلك نفاق ورياء، فكيف سيكون حال سلوك واعتقاد من يكذب بالدين، ويدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فهذا الإنسان الذي ما أمن بالبعث والرجوع إلى الله، كي يرتدع ويأتمر بأمر الله، وتوجهت نفسه للتطلع لكل عمل يقود إلى مرضاته سبحانه، فهل يُتوقع منه الإخلاص والصدق في عبادته، فلا بد إن لجأ لعمل من العبادات أن يفعلها رياءاً ونفاقا ومندفعا للمصلحة الذاتية، وتحقيقاً لهدف ورغبة دنيوية، وليس حباً بها، ولا شوقاً بالإقبال عليها، لذا جاء الجزء الثاني لآيات السورة، ليصف حال المكذب بالدين، أنه منفصل عن خالقه، كما فصل نفسه عن مجتمعه وأهله، فيقول الله سبحانه
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5)
يقول ابن عاشور " موقع الفاء صريح في اتصال ما بعدها بما قبلها من الكلام على معنى التفريع والترتب والتسبب . فيجيء على القول : إن السورة مكية بأجمعها أن يكون المراد بالمصلين عينَ المراد بالذي يكذب بالدين ، ويدُعّ اليتيم ، ولا يحض على طعام المسكين ، فقوله { للمصلين } إظهار في مقام الإِضمار كأنه قيل : فويل له على سهوه عن الصلاة ، وعلى الرياء ، وعلى منع الماعون ، دعا إليه زيادة تعداد صفاته الذميمة بأسلوب سليم عن تتابع ستِّ صفات لأن ذلك التتابع لا يخلو من كثرة تكرار النظائر فيشبه تتابع الإِضافات الذي قيل إنه مُناكد للفصاحة ، مع الإِشارة بتوسط ويل له إلى أن الويل ناشىء عن جميع تلك الصفات التي هو أهلها وهذا المعنى أشار إليه كلام «الكشاف» بغموض ".
وقد جاء في اللغة معنى " ويلٌ: كلمة مثل ويحٍ، إلا أنَّها كلمةُ عذابٍ، يقال: وَيْلَهُ وويْلَكَ وويلي، وفي الندبَةِ: وَيْلاهُ! قال الأعشى: ويلي عليكَ وويْلي منكَ يا رَجُلُ "
إن هذه السورة حسب قول العلماء تعتبر مكية، فإن كانت مكية, أو أن جزء منها مكي والآخر مدني حسب قول بعض العلماء،وبما أن الدعوة كانت في بداية نموها وتطورها، ولم يؤسس المجتمع الإسلامي بعد، والذي أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته في المدينة، فأراد الله سبحانه أن يبين لنبيه وأن يريه ويذكره بطبيعة الشخصيات التي ستواجه الدعوة، فكان أكثر ما يواجهه كثرة تكذيبهم بما يجيء به من آيات ودلائل على وجود الله والبعث، فكانت تلك سمة منتشرة بين صناديد قريش وأصحاب رؤوس الأموال فيها، فكان ذلك التكذيب من صدهم عن الإيمان والإتباع لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى منهم ذلك ويشاهده عيانا، فأراد الله أن يُهول من عاقبة ذلك الفعل ويوضح أنه سيجر إلى أفعال وسلوكيات أخرى، والتي ستجعل القلب مغلقاً عن رؤية الحق، أو الإحساس بمشاعر الإيثار والمساهمة في إعانة الآخرين وعمارة المجتمع، فهؤلاء كان أكثر عدوانهم واستهزائهم بهذه الفئات المستضعفة من الأيتام والمساكين، فجاء الخطاب لفضح ممارسات وسلوكيات يريد أن يطهر الله منها قلوب المؤمنين، ويحذر من إتباعها لأنها من أكثر ما تميت القلب، ويربي نفوسهم على أفضل الأخلاق وأحسنها، وتشكل شخصياتهم الإيمانية على ما يعينها على ثبات الإيمان والصدق والإخلاص، ويفضح ما في قلوب المكذبين من القسوة والجفوة على هذا الدين وأهله، فحذر الله المؤمنين أن يكونوا من أصحاب الويل، والتي ستكون حال من هم أهله، عند اكتشاف ما كذبوا به فتصاحبهم الندامة والحسرة في النفس، فعندما يشاهدون الحق بأم أعينهم، وحقيقة وجود العذاب أمامهم، عندها تنطلق ألسنتهم تلهج بقولهم ( يا ويلي على ما ضيعت وما فرطت في جنب الله ) عندها لا تنفع الندامة ولا العودة .
ثم جاء الوصف العظيم والأساس، والذي سيدفع القلب إلى الإصابة بتلك الدواعي والأمراض، حيث توعد من يدّعون القرب من الله من خلال عبوديته بالصلاة، وهم أصلا بعيدين كل البعد عن ذلك الفعل من الطاعة، لقد سموا أنفسهم بالمصلين، وأنهم من زمرة المصلين، ويصفون في صفوفهم، ويتوحدون معهم لعمارة مجتمعهم، وأفعالهم تفضحهم بغير ذلك، والإتيان بحرف ( عن ) ليدل على البعد والانفصال عن ذلك الفعل بالإرادة والاختيار المتعمد .
بقول ابن عاشور " فوصفهم ب«المصلين» إِذَنْ تهكم ، والمراد عدمه ، أي الذين لا يصلون ، أي ليسوا بمسلمين كقوله تعالى : { قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين } [ المدثر : 43 ، 44 ] وقرينة التهكم وصفهم ب { الذين هم عن صلاتهم ساهون } . وعلى القول بأنها مدنية أو أن هذه الآية وما بعدها منها مدنية يكون المراد { بالمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون } المنافقين . وروَى هذا ابنُ وهب وأشهبُ عن مالك ، فتكون الفاء في قوله : { فويل للمصلين } من هذه الجملة لربطها بما قبلها لأن الله أراد ارتباط هذا الكلام بعضه ببعض ".
روى البغوي بسنده عن سعد قال « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال إضاعة الوقت »
بقول ابن عاشور " والسهو حقيقته : الذهول عن أمر سبق عِلمُه ، وهو هنا مستعار للإِعراض والترك عن عمد استعارة تهكمية مثل قوله تعالى : { وتنسون ما تشركون } [ الأنعام : 41 ] أي تعرضون عنهم ، ومثله استعارة الغفلة للإعراض في قوله تعالى : { بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين } في سورة الأعراف ( 136 ) وقوله تعالى : { والذين هم عن آياتنا غافلون } في سورة يونس ( 7 ) ، وليس المقصود الوعيد على السهو الحقيقي عن الصلاة لأن حكم النسيان مرفوع على هذه الأمة ، وذلك ينادي على أن وصفهم بالمصلين تهكم بهم بأنهم لا يصلون " .
وقد جاء في اللغة معنى النِسيانُ " أنه خلاف الذِكْرِ والحفظ. ورجلٌ نَسْيانُ: كثير النسْيانِ للشيء. وقد نَسيتُ الشيء نِسياناً ولا تقل نَسَياناً بالتحريك، لأنّ النَسَيانِ إنَّما هو تثنية نَسا العِرْقِ. وأنْسانيهِ الله ونَسَّانيه تَنْسِيةً بمعنًى. وتَناساهُ: أرى من نفسه أنَّه نَسيه. والنِسيانُ: الترك. قال الله تعالى: " نَسوا الله فَنَسِيَهم:، وقال تعالى: " ولا تَنْسَوا الفضل بينكم " ، وأجاز بعضهم الهمز فيه " .
أما السَهْوُ " فهو الغفلة. وقد سَها عن الشيء يَسْهو فهو ساهٍ وسَهْوانُ. أبو عمرو: يقال عليه من المال ما لا يُسْهى ولا يُسْهى، أي لا تُبْلَغُ غايته. وحَمَلَتِ المرأة سَهْواً، إذا حبلتْ على حيضٍ ".
إن وصف الله سبحانه بهؤلاء المصلين أنهم ساهون عن صلاتهم، وليس ناسين لها غير متذكرين، لأن النسيان يرفع فيه الحرج والإثم عن صاحبه إن كان ناسيا له دون قصد، أما إذا تناساه فهو يعمل على تجنب ذلك الفعل أو الأمر، رغم وعيه وإدراكه له، ولكنه يعمل على أن يقدم لعقله وفكره وانشغال قلبه بزينة الدنيا ولهوها ولعبها، ويؤخر ذكر ربه وكل عمل يؤدي إليه، فيجعله من وراء ظهره، فيسهو عن الخير والطاعة عمدا وقصدا، دون أن يبحث عما يوقظه من تلك الغفلة، كما أنه لم يتخذ الحذر لنفسه بعدم الوقوع في الغفلة، بل لعله جالس وخالط كل ما يقوده لعدم الانتباه واليقظة، مما جعله يضيع وقته وعمره دون التفات لحقيقة وجوده، وما يطلب منه في هذه الحياة من تكاليف، فقد وصف الله سبحانه الناس في بداية سورة الأنبياء بقوله تعالى ( اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3)
فالغفلة هنا بالإعراض عن التذكر رغم المعرفة، وفضلوا الانشغال باللعب واللهو ومتاع الدنيا على معرفة ربهم وتذكر طاعته وعبادته، فهؤلاء هم المنافقون الذين ظلموا أنفسهم بالابتعاد عن أمر الله وطاعته والانقياد لأمره، وتفضيل كل ما يؤدي للقرب منه، على ما يبعد ويشغل القلب عن الخضوع إليه .
فهؤلاء الفئة من الناس الذين قدموا مصالحهم ومشاريعهم، واشغلوا أوقاتهم كلها في جمع حطام الدنيا، وغفلوا عن أن ما ينفع ليس ذلك المال المجموع، ولا كثرة إشباع الشهوات، ولكن ما ينفع عند الله هو الصالحات من الأعمال، والتي تبدأ، بصحة الإيمان والاعتقاد والإيمان بالغيبيات، ثم بإقامة الصلاة والمحافظة عليها بالخشوع والخضوع، والتي لا بد أن تقود بصاحبها إلى أعمال البر والصلاح بالأرض، فيسعى إلى رعاية المستضعفين من الأيتام والمساكين، فيهوُن عليه بذل ماله لأجل الآخرين، ويكون حب العطاء لإدخال السرور والفرح على قلوب المسلمين، ما يشرب قلبه به، ويكون من أكثر المكاسب عنده، فيرى أن كل شيء في هذه الدنيا إن فقد منه الارتباط بالخالق، فهو باطل ولا أثر له، أما الإيمان الحق، وصدق الإخلاص والنوايا، لا بد أن يظهر الأثر السلوكي الإيجابي على النفس، فيدفعها نحو حب العمل والعطاء .
ولعل تقديم صفات القلب السلبية، من عدم الإيمان بالغيب، ودع اليتيم، وعدم الحض على إطعام المسكين، لأن صلاتهم لم تترك الأثر الإيجابي فيهم، فلو كانت صلاتهم صادقة ومخلصة لكانت تركت الأثر السلوكي الإيجابي عليهم، (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) العنكبوت/45 ، وجاء في الحديث المروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش قولهم : ( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا ) " انتهى." الجامع لأحكام القرآن " (13/348) . والحديث المشار إليه في آخر كلامه : ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ، رقم (2) .
فأين تأثير الصلاة الصادقة الصحيحة على قلوب هؤلاء، فكانت مقدمة السورة تبين تلك الصفات، لتفضح ما أدعوا أنهم يؤمنون به، ويؤيدونه من الصلاة والانتماء لصف الجماعة .ومن المظاهر التي تدل على نفاق هؤلاء المصلين، وعدم صدقهم وإخلاصهم مع ربهم، ومع المسلمين في مجتمعهم، أنهم إن أدو الصلاة، ودخلوا مع الجماعة فيها، فكانت هذه الصلاة مجرد حركات لأجل مصالح ومنافع، ستعود عليهم عند رؤيتهم من قبل المؤمنين، فهم يحرصون كل الحرص على أن يشاهدهم الآخرين وهم في الصلاة، ولعله يظهر الخشوع والذل والانكسار على ملامحه في الصلاة، ليظن الناس به كثرة الصلاح والخير، والانتماء لصفوف المسلمين، فهذه القدرة التمثيلية على إظهار ملامح لسلوك لا يخرج من القلب، ولم يخالط الجوارح والأحاسيس، إنما خرج من بين أوهام وضلال ورياء، وكل ذلك من أجل الحرص على المصالح الذاتية والمكتسبة من مجتمعه الذي ينتمي إليه، أو خوفا على صيته ومكانته بين الناس، فحرص على أن يذكره الناس بالخير والطاعة، ولم يحرص على مرضاة ربه، ولا الخوف والطاعة والعبادة له وحده، فكان النفاق والكذب هو ما احتوى عليه فكره واعتقاده، وهذا ما كان منذ البداية بأنه يكذب بالدين، فكيف به سيكون مؤمنا حق الإيمان والطاعة، وهو لا يؤمن بالعودة والمآل إلى رب السموات والأرض .
ثم يأتي الوصف لحقيقة ما في قلوبهم، فهذا الدين لا يقوم إلا على طهارة النفس وصفائها،
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)
فالرياء كما جاء باللغة " فلانٌ مُراءٍ وقومٌ مُراءُونَ، والاسم الرِياءُ يقال: فعلَ ذلك رِياءً وسُمعة "ً.
فهو لا يفعل عمله إلا لأجل السمعة وإرضاء الآخرين، ولأجل مصالحه ومنافعه، والإتيان بالفعل المضارع أيضا في ذلك الفعل القلبي، ليدل على أن ذلك الأمر متأصل في القلب حتى أصبح مرضا مستعصيا من الصعب الانفكاك عنه، لقد اعتاد على ذلك السلوك، ولم يحاول أن يتخلص منه، أو أن يدرب نفسه على الإخلاص والصدق، والبعد عن كل ما يُبطل العمل ويضيع أجره عند الله، فلو عرفوا هؤلاء أن الله لا يَطلع على صورهم، ولكن محل نظره هو القلب، لكانوا حريصين على ملء قلوبهم بالصدق والإخلاص، ولكن كيف وهم الغافلون الجاهلون، الذين أُشبعت نفوسهم باللهو واللعب، فكيف التذكر واليقظة، وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )
فالرياء هو أخطر مرض قلبي من الممكن أن يصيب قلب الإنسان، فهو يتغلغل إليه في الخفاء دون أن يبصره، وما يساعد الإنسان على الانتباه إليه، والحرص على عدم إصابة القلب به، هو أداء الصلاة والعبادات الخالصة لله، وإلحاقها بالأعمال الصالحة التي تقوي القلب وتشفيه من أي داء .
أما ما ظهر أيضا من سلوك أنهم كانوا يمنعون الماعون، فالإتيان بالفعل المضارع يدل على استمرارية ذلك السلوك، فالمنع في اللغة " خِلاف الإعطاء. وقد مَنَعَ فهو مانِعٌ ومَنوعٌ ومَنَّاعٌ. ومَنَعْتُ الرجلَ عن الشيء فامْتَنَعَ منه. ومانَعْتُهُ ش مُمانَعَةً. ومكانٌ مَنيعٌ، وقد مَنُعَ مَناعَةً. وفلانٌ في عِزٍّ ومَنَعَةٍ بالتحريك، وقد يسكَّن، عن ابن السكيت. ويقال: المَنَعَةُ جمع مانِعٍ، أي هو في عز ومن يَمْنَعُهُ من عشيرته " .
فالمنع هو الحجب للشيء عن قصد وتعمد، فهو قادر على أن يعطيه وأن يقدمه،ولكنه يصر مستكبرا على منع ذلك الفعل أن يخرج منه ومن غيره، فهو كمن وضع حجابا وستارا ليحجب ويمنع عنه رؤية الحق والسير فيه، وأيضاً وضع على قلبه غشاوة لتمنع من نور البصيرة وتفتحها، فالذي يدع اليتيم فهو مانع للخير عنه، ومن لا يحض على طعام المسكين هو مانع للخير والإعانة، ومن يسهو عن صلاته ولا يؤديها إلا رياءا وسمعة، فهو مانع للإتيان بالخير لنفسه ولغيره، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكيف لا يكون من اتصف بكل تلك الصفات السلبية، غير مانع للماعون، وهو كل عمل للخير فيه إعانة وتعاون مع الآخرين، وفيه الفائدة لحياتهم، وإدخال الطمأنينة والسعادة والفرحة على قلوبهم، وجاء في اللغة أن الماعونُ: اسمٌ جامعٌ لمنافع البيت، كالقِدْر والفأس ونحوها. ويسمى الماء أيضاً ماعونا
أما تفسير ابن عبد السلام " { الْمَاعُونَ } الزكاة أو المعروف أو الطاعة أو المال بلسان قريش أو الماء إذا احتيج إليه ومنه المعين الماء الجاري أو ما يتعاوره الناس بينهم كالدلو والقدر والفأس وما يوقد أو الحق أو المستغل من منافع الأموال من المعن وهو القليل " .
ويقول ابن عاشور في تفسيره حول الماعون أنه " يطلق على الإِعانة بالمال ، فالمعنى : يمنعون فضلهم أو يمنعون الصدقة على الفقراء . فقد كانت الصدقة واجبة في صدر الإِسلام بغير تعيين قبل مشروعية الزكاة " .
إن من يضع العراقيل والحواجز التي تمنع عن أفراد المجتمع للمساهمة في خدمة الآخرين، وتقديم العون والمساندة والنصرة لهم، تحت غطاء من الأوهام والضلالات التي يشيعها في مجتمعه، وخاصة إن كان صاحب ملك وحكم وسلطانا، وكانت القوة بيده فاستخدمها ليصد الناس عن الخير والإيمان، إنما ذلك هو ممن انفصل عن معرفة ربه وخالقه، ولم تتسرب إلى نفسه معاني القيم الإنسانية النبيلة، التي تحرك الإنسان أينما كان ليكون إنسانا راقيا محبا للخير والعطاء، وداعيا لذلك المبدأ الإنساني الجميل، الذي لا يأتي إلا بالخير والحضارة والتقدم لمجتمعه وأمته، فكيف إن كان الذي يدعو لحمل تلك المبادئ هو الله، وهو أعلم بمن خلق وما يصلح وينفع لهم وما يضر، فكيف لا تتبع شريعته وأوامره، ويكذب به وبكتابه وشريعته.
فالعبد المؤمن الحق هو من يجعل من قلبه وعاء للخير الدائم، فليس الإيمان بكثرة الأعمال والعبادات، بل هو بالقلب السليم الصادق، الذي تًعرف على ربه، وعلم ما يحبه وسعى إليه، فجعل من قلبه ماعونا لكل مسكين وضعيف ومحتاج، فهؤلاء أصحاب القلوب الكبيرة التي ما عرفت النفاق والرياء، ولا الغل ولا الحقد و الكذب، تربت على موائد الرحمن، حتى اتصفت من صفات عباد الرحمن، لتمد يد الرحمة لكل من يمد يده إليها، فالقلب الكبير هو الماعون الذي فاض من كرمه ومحبته للآخرين، والانتماء لأهله ومجتمعة، وهو الذي يحوي كل ضعيف ومسكين، ليكون عونا له وسندا، وكل ذلك التزاما لأمر ربه، وحبا إليه ونيل مرضاته .
الفوائد التربوية والسلوكية من السورة
- أولى صفات الشخصية الإيمانية إيمانها بالغيب والبعث .
- الكذب على الحق من أكبر الذنوب القلبية التي تمنع الهداية .
- أهمية انتماء الفرد المسلم لمجتمعه والمساهمة في بنائه وتطوره .
- أهمية التكافل والتعاون بين الأفراد والجماعات ليقوى الضعيف بمساندة القوي .
- تربية الأطفال منذ الصغر على حب البذل والعطاء والتضحية لأجل الآخرين .
- التعريف باليتيم والتوعية الدائمة لأهمية دعم هذه الفئة في المجتمع .
- توعية الناس أن من أعظم العبادات كفالة اليتيم والحرص على معونته .
- مراعاة مشاعر الضعفاء وكرامتهم وعدم المساس بهم بالتجريح والإهانة .
- أهمية الإنفاق وإطعام الآخرين وخاصة المسكين ، لما في الطعام ما يدخل السرور على القلب، وحفظ للحياة .
- أهمية العمل على أن يحض المسلمين بعضهم بعضا على حب الخير والعمل به، وجعلها من مبادئ الحياة، وثقافة المجتمع .
- تحقيق العدالة الاجتماعية يقوم عندما يشارك الأغنياء وأصحاب الأموال أموالهم الضعفاء .
- يخلو المجتمع من الانحراف والجريمة وسوء الأخلاق، كلما ساهم المجتمع وأفراده الأقوياء على إعالة المحتاجين وتحسين ظروفهم .
- الصلاة هي الأساس الذي تقوم عليه حياة المؤمن، والتي يجب أن تؤثر في سلوكه واعتقاده نحو زيادة الإيمان والرقي .
- من يقدم مصالحه ودنياه على طاعة الله، وأولها الصلاة فذلك هو الخاسر .
- السهو المتعمد عن الصلاة وعمل الخير من أعظم الجرائم التي يرتكبها الإنسان في حق نفسه.
- ضرورة البعد عن الرياء في الأفعال والأعمال، وأن تكون خالصة لوجهه سبحانه .
- الكذب والبعد عن الطاعة الصادقة لله ستؤدي بالإنسان أن يكونا مانعا لغيره عن فعل الخير أو الحض عليه، بل وعقوبته أو اتهامه بالسوء إن قام به .
أرجوا الله أن أكون تدبرت ما يليق بكتابه وكلامه وجلاله
وإن أخطأت فأرجوا منه العفو والغفران وأن يهديني
لما فيه الخير
والحمد لله رب العالمين